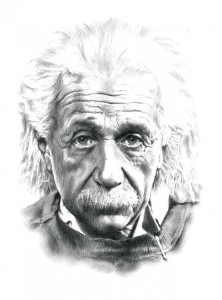 يرتقي البطل فوق منصة خاصة ويتم تسليط شعاع ضوئي على جسده فيختفي من عليها، ويظهر لحظياً في مكان آخر، ربما في قارة بعيدة أو على كوكب آخر ليكون في موقع الحدث أو هارباً من خطر محدق. هكذا في لمح البصر يصير الإنسان في المكان الذي يريده، عبر ما سمي بالانتقال الآني أو الـ «Teleportation». هذا المشهد طالما داعب أحلام محبي أدبيات الخيال العلمي، وتم تكريسه كأحد أبرز شواهد التطور المستقبلية حيث ينتصر الإنسان بالعلم على المعوقات الطبيعية التي تفرضها عليه قيود المكان والزمان.
يرتقي البطل فوق منصة خاصة ويتم تسليط شعاع ضوئي على جسده فيختفي من عليها، ويظهر لحظياً في مكان آخر، ربما في قارة بعيدة أو على كوكب آخر ليكون في موقع الحدث أو هارباً من خطر محدق. هكذا في لمح البصر يصير الإنسان في المكان الذي يريده، عبر ما سمي بالانتقال الآني أو الـ «Teleportation». هذا المشهد طالما داعب أحلام محبي أدبيات الخيال العلمي، وتم تكريسه كأحد أبرز شواهد التطور المستقبلية حيث ينتصر الإنسان بالعلم على المعوقات الطبيعية التي تفرضها عليه قيود المكان والزمان.
حسب خيال كتَّاب أفلام الخيال العلمي، ينطوي الانتقال الآني على تحديد وحفظ المعلومات الخاصة بـ «كينونة» الشخص بدقة لا متناهية.. إلى مستوى أصغر مكوّن ذري من جسده، ومن ثم نقل هذه المعلومات إلى الوجهة التي يقصدها الشخص، ليتم تفكيك وتركيب هذا المسافر آنياً، وترتيب معلومات ذراته من مادة جديدة متوافرة هناك.. حيث سيتمظهر مجدداً، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تدمير النسخة الأصلية للشخص!
لكن هل من الممكن أن يتحقق هذا الحلم بهذا الشكل حقاً؟
بداية مناقشتها علمياً
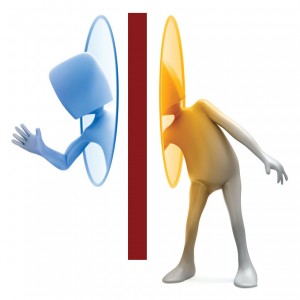 الحقيقة العلمية التي تحوم حولها فكرة الانتقال الآني هي ظاهرة فيزيائية تعرف بالـ «Quantum Entanglement» أو «التشابك الكمي». وهي ظاهرة تنبَأ بوجودها ألبرت آينشتاين مع عالمِين آخرين هما روزن وپودولسكي في سياق مجادلاتهم لدحض نظريات الفيزياء الكمية، التي تناقش حالة المادة على المستوى الذري وما دونه وتقول إن للمادة خاصية جسيمية وخاصية موجية كذلك.
الحقيقة العلمية التي تحوم حولها فكرة الانتقال الآني هي ظاهرة فيزيائية تعرف بالـ «Quantum Entanglement» أو «التشابك الكمي». وهي ظاهرة تنبَأ بوجودها ألبرت آينشتاين مع عالمِين آخرين هما روزن وپودولسكي في سياق مجادلاتهم لدحض نظريات الفيزياء الكمية، التي تناقش حالة المادة على المستوى الذري وما دونه وتقول إن للمادة خاصية جسيمية وخاصية موجية كذلك.
توقع العلماء الثلاثة في جدالهم أن النظرية الكمية ستسمح تبعاتها بالضرورة بوجود ظروف معينة يرتبط فيها جسيمان ارتباطاً وثيقاً، فوتونين مثلاً (الفوتون هو الجسيم الأولي لشعاع الضوء)، فيصبحان وكأنهما نسختان لشيء واحد: أيّ تغير يحدث لأحدهما سينعكس آنياً في اللحظة نفسها على الآخر مهما فصلت بينهما المسافات. فمثلاً عند قيامنا بقياس سرعة دوران أحد أولئك الجسيمين المشتبكين كمياً وتحديدها، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى اتخاذ الجسيم الآخر للسرعة نفسها على الفور. وهذا يعني أن معرفتنا بمعلومات عن أحدهما ستدلنا حتماً على معلومات عن الآخر.
لكن، ووفقاً لفيزياء الكم كذلك، فبحسب مبدأ اسمه مبدأ الريبة (Uncertainty) لا يمكننا تحديد مكان الفوتون وسرعته على وجه الدقة في آن واحد؛ لأن الخواص الكمية لأي جسيم لا تتخذ شكلاً محدداً إلا بعد الملاحظة، وهذا يعني بالضرورة أن خواص الفوتون الثاني لا تتشكل فعلياً إلا بعد ملاحظة الفوتون الأول، وبالتالي فإن معلومات الفوتون الأول يتم مشاركتها مع الفوتون الثاني فقط بعد الملاحظة.
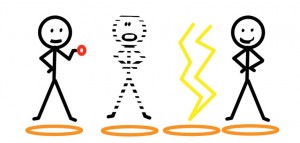 اعتقد آينشتاين بوجود ثغرة في النظرية الكمية. لأنه في حالة وجود فوتونين على مسافة كبيرة عن بعضهما البعض، فإن ذلك يعني أنهما يتشاركان المعلومات بينهما بسرعة كبيرة قد تكون في بعض الأحيان أكبر من سرعة الضوء وهو شيء يستحيل حدوثه حسب قوانين الفيزياء الكلاسيكية. وهذا ما جعله يطلق تهكماً على هذه الحالة التي اعتبرها «تخيلية» وصف «سلوك عفاريتي عابر للمسافات – Spooky Action at a Distance». ولأن الكون لا يخلو من المفاجآت، وخلافاً لما توقعه آينشتاين، فقد تم بالتجربة العملية رصد إمكانية حدوث هذا التشابك الكمي على يد الفيزيائي الفرنسي آلان آسبكت أثناء تجربته الشهيرة عام 1982م.
اعتقد آينشتاين بوجود ثغرة في النظرية الكمية. لأنه في حالة وجود فوتونين على مسافة كبيرة عن بعضهما البعض، فإن ذلك يعني أنهما يتشاركان المعلومات بينهما بسرعة كبيرة قد تكون في بعض الأحيان أكبر من سرعة الضوء وهو شيء يستحيل حدوثه حسب قوانين الفيزياء الكلاسيكية. وهذا ما جعله يطلق تهكماً على هذه الحالة التي اعتبرها «تخيلية» وصف «سلوك عفاريتي عابر للمسافات – Spooky Action at a Distance». ولأن الكون لا يخلو من المفاجآت، وخلافاً لما توقعه آينشتاين، فقد تم بالتجربة العملية رصد إمكانية حدوث هذا التشابك الكمي على يد الفيزيائي الفرنسي آلان آسبكت أثناء تجربته الشهيرة عام 1982م.
فتحت تجرية آسبكت الباب لتجارب عديدة متتالية تهدف لاختبار تطويع هذه الظاهرة لنقل المعلومات «كمومياً» بحيث يتم استغلال التشابك لنقل «معلومات» مشفرة في جسيم كميّ من مكان لآخر، كما في تجربة جامعة فيينا عام 2012م، حين تم بنجاح نقل فوتون مسافة 143 كيلومتراً. وكما كان متوقعاً فإن الفوتون الأصلي قد دُمّر فور ظهور نسخته الأخرى على الطرف الآخر للتجربة! الهدف من وراء هذه التجارب بالطبع لم يكن الوصول إلى وسيلة فائقة لنقل البشر، بل لاستحداث وسائل لنقل معلومات مشفرة لا يمكن كشفها، أو إيجاد شبكة إنترنت كميّة فائقة السرعة والأمان.
المسألة في حجم المعلومات
 وحيث إنه لا يوجد ما يعيق الفكرة نظرياً، ما الذي يمنع استخلاص معلومات الكائن الحي، حتى أصغر ذرة من الذرات المكونة لخلاياه بما تحويه من إنزيمات وتفاعلات وترتيبها الدقيق، ومن ثم إرسالها، مستغلين ظاهرة التشابك الكمي هذه، ومن ثم إعادة تركيب الكائن على الجهة الأخرى المقابلة؟
وحيث إنه لا يوجد ما يعيق الفكرة نظرياً، ما الذي يمنع استخلاص معلومات الكائن الحي، حتى أصغر ذرة من الذرات المكونة لخلاياه بما تحويه من إنزيمات وتفاعلات وترتيبها الدقيق، ومن ثم إرسالها، مستغلين ظاهرة التشابك الكمي هذه، ومن ثم إعادة تركيب الكائن على الجهة الأخرى المقابلة؟
أول المعوقات التقنية متعلق بكمية البيانات التي نحتاجها لنصِفَ كائناً إنسانياً بدقة. إذ إن متوسط عدد الذرات التي يحتويها جسم إنسان يزن 70 كيلوجراماً، هو عشرة مرفوعة إلى القوة 27. ولو قدّرنا أن كل ذرة منها تحتاج إلى مائتي بِتْ (bit) لتشفير معلوماتها الكاملة -وهذا تقدير بالغ المرونة- فإن كمية المعلومات التي لا بد من تسجيلها وإرسالها لإعادة بناء هذا الإنسان هي مائتي ألف يوتابايت (Yottabyte) -اليوتابايت الواحد يساوي تريليون تيرابايت، أو ألف تريليون جيجابايت-. وهذا الرقم المريع يمثل كمية بيانات هي أضعاف أضعاف كمية البيانات التي أنتجها الإنسان منذ بدء الحضارة إلى يومنا هذا، ولا نستطيع حالياً حتى التفكير في طريقة لتخزينها ناهيك عن إرسالها وبسرعة!
وعوائق أخرى
 لكن هناك عائقاً جوهرياً أكبر مما سبق. فمن ناحية المبدأ، لو اعتقدنا بإمكانية حصول الانتقال الآني، فإننا بذلك نكون قد سلّمنا بأن الكائن الحي ما هو إلا خليط من المواد الكيميائية التي يكفل وجودها في بيئة مناسبة بترتيب معين إيجاد الحياة واستمراريتها، وأن الوعي والذاكرة والتجارب ماهي إلا نتيجة طبيعية حتمية لهذه المواد، وهذا ما يتعارض مع ثوابت دينية. أضف إلى ذلك أن عملية تدمير النسخة الأصلية من الكائن الحي تستدعي إعادة النظر في معايير أخلاقية كذلك. فمثلاً؛ ماذا يعني أن تدمر النسخة الأصلية لكائن حي؟ هل هي إنهاء لحياته في مكان وإعادة بثها في مكان آخر؟ في بعض الروايات العلمية، فإن الانتقال الآني يتضمن فقط إيجاد نسخة جديدة من الكائن مع الإبقاء على الأصل، تماماً مثل عملية إرسال رسالة عبر الفاكسميلي. وهنا أيضاً تبرز أسئلة أخلاقية: هل النسخة الجديدة هي نسخة من إنسان متوفى؟ هل هي نسخة أصلية أم صماء محرّفة عن الأصل؟.
لكن هناك عائقاً جوهرياً أكبر مما سبق. فمن ناحية المبدأ، لو اعتقدنا بإمكانية حصول الانتقال الآني، فإننا بذلك نكون قد سلّمنا بأن الكائن الحي ما هو إلا خليط من المواد الكيميائية التي يكفل وجودها في بيئة مناسبة بترتيب معين إيجاد الحياة واستمراريتها، وأن الوعي والذاكرة والتجارب ماهي إلا نتيجة طبيعية حتمية لهذه المواد، وهذا ما يتعارض مع ثوابت دينية. أضف إلى ذلك أن عملية تدمير النسخة الأصلية من الكائن الحي تستدعي إعادة النظر في معايير أخلاقية كذلك. فمثلاً؛ ماذا يعني أن تدمر النسخة الأصلية لكائن حي؟ هل هي إنهاء لحياته في مكان وإعادة بثها في مكان آخر؟ في بعض الروايات العلمية، فإن الانتقال الآني يتضمن فقط إيجاد نسخة جديدة من الكائن مع الإبقاء على الأصل، تماماً مثل عملية إرسال رسالة عبر الفاكسميلي. وهنا أيضاً تبرز أسئلة أخلاقية: هل النسخة الجديدة هي نسخة من إنسان متوفى؟ هل هي نسخة أصلية أم صماء محرّفة عن الأصل؟.
هذه المعوقات جعلت كثيراً من العلماء يجزم بأن استخدام تقنية كهذه في نقل الكائنات الحية سيظل مقصوراً على روايات الخيال العلمي. فتمكن الإنسان من تسخير تقنية كهذه يقتضي تمكنه من كشف سر الحياة، والموت، والوعي، والمادة، والزمن، والمعنى الحقيقي لأن يكون الإنسان إنساناً، وهذا ما لن تحيط به معارفنا أبداً.

في الرياضيات، يرمز الحرف الإغريقي روه () لما يعرف بالعدد الفضي، وهو ما يدفعنا لاستحضار العدد الذهبي أو النسبة الذهبية فاي (ø) والتي قدمناها في عدد يناير-فبراير كقيمة تعبر عن معايير الجمال في أتم قياساتها كما يعتقد الرياضيون. وكنا ذكرنا أن النسبة ø بين الأبعاد موجودة في مظاهر الخلق الجميلة من حولنا في مملكتي النبات والحيوان وفي كل أمثلة التناسق التي أبدعها الفنانون والمهندسون فيما بعد مستوحين من الأمثلة الطبيعية المتقنة.
النسبة متعلقة بمقاييس الجمال كذلك، لكن الرياضيين يضعونها في مرتبة أقل من ø. لذا كانت التسمية بـ «الفضية».. لكونه يعدّ أقل مقاماً في معيار الجمال الرياضياتي من القيمة الذهبية!
بلغة الأرقام، فإن هذا الثابت يمثل القيمة العددية الناتجة عن جمع القيمتين وتساوي تقريباً 2,414. وهو كذلك يمثل الحل التقريبي للأحجية التالية:
لكن أهمية هذا الثابت لم تصنعها الأحاجي ولا الألغاز. فالدافع الذي جعل علماء الرياضيات يطرحون هذه الأسئلة ويعثرون على إجاباتها منذ قرون لم يكن محض التسلية، بل الرغبة في فهم العالم وفي إيجاد تفسير رقمي لكل الموجودات من حولهم. بما في ذلك معايير خلق وتصنيع الموجودات. ولنفهم كيف تم اعتبار النسبة الفضية أحد معايير الجمال سنذكر أن ورق الطباعة ذي القياس المعياري المعروف بـ A4 يتبع النسبة (واحد إلى الجذر التربيعي لاثنين). وإزالة أكبر مساحة مربعة من هذه الورقة سيبقينا مع مساحة مستطيلة أبعادها موافقة كذلك للنسبة الفضية. هذه التراتبية في التركيب والمسافات لها أهمية كبرى عند وضع التصاميم الهندسية والإنشائية المميزة. وهي تصاميم ترتاح لها أعيننا ومكامن النظام في إدراكنا وإن لم ندرك دقائقها العلمية والرياضية.