
الإشاعة ظاهرة اجتماعية قديمة، عمرها من عمر التواصل الاجتماعي حتى في أقدم أشكاله، ويستمر انتشارها وتأثيرها في عصر التقنية الفائقة غير عابئة بما أنجزه البشر من علم وثقافة وتقدّم. ومن بيئاتها اليومية المثلى، الأوقات التي نقضيها مع الأصدقاء والمعارف في تَسَقُّط أخبار المجتمع والناس والأحداث.
كانت الإشاعة، ولا تزال، بحاجة إلى فضاء عام يمكّن الناس من إطلاقها وتداولها. وبعدما كانت ميادين المدن والأسواق والمقاهي أبرز هذه الفضاءات، وبعدما كانت الإشاعة تنتقل ببطء نسبي لارتباطها بسرعة وسائل التواصل المتوفرة، باتت اليوم تنتقل من أقصى العالم إلى أقصاه الآخر في دقائق، بعدما حوَّلت التقنية العالم بأسره إلى مقهى واحد.
سواء أكنا سُذّجاً أم مشككين، أميين أم علماء، أطفالاً أم كباراً، فإننا جميعاً نتورَّط بالإشاعات، لما لديها من قدرة على الانزلاق من بين دفاعاتنا العقلية قبل الاستفسار عنها. فحتى المؤتمرات العلمية العالمية، مثلاً، التي يُنظر اليها على أنها من التجمعات الأكثر رقياً، لا تخلو من الإشاعات.
يقول نيغل نيكولسون، أستاذ السلوك التنظيمي في كلية لندن لإدارة الأعمال، في مقالة له في المجلة المتخصصة “سايكولوجي توداي”، إننا جميعاً، في حفلات الاستقبال الكبيرة وفي المؤتمرات العلمية “نتمتع بملذات النميمة عند الحديث عن الآخرين”.
ويضيف: “شارك في أي مؤتمر علمي، وراقب المدعوين خارج أوقات المحاضرات.
كان جنكيز خان في القرن الرابع عشر الميلادي يرسل الجواسيس إلى خلف خطوط العدو لبث إشاعات بأن أعداد جيوشه كبيرة كالجراد لا يمكن إحصاؤها. في الوقت التي كانت جيوشه فعلياً دائماً أقل بكثير من جيوش أعدائه
المكان يصير أشبه بسيرك كبير مخصص -بشكل رسمي أو غير رسمي- للإشاعة والقيل والقال. وأي مراقب من الخارج سيختبر بسهولة الشعور بالعجز والإقصاء”.
فما هي الإشاعة؟
هي خبر أو قصة متداولة حقيقتها غير مؤكدة أو مشكوك فيها. وهي تختلف عن الدردشة التي تعني اختلاط الكلام وكثرته من دون طائل. ومفردة الدردشة هي مزيج من الفارسية والتركية، دخلت إلى العربية منذ فترة غير بعيدة.
أما النميمة أو القيل والقال، فهي نقل الكلام بغرض الوقيعة بين الناس. والثرثرة، هي كثرة الكلام في مبالغة من دون جدوى. وبينما تنطوي الإشاعة على هذه الخاصيات جميعها، فهي تتعداها إلى التداول بمواضيع أخرى عديدة. فهي ترويج لخبر مختلق لا أساس له في الواقع، أو تعمُّد المبالغة أو التهويل أو التشويه

في سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة، أو إضافة معلومة كاذبة أو مشوهة لخبر صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع والحقيقة، وذلك بهدف التأثير النفسي في جماعة من الناس أو في فرد معيّن. وهناك قول منقول عن سكان أمريكا الأصليين: “أخبرني عن واقعة وسوف أصدق. أخبرني عن حقيقة وسوف أعتقـد. لكن أخبرني قصة وسوف تبقى في قلبي إلى الأبد”.
فللإشاعة والدردشة ومشتقاتها علاقة وثيقة بسرد القصص، حيث يشير كثير من الباحثين وعلماء النفس إلى أننا مفطورون على ذلك. ويؤكدون أن لهذا أهمية في الاندماج الاجتماعي وتقوية نسيجه مقابل جماعة أخرى، وهي في الوقت نفسه وسيلة أساسية للتعلم. فللأطفال نزوع لا يقاوم تجاه القصص. ومنذ القدم، يستعمل الإنسان القصص لغرس الأفكار حول ما يراه عاملاً حيوياً لاستمرار وتنمية مجتمعــه، وتجنب المخاطــر القاتلــة وترسيخ قواعد النجاح والازدهار بواسطة المنافسة مع الآخرين.
هي خبر أو قصة متداولة حقيقتها غير مؤكدة أو مشكوك فيها. وهي تختلف عن الدردشة التي تعني اختلاط الكلام وكثرته من دون طائل. ومفردة الدردشة هي مزيج من الفارسية والتركية، دخلت إلى العربية منذ فترة غير بعيدة.
أما النميمة أو القيل والقال، فهي نقل الكلام بغرض الوقيعة بين الناس. والثرثرة، هي كثرة الكلام في مبالغة من دون جدوى
صراع ما بين مستويين من المعرفة
تتصل الإشاعة بنظر بعض مفكري ما بعد الحداثة بنظرية المعرفة وعلاقتها الوثيقة بالقوة. فقد تكلّم الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو عن التعبيرات الدنيا من المعرفة أو المعرفة الشعبية أو المعرفة غير المؤهلة، وصراعها التاريخي مع المعرفة الرسمية أو الصادرة عن مواقع القوة والسلطة، (مثل الجامعة ومركز البحث والأديب المشهور ومشاهير الفن والتمثيل ووكالات الأخبار والصحف الكبيرة، وغيرها)، حيث تفوز في النهاية القوة الثانية (المؤسسات التي مُنحت سلطة نقل الخبر للرأي العام). وتُعد الأخبار المنقولة عن الجهة الأولى (التداول الشعبي)، غير رسمية، أي إشاعة. والإشاعة هنا هي تعبير عن تلك المعرفة الدنيا، التي ليس بحوزتها سوى هواجسها وأحلامها وخوفها وجهلها، والرافضة في الوقت عينه للمعلومات الرسمية.
وبشكل مبسط، أو من زاوية نظر مختلفة، فإن أحد دوافع الإشاعة هو إيجاد طريقة مبسطة لتفسير ما يجري، تساعدنا على مواجهة القلق والشكوك الناتجة عن الأحداث التي ليس لدينا أي تأثير عليها.
الإشاعة ذات البُعد العالمي
وكأي ظاهرة اجتماعية حية، فإن مفهوم الإشاعة يتطوّر مع الزمن بتطور المجتمع وثقافته وحضارته. ففي عصر آلة الطباعة، تطور مفهوم وانتشار الإشاعات بشكل نوعي. وتوسع ذلك لاحقاً مع صدور الصحف والمجلات والكتب إلى آفاق لم تكن متاحة قبل ذلك، وأصبحت الإشاعة مكتوبة، وليست فقط منطوقة. وفي العصر الرقمي الحالي، خاصة تطور أجهزة الاتصال المتنوعة، أتيح للإشاعات أن تدور حول الكرة الأرضية بسرعة تقارب سرعة الضوء، ولم تعد فقط مكتوبة بل سينمائية بالصورة والصوت. وبدأت تأخذ أبعاداً عالمية متخطية البُعد المحلي.
“لقد كان خبر وفاتي مبالغاً فيه إلى حدٍّ كبير” هكذا علّق الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين (1835-1910) على إشاعة موته

وتزدهر الإشاعة خلال الكوارث والأزمات. ويتشارك الغموض وعدم اليقين جنباً إلى جنب مع قلق الأفراد حول التأثيرات السلبية في تطوير وانتشار الإشاعات. في هذه الحالات تكون لوسائل الاتصالات ومواقع التواصل القدرة على النشر السريع لمعلومات وأخبار غير دقيقة ومضللة.
وبحسب علم الاجتماع، نملك جميعاً نزعة نقل الأخبار السلبية أكثر من الإيجابية. وفي هذا الصدد، تقول هيلين هارتون أستاذة علم النفس في جامعة أيوا الشمالية: “لدينا ميل إلى إعطاء وزن للمعلومات السلبية أكثر من الإيجابية. ولهذا مغزى تاريخي من ناحية تطورية، فمنطقياً كان علينا أن نعرف كيف نتجنب نمراً في الغابة أكثر من أن نعرف أين يوجد حقل من الزهور الجميلة. طبعاً، معظمنا لا يخاف الآن من النمور، لكننا نجزع، مثلاً، من التسريح من العمل، لذلك نرمي الإشاعات شمالاً ويميناً لمعرفة ماذا يجري”. وفي دراسة أجراها عالم النفس الأسترالي ستيفان لاندوفسكي عن سبب تفشي المعلومات الكاذبة وانتشارها في غضون ثوانٍ حول العالم، استنتج أن دماغنا يستهلك طاقة أقل للتصديق عندما يكون البيان كاذباً. “إما نحن كسولون وإما أن أدمغتنا كسولة أو كليهما. فإيجاد الحقيقة يتطلب وقتاً وجهداً، ونحن لا نملك أياً منها”.
في الشركات كما في المدارس الإشاعة تملأ الفراغ
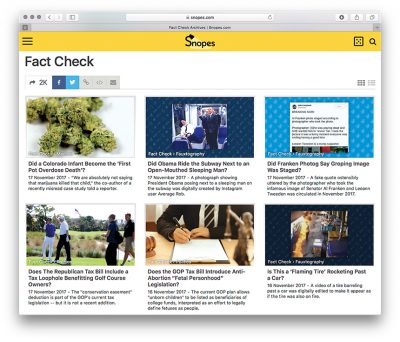
من المعلوم أن الاقتصاد السياسي قائم بطبيعته على تعاقب دورات من الازدهار والركود. في حالات الركود يلفظ السوق خارجاً الشركات والمصانع غير الفعّالة والكفوءة، وغير القادرة على الإنتاج بمستوى تكلفة السوق. فتلجأ حينذاك إدارة هذه الشركات إلى التكتم على أية أزمة وشيكة الوقوع. لكن الطبيعة تكره الفراغ. فتحل الإشاعـة والقيــل والقال مكان هذا الفراغ.
في مثال آخر عندما ينتقل الطفل من البيت إلى المدرسة، يواجه عالماً جديداً غامضاً، لم يألفه في البيت كالعواطف الجديدة وانعدام الأمن و”بلطجة” الآخرين والإشاعات الضارة والاختلافات الاجتماعية وفقدان الصداقة الوثيقة والحميمة كما مع الأم والأب والإخوة. ولا يكون هذا الطفل قد اكتسب بعد وسيلة لتقييم الحقيقة من الكذب، فيقع ضحية الإشاعة بسهولة. وفي سبيل الدفاع عن نفسه وتحسين علاقاته ينشر نفسه الإشاعة أو يختلقها.
في دراسة واسعة قامت بها جامعة جورجيا في الولايات المتحدة سنة 2014، على مئات الطلاب من مدارس الولاية حول استخدام الإشاعة في السلوك العدواني لتحطيم الآخر، من خلال تخريب علاقات وأوضاع الآخرين الاجتماعية، تبيَّن أن معظم الطلاب أو %96 منهم قد مرَّروا إشاعة تسيء إلى آخرين، كما أجاب %90 منهم أنهم كانوا ضحايا لهذا النوع من الإشاعات. وكانت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة فلوريدا سنة 2008 استنتجت أن التلامذة الصغار الذين يتعرَّضون للإشاعات الخبيثة والبلطجة فيما يتعلق بعلاقاتهم، لا تقتصر على تلقي الكدمات واحمرار العيون، بل تمتد وتتطور إلى كآبة حتى مراحل البلوغ المبكر.

الإشاعة السياسية
لتعزيز المعنويات أو لهدمها
في عالم السياسة، وخاصة خلال الحروب وفترات الاضطراب تكثر الشائعات التي يمكنها أن تؤدي وظيفة تاريخية تعجز عنها الحقائق. فقد احتل الفرس أثينا اليونانية ودمروها سنة 480 ق.م، ولم يستطع اليونانيون التغلب عليهم سوى بالخداع من خلال الإشاعات، سنة 449 ق.م. فقد كان كثير من اليونانيين يحاربون إلى جانب الفرس، وأشاع ثيمثتوكليس القائد اليوناني إلى القائد الفارسي أن هؤلاء سيتمردون عليه. فصدق القائد الفارسي هذه الإشاعة ولم يرسلهم إلى الجبهــة، وتلقى بسبب ذلك هزيمـــة ساحقــة، كانت بداية نهاية الإمبراطورية الفارسية.
وكان جنكيزخان في القرن الرابع عشر الميلادي يرسل الجواسيس إلى خلف خطوط العدو لبث إشاعات بأن أعداد جيوشه كبيرة كالجراد لا يمكن إحصاؤها. وفي الواقع، كانت جيوشه فعلياً دائماً أقل بكثير من جيوش أعدائه.
ويمكن للشائعات ذات الخلفية السياسية والوطنية أن تعمّر طويلاً، لتتحوَّل إلى حكاية شعبية.

فمن الهند التي كانت في صراع دموي مع بريطانيا من أجل الاستقلال، انطلقت قبل قرن من الزمن إشاعة تقول إن أحد المهراجات اشترى ست سيارات من ماركة “رولس رويس”، وشغّلها في كنس الشوارع، رداً عل المعاملة غير اللائقة التي واجهها في زيارته لمعرض الشركة في بريطانيا. مما اضطر الشركة إلى الاعتذار وإهدائه عدداً من السيارات كي تنقذ سمعة سياراتها الفاخرة. تمكن المدققون بسرعة من تفنيد صحة هذه الإشاعة، التي لا أساس لها من الصحة. ولكنها ظلت حية حتى يومنا هذا رمزاً لقدرة المواطن الهندي على التفوق على مستعمره القديم. وبعدما نُسب هذا الفعل الوطني في عشرينيات القرن الماضي لمهراجا ألوار، ظهرت نسخة من الإشاعة نفسها قبل سنوات قليلة تنسب الفعل نفسه لمهراجا باتيالا..!
كيف تنتشر الإشاعات؟
لإظهار كيفية انتشار الإشاعات والادعاءات غير المؤكدة وحتى الكاذبة، طور “كريغ سيلفرمان” من مركز تاو للصحافة الرقمية في جامعة كولومبيا الأمريكية برنامج “إيمرجنت” لتتبع نشر الشائعات على الإنترنت. وأظهر إيمرجنت أن الإشاعات والمعلومات المضلّلة والادعاءات غير المتحقّق منها، تطغى على أي جهد لتصحيحها وتواصل انتشارها على الرغم من إثبات عدم صدقيتها على نطاق أوسع بكثير من التصحيحات اللاحقة. وأعطى مثلاً على ذلك وهي إشاعة استيلاء مسلحين على 11 طائرة تجارية في مطار طرابلس سنة 2014. فقد تم تشارك الإشاعة 140,000 مرة على الرغم من تصنيف الخبر بالكاذب من موقع “سنوبس” المحترم والمتخصص بالتحقق من الشائعات. أما هذا التصنيف الكاذب، فقد حاز 735 مشاركة فقط.
انطلقت قبل قرن من الزمن إشاعة تقول إن أحد المهراجات اشترى ست سيارات من ماركة “رولس رويس”، وشغّلها في كنس الشوارع، ردا على المعاملة غير اللائقة التي واجهها في زيارته لمعرض الشركة في بريطانيا
ومن المفيد الإشارة أنه بعد عصر الإنترنت ومواقع التواصل الرقمية، بدأت الدراسات العلمية تأخذ منحى لا يعتمد كلياً على المفاهيم السابقة. إذ توفرت للباحثين أدوات عديدة توصلهم إلى جمع المعلومات وتحليلها، وهي حيوية جداً لأي باحث، ولم تكن متوفرة سابقاً. ولهذا السبب بالذات، كانت الدراسات حول الإشاعة قبل الإنترنت محدودة جداً. كما أن النظرة التقليدية للإشاعة تقوم على اعتبار أنها عمل سلبي بالمطلق. أما النظرة المعاصرة فتتفهم طبيعة الإشاعة كفعل يكاد في بعض أوجهه أن يكون لا إرادياً.

ففي سنة 1902 حاول العالم الألماني ويلهيلم ستيرن، الذي وضع فكرة “أي كيو” لقياس الذكاء، تصميم اختبار يهدف إلى “تشريح” سيكولوجية الإشاعة. فوضع سلسلة من الأشخاص المتطوعين الواحد جنب الآخر، وكان على كل متطوع أن يسرد قصة للشخص بقربه الذي بدوره يسردها للآخر. وكان سهلاً على ستيرن أن يلاحظ كيف كانت التفاصيل، وحتى محتوى القصة يتغيّر مع الابتعاد عن المصدر الأول. وفي سنة 1947 نشر غوردن ألبورت وليو بوستمان كتابهما تحت عنوان “سيكولوجية الإشاعة”، وأجريا اختباراً يعرض خلاله صورة للحرب على شخص ما، والطلب إليه أن يتذكر أكثر ما يمكن من تفاصيلها، ثم وصف ما يتذكر إلى شخص آخر وهكذا دواليك. ولاحظ الباحثان أنه كلما ابتعدت القصة عن نقطة الصفر أو البداية، تغيرت وفق ثلاثة مسارات متتالية:
– الهدم، أي محو بعض التفاصيل وإسقاطها من القصة.
– التشذيب، أي تسليط الضوء على تفاصيل أو مواقف أخرى حقيقية أو متخيّلة.
– الاستيعاب، أي تشويه حقائق معيَّنة في القصة بناءً على لاوعي الشخص.
أقوى من حكمة سقراط
فما العمل في مواجهة الإشاعة؟

هناك قصة شهيرة عن “المصفاة الثلاثية” للأخبار التي كان يعتمدها سقراط. ومفادها أنه في أحد الأيام صادف الفيلسوف اليوناني سقراط أحد معارفه مهرولاً نحوه قائلاً بتلهف: “سقراط هل تعلم ماذا سمعت عن أحد طلابك؟”.
أجابه سقراط: “انتظر لحظة، قبل أن تخبرني أود منك أن تجتاز امتحاناً صغيراً يدعى امتحان “المصفاة الثلاثية”. والمصفاة الأولى هي الصدق، هل أنت متأكد أن ما ستخبرني به صحيح؟”.
“لا” رد الرجل “في الواقع سمعت الخبر و…”
قال سقراط ” حسناً، لنجرب المصفاة الثانية، الطيبة. هل ما ستخبرني به عن طالبي شيء طيب؟”.
-“لا، على العكس…” قال الرجل.
%96 من الطلاب
في ولاية جورجيا الأمريكية مرَّروا إشاعات تسيء إلى الآخرين
فتابع سقراط: “ما زال بإمكانك أن تنجح في الامتحان، فهناك مصفاة ثالثة، الفائدة. هل ما ستخبرني به عن طالبي يفيدني؟”.
-“في الواقع، لا”.
فختم الفيلسوف الحديث بقوله: “إذا كنت ستخبرني شيئاً ليس صحيحاً ولا طيباً ولا فائدة منه، فلماذا تخبرني به من البداية؟”.
كان ذلك قبل نحو خمسة وعشرين قرناً. ومع ذلك لا تزال الحكمة في مواجهة مع الإشاعة، ولا تزال بعيدة جداً عن التغلب عليها.




اترك تعليقاً