 لا حصر للقصص والأفلام التي حلّت مشكلة الترحال الطويل عبر الفضاء بواسطة النوم. نوم طويل يمتد لسنوات.. ربما عقود.. يستيقظ البطل بعده مرهقاً بعض الشيء ومشوش الفكر، لكنه سرعان ما يعاود تنفيذ المهمة المصيرية التي عهد المخرج إليه بها والتي ستكون -غالباً- في صالح الأجيال التي وثقت به وربما لم تعد حيّة لأنها خضعت لسلطان الزمن الطبيعي، ولم تحظ بنعمة الغفوة الطويلة التي تمت هندسة يقظتها بكل دقة. في قصص أخرى، يخضع البطل للتجميد، فكأنه دجاجة محفوظة في الثلاجة، لتتم إعادة تسخينه بعد أجيال فيعود للحياة الطبيعية مخاتلاً ساعته البيولوجية.
لا حصر للقصص والأفلام التي حلّت مشكلة الترحال الطويل عبر الفضاء بواسطة النوم. نوم طويل يمتد لسنوات.. ربما عقود.. يستيقظ البطل بعده مرهقاً بعض الشيء ومشوش الفكر، لكنه سرعان ما يعاود تنفيذ المهمة المصيرية التي عهد المخرج إليه بها والتي ستكون -غالباً- في صالح الأجيال التي وثقت به وربما لم تعد حيّة لأنها خضعت لسلطان الزمن الطبيعي، ولم تحظ بنعمة الغفوة الطويلة التي تمت هندسة يقظتها بكل دقة. في قصص أخرى، يخضع البطل للتجميد، فكأنه دجاجة محفوظة في الثلاجة، لتتم إعادة تسخينه بعد أجيال فيعود للحياة الطبيعية مخاتلاً ساعته البيولوجية.
هل هذه القصص محض خيالٍ؟ أم أن لها أساساً علمياً؟ وهل هي ممكنة الحدوث في المستقبل المنظور أو البعيد بفضل التقدم التقني؟
فلنركز على جزئية التجميد، وهي عملية لها أساس علمي فعلاً ويعبّر عنها بالمصطلح Cryonics التي تعني أصولها اللاتينية «بارد كالثلج»، ويراد به عملية حفظ الأجسام الحية عبر خفض درجة حرارتها تدريجياً إلى مستويات متدنية جداً بحيث لا يموت النسيج الحي، وبحيث تعاد هذه الأجساد لليقظة بعمليةٍ عكسيةٍ بعد فتراتٍ متطاولةٍ من الزمن.
هذه الفكرة تبدو جذَّابة جداً لعدة فئات من الناس. هناك بطبيعة الحال المصابون بأمراضٍ لا برء منها.. أو لم يكتشف العلم –بعد- علاجات لها. المصابون بهذه الأمراض يرغبون في التأكيد بأن يتم تجميدهم، بما يقتضيه ذلك من تعطيلٍ للوظائف الحيوية لأجسامهم، وتعطيل لأمراضهم بالتبعية، إلى الحين الذي يتم فيه اكتشاف علاجات لأمراضهم المزمنة فيتم إيقاظهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية.. إن صحت هذه التسمية!
جديرٌ بالذكر أن هذه الفكرة تحديداً قد دُفع بها لمقدمة الأخبار في الولايات المتحدة عام 2013 بفضل فتاة اسمها كيم سوازي، التي تم تشخيصها بسرطان الدماغ القاتل وهي بعد في الثالثة والعشرين. قامت كيم بجمع ما يكفي من أموال المتبرعين لتجميد جسمها ما إن يتم تشخيص موتها إكلينيكاً.. وسيقرر لنا المستقبل ما إذا كانت فكرتها هذه موفقة أم لا.
يتم تبريد جسمك على سريرٍ من الثلج الجاف حتى يصل إلى درجة 130 مئوية تحت الصفر، والخطوة التالية تتضمَّن إدخال جسمك في وعاءٍ يوضع بعد ذلك في خزان معدني كبير
 الفريق الآخر من المتحمسين لفكرة التجميد هم محبُّو الحياة الأصحاء، من الأثرياء والمفكرين المهووسين بفرضية الخلود. ومع الإقرار بأن الخلود مستحيل، إلا أن تمديد الحياة عبر التجميد المستمر الذي تتخلله فترات يقظة تبدو قريبة بما يكفي لمفهوم الخلود. المدهش أن هناك منشآت تجارية تقدِّم هذه الخدمة حول العالم.. وقد تعمدنا ألَّا نصف هذه المنشآت بالعلمية نظراً لوجود تساؤلات كبرى معلَّقة بخصوص هذه الممارسة فضلاً عن أنها لم يتم إثبات نجاحها للآن. لكن، إذا قررت أن تجمد نفسك طوعاً فعليك أولاً أن تدفع مبلغاً يوازي 150 ألف دولارٍ هي رسوم العملية، فضلاً عن إيجار شهري قدره 400 دولار لخزان التجميد الخاص بك. وحين يتوقف قلبك عن النبض وتُعلن ميتاً قانونياً وإكلينيكياً، فسيتدخل فريق التجميد فوراً ليزود دماغك بالأكسجين والدم. سيُغمر جسدك في الثلج ويحقن بمادة الهيبارين لمنع دمك من التخثر. ثم ستتم إزالة المياه من الخلايا لتستبدل بخليط كيميائي قائم على الجلسرين يسمى cryoprotectant والهدف من ذلك هو حماية الأعضاء والأنسجة من تشكل بلورات الجليد في درجات حرارة منخفضة للغاية. بهذه العملية، سيتم تبريد جسمك على سرير من الثلج الجاف حتى يصل إلى درجة 130 مئوية تحت الصفر، والخطوة التالية تتضمن إدخال جسمك في وعاءٍ يوضع بعد ذلك في خزان معدني كبير مملوء بالنيتروجين السائل تبلغ حرارته 196 درجةٍ مئويَّةٍ تحت الصفر. يتم تخزين جسمك مقلوباً بحيث يكون الرأس إلى الأسفل، تحسباً لأي حادث تسرب في الخزَّان، ولضمان بقاء دماغك مغموراً في سائل التجميد.
الفريق الآخر من المتحمسين لفكرة التجميد هم محبُّو الحياة الأصحاء، من الأثرياء والمفكرين المهووسين بفرضية الخلود. ومع الإقرار بأن الخلود مستحيل، إلا أن تمديد الحياة عبر التجميد المستمر الذي تتخلله فترات يقظة تبدو قريبة بما يكفي لمفهوم الخلود. المدهش أن هناك منشآت تجارية تقدِّم هذه الخدمة حول العالم.. وقد تعمدنا ألَّا نصف هذه المنشآت بالعلمية نظراً لوجود تساؤلات كبرى معلَّقة بخصوص هذه الممارسة فضلاً عن أنها لم يتم إثبات نجاحها للآن. لكن، إذا قررت أن تجمد نفسك طوعاً فعليك أولاً أن تدفع مبلغاً يوازي 150 ألف دولارٍ هي رسوم العملية، فضلاً عن إيجار شهري قدره 400 دولار لخزان التجميد الخاص بك. وحين يتوقف قلبك عن النبض وتُعلن ميتاً قانونياً وإكلينيكياً، فسيتدخل فريق التجميد فوراً ليزود دماغك بالأكسجين والدم. سيُغمر جسدك في الثلج ويحقن بمادة الهيبارين لمنع دمك من التخثر. ثم ستتم إزالة المياه من الخلايا لتستبدل بخليط كيميائي قائم على الجلسرين يسمى cryoprotectant والهدف من ذلك هو حماية الأعضاء والأنسجة من تشكل بلورات الجليد في درجات حرارة منخفضة للغاية. بهذه العملية، سيتم تبريد جسمك على سرير من الثلج الجاف حتى يصل إلى درجة 130 مئوية تحت الصفر، والخطوة التالية تتضمن إدخال جسمك في وعاءٍ يوضع بعد ذلك في خزان معدني كبير مملوء بالنيتروجين السائل تبلغ حرارته 196 درجةٍ مئويَّةٍ تحت الصفر. يتم تخزين جسمك مقلوباً بحيث يكون الرأس إلى الأسفل، تحسباً لأي حادث تسرب في الخزَّان، ولضمان بقاء دماغك مغموراً في سائل التجميد.
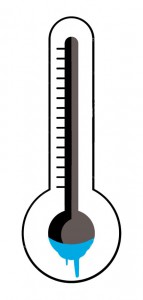 هذا البروتوكول المقنع تعترضه عدة عقباتٍ تقنيةٍ وأخلاقيةٍ. أولها أن الإنعاش القلبي عقب التجميد الطويل غير مؤكد ولا مضمون العواقب. كما أن تكوُّن البلورات الدقيقة المتجمدة بين الخلايا، بالرغم من كل الاحتياطات الواردة سلفاً، يظل قائماً. تلك البلورات الثلجية من شأنها أن تحدث تلفاً حقيقياً بالخلايا لا يفيد معه الإيقاظ. لكن المناصرين للتجميد يزعمون بأن العلم سيتقدم – بالتبعيَّة – ليجد حلولاً لهذه الإشكالات مع حلول أوان الإيقاظ الموعود.
هذا البروتوكول المقنع تعترضه عدة عقباتٍ تقنيةٍ وأخلاقيةٍ. أولها أن الإنعاش القلبي عقب التجميد الطويل غير مؤكد ولا مضمون العواقب. كما أن تكوُّن البلورات الدقيقة المتجمدة بين الخلايا، بالرغم من كل الاحتياطات الواردة سلفاً، يظل قائماً. تلك البلورات الثلجية من شأنها أن تحدث تلفاً حقيقياً بالخلايا لا يفيد معه الإيقاظ. لكن المناصرين للتجميد يزعمون بأن العلم سيتقدم – بالتبعيَّة – ليجد حلولاً لهذه الإشكالات مع حلول أوان الإيقاظ الموعود.
على صعيد آخر، فإن التجميد لفتراتٍ طويلةٍ له تأثيراتٌ غير معلومة على وظائف الدماغ نفسه، وعلى قدرته على التذكر والاسترجاع. وهي كلها محاور بحث غير مثبتة إذ لم يتم إيقاظ أحدٍ بعد من نومة التجميد الطويلة.
يجادل البعض بأن الاستيقاظ بعد مئة عامٍ من الآن – لو أمكن- فسيأخذ بأحدنا لعالم مختلف لا نعرف فيه أحداً ولا ننتمي إليه بأي شكلٍ بحيث تصبح معايشة الواقع الجديد كابوسية. كما أن الافتراض بأن ظروف الحياة ستتحسن في المستقبل بحيث تستحق أن تعاش هو من نوع المقامرة في المستقبل. أما الاتكال على منظومة الرقابة والصيانة التي تشغلها شركة تجميد ما لقاء مبلغ مالي، في عملية ممتدة عبر أجيال إلى حين لحظة اليقظة، فلا تبدو واعدة جداً، وإن كان الأمر مستحقاً للمخاطرة، وفقاً للعشرات الذين خاضوا غمار التجربة حتى اليوم.
الرمز غاما

الرمز غاما (γ) هو الحرف الثالث في الأبجدية الإغريقية، ولهذا الرمز استعمالات عدة في مجالات العلوم، لعل أولها وأكثرها ارتباطاً بالثقافة الشعبية اسم (جزيئات غاما) في مجال الفيزياء النووية. ويعرف متابعو القصص الخيالية أن تعرض الدكتور (بروس بانر) لجرعة من إشعاع جزيئات غاما قد غيّر من تركيب خلاياه وأكسبه القدرة على التحوُّل إلى مسخٍ أخضرٍ مريعٍ هو (الرجل الأخضر)! أما في الواقع فإن هذه الجزيئات تنتج عن التفاعلات الذرية التي تحصل في الفضاء من حولنا، وهي ذات نفاذية عالية وتأثير مدمر على النسيج الحي ولا يصدّها عنا إلا الغلاف الجوي لكوكبنا الأرض.
أما في الفيزياء، فترمز غاما لجزيء الضوء (الفوتون) الذي تنتقل جسيمات غاما الواردة أعلاه بسرعته القصوى نفسها. كما يعتمد علماء الفيزياء النسبية الرمز غاما للتعبير عما يُعرف بـ «معامل لورنتس» – نسبة إلى العالم الهولندي هندريك أنتون لورنتس – ويمثل هذا المعامل كمية يستعملها الفيزيائيون في حسابات النظرية النسبية الخاصة وتحديداً في حسابات تقلص الأطوال وتباطؤ الزمن.
وثمة علم آخر متعلق بـ «نظرية المخططات» مهتم بحل نوعية ظريفة من المسائل، منها ما يعرف بـ «مسألة تلوين المخطط». فإذا تخيلنا مخططاً – أو خريطة – مكوَّنة من عدد من القطع المتجاورة، فعلينا أن نلون هذه الخريطة بحرص بحيث لا تتشارك أي قطعتين متجاورتين -أو دولتين جارتين على الخريطة- باللون نفسه. وهذا مهم جداً للتمييز بين أجزاء الخريطة ولتفادي سوء الفهم السياسي كذلك. وهي مسألة رياضية لها تطبيقات في علم الكمبيوتر أيضاً، وحلها المتمثل في العدد الأدنى من الألوان الذي سنحتاجه لتلوين الخريطة، يعرف بـ (عدد التلوين)، ويُرمز له أيضاً بالرمز غاما.