 ما الذي يجعلنا ندفع مبلغاً زائداً، دون أن نحصل مقابل ذلك على أي خدمة إضافية؟ ولماذا نشعر دوماً بالحرج، ونتحاشى أن تلتقي عيوننا بعيون من نقدِّم له هذاالمال؟هل نسهم بهذا التقليد في النيل من كبرياء شخص آخر وعزة نفسه، وفي مساعدة أصحاب العمل على استغلال العاملين لديهم؟ هل نقبل أن يقدِّم لنا شخص مهما علت مكانته مبلغاً من المال دون مقابل؟
ما الذي يجعلنا ندفع مبلغاً زائداً، دون أن نحصل مقابل ذلك على أي خدمة إضافية؟ ولماذا نشعر دوماً بالحرج، ونتحاشى أن تلتقي عيوننا بعيون من نقدِّم له هذاالمال؟هل نسهم بهذا التقليد في النيل من كبرياء شخص آخر وعزة نفسه، وفي مساعدة أصحاب العمل على استغلال العاملين لديهم؟ هل نقبل أن يقدِّم لنا شخص مهما علت مكانته مبلغاً من المال دون مقابل؟
البقشيش في الماضي والحاضر
قبل البحث في كهوف التاريخ عن بدايات الإكرامية، تجدر الإشارة إلى أننا لا نتكلم عن قضية هامشية، فيكفي أن نعلم أن ما تحصل عليه المطاعم وحدها في الولايات المتحدة الأمريكية من البقشيش يبلغ سنوياً 21 مليار دولار، أي ما يعادل 78,7 مليار ريال سعودي، وأن الإكرامية تمثِّل نسبة لا يستهان بها في ميزانيات الدول التي تعيش على السياحة. لقد كانت الإكرامية سبباً في اندلاع مظاهرات، ورفع قضايا لا حصر لها أمام المحاكم، والإدانة بالسجن، وكانت موضوعاً لعديد من رسائل الدكتوراة، التي تناولتها من الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية. والأهم من كل ذلك أن كثيراً من أنظمة الحكم الرأسمالية والشيوعية، الديمقراطية والاستبدادية حاربت الإكرامية. ولكن التاريخ يثبت أن كل الأنظمة تزول، وتبقى الإكرامية على مر العصور، وأنها نجحت في التغلغل في جميع أرجاء الأرض، ولم تقف أمامها حواجز ثقافية أو دينية.
لم يرد في كتب التاريخ اسم أول من دفع الإكرامية، ولا أسباب قيامه بذلك السلوك الغريب على طباع الإنسان. لكن بعض المراجع تؤكد وجود هذا السلوك في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان أصحاب الوظائف الرسمية، يحصلون على مبالغ إضافية تقديراً لعملهم، كما كان هناك تقليد متبع في أوروبا في العصور الوسطى، وهو أن كل من يأتي ببشارة وأخبار سعيدة، يحصل على إكرامية.
في العصور الوسطى أيضاً كانت هناك حاجة لالتقاء التجار من مختلف الدول والممالك الأوروبية. فكانوا يجتمعون في مكان واحد، وظهرت الحاجة إلى ما يشبه الفنادق، حتى يقيم فيها الغرباء، وفي هذه الفنادق البدائية التي تشبه الخانات الشرقية إلى حدٍّ ما، كان النزيل الذي يدفع مبلغاً زائداً عن الأجرة، ينال مكاناً أكثر راحة من غيره.
وفي بريطانيا تعود جذور الإكرامية إلى القرن السادس عشر، وانتشرت عادة لا علاقة لها بالفنادق أو المطاعم، بل كانت مرتبطة بالدعوات الخاصة في المنازل. فحينما يقوم أحد النبلاء بدعوة ضيوفه لتناول الطعام عنده، فإنهم لم يكونوا يغادرون بيته، إلا بعد أن يقدِّموا الإكراميات للخدم، الذين كانوا يصطفون في انتظارها بعد الدعوة.
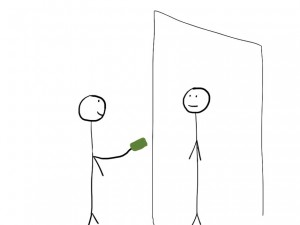 وبعد أن ترسخت هذه العادة، وأصبحت تقليداً متبعاً، بدأ صاحب الدعوة يخفِّض من رواتب الخدم، الذين كانوا يحصلون على الإكراميات بسخاء. بل إن بعض النبلاء لم يجد حرجاً في اقتسام الإكراميات مع الخدم، وفي المقابل أصبح الضيوف يحسبون ألف حساب لهذه التكاليف الباهظة المرتبطة بقبول الدعوة. لذلك جاءت مبادرة من النبلاء في عام 1760م تدعو لوقف الإكراميات، واستمرت المحاولات لسنوات، حتى بدأ هذا التقليد في التراجع، فإذا بالخدم يقومون باضطرابات ومظاهرات في العاصمة البريطانية في عام 1764م، ويعلنون رفضهم تماماً للتخلي عن الإكراميات، التي اعتادوا عليها، وأصبحت مصدراً رئيساً لدخلهم.
وبعد أن ترسخت هذه العادة، وأصبحت تقليداً متبعاً، بدأ صاحب الدعوة يخفِّض من رواتب الخدم، الذين كانوا يحصلون على الإكراميات بسخاء. بل إن بعض النبلاء لم يجد حرجاً في اقتسام الإكراميات مع الخدم، وفي المقابل أصبح الضيوف يحسبون ألف حساب لهذه التكاليف الباهظة المرتبطة بقبول الدعوة. لذلك جاءت مبادرة من النبلاء في عام 1760م تدعو لوقف الإكراميات، واستمرت المحاولات لسنوات، حتى بدأ هذا التقليد في التراجع، فإذا بالخدم يقومون باضطرابات ومظاهرات في العاصمة البريطانية في عام 1764م، ويعلنون رفضهم تماماً للتخلي عن الإكراميات، التي اعتادوا عليها، وأصبحت مصدراً رئيساً لدخلهم.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فكانت الإكرامية غير معروفة على الإطلاق، حتى عام 1840م، وفي مصادر أخرى حتى الحرب الأهلية في الفترة من 1861 حتى 1865م، لأن المجتمع كان منقسماً بوضوح إلى سادة وعبيد، وكان الاعتقاد سائداً بأن السادة لا يقبلون الإكرامية، والعبيد لا مبرر لمنحهم شيئاً إضافياً. لكن موجة الهجرة من أوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية هناك، أتاحت للمهاجرين أن ينقلوا معهم هذه العادة إلى الأراضي الأمريكية.
وبعد تحرر العبيد، وجد كثير من السود في المقاهي والمطاعم فرصة ذهبية للعمل الذي لا يتطلب مؤهلات أو خبرات سابقة، وكانوا معتادين على معاملة البيض باعتبارهم طبقة أرقى منهم، وكانوا يقبلون الإكرامية بصدر رحب. لكن بعض الطلاب البيض دخلوا هذا المجال أيضاً، وكانوا يحصلون على إكراميات أعلى من زملائهم السود.
وتناولت وسائل الإعلام الأمريكية في مطلع القرن العشرين هذه الظاهرة بكثير من النقد. وحارب بعض الكتَّاب في صحيفة (نيويورك تايمز) في عام 1908م، قبول الشباب البيض الإكرامية، معتبرين أن «الرجل الحر الذي يملك حق الانتخاب، لا يليق به أن يعمل خادماً».
وأصدرت ولايات أمريكية عديدة في عام 1909م قوانين تمنع الإكرامية، وفرضت بعضها عقوبة على من يدفعها ومن يقبلها. لكن غالبية الولايات قصرت العقوبة على من يقبلها، لأنهم كانوا غالباً من السود، وعدم محاسبة من يدفعها، وغالبهم من البيض. وكانت العقوبة لا تقتصر على الغرامة بل تشمل الحبس أيضاً. إلا أن الحكم الصادر على نادل في أحد المطاعم بالسجن، بعد قبوله إكرامية بقيمة 15 سنتاً، ثم استئنافه أمام المحكمة العليا التي ألغت العقوبة، وقضت بعدم دستورية هذه القوانين، أدى إلى إلغاء القوانين في الولايات الواحدة تلو الأخرى. ثم تأسست جمعية محاربة الإكرامية في عام 1916م، وأعلن مرشح رئاسي عزمه على إلغاء هذا «السلوك الأعوج»، ولكن كل هذه الجهود والمحاولات ذهبت سدى. ومرت الأيام وانعكست الأحوال وأصبح الأوروبيون يتهمون الأمريكيين بأنهم هم الذين أفسدوا مواطني الدول التي دخلوها، لأنهم يغدقون الإكراميات بغير حساب.
فقد صدرت تعليمات للجنود الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945م، بمنع تقديم الإكراميات لمواطني الدول التي بقيت فيها القوات الأمريكية. فلجأ الجنود إلى حيلة لتفادي هذه التعليمات، وهي تقديم الهدايا العينية، مثل السجائر والشوكولاتة، خاصة وأن البلاد التي تعرضت للدمار والهزيمة لم يكن فيها ما يمكن شراؤه بالمال. فصدرت تعليمات جديدة في عام 1946م، تمنع الجنود من تقديم الهدايا، لكن اشتراك الجميع في مخالفة التعليمات، حال دون محاسبة أحد.
وفي فرنسا كان بديهياً أن يحصل القضاة على عطايا من الأطراف المتنازعة، وكانت الإكرامية في البداية عبارة عن هدايا قيِّمة من المستعمرات الفرنسية، وأهمها التوابل، ثم أصبحت مبالغ نقدية. ولم يكن القضاة يجدون أي حرج في تقبل هذه الإكراميات، التي من المفترض أنها لم تكن تؤثر على أحكامهم، بل كانوا يعتبرونها تقديراً لجهودهم. لكن الثورة الفرنسية فرضت في قانون العقوبات الصادر في عام 1810م، منع ذلك بصورة صارمة، ورفعت رواتب القضاة وغيرهم من موظفي الدولة.
في كل من ألمانيا وإسبانيا واللغات الإسكندنافية، كانت تسمية الإكرامية مرتبطة بالشرب، فيقال في الألمانية مثلاً (Trinkgeld) أي نقود الشرب. فبعد أن ينتهي العمل، كان العامل ينفق هذه الإكرامية أو على الأقل جزءاً منها فعلاً على من يقدِّم له المشروب. وفي اللغة الإيطالية كان مصطلح «اليد الخيِّرة» مرادفاً للإكرامية.
وشهدت الصين، التي لم تكن تعرف الإكرامية أبداً، إقبال السياح الغربيين ورجال الأعمال في فترة الانفتاح النسبي منذ عام 1977م، وحملوا معهم عادة الإكرامية، فصدرت قوانين تمنع ذلك. ثم عادت الإكرامية تدريجاً من جديد في الثمانينيات والتسعينيات. إلا أن عودة هونج كونج إلى أحضان الصين، في عام 1997م، واختلاط مواطني هونج كونج الذين عاشوا طويلاً في ظل نظام بريطاني، جعلت الإكرامية شيئاً بديهياً، وتفشت هذه الظاهرة، ولم تعد مقتصرة على السياح الغربيين.
وتكرر هذا الأمر في اليابان وأستراليا وغيرها من الدول التي كانت بعيدة كل البعد عن هذا التقليد، ولكن يبدو أن انتشار السياحة الغربية في العالم، نقل معه أنماطاً معيشية وسلوكيات غريبة عن البلدان المضيفة. وإذا رفضت هذه الدول الانصياع لاحتياجات هؤلاء السياح، فإنهم يرفضون الحضور، أو على الأقل لا يأتون بأعداد هائلة، وكأن الإكراميات لم تعد مقصورة على العمال فقط، بل تتقبلها الدول، التي تفعل من أجل ذلك ما يريد السائحون.
الإكرامية والسياحة
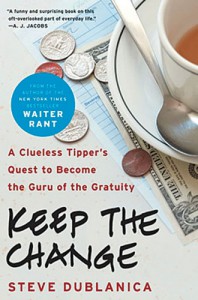 وبغض النظر عن البدايات المحدودة للسياحة في أواسط القرن السابع عشر، التي اقتصرت على الأثرياء، -كما ورد في ملف القافلة في عدد سبتمبر/أكتوبر 2014م-، فإن القرن التاسع عشر شهد توسعاً في هذا النشاط باستخدام القطارات والسفن، وأصبحت هناك حاجة لكثير من الأيادي العاملة، فوجدت النساء خاصة، والشباب غير المؤهلين فرصتهم في دخول سوق العمل. لم يكن أصحاب الفنادق والمطاعم على استعداد لدفع رواتب مجزية لكل هذا العدد الهائل من العمال، فكانت الإكرامية هي الحل. وكان السياح القادمون من دول أخرى على استعداد لدفع الإكراميات، لإظهار مكانتهم الاجتماعية، وحتى يتجنبوا المواقف المحرجة، ولا يبدون كمن لا يفهم آداب اللياقة.
وبغض النظر عن البدايات المحدودة للسياحة في أواسط القرن السابع عشر، التي اقتصرت على الأثرياء، -كما ورد في ملف القافلة في عدد سبتمبر/أكتوبر 2014م-، فإن القرن التاسع عشر شهد توسعاً في هذا النشاط باستخدام القطارات والسفن، وأصبحت هناك حاجة لكثير من الأيادي العاملة، فوجدت النساء خاصة، والشباب غير المؤهلين فرصتهم في دخول سوق العمل. لم يكن أصحاب الفنادق والمطاعم على استعداد لدفع رواتب مجزية لكل هذا العدد الهائل من العمال، فكانت الإكرامية هي الحل. وكان السياح القادمون من دول أخرى على استعداد لدفع الإكراميات، لإظهار مكانتهم الاجتماعية، وحتى يتجنبوا المواقف المحرجة، ولا يبدون كمن لا يفهم آداب اللياقة.
اعتاد العمال على الإكرامية، ولم يعد الأمر يقتصر على النادل في المطعم، والعاملة التي تقوم بترتيب الغرفة، والفتى الذي يحمل الحقائب، وسائق سيارة الأجرة، والمرشد السياحي في المدينة. بل أصبح الكل ينتظر الإكرامية، حتى صاحب المطعم، الذي اكتشف أن النادل يكسب أكثر منه، وصاحب الفندق أيضاً، وموظف الاستقبال، وعامل المصعد، وبوَّاب الفندق، وشرطي الجوازات، علاوة على جموع المتسولين الذين يحيطون بالفندق وأماكن وجود السياح.
بدأ الصراع في أوروبا بين المؤيدين والمعارضين للإكرامية، وصدرت قوانين تمنعها في عديد من العواصم، مثل إيطاليا في عام 1920م، وإسبانيا في عام 1928م، وقررت فنادق في دول أخرى رفع رواتب الموظفين، وإضافة رسوم خدمة على الفاتورة، بهدف إلغاء الإكرامية، وفي المقابل بدأت اتحادات لعمال الفنادق والمطاعم تتكون على مستوى الدول، ثم على مستوى أوروبا، تعارض وقف الإكراميات. وفي عام 1921م شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرات حاشدة لرافضي وقف الإكرامية، وأخرى لمؤيديها. وظهرت خلافات حادة داخل كل معسكر، إذ كان هناك بين العمال من يؤيد رفع الرواتب، بدلاً من الإكرامية، وآخرون يرفضون تقسيم الإكرامية على الجميع، ويصرون على أن يحتفظ كل نادل أو نادلة بما يأخذه من الزبون، وكان بين ضيوف الفنادق وزبائن المطاعم من يؤيد الإكرامية وآخر من يعارضها.
جرب فندق «شفايتسر هوف» السويسري العريق في مدينة لوزان، منع الإكرامية تماماً، ووضع لافتة في كل غرفة، تحمل عبارة: «يحصل موظفونا على رواتب مجزية، ولذلك فإنه محظور عليهم قبول الإكرامية». وأضاف رسوم خدمة على أجرة الغرفة. فإذا بالنزلاء يصرون على دفع الإكرامية، باعتبار أن من يدفع الآن فهو غير واقع تحت ضغوط التقاليد، بل يفعلها بناءً على رغبته، وزادت الإكراميات عن ذي قبل. وكانت تسعة فنادق سويسرية قد قررت في عام 1877م فصل العامل الذي يقبل الإكرامية. فاعترض النزلاء بشدة، وقالوا إنه ليس من حق الفندق أن يفرض عليهم سلوكاً ما، وكانوا يجبرون العمال على قبول الإكرامية، حتى لو أدى ذلك لفقدان العامل لوظيفته.
في المقابل روى أحد الأثرياء في مطلع القرن العشرين أنه نزل ضيفاً على فندق في موسكو، وحينما هَمَّ بمغادرة الفندق، وجد صاحب الفندق في وداعه، وخلفه عشرين موظفاً وموظفة، كلهم ينتظرون الإكرامية، مع أنه لم يرَ غالبيتهم من قبل. وحينما أبدى رفضه لهذا الاستغلال، بقيت حقائبه في مكانها، ورفض الجميع مساعدته في حملها إلى السيارة التي تنتظره.
وفي أسكتلندا ذهب أحد الأثرياء لممارسة رياضة الصيد، وحظى بخدمة متميزة من مرافقه الأسكتلندي، فوضع في يده مبلغاً من المال كإكرامية. لكن المرافق اعترض على عدم قبوله مثل هذا المبلغ، وطالبه بأضعافه، فرفض الثري ذلك، معتبراً أن الأصل في الإكرامية أنها اختيارية، ومنذ هذه اللحظة لم يجد أي طائر أو حيوان يصطاده، لأن المرافق عمل على تنبيه الحيوانات والطيور، قبل وصولها إلى أعين الضيف.
وقد انتشرت في أوروبا شائعات عن عمال الفنادق، الذين إذا لم يحصلوا على إكرامية سخية، فإنهم يضعون علامة على الحقائب، يعرفها عمال الفنادق في العالم كله، فما يكاد النزلاء يصلون إلى أي فندق في أقصى الأرض، إلا واستقبلهم الموظفون بفتور، وعاملوهم بازدراء، وهم لا يفهمون السر وراء ذلك.
كما انتشرت حكايات عن انتقام نادل المطعم الذي لا يحصل على إكرامية، مثل وضع شيء في الطعام، أو سكب المياه فوق رأس الضيف، أو فضحه على رؤوس الأشهاد، والصراخ فيه أمام كل الحاضرين، الأمر الذي جعل السياح يدفعون بسخاء خوفاً من هذه المواقف.
وفي ميونيخ التي تقام فيها احتفالات أكتوبر التي يحضرها ملايين السياح من داخل ألمانيا وخارجها، كان هناك تقليد متبع، وهو أن يدفع النادل ثمن المشروبات من جيبه الخاص، ثم يحاسب الزبائن، ويحتفظ بالإكرامية لنفسه، ولذلك فإن إحدى رسائل الدكتوراة تناولت الوضع القانوني لذلك، وتوصلت إلى أنه في حالة وفاة النادل قبل تحصيل المبلغ والإكرامية، فإن هذه الأموال تكون من حق الورثة، وإذا احتفظ صاحب المقهى بالإكرامية، فإنه يجعل نفسه تحت طائلة قوانين الاعتداء على الإرث.
الإكرامية والأخلاق
حاول معارضو الإكرامية تصويرها باعتبارها مصدر البلاء والشرور، فهي السبب في إفساد النفوس، بسبب سهولة حصول العاملين في المقاهي والمطاعم على هذه الأموال، فيسهل عليهم إنفاقها دون طول تفكير، ورغبة في الشعور ببعض عزة النفس، وتبادل الأدوار مع ضيوف المطاعم والمقاهي والحانات… ونبهوا إلى أن الإكرامية تثير الجشع في نفوس العمال، فيرفضون الحصول على وقت للراحة، ويبيتون الليالي من أجل جمع أكبر قدر من المال، ولذلك فإن الغالبية العظمى منهم لا تقدر على تأسيس أسرة، وتظل على هذا الحال، حتى يتقدَّم السن بالعامل.. وما دامت الإكرامية ليست جزءاً من الراتب، فإنها لا تفيده في معاشه.
بين الإكرامية والرشوة
تجدر الإشارة إلى أن مسألة العلاقة بين الإكرامية والرشوة مطروحة منذ العصور الوسطى. فقد كان السجناء يقدِّمون هدايا مالية لحرَّاس السجن، حتى يخفِّفوا من تعذيبهم، وحتى يجعلوا إعدامهم أقل ألماً، وأسرع تنفيذاً، فهل يمكن اعتبار هذه المبالغ إكرامية أم رشوة؟ الغالب أنها رشوة، لأن الأصل أن يقوم الموظف بعمله على أكمل وجه، انطلاقاً من التزامه أخلاق العمل وأنظمته، وألاَّ يفرق في المعاملة بين الأشخاص، بسبب ما يحصل عليه من مبالغ، مهما كان اسمها.
وما زال هذا الخلط أيضاً قائماً حتى عصرنا الحديث. وتقارير محاربة الفساد حول العالم خير دليل على ذلك، ففي حين يجاهر بعض موظفي الدول بطلب مبالغ مالية، صغيرة كانت أو كبيرة، قبل البدء في أي إجراء، حتى ولو كان من صميم عملهم، فإن موظفين آخرين، لا يجاهرون بذلك بل يعقِّدون الأمور حتى يفهم أغبى الناس، أن الطريق الوحيد لتسيير المعاملة هو تقديم «الإكرامية»، التي ليست سوى رشوة واضحة وضوح الشمس.
 وفي دول كثيرة تنص القوانين صراحة على أن أي «هدية» لموظف دولة، تزيد قيمتها عن مبلغ ضئيل للغاية –يبلغ في ألمانيا مثلاً 10 يورو-، تمثل رشوة يعاقب عليها القانون بصرامة، ويكفي أن الرئيس الألماني السابق كرستيان فولف فقد منصبه بسبب اتهامات بحصوله على هذا النوع من الإكراميات، مثل موافقة شركة الطيران على ترقية تذاكر أسرته من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، أثناء قيامه برحلة خاصة، أو لأن صديقاً له دعاه على نفقته الخاصة للمشاركة في احتفال في مدينة ميونيخ، وهي اتهامات بمبالغ محدودة للغاية، ورغم أن القضاء أثبت براءته منها جميعاً، فإنه كان قد تعرَّض للضغوط الشعبية التي اضطرته للاستقالة، لأنه لم يعد قدوة حسنة لشعبه، حتى ولو لم يكافئ من قدَّم له هذه الإكراميات -المزعومة- بأي مقابل من أموال الدولة.
وفي دول كثيرة تنص القوانين صراحة على أن أي «هدية» لموظف دولة، تزيد قيمتها عن مبلغ ضئيل للغاية –يبلغ في ألمانيا مثلاً 10 يورو-، تمثل رشوة يعاقب عليها القانون بصرامة، ويكفي أن الرئيس الألماني السابق كرستيان فولف فقد منصبه بسبب اتهامات بحصوله على هذا النوع من الإكراميات، مثل موافقة شركة الطيران على ترقية تذاكر أسرته من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، أثناء قيامه برحلة خاصة، أو لأن صديقاً له دعاه على نفقته الخاصة للمشاركة في احتفال في مدينة ميونيخ، وهي اتهامات بمبالغ محدودة للغاية، ورغم أن القضاء أثبت براءته منها جميعاً، فإنه كان قد تعرَّض للضغوط الشعبية التي اضطرته للاستقالة، لأنه لم يعد قدوة حسنة لشعبه، حتى ولو لم يكافئ من قدَّم له هذه الإكراميات -المزعومة- بأي مقابل من أموال الدولة.
وفي حين كانت قوانين بعض الدول الأوروبية تسمح في الماضي بدفع «إكراميات» للمسؤولين الحكوميين في دول العالم الثالث، للحصول على صفقات ضخمة من الشركات الأوروبية، فإن اعتراض المواطنين الغربيين من دافعي الضرائب على ازدواجية المعايير في التعامل مع المبادئ الأخلاقية، اضطرت هذه الدول لتعديل هذه القوانين، واعتبرت أن هذه «الإكراميات» رشاوى، لا يجوز دفعها، حتى ولو تسبب ذلك في فقدان الصفقات التجارية، التي تضمن الحفاظ على أماكن العمل في مصانعها.
ولعل أهم معلم للرشوة أنها تجعل من يدفعها يحصل على ما لا يستحق، مثل أن يؤدي دفعها لحصوله على صفقة، رغم أن عرضه لم يكن أفضل العروض، أو حتى أن يجري تقديمه على غيره في أمور يومية، مثل الدخول إلى الطبيب قبل من سبقه في الحضور. كما أن الرشوة غالباً ما يدفعها الشخص قبل حصوله على الخدمة، على عكس الإكرامية التي يحصل عليها الشخص بعد الانتهاء من العمل، ولعل من أسباب الخلط بين الرشوة والإكرامية أنهما تبدوان كما لو كانتا نابعتين من الشخص الذي يقدِّمهما، أي إنه يفعل ذلك طواعية -على الأقل ظاهرياً.
ولعل أسهل الطرق للتفريق بين الرشوة والإكرامية، هي أن حصول أي موظف حكومي على أي هدية، يُعد رشوة. وأي مال يقدَّم إلى عامل لا علاقة له بالدوائر الحكومية على الإطلاق، مقابل قيامه بخدمة ممتازة تفوق المعتاد، فإنها إكرامية، بشرط ألا تكون بناءً على طلبه، وألا تجعله مستعداً لأن يتخلى عن عزة نفسه أو كرامته، مثل أن ينحني أو يقبِّل اليد، أو أي سلوك يحط من قيمته كإنسان، وهو الأمر الذي لا يجوز أن يشجعه الضيف أو النزيل، بأن يدفع مكافأة على ذلك الانهيار الأخلاقي.
الإكرامية بعيداً عن المادية
يطالب فريق من مؤيدي الإكرامية بعدم التركيز على البُعد المادي. ويقولون إن من يقدِّم إكرامية إنما يقول لمن يخدمه، إنه يعتبره شخصاً مهماً، ويقدِّر عمله ويحترمه، ولذلك يريد أن يكافئه. فالمال هنا تعبير معنوي وليس مادياً. وليست القضية، يداً عليا ويداً سفلى، بل يد تمتد ليد أخرى، وليس الهدف منها إراقة ماء وجه الآخر، بل إقامة علاقة مع طرف آخر.
أما فينفريد شبايتكامب أستاذ التاريخ الحديث بجامعة جيسن الألمانية، فيشدد على أن ما يحدث في الإكرامية هو تبادل العطاء، وليس تبادل المكانة، أي لا ينزل الضيف عن السلوك المقبول، فيطلب من العامل أن يجلس معه على الطاولة، وبالمقابل لا يتجرأ العامل، ويسأل الضيف عما لا يعنيه. بل إن العامل لا يحق له من الأساس أن يطرح أسئلة، بل يقتصر دوره على الرد على أسئلة الضيف، ثم ينصرف بهدوء، ليترك للضيف المجال ليستمتع بجلسته. كما لا يجوز للنادل أن يجلس إلى الطاولة المجاورة للضيف، بعد انتهاء وقت عمله، لأن ذلك يؤدي إلى صعوبة التعامل بينهما مستقبلاً.
ويشير بعض الكتَّاب النمساويين إلى أن المقهى في فيينا ليس مكاناً يجتمع فيه زبائن وعمال، بل هو بيت يقضون فيه جميعاً جزءاً كبيراً من حياتهم كل ليلة، يتقاسمون الوقت، ويقوم كل طرف بدوره. فكأن المقهى مرآة للمجتمع، إذا كان طبقياً ظهرت هذه الطبقية في سلوك الضيوف مع العمال. وإذا كان المجتمع في حالة صلح مع الذات، ظهر ذلك في التعامل بينهم، وأن سلوك الشخص الذي يقدِّم الإكرامية، يكشف كثيراً من رؤيته لنفسه، وللمجتمع من حوله، وأن الإكرامية لا تصبح مشكلة، إلا إذا كان المجتمع يعاني من أزمة، مثل خوف الأمريكان البيض من منازعتهم السود على مكانتهم، بعد انتهاء عصر العبودية.
وختاماً: من حقنا أن نمارس الرفاهية الفكرية أو نتفلسف حول الإكرامية، وأن نبحث مختلف الجوانب والحجج، والآراء المؤيدة والمعارضة، لكن النتيجة الحتمية هي الانصياع في النهاية لهذا التقليد. ليس بسبب الخوف من سوء سلوك العمال، بل لأن الإنسان لا يحب أن يكون شاذاً عن المجتمع، ولا متجاهلاً لأعرافه. ولذلك، فإنه يجد أن الإكرامية مهما كانت تمثل من خسارة مادية، فإن العواقب المترتبة على تجاهل الأعراف أشد خسارة، لذلك تأكد أنك ستظل تستخدم عبارة (الباقي لك!).