 لقد فقست البيضة، وكبر الطائر في العش، واستنزف موارده، وازدحم به المكان، لا بد له من المغادرة. ريشه بدأ بالنمو، وسيصبح له جناحان يوماً ما، وسيغادر. مغادرة الطائر للعش ليست مجرد رغبة منه في الطيران، أو تباهياً منه بقدرته عليه، أو حتى شعوره بحريته، إنما هي دعوة تأتيه من حاجته للبقاء حياً أيضاً، إنها دعوة للتكاثر ولنقل جيناته إلى الجيل الذي يليه، إنه سيغادر مرغماً يوماً ما. ذلك الطير هو الإنسان، والعش هو الأرض.
لقد فقست البيضة، وكبر الطائر في العش، واستنزف موارده، وازدحم به المكان، لا بد له من المغادرة. ريشه بدأ بالنمو، وسيصبح له جناحان يوماً ما، وسيغادر. مغادرة الطائر للعش ليست مجرد رغبة منه في الطيران، أو تباهياً منه بقدرته عليه، أو حتى شعوره بحريته، إنما هي دعوة تأتيه من حاجته للبقاء حياً أيضاً، إنها دعوة للتكاثر ولنقل جيناته إلى الجيل الذي يليه، إنه سيغادر مرغماً يوماً ما. ذلك الطير هو الإنسان، والعش هو الأرض.
الأرض، قد لا تكون الخيار الأوحد للبشر من حيث الموارد التي عليها. فالموارد محدودة، والبشر في ازدياد، وعلى سبيل المثال تدل المؤشرات على أنه سيأتي اليوم الذي لا يغطي فيه الماء العذب حاجة البشر، وحتى إن وجدت أساليب للتحلية، فإنها قد تكفي لشربهم، ولكنها لن تكفي للري وللكائنات الحية الأخرى. وكذلك بالنسبة للطعام، قد يبدو أننا في عصر ذهبي طورت فيه أساليب إطعام 7 مليارات نسمة، ولكن مهما تعاظمت هذه التقنيات إلا أنها لن تستطيع مواكبة الأعداد المتضاعفة أُسّياً، فالشخص الواحد يحتاج لأراضٍ شاسعة بما فيها من نباتات وحيوانات لاستخراج طعام كافٍ له هو فقط.
الأرض ليست الخيار الأوحد للبشر من حيث المساحة أيضاً، فلو جُمع كل البشر منذ بدء الخليقة –يُقدَّر عددهم بحوالي 108 مليارات نسمة- ووضع كل منهم في رقعة متر واحد طولاً وعرضاً، لاحتوتهم جميعاً مساحة المملكة العربية السعودية. فهذا العدد من البشر سيحتاج إلى 108 مليارات متر مربع. ومساحة المملكة العربية السعودية هي 2,149 مليار متر مربع. أي إنه ستبقى مساحة 2041 مليار متر مربع لبشر لم يولدوا بعد!
ولكن المساحات التي يحتاجها الإنسان للعيش تشتمل على أراضٍ تحتوي على الحيوانات والنباتات التي يتغذى عليها، وكذلك على المصانع التي تنتج جميع مستلزماته، بالإضافة لاشتمال تلك المساحات على مقار ضخمة مجهزة لتوفر بيئة مناسبة للحياة، فلا يمكن للإنسان العيش في مساحة قدرها متر مربع واحد، إذن، المساحة هي أيضاً مورد في حد ذاتها، يتصارع عليها البشر في دور القضاء كحد أدنى، وفي الحروب حتى الموت كحد أقصى.
تلك كلها أسباب تدفع البشر للخروج مرغمين. ولكننا نجد على الطرف الآخر من كفة ميزان الحركة لترك الأرض الرغبة المُلِحَّة للاستكشاف أيضاً، أصبحنا ندرك أن الكون حاضن لكواكب أخرى قد تكون مناسبة لحياة الإنسان عليها، بل قد تكون مأهولة حالياً بكائنات أخرى.
كم عدد تلك الكواكب؟ تقول الإحصاءات إن عدد الكواكب القابلة للحياة قد تصل إلى 10 مليارات كوكب، وهذا العدد هو فقط في مجرة درب اللبانة، ناهيك عن المليارات من الكواكب الأخرى في المجرات المحيطة بها ثم التي تليها، أي لو أننا أعطينا لكل إنسان كوكباً واحداً، لتمكنت الكواكب من استيفاء البشر فرداً فرداً، ولبقيت لدينا كواكب غير مأهولة ومستعدة لاستقبال مزيد، وهذا فقط في مجرتنا مجرة درب اللبانة.
اجمع هذه الحاجة للموارد مع الرغبة في الخروج، وستجد سهماً مؤشراً إلى الفضاء الخارجي، وإلى طريق وعر لم يعبَّد بعد. ذلك الطريق يحتاج إلى علم هائل للقفز بالإنسان إلى ارتفاعات كونية.. إلى المجموعة الشمسية، ثم إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
كيف الوصول إلى هناك؟
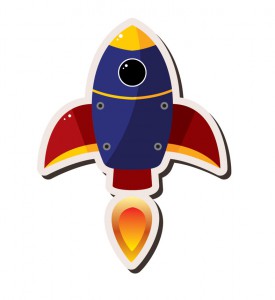 تتضح مشكلة قطع المسافات بعقد مقارنة مع أقرب نجم للأرض: بروكسيما سنتوري (القنطور)، فهو يبعد عنا حوالي 4.25 سنة ضوئية، أو 40,000 مليار كيلومتر، لو أننا قررنا السفر إليه باستخدام أسرع مركبة فضائية بدفع ذاتي لاستغرقتنا الرحلة مليار ساعة، أو 114 ألف عام. وإن كنا كسلالة بشرية قد استغرقنا 5 آلاف عام لنهتدي إلى ابتكار الصاروخ، فإننا سنحتاج إلى 100 ألف عام للوصول إلى سرعات توازي نسبة سرعة الصاروخ إلى سرعة المشي، ويكبر المأزق حينما نعلم أن النجم القنطور قد لا يمتلك كواكب قابلة لتسكين البشر. وبالتالي، سنحتاج للسفر إلى مسافات أكبر بكثير للوصول إليها، إنها مشكلة حقاً!
تتضح مشكلة قطع المسافات بعقد مقارنة مع أقرب نجم للأرض: بروكسيما سنتوري (القنطور)، فهو يبعد عنا حوالي 4.25 سنة ضوئية، أو 40,000 مليار كيلومتر، لو أننا قررنا السفر إليه باستخدام أسرع مركبة فضائية بدفع ذاتي لاستغرقتنا الرحلة مليار ساعة، أو 114 ألف عام. وإن كنا كسلالة بشرية قد استغرقنا 5 آلاف عام لنهتدي إلى ابتكار الصاروخ، فإننا سنحتاج إلى 100 ألف عام للوصول إلى سرعات توازي نسبة سرعة الصاروخ إلى سرعة المشي، ويكبر المأزق حينما نعلم أن النجم القنطور قد لا يمتلك كواكب قابلة لتسكين البشر. وبالتالي، سنحتاج للسفر إلى مسافات أكبر بكثير للوصول إليها، إنها مشكلة حقاً!
البُعد الأخلاقي والتكنولوجي
أضف إلى ذلك مشكلة أخرى، وهي التطور التكنولوجي المتسارع. فلنفترض أن العلماء اكتشفوا طريقة للسفر بسرعات مناسبة، ثم أطلقوا رواد الفضاء إلى كوكب بعيد، وفي أثناء سفرهم طور العلماء دفعاً أفضل بكثير من الدفع السابق، ذلك يعني إن أطلقوا المركبة الأحدث فإنها ستجتاز الأولى بسرعة أكبر، وستصل إلى الكواكب البعيدة في وقت أقصر، وسيتأخر عنها الفريق الذي أرسل أولاً، فيصبح التساؤل: متى يحق لنا أن نطلق البشر؟ وبأي تكنولوجيا؟ وهذه هي مشكلة أخلاقية تحتاج لنظر فلاسفة الأخلاق.
تتفاقم المشكلة حينما نأخذ بعين الاعتبار الطاقة الهائلة المستهلكة في دفع الصاروخ، كلما احتاجت المركبة لطاقة أكبر ثقلت أكثر، وذلك لحملها وقوداً أكثر. أضف إلى ذلك أن أي رحلة ستحمل معها البشر ستكون مكلفة للغاية، فالإنسان يحتاج لموارد كثيرة وتجهيزات كبيرة لإبقائه على قيد الحياة لفترات سفر طويلة، عوضاً عن حمايته من الأشعة الكونية وحبيبات الغبار، حيث بإمكانها التسبب بأضرار بالغة في المركبة إن اصطدمت بها، وهذا خلاف ما نراه من أفلام الخيال العلمي من قتال المراكب الفضائية التي تتحطم بالانفجارات التوربينية الصاروخية، ثم تخرج سالمة، فمراكب «ناسا» تتأثر تأثراً بالغاً بمجرد اصطدامها بذرات بسيطة من الغبار.
بعد سرد الإحباطات المتتالية، قد نصل إلى نتيجة أن السفر إلى الكواكب البعيدة وتسكين البشر فيها هو أمر بعيد المنال، أو يطل على شرفة الاستحالة. على العكس من ذلك، فهذه الإشكالات لم تُحبط العلماء، فهم يعملون على حلها اليوم. ولديهم بعض الاقتراحات الجادة لصناعة مراكب تصل سرعاتها إلى ما يقارب سرعة الضوء، بل إن هناك سراً في نظرية النسبية الخاصة لآينشتاين قد تسمح للمسافر الوصول في زمن بسيط إلى الكواكب البعيدة، حتى وإن كان الوصول إلى هذا السر بالنسبة لنا بعيد الأمد.
 الرمز بيتا (β) هو الحرف الثاني في الأبجدية الإغريقية، وهو -كما نلاحظ- جدّ الحرف الإنجليزي B.. وجد الصوت «ب» في لغات أخرى كثيرة. بعيداً عن اللغويات، فإن «بيتا» هو رديف للرقم 2 كذلك.. مثلما هو «ألفا» رديف للرقم 1 كما ذكرنا في العدد الماضي. ويتجلَّى ذلك في عوالم البرمجيات. فالنسخة «بيتا» من أي برنامج هي النسخة التجريبية الثانية، وما قبل الأخيرة، التي اجتازت قسوة الاختبارات الابتدائية فسُمح لها بأن توزع على الجمهور ليجربها قبل إطلاق النسخة النهائية.
الرمز بيتا (β) هو الحرف الثاني في الأبجدية الإغريقية، وهو -كما نلاحظ- جدّ الحرف الإنجليزي B.. وجد الصوت «ب» في لغات أخرى كثيرة. بعيداً عن اللغويات، فإن «بيتا» هو رديف للرقم 2 كذلك.. مثلما هو «ألفا» رديف للرقم 1 كما ذكرنا في العدد الماضي. ويتجلَّى ذلك في عوالم البرمجيات. فالنسخة «بيتا» من أي برنامج هي النسخة التجريبية الثانية، وما قبل الأخيرة، التي اجتازت قسوة الاختبارات الابتدائية فسُمح لها بأن توزع على الجمهور ليجربها قبل إطلاق النسخة النهائية.
في مجال المالية والاقتصاد، هناك ما يُعرف بـ «معامل بيتا»، وهو مقياس لحساب المخاطرة على عائدات الاستثمار مقارنة بالمعتاد في تغيّر عائدات السوق.
في الفيزياء هناك (جسيمات بيتا) المنبعثة عن المواد المشعة. وجسيمات بيتا لها القدرة على اختراق المادة الحية لمدى معين بحيث يستخدمها خبراء الطب الإشعاعي في تغيير ترتيب الجزيئات. في معظم الحالات يكون لهذا التغير نتائج خطرة كالسرطان وحتى الموت، ولعله من المدهش أن التحكم في جرعة هذه الجسيمات تحديداً هو في حد ذاته علاج مقترح للسرطان! ويبحث العلماء اليوم في ابتكار خلايا بيتا الفولتية لتوفير الطاقة للأجهزة الإلكترونية كالجوّالات دون الحاجة لإعادة شحنها مدى الحياة.
وكثيراً ما يستخدم بيتا للدلالة على متغيرات أو مجاهيل في الرياضيات والإحصاء. () هو رمز معامل الانحدار الجزئي. أما في الذاكرة الشعبية فيحضر بيتا على أكثر من صعيد. فهو كان اسم الإعصار المدمر الذي ضرب سواحل الكاريبي في 2005م، وقبل ذلك بثلاثين عاماً كان الرمز حاضراً في كل منزل حين اختارته شركة (سوني) لتسمية طرازها المعياري من أشرطة الفِديو المنزلية (بيتا-ماكس).