كتاب عن الضوضاء: ملاحظات حول الأوراكيولس
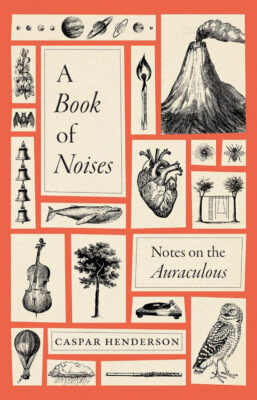
A Book of Noises: Notes on the Auraculous by Caspar Henderson
تأليف: كاسبار هندرسون
الناشر: 2023م، University of Chicago Press
هل سبق أن فكر أحدنا في النطاق الهائل للأصوات من حولنا؟ في هذا الإطار قد يخطر في بالنا الجهود البشرية المتعمدة لتحريك الأثير، مثل: الموسيقى والأغاني والأشعار والبكاء والهمسات. وقد تتبادر إلى الأذهان أصوات أخرى من صنع الإنسان، مثل: صفارات الإنذار والأجراس والألعاب النارية وضوضاء الشوارع، بالإضافة إلى أصوات الحيوانات والطيور والأصوات الطبيعية كحفيف الأغصان وخرير الجداول وصفير الرياح. وإذا كنا نتحدث بشكل مجازي، فربما نتصور “أصوات” الكون، مثل أصداء “الانفجار العظيم”، الذي ما زال صداه يتردد، ولو بشكل ضعيف، على شكل إشعاع ميكروي في الخلفية الكونية.
في هذا الكتاب يدعونا الكاتب والصحفي الإنجليزي كاسبار هندرسون، للانتباه إلى كل هذه الأصوات وغيرها الكثير، والإنصات إلى العالم من حولنا بكل ضوضائه المثير للدهشة.
يتضمن الكتاب 48 مقالة تركز على وصف الأصوات من جميع أنحاء العالم الطبيعي والبشري، وهي بذلك تحتفي بكل الأشياء “الأوراكيولس”، الكلمة التي صاغها هندرسون نفسه، لتصور المزيج بين السمعي والإعجازي في عالم الصوت “المليء بالعجائب”، بحسب قوله. صُنّفت مقالات الكتاب وفق أربعة عناوين رئيسة: “الكوزموفونية: أصوات الفضاء”، و”الجيوفونية: أصوات الأرض”، و”البيوفونية: أصوات الحياة”، و”الأنثرفونية: أصوات الإنسانية”، وهي تبدأ بالانفجار الكبير وتنتهي بالصمت، ذلك التناقض الحيوي للصوت.
يصف هندرسون صدى الكون الشاسع “كما لو كان مملوءًا بأجراس كونية لا حصر لها”، ويشرح كيف أدّت “الذبذبات الكونية” دورًا رئيسًا في تحويل النوى الذرية في المراكز الرئيسة شديدة السخونة للنجوم المتساقطة. كما يصف بشكل دقيق العالم الصوتي المدهش للطيران في المنطاد الهوائي، حيث تُسمع الضوضاء على الأرض أدناه بوضوح غريب، وحيث تكون “الصوتيات السمعية الشاملة مثيرة للإعجاب مثل البانوراما المرئية، بالإضافة إلى استكشافه فكرة “موسيقى الأفلاك” منذ أصولها في العالم القديم حتى يومنا هذا. ويشير المؤلف إلى “الصوتنة” وكيف يمكنها، بمساعدة الكمبيوتر، ترجمة أي شيء تقريبًا إلى صوت مسموع، بما في ذلك حركة الكواكب.
باختصار، هذا الكتاب هو دعوة للاستماع إلى أصوات العالم من حولنا، وتعميق تقديرنا للبشر والحيوانات والصخور والأشجار التي تبث نوعًا من “الكيمياء الموسيقية”، التي من دونها، لم تكن الحياة لتكون موجودة أصلًا.
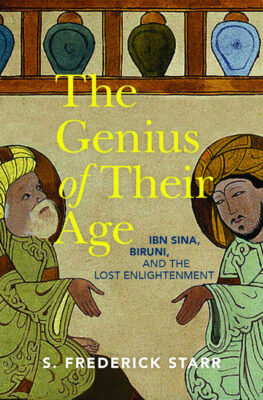
The Genius of their Age: Ibn Sina, Biruni, and the Lost Enlightenment by S. Frederick Starr
تأليف: س. فريدريك ستار
الناشر: 2023م، Oxford University Press
عبقرية زمانهما.. ابن سينا والبيروني والتنوير الضائع
في هذا الكتاب يسلط الخبير في سياسات وتاريخ آسيا الوسطى، س. فريدريك ستار، الضوء على اثنين من أبرز شخصيات عصر التنوير العربي الذي سبق النهضة الأوروبية وكان مصدر إلهام لها. منذ حوالي ألف عام، حقق عملاقان من عمالقة الفكر وهما أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا وأبو الريحان محمد بن أحمد البيروني إنجازات مذهلة في مجالات متنوعة مثل: الطب وعلم الفلك والرياضيات والفلسفة والجغرافيا والفيزياء. أثّرت كتابات ابن سينا في الفلسفة والميتافيزيقا، في أفكار عدد لا يحصى من المفكرين الأوروبيين، ومنهم القديس توما الأكويني؛ في حين أصبحت مؤلفاته الطبية المرجع الطبي الأهم على مدى الأعوام الستمائة التالية في أوروبا والشرق الأوسط والهند. وفي الوقت نفسه، كان معاصره البيروني قد قام بقياس قطر الأرض بشكل أكثر دقة من أي شخص آخر حتى القرن السادس عشر، وفكر في مركزية الشمس في هذا الكون، وافترض وجود أمريكا الشمالية والجنوبية كقارّة مأهولة.
ولكن فريدريك ستار لم يهدف في هذا الكتاب إلى الشروع في تشريح أعمالهما الجبارة، إذ إن هناك العديد من العلماء والمفكرين الذين قاموا بذلك منذ فترة طويلة؛ بل ركز أكثر على وضع أعمالهما في سياقها وجعل العصر الذي عاشا فيه ملموسًا للقارئ، وعلى منح إنجازات كل من ابن سينا والبيروني بُعدًا إنسانيًا خالصًا. فمن حيث الطباع الشخصية كان ابن سينا (المولود حوالي 980م) اجتماعيًا، وكان يرغب في “إنشاء مظلة واحدة يمكن في ظلها تنظيم كل المعرفة”. بينما كان البيروني (المولود حوالي 973م) رجلًا منطويًا على نفسه، وكان قد “قضى معظم حياته يكدح بمفرده” ويركز على الظواهر المنفصلة، ولم يشرع في أي تعميم إلا على أساس ما لاحظه على مستوى التفاصيل. ومن جهة أخرى، تعلّم البيروني، اليتيم واسع المعرفة، من مثال زوج والدته، ابن عراق، صهر آخر حاكم لخوارزم فيما يُعرف الآن بأوزبكستان. أمَّا والد ابن سينا، فكان “موظفًا حكوميًا كبيرًا طموحًا وعلى درجة عالية من الثقافة”.
تنافس هذان العالمان وتداخلت حياتهما، فتبادلا المراسلات والتعليقات التي حفزت أعمالهما على الرغم من الخلاف المرير الذي ساد بينهما في بعض الأحيان. ولكن قبل أن يلحق بهما الغرب بقرون، عكس ابن سينا والبيروني إنجازات عصرهما وذروته الفكرية، واستمرا في أبحاثهما وحافظا على استقلاليتهما الفكرية وسط الاضطرابات والتغيرات السريعة التي شهدتها آسيا الوسطى في ذلك الزمن.
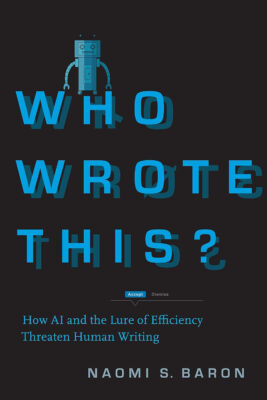
Who Wrote This?: How AI and the Lure of Efficiency Threaten Human Writing by Naomi S. Baron
تأليف: نعومي س. بارون
الناشر: 2023م، Stanford University Press
من كتب هذا؟ كيف يهدد الذكاء الاصطناعي وإغراء الكفاءة الكتابة البشرية؟
تمثل أدوات الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، المثيرة للإعجاب، تحديًا كبيرًا، فهي تدفع أي كاتب للوقوع في الحيرة بين اعتماد المزايا التي تقدمها تلك الأدوات لتوفير الجهد والوقت، من دون تفكير، وبين التوقف ليزن ما يمكن أن يكسبه ويخسره عندما يسلم كلمته المكتوبة للذكاء الاصطناعي. ولفهم كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف ما تعنيه الكتابة والتفكير أيضًا، تقودنا عالمة اللغة، نعومي س. بارون، في هذا الكتاب في رحلة تربط فيها النقاط بين معرفة القراءة والكتابة البشرية والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم تحليلًا لغويًا بأبعاده الفلسفية والتاريخية لبعض من أصعب الأسئلة حول الغرض الأساس من اللغة المكتوبة لمستقبل البشرية.
بدءًا من دروس الكتابة الإنشائية في القرن التاسع عشر، إلى الآلة التي اخترعها عالم الرياضيات آلان تورينغ لفك رموز الرسائل زمن الحرب العالمية الثانية، ثمّ المنصات المعاصرة مثل “شات جي بي تي”؛ تقدم بارون نظرة تاريخية عامة على ظهور كل من معرفة القراءة والكتابة، والذكاء الاصطناعي، ولمحة إلى إمكاناتهما المستقبلية. وتقول الكاتبة إنه نظرًا لأن التكنولوجيا أصبحت متطورة ومتوفرة بشكل متزايد، فمن المغري أن نتخذ الطريق السهل ونترك الذكاء الاصطناعي يعمل نيابةً عنا. ولكنها تحذر من أن الأمر لن يكون دائمًا لمصلحتنا، إذ بينما يمطرنا الذكاء الاصطناعي بالاقتراحات والنصوص الكاملة، فإننا نخاطر بخسارة، لا تقتصر على مهاراتنا التقنية فحسب، بل تشمل أيضًا قوة الكتابة كنقطة انطلاق للتأمل الشخصي والتعبير الفريد.
فعلى الرغم من أن القسم الأكبر من الكتابة التي ينتجها معظمنا غير شخصية، مثل المهام اليومية في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات، وربما نشر القصص الإخبارية أو الواجبات المدرسية، التي أثبت الذكاء الاصطناعي مهارة عالية فيها؛ فإن الدوافع البشرية للكتابة هي أعمق بكثير. فنحن نكتب لكي ننفتح على الخارج، كما هو الحال مع الأعمال الأدبية التي تنقل وجهة نظرنا حول الحالة الإنسانية، ونحن نكتب لكي ننظر إلى داخلنا، بما في ذلك معرفة طبيعة أفكارنا، ونحن نكتب من أجل التفريغ الشخصي، سواء أكان ذلك في مذكرات أم رسالة غاضبة إلى صاحب العمل. وكل أنواع الكتابة هذه ترتكز على الوعي البشري، الذي لا يمتلكه الذكاء الاصطناعي.
باختصار، يهدف هذا الكتاب إلى تعميق فهمنا للفرق بين النص المكتوب من قبل الذكاء الاصطناعي وبين النص الذي يكتبه البشر، الذي هو جزء أساس من فهمنا لما يعنيه أن تكون إنسانًا.
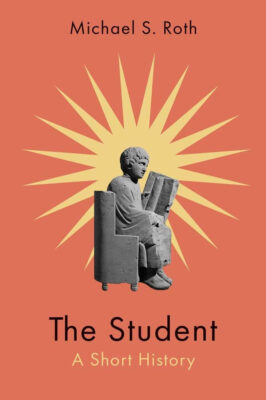
The Student: A Short History by Michael S. Roth
تأليف: مايكل س. روث
الناشر: 2023م، Yale University Press
الطالب.. تاريخ مختصر
في هذا الكتاب يروي الكاتب ومدير جامعة ويسليان في الولايات المتحدة الأمريكية، مايكل روث، تاريخًا حيويًا لمفهوم الطالب عبر العصور، مستكشفًا بعض النماذج الرئيسة للتعلم التي تطورت في سياقات مختلفة تمامًا، من القرن السادس قبل الميلاد حتى وقتنا الحاضر. على مر القرون، واجه الطلاب أنماطًا متعددة من التعلم كتلك المرتبطة بكونفوشيوس، وسقراط، وغيرهما من أبرز المعلمين في العالم، فكان منها تلك التي تميّزت بالتكامل المتناغم مع الأستاذ المرشد، ومنها ما اعتمدت على الوعي الذاتي النقدي، ومنها ما ارتكزت على التجديد من خلال تجاوز المسار الذي يحدده المعلم. وغالبًا ما كانت مختلف أنماط التعلم تثير أسئلة لدى الطلاب عامة: هل من المفترض أن أتعلم المهارات من أستاذي، أم أنّ ما عليّ اكتسابه هو أسلوب حياة ليس إلا؟ هل يجب أن أبقى مخلصًا لمعلمي، أم أنه من المفترض أن “أتخرج” من كوني طالبًا إلى الاعتماد على الذات، أو حتى التمرد؟
هناك طرق عديدة لتكون طالبًا، هذا ما يخبرنا روث في هذا الكتاب، فهناك الطلاب الذين يسعون لتحقيق التوازن والانسجام من خلال التوافق مع السياق التعليمي، وهناك من يهتم ببناء “عضلات” فكرية من خلال انتقاد كل خطوة يقوم بها المعلم، وهناك من يتعلم من خلال التقليد ويسعى إلى التماهي مع زملائه في الفصل وكذلك مع المعلم. ولكن، على الرغم من ذلك، يبقى جوهر عملية التعلم تطوير القدرة على التفكير الذاتي.
من ناحية التطور التاريخي، يقول روث إن “التعليم الحديث ونمط الطالب كما نعرفه اليوم لم يظهر إلا مع عصر التنوير”، وفي هذا الإطار يشير إلى ما ذكره الفيلسوف التنويري من القرن الثامن عشر إيمانويل كانط، في مقالته “ما هو التنوير؟” التي كتبها في عام 1784م، إذ يقول إن التنوير هو “خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه بعدم استخدامه لعقله إلا بتوجيه من إنسان آخر”، وهي الجملة التي تؤشر بوضوح إلى بروز المفهوم الحديث للطالب الذي يهدف من خلال عملية التعلم إلى التحرر الفكري والخروج عن الوصاية. ومن ثم، يناقش كيف تبعت تلك المرحلة تطورات في المناهج الجامعية الحديثة التي أعطت الأولوية لاكتساب المهارات الفكرية التحليلية على حساب مجرد اكتساب المحتوى.




اترك تعليقاً