الجينز والعولمة
في ملف القافلة (الجينز الأزرق) لعدد يناير/فبراير 2016م، الذي وقع في يدي مؤخراً، وجدت كل ما كنت أتمنَّى معرفته عن قطعة الملابس هذه. استمتعت بالخلفية التاريخية الشيقة، واستمتعت أكثر بما ورد في ثنايا الملف من استنتاجات، عن إمكانية أن يكتشف كل إنسان منجم ذهب خاص به، إذا امتلك روح المغامرة ولم يبق في بيته، بل تحرَّك وفتح عينيه. وإذا خطرت على باله فكرة جيدة، فعليه ألَّا يتردَّد كثيراً في تنفيذها.
لكن الملف لم يحل معضلة مهمة، وهي كيفية التفريق بين الجينز الرجالي والنسائي، خاصة إذا تعلق الأمر بتصاميم ليست واضحة المعالم من خلال لونها أو تطريزها أو تصميمها. فقد كان شائعاً في الماضي أن “الموديلات” الضيقة للنساء والواسعة للرجال، وأن الجينز الرقيق للنساء والسميك للرجال، وأن زر فتح البنطلون يكون عند الرجال على اليمين، وعند النساء على اليسار، وأن الجيبين الأماميين يكونان عند الرجال في الوسط، وعند النساء على الجانبين.
فكيف استطاع الجينز أن يلغي عنصراً رئيساً يحدِّد هوية الشخص؟ يبدو أن العولمة بدأت بالجينز، ولم تكتف بأن تجعل الناس من مختلف الثقافات نسخاً مكرَّرة عن بعضها، يأكلون الطعام نفسه، ويشربون القهوة نفسها، ويفكرون بالطريقة نفسها، ويضيعون الوقت نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، بل إنها محت الفرق بين الجنسين. ألم يكن هذا الجانب جديراً بالطرح في هذا الملف التفصيلي؟
منى أمين
ألمانيا
تعليقاً على “الثقافة وخلافها”
قرأت ما أجاد به الأستاذ عبود عطية في مقالته التي نُشرت في العدد الأخير مارس/أبريل 2019 بعنوان “الثقافة وخلافها” وقد أدركت أهمية ما طرحه وبيّنهُ وناقشه.
فنحن حينما ننظر إلى مفهوم الثقافة كما وصفه إدوارد تايلور بأنه ذلك الكل المركَّب من الفنون والأخلاق والعادات… إلخ. نجد أنه وصفه في أول جملته بأنه الكل المركَّب وذلك يدل على أن الثقافة تراكمية متفاعلة بين أكثر من جيل وأكثر من زمن، وهذا التركيب هو ما جعل من أبرز سماتها السعة والانتشار ولكن بالنظر إلى كونها مركَّبة ومتناقلة إذاً لا بد أن ترتكز على قواعد ومراسٍ تمتاز بالقوة والمتانة والثقة في مرجعيتها وفي طرحها وجمعها ثم نقلها وبعد ذلك الإضافة عليها، وأنا أتفق مع الأستاذ في أنها في الوقت الحالي أصبحت معلومات تصنعها المفوضية الثقافية المؤلفة من المدرسة والإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي والتلفزيون وغيرها من أدوات صنع ونقل الثقافة، أو كما في الوقت الراهن “المعلومات”، فهناك كم هائل من المعلومات التي يفيض بها إعلامنا بشتى قنواته ولكن ما قيمة تلك المعلومات لأجيالنا؟ وهل هي صالحة لأن تنضم إلى ذلك الكل المركَّب “الثقافة”.
باتت معلومات بعض شباب اليوم هشة ضعيفة لا تحوي شيئاً يستحق أن يُذكر أو أن يُدرج في مفهوم الثقافة، فإن لم يُذكر مجد من سبقنا بعلمه وفنه وحكمته وذكائه وفطنته ومروءتهِ فكيف ستُصنع ثقافة اليوم لتكمل ذلك الكل المركَّب الذي لا بد أن يتناقله الأجيال فيما بينهم حتى نحافظ على ثقافتنا من منبعها السابق إلى آخر ما يُضاف إليها ويتم تداوله؟
فلم تعد هذه القنوات أو المفوضية الثقافية تكتُب أو تنشُر عن عباقرة العلم وأوائله أو فحول الشعر وقوافيه ولم يعُد يُعرض عن علمٍ من أعلام تاريخنا في الشاشات أو المجلات بل اكتفينا بما هو دون، معلومات هائلة لكنها لا تُغني ولا تُسمن من جوع.
فمقالتنا هنا لعلها تحفظ للثقافة شيئاً يسيراً من أصالتها ومتانة منابعها وطيّب شواهدها، ولعل جيل شباب اليوم يتغانم الفرصة ويضيف للثقافة ما يُثقِل ميزانها ويُعلي هامتها ويصنعُ فرقاً ثقافياً يستحقُ أن يُتناقل بين الأجيال.
هند القحطاني
المملكة العربية السعودية
مكانة الفلسفة في عالم اليوم
طالعت في عدد القافلة لشهري مارس/أبريل 2019م، افتتاحية رئيس التحرير بعنوان “الفلسفة مهارة متأنية”، ثم ندوة النقاش التي دارت تحت عنوان “الفلسفة في الحياة والتعيلم”. وهذا ما دفعني إلى كتابة هذه السطور حول أهمية الفلسفة في عالم اليوم.
بداية، يشير الفيلسوف الألماني الشهير إيمانويل كنط إلى سمة فريدة تميِّز العقل البشري، وهي سعيه الدائم في البحث عن إجابات لأسئلة يستحيل الإجابة عنها. ومع علمه بهذه الاستحالة، فإنه لا يكفُّ عن طرح تلك التساؤلات. ورأى أن هذه هي السِّمة الفريدة التي تشكِّل قوام الفلسفة. ونلمس هنا كيف أدرك كنط أن طبيعة الفلسفة هي أقرب إلى طرح الأسئلة منها إلى تقديم الإجابات، ولكن ليس معنى هذا أن الفلسفة تعجز عن تقديم الإجابات وطرح الحلول دائماً، بل إن الإجابات التي تقدِّمها الفلسفة تحرّض على مزيد من التساؤل، أو تشحذ في أذهاننا ملكة التساؤل والتفكير.
وعالم اليوم المثقل بالإنجازات العلمية الكبيرة، من غزو الفضاء إلى البيولوجيا الدقيقة إلى اكتشاف الخريطة الجينية وثورة الاتصالات التي أدخلت البشرية عصراً جديداً، أصبح يعرف بالعصر الرقمي. وهذا الأمر يدفع إلى التساؤل: ما دور ومكانة الفلسفة في هذا العصر الذي خطت فيه البشرية خطوات كبيرة نحو عصر علمي وتكنولوجي جديد، بدأت تأثيراته تظهر في العالم بأسره، ويصعب التنبؤ بجميع نتائجه وتداعياته؟ وهل بقي للفلسفة وسط هذا الزخم العلمي أي مجال خاص بها، يمكنها أن تهتم به؟ أم إن حالها ومآلها باتا محصورين في الاجترار العقيم لقضايا عتيقة؟
التقدُّم العلمي يطرح مزيداًمن الأسئلة
إنَّ كل تقدُّم علمي جديد يفتح أبواباً واسعة لتساؤلات فلسفية جديدة لم تكن مطروحة من قبل، ولا يستطيع العلم اليوم أن يتغافلها أو يتجاهلها، بل لن نكون مبالغين في القول إن مستقبل العلم يتوقف بدرجة كبيرة على التساؤلات الجديدة التي تطرحها الفلسفة. وهناك أمثلة وشواهد كبيرة أصبحت اليوم محط تساؤلات فلسفية، تأتي في مقدِّمتها هذه الثورة الرقمية التي نعيش بداياتها في هذا القرن، والتي فتحت معها مجالات جديدة لتساؤلات لم تكن واردة سابقاً، مثل: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يمكنني أن أعمل؟ ماذا يمكنني أن آمل؟ وإذا كانت هذه التساؤلات جميعاً تصل في نهاية المطاف إلى غايات الوجود البشري، فإنها تصاغ اليوم صياغة جديدة على ضوء هذه المعطيات والشروط الملموسة للعالم المعاصر بقفزاته العلمية الكبيرة. الأمر الذي دفع بالفيلسوف والمفكِّر الألماني الشهير جورجين هيرماس إلى القول “إذا كان من الضروري إعادة النظر إلى طبيعة المهمة الملقاة على عاتق الفلسفة، باعتبارها أداة لنشر العقلانية والفكر النقدي، فإن هذه المهمة غدت ممكنة ومتاحة في الفضاءات الفكرية الجديدة لعالم اليوم، بل أضحت تمثل انشغالاً أساسياً في الفكر المعاصر”.
مهمة جديدة للفلسفة؟
ومن هذا المنطلق طرح فيلسوفنا، جورجين هيرماس، نظرية فلسفية جديدة للعلاقات الإنسانية في ظل هذه الثورة الرقمية، تقوم على أساس تحقيق أكبر قدر من التفاهم المتبادل بين الأفراد والجماعات، من أجل تحقيق أكبر قدر من المواءمة بين هذه الثورة الرقمية وثقافات الشعوب، وذلك بفتح نقاش وحوار يؤدي إلى آفاق جديدة لتساؤلات فلسفية جديدة، تتطلب أجوبة عنها. والفلسفة بأوسع معانيها هي وحدها القادرة على طرح النقاش والحوار، وتبادل الآراء حولها. وكلما تمكَّنت هذه الثورة الرقمية من فتح أفق جديد للإنسان، ازداد الإلحاح على الفلسفة بالأسئلة المتعدِّدة، كي تساعدنا على استعادة التوازن، واسترجاع التناسق في رؤية الإنسان لعالمه المعاصر.
خلف أحمد أبوزيد
مصر



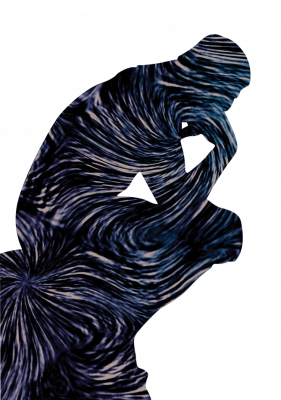




اترك تعليقاً