تربط مختلف النظريات الأدبية العمل الأدبي بتخصصات أخرى، مثل الفلسفة وعلوم الاجتماع والنفس والتاريخ واللغة والاقتصاد؛ ومن هنا نشأت الفكرة القائلة إن الأدب يجمع بين حقول دراسات أو تخصصات متعدِّدة. ويبرز هذا الملمح بصورة أوضح في ما يتعلق بأدب الخيال العملي الذي نراه في بعض الأحيان على تماس واقعي مع العلم، وفي أحيان أخرى يشطح بعيداً عنه وعن الممكن.
يعرّف معجم أكسفورد أدب الخيال العلمي بأنه: “خيال يتعامل مع مكتشفات ومخترعات علمية حديثة بطريقة متخيلة”. ويعرِّف سعيد علوش في كتابه “معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة” رواية الخيال العلمي بأنها: “تستبق الأحداث العلمية بتخيلها، وهي تصوِّر أحداث الغد، مع التأكيد على عنصر التحوُّلات الإنسانية”. ويُدرجه مجدي وهبة وكامل المهندس في “معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب” تحت مصطلح “القصص العلمي التصوري”، ويعرِّفانه بأنه: “ذلك الفرع من الأدب الروائي الذي يعالج بطريقة خيالية استجابة الإنسان لكل تقدُّم في العلوم والتكنولوجيا، ويُعدُّ هذا النوع ضرباً من قصص المغامرات، إلا أن أحداثه تدور عادة في المستقبل البعيد أو على كواكب غير كوكب الأرض..” ويحاول جون أنتوني كودون في معجم “المصطلحات الأدبية والنظرية الأدبية”، أن يضع تعريفاً أشمل، فيذكر أن أدب الخيال العلمي “يتعامل جزئياً أو كلياً مع موضوعات الغرائب والخوارق والمخاطر، وهذا يتيح لنا إدخال كتّاب مثل بورغيس وكافكا وآخرين ضمن هذه الفئة… وهذا يعني أيضاً أن أدب الخيال العلمي في الأساس شكل حديث وشائع، يتصل بعدد من الأعمال العظيمة القديمة منذ ثلاثة آلاف عام، فأوديسا هوميروس على سبيل المثال، ستكون مؤهلة جداً لأن تكون أدباً خيالياً علمياً تحت هذا التعريف”.
تخيّل الوصول إلى القمر
بين غودوين وكيبلر
يبيِّن لنا هذا الاختلاف في التعريفات أن أدب الخيال العلمي يعاني من خلط واضح بأنماط أخرى من التعبير الأدبي كالفنتازيا والأسطورة والخرافة. حتى إنه يلتبس أحياناً بما يسمى بالرواية “البوليسية”. ويلاحظ إبراهيم فتحي في “معجم المصطلحات الأدبية” أن القصص العلمية “كانت معروفة على الأقل ابتداءً من القرن الثاني (الميلادي). فقد ابتدع الكاتب اليوناني لوسيان بطلاً سافر إلى القمر”. وهذا ما يشير بصورة غير مباشرة إلى البداية الأدق، حيث تتجلي العلاقة بين أدب الخيال العلمي والعلم والخيال والسياسة.
ففي ثلاثينيات القرن السابع عشر، نُشر كتابان يتفق الجميع على أنهما العلامة الأبرز لتلاقي تلك المجالات من الانشغال الإنساني الدائم. والكتابان عن رحلة إلى القمر. الأول كتبه أسقف إنجليزي والآخر كتبه عالم ألماني كبير، وبين الكتابين أوجه شبه بمقدار ما بين مؤلفيهما من اختلاف، والقاسم المشترك الأهم بينهما، بالإضافة طبعاً إلى تقاربهما الزمنى المدهش، وظروف نشرهما، أنهما يتناولان ما عرف في ذلك الوقت بـ “علم الفلك الجديد”، الذي كان بمثابة “ثورة علمية” لها صبغة دينية حاسمة، تمحورت حول جهود نيكولاس كوبرنيكوس (1543-1473م) الراهب وعالم الرياضيات والفلك البولندي، الذي صاغ نظرية مركزية الشمس وأن الأرض جرم يدور في فلكها في كتابه “حول دوران الأجرام السماوية”، ناقضاً فيه التصورات القديمة التى كانت تَعُدُّ الأرض مركز الكون.
في كتابه “الإنسان على القمر”، يجعل الأسقف الإنجليزي، فرانسيس غودوين (1633-1562م)، بجعات أسيرات تحمل مسافراً إلى القمر في رحلة تستغرق اثني عشر يوماً، و”يجد المغامر الجديد القمر مغطى ببحر تنتثر فيه جزر صغيرة… مكان مثالي، حيث يعيش القمريون العاديون في ظل حكم ملكي، القائمون عليه محبون للخير، وفي مجتمع يخلو من الجريمة والمرض. وبلد أرضه شديدة الخصوبة والغذاء فيه وفير، وهو ما يتيح للطبقات العاملة أن تنعم ببحبوحة العيش وبحياة هانئة”. وكان غودوين قد كتب رحلة الاكتشـاف الطوبـاوي تلك لدعم التصورات التى كانت الكنيسة تنكرها وتطارد مؤيديها. وربما لذلك أحجم عن نشرها، ولم ينشر الكتاب إلا بعد وفاته بخمس سنوات وتحت اسم مستعار.
وفي الفترة نفسها تقريباً، كتب عالم الفلك والفيلسوف الألماني يوهانس كيبلر (1630-1571م) روايته “Somnium” (الحلم)، وهي تُعرف بنطقها ذاك “صومنيوم”، ويعدُّها كثيرون “أول رواية خيال علمي”، وهي مثل “الإنسان على القمر” لم تنشر في حياة مؤلفها، بل نشرها ابنه بعد وفاته بأربع سنوات. وتتناول هذه الرواية مغامرات طالب صغير يتمّ نقله بقوى غامضة إلى القمر، حيث اليوم هناك يعادل 14 يوماً أرضياً”.
من الممكن العمل على قصص الأطفال المميَّزة لتحويلها إلى دراما في المدارس، أبطالها أطفال، أو تصويرها تلفزيونياً أو سينمائياً، لتكون مادة بصرية تلبِّي حاجة أطفالنا إلى أعمال تشبههم.
من الخيال إلى “علم الفلك الجديد”
تكتسب “صومنيوم” قيمتها من مكانة مؤلفها المرموقة في مسيرة “علم الفلك الجديد”. فقد قدَّم فيها وصفاً تخيلياً مفصلاً لكيفية ظهور الأرض عند النظر إليها من القمر. وبذلك تُعد أول بحث علمي جاد حول علم الفلك القمري. وقد أكسبت العالم الكبير أبعاداً أكثر تميزاً، فبقدر تناوله العلمي يجرى النظر إلى كيبلر من زاوية أدبية. فالكاتب الإيرلندي وليام جون بانفيل يضع كيبلر في “ثلاثية الثورات”، التي نُشرت بين عامي 1976 و1982م، في مركز مميز وسط كوبرنيكوس ونيوتن.
ويشير بانفيل إلى إنه أصبح مهتماً بكيبلر، وغيره من العلماء بعد قراءة كتاب “المسرنمون: تاريخ رؤية الإنسان المتغيرة للكون” للكاتب الإنجليزي الهنغاري الأصل آرثر كوستلر، الذي يتتبع تاريخ علم الكونيات الغربي، بداية من علوم الفلك عند شعوب بلاد ما بين النهرين القديمة إلى إسحاق نيوتن، متصوراً أن الاكتشافات العلمية (الكبري) تنشأ من خلال عملية تشبه المشي أثناء النوم. ليس بمعنى أنها تنشأ بالصدفة، بل بمعنى أن العلماء لا يكونون على دراية تامة بما يوجه أبحاثهم، ولا يدركون تماماً تداعيـات ما يكتشفون.
كتب كوستلر تصوراته تلك في عام 1959م، معتبراً أن الشخصيات العظيمة في تاريخ علم الكونيات الحديث (كوبرنيكوس، كبلر، غاليليو، نيوتن)، مثلهم مثل معظم العقول المبدعة في تاريخ العلم، لا يعرفون بالضبط المدى الواسع التأثير لما كانوا يفعلونه. وهذه التصورات تسبق مقولات تومـاس كون في كتابه بنية الثورات العلمية (1962م)، وهو أحد أهم النصوص في مجال فلسفة العلم، حيث يدرس كون لحظات الانعطاف الرئيسة في التطور العلمي، في أعمال كوبرنيكوس ونيوتن ولافوازييه وإينشتاين، ويُبرز الملامح التي يعدّها صفات للثورة العلمية الحقيقية.
خيال أصبح واقعاً
وآخر بقي خيالاً.. حتى الآن
خيال لوسيان وغودوين وكيبلر الذي قادهم إلى القمر أضحى واقعاً تجاوزه الإنسان الآن، وهو يفكر في مدى أبعد، فيعمل جدياً للوصول إلى المريخ، وإلى ما أبعد منه من كواكب المجموعة الشمسية، ويرنو إلى خارجها. لكن خيال فيرن وميتشل ما زال حبيس الأوراق، فالإنسان أظهر شغفاً وقدرة على التحليق في الفضاء، لكنه عاجز، وربما خائف، من النزول إلى ما تحت سطح الأرض.
هذه المفارقة تتجاوز الخيال والعلم وتصطدم بأمور كثيرة من بينها المخاوف والقدرات التقنية. فقد نشر جول فيرن (1905-1828م)، رواية “رحلة إلى مركز الأرض” عام 1864م، كما نشر الكاتب الأمريكي إدوارد بيدج ميتشل (1927-1852م) قصة “باطن الأرض- فجوة عملاقة تمتد عبر الكوكب من قطبه الشمالي إلى الجنوبي” في صحيفة “ذا صن” اليومية في نيويورك، عام 1876م. لكن طموح الوصول إلى باطن الأرض لم يجد سبيله إلى محاولة التحقق إلا في غمرة الحرب الباردة، حين كان التنافس على أشده بين القوتين العظميين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. ففيما نجحت هاتان القوتان في قذف الإنسان إلى الفضاء والوصول إلى القمر، عجزتا عن التوغل عميقاً في القشرة الأرضية، أو حتى الوصول إلى الطبقة التي تعرف بـ “الدثار”، أو حتى إلى انقطاع “موهو” أو انقطاع موهوروفيتش وهو الحد الفاصل بين القشرة الأرضية والدثار. الذي سمي على اسم عالم الزلازل الكرواتي أندريا موهوروفيشيك.
فقد أطلقت الولايات المتحدة شرارة سباق الحفر في أواخر الخمسينيات ثم توقفت. لكن السوفيات خطوا خطوات أبعد في “بئر كولا” لحفر أعمق حفرة داخل قشرة الأرض، غير أن العمق الذي وصلوا إليه عندما قرروا غلق المشروع (عام 2005م) لم يتجاوز 12.262 متراً، وهو أقل من ثلث المستهدف، وقد رافقه كثير من الضجيج والحكايات والخرافات.
تقنيات تحقِّق أمنيات
في صيف عام 1897م، نشر هـ. ج. ويلز روايته “الرجل الخفي” مسلسلة في مجلة “بيرسون” الأسبوعية، وأصدرها كتاباً في خريف ذلك العام، وهي تدور حول عالم بصريات يخترع وسيلة تتحكم بمعامل انكسار الضوء وتغيره ليصبح شخصاً ما غير مرئي. وربما ترجع شهرة الرواية إلى تلك الأحداث المثيرة، والأسئلة التي تثيرها في ذهن القارئ، مثل: ماذا يجنيه ذلك الشخص الذي يمتلك القدرة على أن يصبح غير مرئي؟ وهل هي ميزة؟ وكيف يمكن لرجل خفي أن يعيش في عالم كل من حوله يخاف منه؟ وهل سيكون هناك أي دفاع لو تحوَّل هذا الخفي إلى عدو للمجتمع كله؟ وهل تمنحه قدرته على الاختفاء قوة خارقة في مواجهة الآخرين؟
تلك “الأمنية” التي تسري في اللاوعي، أمنية “طاقية الإخفاء”، لم تعد مجرد خيال. إذ باتت واقعاً في طور التحسين والتجويد في مصانع شركات الأسلحة ومعدات الحروب وتجهيزاتها. فثمة خبر عن “عباءة رقيقة تخفي الأشياء عن العيون”، حيث طوَّر فريق من العلماء الأمريكيين عباءة مصنوعة من شبكة نحاسية رقيقة يمكن استخدامها لإخفاء الأشياء. وخبر آخر عن “تطوير شركة متخصصة في إنتاج الأزياء العسكرية المموهة، مادة شفافة تكسر الأشعة وقادرة على إخفاء الأشياء وحتى الأشخاص”. وقبل ذلك، – وحتى لا ننسى- كانت الولايات المتحدة قد وضعت في ميادين المعارك الطائرة الشبح “قاذفة القنابل” التي لا تستطيع أجهزة الرادار كشفها، وهي الآن بصدد محاولة تصنيع طائرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وليس الرادار.
في رحاب السلام العالمي
التحذير شعرياً وعلمياً
إذا كانت الجوائز الأدبية الكبرى معياراً للنجاح والتأثير والمكانة، فإن نصيب أدب الخيال العلمي منها يبدو ضئيلاً، إذ لم يحظَ كُتابه بجائزة الأكاديمية السويدية (نوبل للآداب) إلا مرَّة واحدة عام 1974م، حين نالها الأديب السويدي هاري مارتنسون (1978-1904م)، مناصفة مع مواطنه الروائي أيفند جونسون.
ما عُد من نوعية الخيال العلمي من بين أعمال مارتنسون هو ديوانه “انيارا”، الذي نشره عام 1956م، وهو أقرب إلى الشعر المستقبلي، يتناول فيه علاقة الإنسان بالآلة، ويحذِّر من الدمار الذي ستلحقه القنابل الذرية بكوكب الأرض. فقد تخيل الأديب الشاعر صاروخاً يحمل مجموعة بشرية ناجية من دمار شامل أصاب الأرض إلى معسكرات عمل فوق كوكبي الزهرة والمريخ. لكن الصاروخ يضيع في الفضاء بمن فيه “لأنهم حملوا معهم كل التناقضات البشرية”. يحمل هذا الديوان؛ الذي يوصف بأنه قصيدة ملحمية من الخيال العلمي، أجواء الحرب الباردة، والمخاوف من الأسلحة النووية، التي عبَّر عنها الشاعر بهذه الكلمات:
“ما أكثر المذابح التي شهدناها بأم أعيننا
والمعارك التي كنا فيها طرفاً
كنا نلمح القتلى الذين خروا صرعي
ونقفز فوق الجثث، في انتظار موجة أخرى”.
وقد عبّر سياسياً عن الهاجس نفسه في ذلك الوقت عالم الفيزياء الأمريكي روبرت أوبنهايمر بقوله: “الساعة تدق بسرعة أكبر الآن. وتمكن مقارنتنا (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) بعقربين داخل جرة، كل يملك الفرصة لقتل الآخر، ولكن على حساب موته هو”.
وبعد نحو نصف قرن على نبوءة مارتنسون الشعرية، عبّر عنها بصيغة “علمية” واحد من أكثر العلماء شعبية وخيالاً، وهو ستيفن هوكينج (2018-1942م) حين قال:”لا أعتقد أن الجنس البشري سوف ينجو في الألف سنة المقبلة، إلا إذا انتشر في الفضاء”.
ففي محاولته الإجابة عن أسئلة مثل: كيف يمكننا فهم العالم الذي وجدنا أنفسنا فيه؟، كيف يتصرف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ شارك هوكينج علماء آخرين رؤية “خيالية”، تبدو حتى اللحظة بعيدة، إن لم تكن مستحيلة، رؤية تنطلق من أن تاريخ العلم يمثل تتابعاً لتطوير وتحسين النظريات والنماذج، من أفلاطون حتى نظرية نيوتن الكلاسيكية إلى النظريات الحديثة للكم. ومن الطبيعي أن يسأل العلماء: هل سيصل هذا التسلسل حتماً إلى نقطة نهاية، إلى النظرية النهائية للكون، التي ستشمل كافة القوى، وتتنبأ بكل ملاحظة يمكننا القيام بها، أم سنستمر إلى الأبد في إيجاد نظريات أفضل، من دون العثور على هذه النظرية التي لا يمكن تعديلها؟.

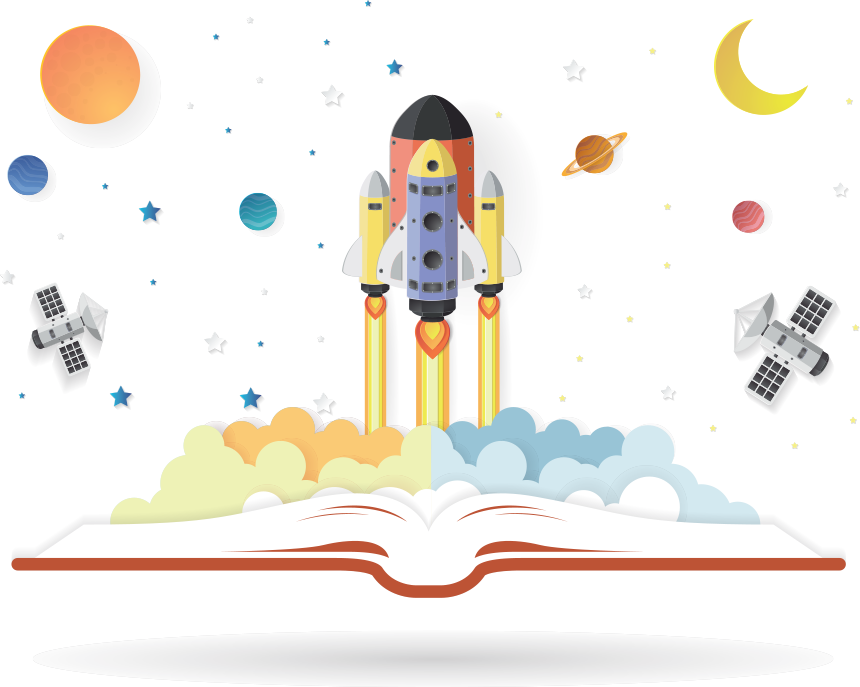


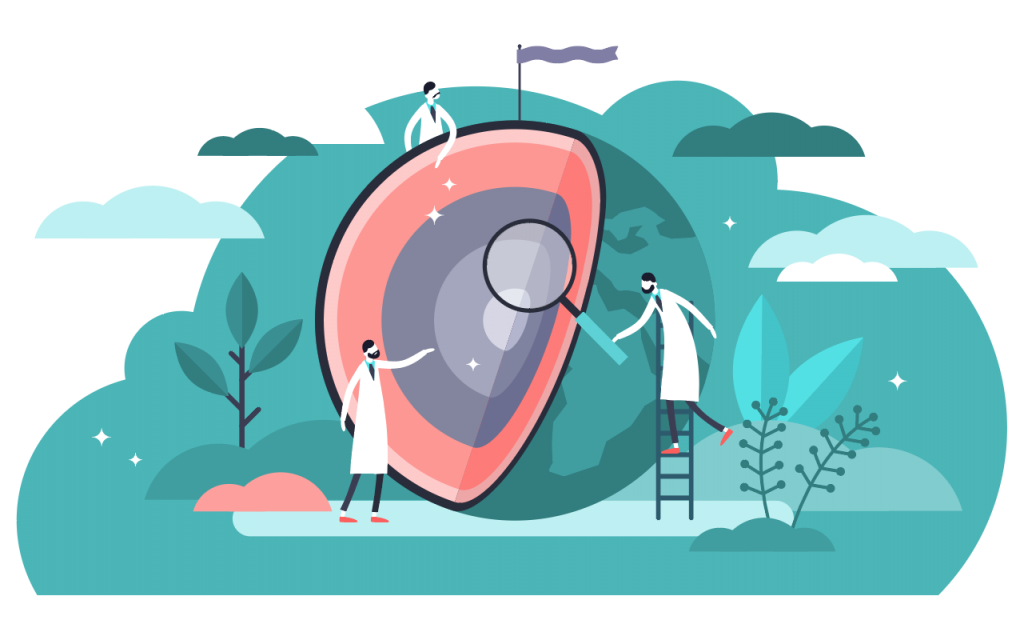




اترك تعليقاً