 في ضيافة “كيدزانيا”، المدينة التي يحكمها الأطفال في مول العرب في جدة، ووسط لعبهم وأصوات ضحكهم، عقدت مجلة القافلة جلسة نقاش مفتوح بعنوان: “كيف تغيّر لَعب الصغار؟”، ناقشت الأهمية التي يشغلها اللَّعِب في حياة الأطفال،وقارنت بين ما كانت عليه ألعاب الحي والحارة قديماً، وما أصبحت عليه ألعاب اليوم، إضافة إلى سلبيات وإيجابيات كلٍّ منها.
في ضيافة “كيدزانيا”، المدينة التي يحكمها الأطفال في مول العرب في جدة، ووسط لعبهم وأصوات ضحكهم، عقدت مجلة القافلة جلسة نقاش مفتوح بعنوان: “كيف تغيّر لَعب الصغار؟”، ناقشت الأهمية التي يشغلها اللَّعِب في حياة الأطفال،وقارنت بين ما كانت عليه ألعاب الحي والحارة قديماً، وما أصبحت عليه ألعاب اليوم، إضافة إلى سلبيات وإيجابيات كلٍّ منها.
وعرّجت الجلسة على شخصيات الأطفال التي أنتجتها الألعاب القديمة والحديثة، وأيضاً على الهدف من اللَّعِب: هل هو من أجل التعلُّـم واكتسـاب المهـارات أم من أجل متعة اللَّعِـب نفســه؟ وانتهت باستنتاجـات عن واقع صناعة لُّعب الأطفال.
 شارك في الجلسة عدد من المتخصِّصين في مجالات الألعاب والتربية ورعاية الطفولة، وهم (بالترتيب الأبجدي): المشرفة التربوية أميرة الصائغ، مدير عام “كيدزانيا” جدة، أندريس فوري، مديرة التسويق في “كيدزانيا”، الجوهرة منور، التربوي والكاتب خالد العباسي، المعالِجة باللعب ومسؤولة بناء وتصميم الألعاب في “حجر ورقة مقص” رفاه سحاب، مدير عام “فناتير للألعاب” عبدالله العمودي، مدير الشركة التجارية بمدينة “كيدزانيا” علي الحبوبي، طبيبة الأسرة وسفيرة حقوق الطفل الدكتورة فاطمة الأنصاري، المشرف العام على مؤسَّسة الطفل القارئ فيصل بن سلمان، مديرة إدارة رياض الأطفال بإدارة تعليم جدة مها الياور، الكاتب الصحافي يحيى باجنيد. وأدار الجلسة الزميلان وليد الحارثي وخالد ربيع.
شارك في الجلسة عدد من المتخصِّصين في مجالات الألعاب والتربية ورعاية الطفولة، وهم (بالترتيب الأبجدي): المشرفة التربوية أميرة الصائغ، مدير عام “كيدزانيا” جدة، أندريس فوري، مديرة التسويق في “كيدزانيا”، الجوهرة منور، التربوي والكاتب خالد العباسي، المعالِجة باللعب ومسؤولة بناء وتصميم الألعاب في “حجر ورقة مقص” رفاه سحاب، مدير عام “فناتير للألعاب” عبدالله العمودي، مدير الشركة التجارية بمدينة “كيدزانيا” علي الحبوبي، طبيبة الأسرة وسفيرة حقوق الطفل الدكتورة فاطمة الأنصاري، المشرف العام على مؤسَّسة الطفل القارئ فيصل بن سلمان، مديرة إدارة رياض الأطفال بإدارة تعليم جدة مها الياور، الكاتب الصحافي يحيى باجنيد. وأدار الجلسة الزميلان وليد الحارثي وخالد ربيع.
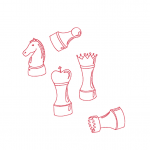 بدأت الجلسة بكلمة تمهيدية للحارثي قال فيها: “كانت البساطة والتلقائية عنواناً للألعاب التي لعبها أطفال الأمس (كبار اليوم)، فقد كانوا يمارسون ترفيهاً مستمداً مما تجود به بيئتهم المحلية، ونمط حياتهم المحدود، بعيداً عن شراء ألعاب جاهزة، أو مصنوعة خصيصاً لهم. أما اليوم، فقد تغيَّر الحال بشكل ملحوظ كما نعرف جميعاً. فما هي طبيعة هذا التغيُّر؟ أهو للأفضل أم لا؟ وأية أهمية حملها اللعب للأطفال بين الأمس واليوم؟ وهل تغيَّرت النتائج المرجوُّة منه بين الزمنين؟
بدأت الجلسة بكلمة تمهيدية للحارثي قال فيها: “كانت البساطة والتلقائية عنواناً للألعاب التي لعبها أطفال الأمس (كبار اليوم)، فقد كانوا يمارسون ترفيهاً مستمداً مما تجود به بيئتهم المحلية، ونمط حياتهم المحدود، بعيداً عن شراء ألعاب جاهزة، أو مصنوعة خصيصاً لهم. أما اليوم، فقد تغيَّر الحال بشكل ملحوظ كما نعرف جميعاً. فما هي طبيعة هذا التغيُّر؟ أهو للأفضل أم لا؟ وأية أهمية حملها اللعب للأطفال بين الأمس واليوم؟ وهل تغيَّرت النتائج المرجوُّة منه بين الزمنين؟
ما الذي تغيّر؟ وما تأثيره؟
 في الإجابة عن هذه الأسئلة العريضة، قالت أميرة الصائغ : “ثمة فرق كبير بين ألعاب الحي والحارة، وبين الألعاب اليوم. فألعاب الأمس لم تكن تقتصر على مشاركة الأم والأب فقط. بل كانت تمتد لتشمل أحياناً كثيرة مشاركة الجيران، وأبنائهم وأولاد الحارة كلها. وكانت ألعابهم تعتمد على الحركة، وتساعد على تنمية القدرات والتفكير، ومهارات استخدام الألفاظ، وهذا يرتبط بالسلوكيات الاجتماعية التي تتضمَّن احترام الكبار، واحترام النظام، واحترام دور كل واحد منهم في اللَّعِـب. وهذا كله نفتقده في ألعاب اليوم، التي ابتعدت عن تعليم السلوكيات. لأنَّ الطفل صار يجلس وحيداً أمام أجهزة الكمبيوتر والألعاب وهو صامت لا يتكلم. وأصبح يتلقى من تلك الأجهزة كل المعلومات التي يمكن أن تكون خاطئة.
في الإجابة عن هذه الأسئلة العريضة، قالت أميرة الصائغ : “ثمة فرق كبير بين ألعاب الحي والحارة، وبين الألعاب اليوم. فألعاب الأمس لم تكن تقتصر على مشاركة الأم والأب فقط. بل كانت تمتد لتشمل أحياناً كثيرة مشاركة الجيران، وأبنائهم وأولاد الحارة كلها. وكانت ألعابهم تعتمد على الحركة، وتساعد على تنمية القدرات والتفكير، ومهارات استخدام الألفاظ، وهذا يرتبط بالسلوكيات الاجتماعية التي تتضمَّن احترام الكبار، واحترام النظام، واحترام دور كل واحد منهم في اللَّعِـب. وهذا كله نفتقده في ألعاب اليوم، التي ابتعدت عن تعليم السلوكيات. لأنَّ الطفل صار يجلس وحيداً أمام أجهزة الكمبيوتر والألعاب وهو صامت لا يتكلم. وأصبح يتلقى من تلك الأجهزة كل المعلومات التي يمكن أن تكون خاطئة.
وأضافت : “مع الأسف، هناك كثير من الألعاب الإلكترونية التي تشجِّع على سلوكيات خاطئة: كالعنف، واستخدام الألفاظ غير المهذَّبة على سبيل المثال. وهذا يحدث في ظل غياب توجيه للطفـل، وتصحيح الأخطــاء التي يشاهـدها أثناء اللَّعِــب، والتي قد يقـــوم الطفـل بعد ذلك بتطبيقها على أرض الواقــع بين إخوته وأقرانه”.
 وتحدَّثت في السياق نفسه مها الياور، التي رأت أن اللَّعِب حاجة للنفس البشرية، وحاجة للطفل بشكل خاص، كحاجته للماء والهواء والتعليم، وهذا أمر لا جدال فيه.
وتحدَّثت في السياق نفسه مها الياور، التي رأت أن اللَّعِب حاجة للنفس البشرية، وحاجة للطفل بشكل خاص، كحاجته للماء والهواء والتعليم، وهذا أمر لا جدال فيه.
وذهبت إلى القول إن اللَّعِب ينمِّي الطفل من جميع النواحي، فهو ليس تسلية فحسب. بل هو تنميــة للطفل اجتماعياً ونفسياً وسلوكياً ولفظياً وحركياً، كما أنه يهيِّئه للتعلُّم لاحقاً في مختلف المهارات والعلوم. ولذلك، يتم التأكيد بشكل دائم على أن يكون اللَّعِبُ هادفاً.
وبالحديث عن أنواع الألعاب، قالت الياور: “هناك الألعاب الشعبية، والألعاب الحركية التي نحرص في رياض الأطفال على أن تكون متوفِّرة في البرنامج اليومي للطفل بما لا يقل عن ساعة واحدة يومياً، وذلك لتلبية احتياجات نموِّه من جميع النواحي”. وهناك من جهة أخرى الألعاب الإلكترونية بسلبياتها وإيجابياتها، لكن سلبياتها أكثر بكثير من الإيجابيات، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع منع الأطفال من اللَّعِب بها، وإنما تقنينها بوقت محدَّد”.
وعادت الياور إلى الحديث عن الفوائد التي تنطوي عليها الألعاب الشعبية والحركية، فأكدت أنها تنمِّي الطفل اجتماعياً، وتنمِّي مهارات القيادة لديه، ويلاحظ هذا عندما  تلعب مجموعة من الأطفال ألعاباً جماعية، ويختارون قائداً لهم. ومنها يتعلَّم الطفل أيضاً التواصل مع الآخرين، وينمو لغوياً، ويكتسب مهارة حل المشكلات التي تواجهه. وهي مشكلات صغيرة، لكنَّها تُمهِّد له كيفية التعامل مع ما سيتعـرَّض له عندما يكبر. كما أن هذه المشكلات تعلِّم الطفل روح التعاون، وأسماء الأشياء، وتنقل الخبرات بينه وبين أقرانه من الأطفال.
تلعب مجموعة من الأطفال ألعاباً جماعية، ويختارون قائداً لهم. ومنها يتعلَّم الطفل أيضاً التواصل مع الآخرين، وينمو لغوياً، ويكتسب مهارة حل المشكلات التي تواجهه. وهي مشكلات صغيرة، لكنَّها تُمهِّد له كيفية التعامل مع ما سيتعـرَّض له عندما يكبر. كما أن هذه المشكلات تعلِّم الطفل روح التعاون، وأسماء الأشياء، وتنقل الخبرات بينه وبين أقرانه من الأطفال.
طرح الحارثي سؤالاً عليها، بحكم خبرتها في رياض الأطفال، حول دور المنزل والوالدين في تنمية ثقافة اللعب وصناعة بيئة فعَّالة لأبنائهم للَّعِب قبل ذهابهم إلى المدرسة أو رياض الأطفال، قالت الياور: “من المعروف أن الطفل ومنذ كونه رضيعاً يبدأ باللَّعِب، ويستخدم فمه، حيث تكون حاسة التذوق أول حاسة تعمل عنده. ويفترض بأهل الطفل اللَّعِب معه، وتهيئة البيئة الآمنة لذلك. ومن الملاحَظ على الألعاب التي يلعبها الأطفال بصورة عفوية أنها مستمدة من بيئتهم المحليَّة، وأن الطفل يبدأ بابتكار واختراع ألعابه بنفسه، ومن الأشياء المحيطة به. هذا من شأنه أن يثير عقل الطفل وتفكيره، وينمِّي لديه مساحة الإبداع”.
عالم غريب على براءة الأطفال
 وضمن التبدلات التي طرأت على تأثير الألعاب بين الأمس واليوم، كان يكفي لخالد ربيع أن يشير إلى “براءة” الألعاب التي يجب أن تتماشى مع براءة الطفولة، ليتولىَّ الكلام يحيى باجنيد قائلاً بشيء من الحدَّة: “براءة الطفل انتزعت منه في هذا الزمن، فلم يَعُد بريئاً، وذلك ليس بإرادته، وإنما أريد له ذلك، أو حدث ذلك بالمصادفة”.
وضمن التبدلات التي طرأت على تأثير الألعاب بين الأمس واليوم، كان يكفي لخالد ربيع أن يشير إلى “براءة” الألعاب التي يجب أن تتماشى مع براءة الطفولة، ليتولىَّ الكلام يحيى باجنيد قائلاً بشيء من الحدَّة: “براءة الطفل انتزعت منه في هذا الزمن، فلم يَعُد بريئاً، وذلك ليس بإرادته، وإنما أريد له ذلك، أو حدث ذلك بالمصادفة”.
وأضاف: “لقد سيق الطفل إلى أن يطَّلع على كل شيء: الممنوع، والمرغوب على السواء. وهذه حقيقة هي أقرب إلى الوباء، وإن كانت منظمة الصحة العالمية، تخلَّصت من كثير من الأوبئة، إلاَّ أنّ هذا الوباء يستعصي على الحلّ، إلاَّ إذا اقتنعت المجتمعات بأن يكون لها دور فاعل في دراسة هذا الواقع ومعالجته”.
 وعلَّق باجنيد على المقارنة بين ألعاب الأمس واليوم بقوله: تبدو هذه المقارنة على قدر من التحيّز، وإن كنت بوجداني وعواطفي أتحيَّز لذلك الزمان بشكل أو بآخر. فألعابنا كنَّا نصنعها بأنفسنا: (القطار، واللوري، والسيارة، وبرميل حمار السقا ..إلخ). وكان لدينا العالم كله، ولكن على مستوى صغير. وكان لنا دور كبير في هذا العَالَم”. ومضى يقول: “في تلك الأيام، كانت قطرة الدم ترعبنا عندما تخرج من إصبع أحدنا، فما بالك بذبح الخروف؟. أما اليوم، فالدم أمامنا على الهواء مباشرة، والقتل الجماعي على الهواء، وعندما تدير جهاز التلفزيون، تكاد ألَّا ترى شيئاً إلا العنف. وهذا يعيدنا إلى الطفل الذي نتحدَّث عنه وعن ألعابه: كيف يعيش في هذا العالم الغريب على براءته؟! هذا ما يؤكِّد أن البراءة انتزعت من طفل اليوم. ومع الأسف، فإنَّنا نتعامل بسلبية مع هذا العدوان! ونترك الطفل في مواجهة ذلك العنف كله”.
وعلَّق باجنيد على المقارنة بين ألعاب الأمس واليوم بقوله: تبدو هذه المقارنة على قدر من التحيّز، وإن كنت بوجداني وعواطفي أتحيَّز لذلك الزمان بشكل أو بآخر. فألعابنا كنَّا نصنعها بأنفسنا: (القطار، واللوري، والسيارة، وبرميل حمار السقا ..إلخ). وكان لدينا العالم كله، ولكن على مستوى صغير. وكان لنا دور كبير في هذا العَالَم”. ومضى يقول: “في تلك الأيام، كانت قطرة الدم ترعبنا عندما تخرج من إصبع أحدنا، فما بالك بذبح الخروف؟. أما اليوم، فالدم أمامنا على الهواء مباشرة، والقتل الجماعي على الهواء، وعندما تدير جهاز التلفزيون، تكاد ألَّا ترى شيئاً إلا العنف. وهذا يعيدنا إلى الطفل الذي نتحدَّث عنه وعن ألعابه: كيف يعيش في هذا العالم الغريب على براءته؟! هذا ما يؤكِّد أن البراءة انتزعت من طفل اليوم. ومع الأسف، فإنَّنا نتعامل بسلبية مع هذا العدوان! ونترك الطفل في مواجهة ذلك العنف كله”.
 ضياع الحلم بالأمومة
ضياع الحلم بالأمومة
في ألعاب البنات
كان الحديث عن العنف في ألعاب الأطفال مدخلاً للحديث عن الاختلافات بين ألعاب الصبيان وألعاب الفتيات، وتحدَّثت في هذا الموضوع الدكتورة فاطمة الأنصاري ومن واقعها الذي نشأت فيه، فقالت: كان بيتنا من البيوت التي تمنع البنت فيها من اللَّعِب في الشارع، ويسمح لها باللَّعِب داخل المنزل، أو على الأكثر على السلّم أمام باب الفيلا الداخلي، أما الإخوة الذكور فكان يسمح لهم اللَّعِب بالكرة لمدة قصيرة في الشارع”.
وأضافت: لم ندرك وجيلي الألعاب التي كانت تلعبها أخواتنا وأمهاتنا خارج البيوت. لكن هذا الموضوع يتكرَّر اليوم مع ابنتي التي يبلغ عمرها 15 عاماً. فهي تشاهد الأفلام القديمة، وتشاهد ألعاب الأطفال في الحارة وتسألني: لماذا لا يكون عندنا ألعاب مثلهم؟ فهي تتمنى أن ترجع لذاك الزمن وتلعب تلك الألعاب: كأن تكوّن منزلاً من الوسائد والأغطية وتلعب هي والأخريات تحته! أو أن يمثلن قدوم ضيوف إلى المنزل، فيطبخن ويخبزن ويضيّفن! هذه الحكايات عندما تسمعها، تشعر برغبة في أن تعود لذلك الزمن وتعيشه مثلما عشناه”.
 ولم تُخفِ الأنصاري أنها سمعت أكثر من طفل وطفلة، يردِّدون هذه الأمنية: “يا ريت نرجع زمان!” قائلة إن في هذا إشارة إلى أنّ حاجة الطفل للَّعِب هي حاجة أساسية، فهو عندما يرغب بالرجوع إلى ذلك الزمن القديم، فذلك من أجل أن يلعب ويمرح، وليس من أجل أي شيء آخر. هذا التأثير معناه أيضاً أنه على قدر ما تسعدهم الألعاب التي يلعبونها اليوم، سواء أكانت ألعاباً كبيرة وضخمة، أو ألعاباً إلكترونية، أو ألعاباً باهظة الثمن، فإنهم يتوقون إلى تلك الألعاب البسيطة والتلقائية والجماعية.
ولم تُخفِ الأنصاري أنها سمعت أكثر من طفل وطفلة، يردِّدون هذه الأمنية: “يا ريت نرجع زمان!” قائلة إن في هذا إشارة إلى أنّ حاجة الطفل للَّعِب هي حاجة أساسية، فهو عندما يرغب بالرجوع إلى ذلك الزمن القديم، فذلك من أجل أن يلعب ويمرح، وليس من أجل أي شيء آخر. هذا التأثير معناه أيضاً أنه على قدر ما تسعدهم الألعاب التي يلعبونها اليوم، سواء أكانت ألعاباً كبيرة وضخمة، أو ألعاباً إلكترونية، أو ألعاباً باهظة الثمن، فإنهم يتوقون إلى تلك الألعاب البسيطة والتلقائية والجماعية.
وخلصت الأنصاري إلى القول إن الأطفال عندما كانوا في السابق يلعبون بمفردهم، وخصوصاً الذين ليس لهم إخوة أو جيران، فإنهم كانوا يهيئون لأنفسهم الجو المناسب للَّعِب، ويستمتعون بذلك. بل ويخترعون من الأشياء حولهم ألعاباً لهم.
 وعندما سألها ربيع ما إذا كانت هذه الألعاب البيتية تؤثِّر على شخصيات الفتيات عندما يكبرن، أجابت بالتأكيد ذلك، وأضافت في مقارنة واضحة بين فتيات الأمس واليوم: البنت التي كان لديها طموح كبير بأن تصبح وزيرة، كان في شخصيتها أيضاً أمر أساسي وفطري، وهو أن تصبح أُمَّاً، وأن يكون لها بيتها الخاص الذي تمارس فيه كل ما يحلو لها، كما كانت تفعل أمها. أما اليوم، فإن شعور البنت بأن تصبح أُمَّاً في المستقبل هو شعور غير ظاهر في طفولتها. فعلى الرغم من كل الألعاب المتطوِّرة الموجودة، وأشكـال دُمى الرضــع التي تكاد تكون حقيقية، إلا أنهن لا يعاملنها كما كانت البنت في السابق تعامل لعبتها، وهذا بسبب تأثير البيئة المعاصرة، على الكبار قبل الصغار”.
وعندما سألها ربيع ما إذا كانت هذه الألعاب البيتية تؤثِّر على شخصيات الفتيات عندما يكبرن، أجابت بالتأكيد ذلك، وأضافت في مقارنة واضحة بين فتيات الأمس واليوم: البنت التي كان لديها طموح كبير بأن تصبح وزيرة، كان في شخصيتها أيضاً أمر أساسي وفطري، وهو أن تصبح أُمَّاً، وأن يكون لها بيتها الخاص الذي تمارس فيه كل ما يحلو لها، كما كانت تفعل أمها. أما اليوم، فإن شعور البنت بأن تصبح أُمَّاً في المستقبل هو شعور غير ظاهر في طفولتها. فعلى الرغم من كل الألعاب المتطوِّرة الموجودة، وأشكـال دُمى الرضــع التي تكاد تكون حقيقية، إلا أنهن لا يعاملنها كما كانت البنت في السابق تعامل لعبتها، وهذا بسبب تأثير البيئة المعاصرة، على الكبار قبل الصغار”.
الألعاب وظاهرة النضج المبكِّر
غنى في المعلومات وفقر في الخبرة
 وهنا قادت القافلة النقاش إلى منعطف مهم، بالإشارة إلى أن أطفال اليوم يبدون أكثر نضجاً وذكاءً من الأطفال قديماً، فالطفل الذي عمره اليوم أربع سنوات، يساوي في نضجه الذهني طفلاً عمره 8 سنوات من الجيل السابق. وقد التقطت الصايغ الحديث وقالت: “تعرضَّت لهذا السؤال كثيراً في السابق. والذي أراه هو أن البيئة التي تحيط بالطفل هي التي تشكِّل ذكاءه، ولا مجال للمقارنة بين طفل الزمن السابق، وطفل اليوم، لأنّ البيئات تختلف. فاليوم يجد الطفل الأشخاص من حوله يلتصقون بأجهزتهم كثيراً، بينما طفل الأمس كان يرى أمه تمسك بالإبرة والخيط وتقوم بالغزل على سبيل المثال”.
وهنا قادت القافلة النقاش إلى منعطف مهم، بالإشارة إلى أن أطفال اليوم يبدون أكثر نضجاً وذكاءً من الأطفال قديماً، فالطفل الذي عمره اليوم أربع سنوات، يساوي في نضجه الذهني طفلاً عمره 8 سنوات من الجيل السابق. وقد التقطت الصايغ الحديث وقالت: “تعرضَّت لهذا السؤال كثيراً في السابق. والذي أراه هو أن البيئة التي تحيط بالطفل هي التي تشكِّل ذكاءه، ولا مجال للمقارنة بين طفل الزمن السابق، وطفل اليوم، لأنّ البيئات تختلف. فاليوم يجد الطفل الأشخاص من حوله يلتصقون بأجهزتهم كثيراً، بينما طفل الأمس كان يرى أمه تمسك بالإبرة والخيط وتقوم بالغزل على سبيل المثال”.
 لكن عبدالله العمودي، لفت إلى أنَّ الطفل يتعرَّض اليوم لكمّ هائل من المعلومات، والخبرات سواءَ عن طريق الفضائيات، أو الأجهزة الذكية. وهذا يؤثِّر عليه بلا شك. وأضاف في معرض حديثه عن دور الألعاب في تنمية ذكاء الطفل، وتخصّصهم في “فناتير” في هذا المجال: منذ قرابة 26 سنة، ونحن نعمل في مجال الألعاب التعليمية الترفيهية للأطفال، ونطِّور الألعاب الشعبية القديمة وفق منهج حديث. فبات لدينا ما يربو على 1000 لعبة منتقاة بشكل يتناسب مع نمط حياتنا، وتساعد على اكتشاف بعض المهارات المختلفة لدى الأطفال”.
لكن عبدالله العمودي، لفت إلى أنَّ الطفل يتعرَّض اليوم لكمّ هائل من المعلومات، والخبرات سواءَ عن طريق الفضائيات، أو الأجهزة الذكية. وهذا يؤثِّر عليه بلا شك. وأضاف في معرض حديثه عن دور الألعاب في تنمية ذكاء الطفل، وتخصّصهم في “فناتير” في هذا المجال: منذ قرابة 26 سنة، ونحن نعمل في مجال الألعاب التعليمية الترفيهية للأطفال، ونطِّور الألعاب الشعبية القديمة وفق منهج حديث. فبات لدينا ما يربو على 1000 لعبة منتقاة بشكل يتناسب مع نمط حياتنا، وتساعد على اكتشاف بعض المهارات المختلفة لدى الأطفال”.
من جهته، أشار خالد العباسي إلى أن وسائل نشر المعلومات أصبحت اليوم قوية ومؤثِّرة جداً، بعكس بناء الخبرة التي أصبحت ضعيفة جداً. وهذا أثّر على أطفالنا كثيراً. إذ إنَّ الطفل يكبر اليوم إلى أن يصل سن العشرين وهو عديم الخبرة. بخلاف الطفل في السابق الذي كان باستطاعته في سن الثانية عشرة أو الخامسة عشرة إدارة بيت كامل.
اللَّعِب ينمِّي الطفلُ من جميع النواحي، فهو ليس تسلية فحسب. بل هو تنميةٌ للطفل اجتماعياً ونفسياً وسلوكياً ولفظياً وحركياً، كما أنَّه يهيِّئه للتعلم لاحقاً في مختلف المهارات والعلوم.
وأضاف : إن طرح هذا الموضوع بالذات، هو إشارة إلى أنه تحدٍّ تربوي حقيقي، وليس مسألة عادية. فلا يوجد بيت في العالم كله إلا ويعاني من انتشار وتأثير الألعاب الإلكترونية، ومن صعوبة انتشال الأطفال من ضررها. ومشكلة هذا النوع من الألعاب أنها تسبِّب اختلاف الذوق لدى الطفل، الذي أصبح ملولاً! فما تعرضه الألعاب الإلكترونية متسارع مثل حياة اليوم التي أصبحت متسارعة بشكل كبير، بخلاف الحياة السابقة التي كان إيقاعها بطيئاً، وكان بمقدور الطفل تكرار اللعبة مرَّة ومرَّتين وثلاثاً دون كلل أو ملل، مستمتعاً ومقابلاً وجوهاً مختلفة في كل مرَّة. أما اليوم فإن اللعبة الجديدة تلغي في نظره أهمية اللعبة التي اكتشفها بالأمس القريب. والحقيقة أن هذا في حد ذاته يمثل تحدياً للبيت، وتحدياً للمدرسة (أو المؤسَّسات التربوية)؛ لأنَّ الطفل لا يتحرَّك، ويبقى أسيراً للكبت.
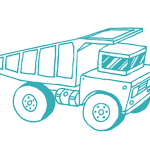 وانتهى العباسي إلى القول بأنَّ هذا يشير بصورة كبيرة إلى أنّ الطفل الذي كان يجلس في المدرسة منذ الحصة الأولى وحتى الحصة الأخيرة، على كرسيه دون أن يتحرَّك لم يَعد موجوداً اليوم. بل أصبح من المستحيل فرض الجلوس المستمر على الطفل طيلة اليوم الدراسي. ولذلك كنتُ دائماً ما أقول للمدارس إن حصة تربية رياضية مرَّتين في الأسبوع الدراسي أصبحت من الزمن الغابر، ولا بد من أن يمارس الطفل الرياضة مرَّة واحدة يومياً على الأقل، بحيث يلعب وينفِّس عن طاقته، وتكون في الوقت نفسه علاجاً للمتغيرات التي استجدت في هذا الزمن”.
وانتهى العباسي إلى القول بأنَّ هذا يشير بصورة كبيرة إلى أنّ الطفل الذي كان يجلس في المدرسة منذ الحصة الأولى وحتى الحصة الأخيرة، على كرسيه دون أن يتحرَّك لم يَعد موجوداً اليوم. بل أصبح من المستحيل فرض الجلوس المستمر على الطفل طيلة اليوم الدراسي. ولذلك كنتُ دائماً ما أقول للمدارس إن حصة تربية رياضية مرَّتين في الأسبوع الدراسي أصبحت من الزمن الغابر، ولا بد من أن يمارس الطفل الرياضة مرَّة واحدة يومياً على الأقل، بحيث يلعب وينفِّس عن طاقته، وتكون في الوقت نفسه علاجاً للمتغيرات التي استجدت في هذا الزمن”.
براءة اللعب الحرّ
 وأكدت رفاه سحاب، أهمية اللعب الحر، غير أنها رأت أن القضية هي في إعطاء الطفل حرية اتخاذ القرار. وقالت : “يمكننا الجلوس والحديث ساعات طويلة عن الحنين إلى زمننا السابق الجميل، الذي عشنا فيه طفولة رائعة، لكن كل ذلك لن يكون مفيداً على أية حال.
وأكدت رفاه سحاب، أهمية اللعب الحر، غير أنها رأت أن القضية هي في إعطاء الطفل حرية اتخاذ القرار. وقالت : “يمكننا الجلوس والحديث ساعات طويلة عن الحنين إلى زمننا السابق الجميل، الذي عشنا فيه طفولة رائعة، لكن كل ذلك لن يكون مفيداً على أية حال.
بل علينا أن نتساءل: من الذي قرَّر أن طفل اليوم لا يستطيع أن يلعب في الشارع، أو أن يكون مبتكراً ومبدعاً ومسؤولاً. اللعب والبراءة هي فطرة، وجزء من كينونة الطفل، لا يستطيع أحد أن يسلبه ذلك (لا أم، ولا أب، ولا شركة ألعاب)، وإذا أعطي الطفل فرصة، فسينطلق سريعاً في رحاب اللَّعِب، وقد رأيت ذلك بأم عيني ليس في المجتمعات المرفَّهة، وإنما في مخيمات اللاجئين في سوريا، عندما عملت ضمن جهود الدعم النفسي لهم”.
وأشارت سحاب إلى دراسة علمية كشفت أن أعظم المبتكرين في عصرنا من أمثال بيل جيتس ومارك زوكربرغ وغيرهما، لم يتعلموا في مدارس تقليدية، بل درسوا في مدارس تسمح باللَّعِب الحرّ، وأنهم كانوا لا يملكون ألعاباً ملموسة، وإنما كانت لديهم مساحة مفتوحة ليبتكروا ألعابهم بأنفسهم.
وأضافت أنَّ مِن المهم القول إن بداية أي اختراع في العالَم تكون من اللَّعِب. وبعد اللَّعِب يبدأ الطفل في اكتشاف نفسه حتى ينتهي إلى تكوين صورة لشغفه، ومن شغفه يتحوّل إلى قضية أو رؤية للحياة”. وعقَّبت على بعض ما قيل في الجلسة بقولها : “أنا لا أشعر أننا في كارثة سوداء في ما يتعلَّق بلعب أطفالنا. فاللَّعِب مستمر، وسوف يستمر. وهناك وسائل تساعد الآباء والأمهات على التعامل بهذا الشأن مع أبنائهم حتى تنطلق فطرتهم الذاتية وتنمو”.
تعليم المهن بالألعاب
 كانت العلاقة بين اللَّعِب الحر والإبداع التي أشارت إليها سحاب، مدخلاً للتطرق إلى ما يسمى بالألعاب التعليمية، البعيدة عن عيوب الجلوس أمام الألعاب الإلكترونية لساعات، دون الجزم بمستوى إمتاعها للطفل. ولاستطلاع هذا الجانب من اللَّعِب الحديث وما آلت إليه بعض ألعاب اليوم، طلب الحارثي من علي الحبوبي عرض تجربة “كيدزانيا” في هذا المجال. فقال الحبوبي: “كيدزانيا مدينة تعليمية ترفيهية، وشعارها: مدينة يحكمها الأطفال. فالطفل عندما يدخل إلى المدينة يدلف إلى مطار يقلع منه إلى عالم ثانٍ بعد أن يحصل على بطاقة سفر. فهو يدخل على عالَمِ حقيقي واقعي للأطفال، ويأخذ معه “شيك” بعملة كيدزانيا، وهي عملة يتم صرفها من بنك حقيقي داخل المدينة، ويستخدمها في الشراء، أو في ممارسة اللَّعِب في أكثر من 70 نشاطاً ترفيهياً تعليمياً، ليس من بينها أي نشاط مرتبط بالكمبيوتر، وإنما هي مهن للمستقبل، بعضها يقوم الطفل بالدفع مقابلها، وبعضها يحصل منها على نقود. وعندما لا تكون لديه نقود، فسيكون لزاماً عليه أن يلجأ إلى العمل في إحدى المهن ليكسب منها النقود، حتى يتمكَّن من اللَّعِب.
كانت العلاقة بين اللَّعِب الحر والإبداع التي أشارت إليها سحاب، مدخلاً للتطرق إلى ما يسمى بالألعاب التعليمية، البعيدة عن عيوب الجلوس أمام الألعاب الإلكترونية لساعات، دون الجزم بمستوى إمتاعها للطفل. ولاستطلاع هذا الجانب من اللَّعِب الحديث وما آلت إليه بعض ألعاب اليوم، طلب الحارثي من علي الحبوبي عرض تجربة “كيدزانيا” في هذا المجال. فقال الحبوبي: “كيدزانيا مدينة تعليمية ترفيهية، وشعارها: مدينة يحكمها الأطفال. فالطفل عندما يدخل إلى المدينة يدلف إلى مطار يقلع منه إلى عالم ثانٍ بعد أن يحصل على بطاقة سفر. فهو يدخل على عالَمِ حقيقي واقعي للأطفال، ويأخذ معه “شيك” بعملة كيدزانيا، وهي عملة يتم صرفها من بنك حقيقي داخل المدينة، ويستخدمها في الشراء، أو في ممارسة اللَّعِب في أكثر من 70 نشاطاً ترفيهياً تعليمياً، ليس من بينها أي نشاط مرتبط بالكمبيوتر، وإنما هي مهن للمستقبل، بعضها يقوم الطفل بالدفع مقابلها، وبعضها يحصل منها على نقود. وعندما لا تكون لديه نقود، فسيكون لزاماً عليه أن يلجأ إلى العمل في إحدى المهن ليكسب منها النقود، حتى يتمكَّن من اللَّعِب.
ويضيف الحبوبي: بعض المهن، لا يمكن لأقل من 4 أطفال أن ينخرطوا فيها، وهذا ينمِّي روح العمل الجماعي عندهم، والتواصل في ما بينهم، وتوزيع الأدوار. وفي بعض الألعاب، يتم عرض فيديو تعليمي حول كيفية التعامل مع بعض الأعمال بطريقة ترفيهية، وبواسطة شخصيات محبَّبة إلى الأطفال.
أطفال اليوم يبدون أكثر نضجاً وذكاءً من الأطفال قديماً، فالطفل الذي عمره اليوم أربع سنوات، يساوي في نضجه الذهني طفلاً عمره 8 سنوات من الجيل السابق.
ومن الأقسام المهمة لدينا قسم للمعلومات الوظيفية واكتشاف الشخصية، حيث يُجرى اختبار للطفل عند دخوله إلى المدينة للمرة الأولى، وبناءً على نتيجة هذا الاختبار يتم توجيهه إلى المهن التي تناسب شخصيته، ومهاراته. إضافة إلى وجود “جامعة كيدزانيا” التي يدخلها الطفل، ويقوم بإجراء اختبارات متنوِّعة، وعندما يجتازها بدرجة معيَّنة يمنح شهادة بكالوريوس أو شهادة ماجستير وهو أمر يبدو ممتعاً جداً للأطفال.
وحول طبيعة الألعاب في “فناتير”، وتصميمها قال عبدالله العمودي: دورنا هو اكتشاف مهارات الطفل من خلال الألعاب الفردية والجماعية، التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي أكثر بفعل المشاركة مع الآخرين. وعادة، تقوم  لجنة مختصة من “فناتير” بالاطلاع على آلاف الألعاب والمنتجات التي تعرضها الشركات الكبيرة، واختيار ما يتناسب منها مع بيئتنا، ويتوافق مع المسموح به لدينا. ومن المهم الإشارة في هذا الإطار إلى أن الشركات الكبيرة في الخارج لا تستهدف العالم العربي بشكل كبير. وهذا يدفعنا إلى القيام بجهد كبير لاختيار الأصناف، وترجمتها، والتأكد من جميع المواصفات والمقاييس، وألاَّ يكون فيها ضرر على الأطفال، وخصوصاً في المراحل المبكرة”. وحول سؤال طرحه أحد المشاركين عمّا قد تسبِّبه بعض الألعاب من أضرار أو أفكار قد تخالف ما نؤمن به ونعتقده، أوضح العمودي أنه ينبغي أن يكون هناك تحصين فكري من قِبل الآباء والأمهات لأبنائهم حول ما يمكن ان يتعرَّضوا له من الألعاب، أو بصورة عامة في حياتهم كلها.
لجنة مختصة من “فناتير” بالاطلاع على آلاف الألعاب والمنتجات التي تعرضها الشركات الكبيرة، واختيار ما يتناسب منها مع بيئتنا، ويتوافق مع المسموح به لدينا. ومن المهم الإشارة في هذا الإطار إلى أن الشركات الكبيرة في الخارج لا تستهدف العالم العربي بشكل كبير. وهذا يدفعنا إلى القيام بجهد كبير لاختيار الأصناف، وترجمتها، والتأكد من جميع المواصفات والمقاييس، وألاَّ يكون فيها ضرر على الأطفال، وخصوصاً في المراحل المبكرة”. وحول سؤال طرحه أحد المشاركين عمّا قد تسبِّبه بعض الألعاب من أضرار أو أفكار قد تخالف ما نؤمن به ونعتقده، أوضح العمودي أنه ينبغي أن يكون هناك تحصين فكري من قِبل الآباء والأمهات لأبنائهم حول ما يمكن ان يتعرَّضوا له من الألعاب، أو بصورة عامة في حياتهم كلها.
كيف يمكن أن تكون الأشياء الجادة لعبة؟
 حول هذا الشأن تحدَّث فيصل بن سلمان عن “اللعب والجدية”، وأكد أن ذلك مرتبط بكون اللعبة متعة، إذ لا يعيب الجدية أن تكون لعبة، وإنما مربط الفرس في أن تكون ماتعة.
حول هذا الشأن تحدَّث فيصل بن سلمان عن “اللعب والجدية”، وأكد أن ذلك مرتبط بكون اللعبة متعة، إذ لا يعيب الجدية أن تكون لعبة، وإنما مربط الفرس في أن تكون ماتعة.
وأضاف: إذا نظرنا إلى بعض ألعاب الملاهي، فسنجد أنها تخيف بعض الفئات العمرية، ولا تناسبها أساساً. ولذلك لا تُسمَّى لعباً، وإنما هي شيء مخيف ومرعب. وفي الحقل التربوي، دائماً ما نسعى لربط الأشياء الجادة بالمتعة في ما يعرف بـ”التعليم بالترفيه والتربية بالترفيه”. والحق أننا نواجه تحدياً مع (القراءة) في هذا الإطار، وهو كيف نجعل من القراءة متعة للطفل، حتى يتعامل معها وكأنه يتعامل مع الأشياء التقنية ومع الألعاب. فالكتاب في مواجهة مع الآيباد وألعاب الذكاء وأفلام الكرتون. والتحدي الحقيقي هو كيف نجعل من الكتاب متعة أمام ذلك كله، خصوصاً أن كثيراً من الألعاب تعتمد على المتعة بمؤثرات صوتية، وأشكال جذابة وغيرها.
دراسة علمية كشفت أن أعظم المبتكرين في عصرنا لم يتعلَّموا في مدارس تقليدية، بل درسوا في مدارس تسمح لهم باللَّعِب الحرّ، وأنهم كانوا لا يملكون ألعاباً ملموسة، وإنما كانت لديهم مساحة مفتوحة ليبتكروا ألعابهم بأنفسهم.
نحن نبحث عن الكتب التي تشابه اللعب في متعتها. ومن الأمثلة على ذلك: كتاب “أصدقائي في البحر”، فما المتعة في هذا الكتاب؟! إنه عبارة عن قصة، لكن الطفل عندما يفتح الكتاب، يظهر له الحوت على شكل مجسم وكائنات بحرية أخرى. وهذا ما يجلب المتعة للطفل، ويجعله مرتبطاً بالقراءة وبالكتاب. وهناك كتب أخرى تتلوَّن بالماء، يمكن أن يلعب بها الطفل أثناء الاستحمام أو السباحة. وهذه أمثلة على الكتب التي يمكن أن تكون ألعاباً، يلعب بها الطفـل، بعيداً عن القراءة فيها، ويكون دور المربي (أو الوالدين) إشعار الطفل بأن هذا كتاب، ويضم صفحات، وهذه الصفحات للقراءة.
اللَّعِب العنيف ليس كله سيئات!
 وفي نهاية جلسة النقاش، كانت الكلمة لسحاب التي أشارت فيها إلى تعريف الجمعية الوطنية للَّعِب في أمريكا، وهو أن اللَّعِب نشاط طوعي، لا يشعر فيه الإنسان بنفسه. مضيفةً أن ذلك جعل أشكاله غير محدودة تماماً، ويكون الطفل مستمتعاً فيه حتى أقصى درجة، سواء أكان قراءة كتاب، أو لُعبة، أو جري، أو تبادل أدوار، أو غناء، أو رسم، أو أي نوع من أنواع الفنّ التي تُعدَّ ألعاباً.
وفي نهاية جلسة النقاش، كانت الكلمة لسحاب التي أشارت فيها إلى تعريف الجمعية الوطنية للَّعِب في أمريكا، وهو أن اللَّعِب نشاط طوعي، لا يشعر فيه الإنسان بنفسه. مضيفةً أن ذلك جعل أشكاله غير محدودة تماماً، ويكون الطفل مستمتعاً فيه حتى أقصى درجة، سواء أكان قراءة كتاب، أو لُعبة، أو جري، أو تبادل أدوار، أو غناء، أو رسم، أو أي نوع من أنواع الفنّ التي تُعدَّ ألعاباً.
ولفتت إلى ما يسمى بـ”اللعب العنيف”، وأوضحت: هناك دراسة على هذا النوع من اللعب، مثل الكاراتيه، أظهرت أن الأطفال الذين لا يمارسون هذه اللعبة، أو يمنعون من التشابك بالأيدي في ما بينهم، معرَّضون لاحتمال دخولهم السجن عندما يكبرون أكثر من الأطفال الذين تركت لهم مساحة للاشتباك في البيت، وذلك لأنهم اضطروا أن يأخذوا العنف إلى الشارع وإلى الواقع. ولذلك فإن استخدام الأيدي في اللعب مفيد، ونقول للأطفال فوق عمر السنتين مارسوا رياضة “الكاراتيه”.
وختمت سحاب بالإشارة إلى صناعة الألعاب في المملكة، بقولها إن صناعة الألعاب في المملكة بدأت تتطور كثيراً، وهذا يعود إلى حاجة عالمية للتواصل. ونحن جميعاً لدينا هذه الحاجة.
كيف تلعب تولان؟

استضافت جلسة النقاش الطفلة تولان (12 سنة) التي حدَّثت الحاضرين عن الألعاب التي تفضِّلها، وأجابت عن بعض أسئلتهم.
فحول الألعاب التي تُحب أن تلعبها في البيت قالت : “في البيت أحبُّ أن أحضر ورقة وقلماً، وأكون برفقة أمي، وأسألها عن جميع الأحداث التي حدثت في المنزل، ثم أقوم بكتابتها، وطباعتها مرَّة أخرى على الكمبيوتر، وتعليقها على الجدار.
وحول الألعاب القديمة، وهل سبق أن لَعِبتها أو سمعت بها، قالت: نعم أسمع بها، وأعرف بعضها، لكنني لا أحبُّ أن ألعبها لأنَّ فيها جرياً، ومضاربات، واحتكاكاً جسدياً مع الآخرين، هكذا فأنا أحبُّ الألعاب التي أستمتع بها فعلاً، مثل ألعاب الكمبيوتر، التي فيها كتابة، وتصميم، وطباعة مثلاً.
وتضيف: تعلَّمت من خلال اللَّعِب في “كيدزانيا” أن أستعد للمستقبل، وأستمتع فيها بألعاب تبعدني عن الأجهزة الإلكترونية والذكية! إضافة إلى أنني أصبحت اجتماعية أكثر، أعمل دائماً مع فريق وليس بمفردي.ومع الإعجاب بما قالته هذه الطفلة، انقسم الحضور بين مَنْ يرى أن لعبها يجافي اللعب نفسه. فاللعب لَهْوٌ، وقفزٌ، وضحكٌ، وشجارٌ، وخلافٌ، ولا قيود فيه. وهذا اللَّعِب الحرّ الممتع هو ما يفتقده طفل اليوم. في حين رأى بعض آخر أننا لا نستطيع الاستغناء عن اللعب أو الترفيه بالتعليم، ولا عن اللعب الحر لأجل المتعة، فكلاهما يتكاملان في تنمية شخصية الطفل.