يُعرف عن الكاتب الكبير غابرييل غارسيا ماركيز أنه ما كان يستطيع الكتابة الإبداعية إلا إذا تنشق رائحة الورد الأصفر العطرة. وبالمقابل، لم يكن يأتي الإلهام إلى الملكة الإنجليزية إليزابيث الأولى إلا إذا وضعت على قلادتها رائحة التفاح المتعفن الكريهة. فكيف لنا، في عصر الذكاء الاصطناعي، أن نعلّم الآلة قياس الرائحة إذا كانت الروائح المتناقضة تثير المشاعر نفسها؟
لقد نجح الذكاء الاصطناعي حتى اليوم في محاكاة كثيرٍ من الخصائص الإدراكية والمنطقية لحواس الإنسان، خاصة حواس البصر والسمع واللمس وحتى التذوق، لكنه تعثّر في حاسة الشَّم. فهل لتداخل التركيب البيولوجي لجهاز الشَّم مع تراكم التأثيرات الثقافية، للبيئات الخاصة عبر التاريخ، علاقة بهذا التعثر؟
لا شكّ أن حاسة الشّم، بالإضافة إلى كونها جزءاً من التركيب البيولوجي للإنسان والحيوان، تمتلك أبعاداً ثقافية مكتسبة تختلف من شخص إلى آخر ومن بلدٍ إلى آخر. فبعض روائح الطهي مثلاً، تثير شهية أشخاص، بينما هي نفسها تثير الغثيان عند البعض الآخر. لذلك، عندما نسأل: ماذا تثير لدى بعض الأفراد رائحة الياسمين أو الشاي الأخضر؟ من الصعب أن نتلقّى إجابة ثابتة تنطبق على الجميع. لأن الإجابات تتفاوت من ثقافة إلى أخرى.
إذا كان الكمبيوتر يستطيع أن يتعرَّف إلى رائحة القهوة، وبناء برمجيات تعتمد على التحليل الكيميائي لذلك، فهل تكون رائحة القهوة معروفة عندما تختلط برائحة الطبخ مثلاً؟ هذا ما يحاول الباحثون حله حالياً، أي تجزئة الروائح ووصفها كما هي، حتى في البيئات المختلفة. ويتعلق هذا الأمر بإعادة تكوين حاسة الشَّم في الأنف البشري.
ولو كنا نتشارك اللغة أو التقاليد، فالروائح تبقى، في جانبٍ منها على الأقل، شأناً ذاتياً. لأن الجهاز الشّمّي يتعرَّض منذ اللحظات الأولى لولادة الجنين، وحتى ما قبل الولادة، لتحفيزات مختلفة تحدّد الروائح التي يفضّلها، ثم يأتي بعد ذلك دور البيئة ونمط الحياة ليعزِّز ذلك. وبحسب بعض الدراسات العلمية، فإنَّ الحاسة الأولى التي تكتمل لدى الطفل هي حاسة الشم، ويرجّح أنها تكتمل داخل الرحم في الشهر السابع، ما يساعده على تمييز الروائح التي تنتقل إليه من خلال سائل الأمنيوتيك. ما يعني أنها من أوائل الحواس الإدراكية التي يتعامل بها مع محيطه.
وهناك عامل آخر يضفي خصوصية على حاسة الشَّم، وهو علاقتها بالحواس الأخرى. فإذا كانت العلاقة بين التذوق والشّم وثيقة، فإن العلاقة مع الحواس الإدراكية الأخرى ما زالت غير واضحة. فهل ثَمَّة تفاعلات بين الصوت والرائحة؟ هل المنبّهات الشمّية تتعلق بالاستماع إلى الموسيقى؟ طبعاً للأمكنة روائح خاصّة أيضاً، فهل من هُوية شميّة للمدن؟
وبالإضافة إلى التباينات الثقافية التقليدية، فإن هذا الموضوع تشعّب إلى تعقيدات حديثة إضافية، تتعلق بتلاعب عمليات الترويج والتسويق بأذواق المستهلكين، باعتبار أنَّ الزبائن يتفاعلون بحواسهم كافّة عند التسوق، وهو ما يسمّى “التسويق الحسـي”. إننا نتحدث عن علاقة وثيقة بين الروائح والذاكرة والمشاعر والتسويق، للتأثير في سلوكيات الفرد، كما في علاقاتهم الاجتماعية ومهاراتهم التواصلية.
بداية رحلة الذكاء الاصطناعي
إنَّ التطورات التكنولوجية التي شهدتها فترة الثمانينيات في مجال أجهزة الكمبيوتر، سمحت للأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي بعبور مسار طويل. فقد جرى التنبؤ بهذه التطورات في العام 1965م، من خلال ملاحظات المهندس الكهربائي ومؤسّس شركة “إنتل” جوردون مور. يتعلَّق قانون “مور”، وهو الاسم الذي ارتبط بهذه الآلية الحسابية، بالقدرة على معالجة الدوائر المتكاملة، وهو يفترض أنَّ عدد الترانزستورات في كل دائرة متكاملة (وبالتالي القدرة الحاسوبية للدائرة) يتضاعف كل عام (عاد لاحقاً وعدله إلى سنتين). وكان هذا التنبؤ دقيقاً حتى الآن، ما يوضح النمو الهائل لأجهزة الكمبيوتر والصناعة الرقمية ككل.
يحاول الباحثون اليوم القيام بما قام به تورينغ مع اللغة، من أجل الرائحة الافتراضية للتحقّق من فعاليتها. وقد تم اختراع “اختبار تورينغ” لمعرفة ما إذا كان الإنسان قادراً على التمييز بين ما يشبه الذكاء الاصطناعي عند تبادل الرسائل المكتوبة. في نسخته “الشمية”، يربط الاختبار مقطع فيديو من المكان الذي جمعت فيه الرائحة برائحة اصطناعية منتشرة، لتحديد ما إذا كان ذلك يبدو “حقيقياً” بالنسبة إليه.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تتعلَّق المساهمة الرئيسة لقانون مور بتطور تعلّم الآلة: القدرة على تطوير الخوارزميات وتنفيذها (مجموعات القواعد التي تحكم أنشطة الحساب والحوسبة)، لحلّ المشكلات التي يمكن أن تتعلَّم بالفعل من البيانات الإدراكية الأولية بدلاً من المعلومات المحدَّدة مسبقاً. إنَّ تطوّر نظام واتسون (نظام حاسوب للذكاء الاصطناعي يستطيع الإجابة عن أسئلة بلغة طبيعية)، الذي تمكن في عام 2011م من حل الألغاز اللغوية والفوز في برنامج مسابقات “جيوباردي” التلفزيوني الأمريكي، يعطي لمحة عن هذه القدرة.
وإذا كان الذكاء الاصطناعيّ وما يطمح إليه هو بناء برمجيات تحاكي الفكر البشري ذهنياً، فعلى البرمجيات أن تزوّد الآلات بمهارات يتمتع بها العقل البشري وكذلك بكل المعطيات الموجودة في بيئته أيضاً، لكي تخلص إلى نتيجة تسهم في صنع القرار خاصة تمثيل الميزات البشرية المعقدة مثل حاسة الشَّم فهل سيتمكن الكمبيوتر من أن يتمتع بهذه الخاصية، أي إنشاء أنف اصطناعي؟
قياس الرائحة
حتى الآن، يوجد عديد من التجارب البحثية في هذا المجال، يُستخدم أكثرها في تطبيقات قادرة على تحليل البيئة واكتشاف وجود بعض المواد الكيميائية في الغلاف الجوي، تكون بمثابة إصدار أولي للرائحة.
وإذا كان بإمكان الكمبيوتر التعرف إلى بعض الروائح المحددة في بيئة صافية، من خلال تحليل الجزيئات الكيميائية التي تنبعث منها، فماذا عن إمكانية تطوير البرمجيات لكي تتأقلم مع البيئات المتقلّبة التي تصدر روائح مختلفة، لأن الجزيئات التي تصدرها تكون في أغلب الأحيان مختلطة مع جزيئات كيميائية أخرى في الحيز الفضائي نفسه؟ فإذا كان الكمبيوتر يستطيع أن يتعرف إلى رائحة القهوة، وبناء برمجيات تعتمد على التحليل الكيميائي لذلك، فهل ستكون رائحة القهوة معروفة عندما تختلط برائحة الطبخ مثلاً؟ هذا ما يحاول الباحثون حله حالياً، أي تجزئة الروائح ووصفها كما هي، حتى في البيئات المختلفة. ويتعلق هذا الأمر بإعادة تكوين حاسة الشمّ في الأنف البشري، من أجل تزويد الآلات بالمهارات التي تتجاوز القدرة على التعرف إلى المواد الكيميائية.
وبحسب آخر الأبحاث في جامعة “إم آي تي”، فإنّ إعادة إنتاج الأحاسيس “الشمّية” ما زالت تشكّل تحدياً حتى الآن، وما زال بعض الباحثين يحاولون تخطّي هذه المعضلة. فإذا كانت إعادة إنتاج الإشارات البصرية مع التصوير الفوتوغرافي والصوت عبر الهاتف قد أعطى نتائج مقنعة إلى حد ما، بعد تطورهما المبكر في القرن التاسع عشر، فمع الرائحة، لا وجود لشيء مماثل، لأنَّ التكاثر الصناعي للروائح يعد تحدياً إضافياً أكثر تعقيداً.
لذلك، يحاول الباحثون اليوم القيام بما قام به تورينغ مع اللغة، من أجل الرائحة الافتراضية للتحقّق من فعاليتها. وقد تم اختراع “اختبار تورينغ” لمعرفة ما إذا كان الإنسان قادراً على التمييز بين ما يشبه الذكاء الاصطناعي عند تبادل الرسائل المكتوبة. في نسخته “الشمية”، يربط الاختبار مقطع فيديو من المكان الذي جمعت فيه الرائحة برائحة اصطناعية منتشرة، لتحديد ما إذا كان ذلك يبدو “حقيقياً” بالنسبة إليه.
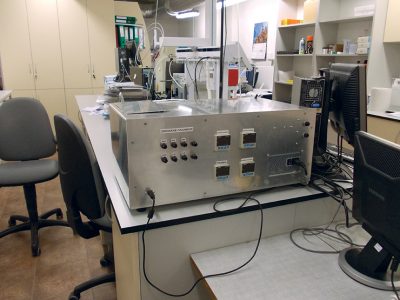
حدود قدرة الذكاء الاصطناعي
من المؤكّد أن البرمجيات ما زالت عاجزة عن القيام بأمور عديدة! وبحسب كونراد كوردينج، عالم الأعصاب الحسابي في جامعة بنسلفانيا، فإنَّ الحواسيب “فاشلة في تأليف الموسيقى أو كتابة قصص قصيرة”، ذلك أنَّ قدرتها على “التفكير” المنطقي ما زالت تشكِّل معضلة كبيرة، على الرغم من أنّ كل تصاميم الخوارزميات يرتكز على علم المنطق، مهما كانت طبيعتها، سواء للتعلم الآلي، أو التعلّم المعمّق، أو الشبكـات العصبيـة الاصطناعيـة، أو للبرمجة التركيبية.
وبشكل مبسّط، إنَّ دراسة الصور والتعرف إليها يحصل من خلال التعرف إلى تداخل البيكسلات في ما بينها وتوزيعها وتطابقها مع صور أخرى، وبالتالي التعرّف إلى الأشكال، أي إلى الهيكل العام لكل كائن (البيكسل هو أصغر عنصر في مصفوفة صور نقطية). وتصنّف الصور وفقاً لهذه القواعد المبرمجة أو تلك التي تبرمج تباعاً بناءً على خوارزميات التعلم الآلي. فيقوم الكمبيوتر بتقليد الهيكل المرئي، ثم تحاول البرمجيات أن تتعرَّف أكثر إلى الألوان وإلى التغيرات في الهيكل (العظمي)، لأن الناس تختلف قليلاً في هيكلها بحسب القوميات والجنسيات.
إذاً، كيف سيتم تطوير خوارزميات تعتمد على حاسة الشَّم من دون أن يكون لذلك بيانات سابقة حتى تستطيع الخوارزميات استنتاج الأنماط منها؟ وهل يمكن تحسين أداء تقنيات التعلم الآلي في عمليات البحث عن التشابه واكتشاف كل جديد؟
عندما درس الباحثون حاسة الشم في مطلع العقد الأول من القرن العشرين، طوروا خوارزميات لتحديد كيف ساعد التضمين العشوائي والتناثر في الأبعاد العليا في الكفاءة الحسابية. وما زالوا يبحثون عن طرق لاكتشاف العلاقة بين آلية عمل حاسة الشم والتعلم الآلي، لربطهما معاً وصولاً إلى بناء خوارزميات تحاكي هذه العملية المعقدة نسبياً حتى الآن.
عند البحث عن الصور، من الممكن احتساب البيكسلات والقيام بالتطابق. ولكنَّ حاسة الشم لها آليات مختلفة، لأنَّ الصور والعين وارتباطها بالخلايا الدماغية وتفاعلاتها متشابهة، أما البيانات المستقاة من حاسة الشم، فهي ليست متشابهة. وتتمثل مشكلة الروائح في كونها غير مهيكلة وغير محصورة في إطار مكاني محدَّد، كما أنها ليست جزيئات يمكن جمعها في الفضاء، فهي مزيج من تركيبات كيميائية منتشرة في المكان، ومن الصعب تصنيفها، لأنها غير متماثلة، وهي في الوقت نفسه ليست مختلفة، فكيف يمكن تحديد ميزاتها بشكل عام؟ (مع أن موضوع دراسة نفَس الإنسان للتعرّف إلى بعض الأمراض ممكن حالياً).
ونعلم أن حاسة الشَّم مرتبطة بحاسة التذوق أيضاً. وتجري عملية شم الروائح بواسطة شبكة مؤلفة من ثلاث طبقات، تبدأ من الشعيبات الأنفية، وتنتقل إلى الجهاز العصبي في الدماغ المهيأ لذلك. وتقوم الخلايا العصبية في المناطق الشمّية بأخذ عيِّنات عشوائية من مساحة الاستقبال بالكامل، تُترجم في الخلية العصبية كنوع المعلومات التي تحملها. وتثير رائحة واحدة عديداً من الخلايا العصبية المختلفة، وتمثل كل خلية عصبية مجموعة متنوِّعة من الروائح، يعدها البعض فوضى معلومات، من تمثيلات متداخلة تتواجد في ما يعرف باسم “القشرة المخية”، ما يسهل التمييز بين الروائح وأنماط الاستجابات العصبية.
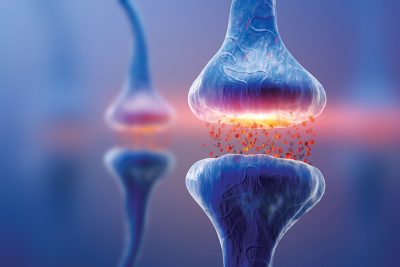
عندما درس الباحثون حاسة الشم في مطلع العقد الأول من القرن العشرين، طوروا خوارزميات لتحديد كيف ساعد التضمين العشوائي والتناثر في الأبعاد العليا في الكفاءة الحسابية. وما زالوا يبحثون عن طرق لاكتشاف العلاقة بين آلية عمل حاسة الشم والتعلم الآلي، لربطهما معاً وصولاً إلى بناء خوارزميات تحاكي هذه العملية المعقدة نسبياً حتى الآن.
وقد بدأ العلماء بإعادة النظر في كيفية التركيب البيولوجي لحاسة الشم، لمعالجة مشكلات التعلم الآلي المحدَّدة، من خلال إعطاء الخلايا العصبية الاصطناعية مزيداً من بيانات التدريب، لمعرفة كيف تستطيع الكائنات الحية إجراء مقارنات سريعة ودقيقة عند تحديد الروائح، ولكن المشكلة تقع عندما تختلط الجزيئات خلال عمل النظام الشمّي، لأنّ الإنسان يميز بعض الروائح كرائحة فردية، وأخرى كمزيج من الروائح.
هل نستطيع التحدث عن الذكاء عند الحديث عن آلة؟ فالذكاء تم تخصيصه للإنسان على وجه التحديد، نشأ وتبلور تاريخياً كحاجة تطورية بقائية، فهل له المعنى نفسه في سياق آخر؟
ومقارنة بما يتعلّق بتمييز الأصوات عندما يتكلم عدة أشخاص في الوقت نفسه، فقد يحلّ الذكاء الاصطناعي هذه المشكلة عن طريق تقطيع الإشارات الصوتية إلى نوافذ زمنية صغيرة جداً من الممكن أن تؤدي إلى تفكك شبكة المحادثات، ولكن العقدة في حاسة الشم هي أن الروائح ذات الهياكل الكيميائية المماثلة يمكن اعتبارها مختلفة في حالات أخرى.
مشكلة الخلط بين
تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي
في كل الأحوال، ربما يشكِّل هذا التحدي الذي تفرضه حاسة الشم على باحثي ومطوري الذكاء الاصطناعي، فرصة لكشف بعض الأوهام التي نغرق فيها حول الخلط بين تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي. والمطلوب إعادة تعريف هذه المفاهيم بدقة.
فإذا كان الذكاء الاصطناعي يقوم في الأساس على إنشاء خوارزميـات أو آلات قادرة على “تقليد البشــر” في أشكال معينـة من أعمالهم (النظــر، القـراءة، التواصل، التحليل، والمشي…)، فإنَّ هـذه العمليـة تتمّ بالتعلـم من خلال نمذجـة التجارب السابقة للإنسان، والتعلم الآلي هو أحد العمليات التي تسمح للذكاء الاصطناعي بالتعلم. لذلك، إنه وسيلة يمكن فصلها عن الذكاء الاصطناعي.
هذه الإشكالية هي انعكاس حقيقي لمعنى الذكاء، فهل نستطيع التحدث عن الذكاء عند الحديث عن آلة؟ فالذكاء تم تخصيصه للإنسان على وجه التحديد، نشأ وتبلور تاريخياً كحاجة تطورية بقائية، فهل له ذات المعنى في سياق آخر؟
ومن غير المنطقي التحدث عن الأجهزة الذكية، بغض النظر عما تفعله، فهو ليس سوى ما نفعله نحن! كما أن الذكاء والغباء ليسا من الخصائص التي تميز الآلات، بل هما خاصيتان متعلقتان بالبشر فقط. فالآلات لا تفكر، وهي في الأساس عبارة عن خوارزميات؛ صحيح أن الآلات لها حياة، لكن هذه الحياة ليست إنسانية!
ومهما كانت التسمية، المهم أن الذكاء الاصطناعـي اليوم هو بمثابة رصيد حقيقي للبشرية، ويبدو أنه قد يصبح قوة في خدمة الإنسان إذا ما استُخدم بشكل صحيح، بالرغم من تمرد حاسة الشم حتى الآن.
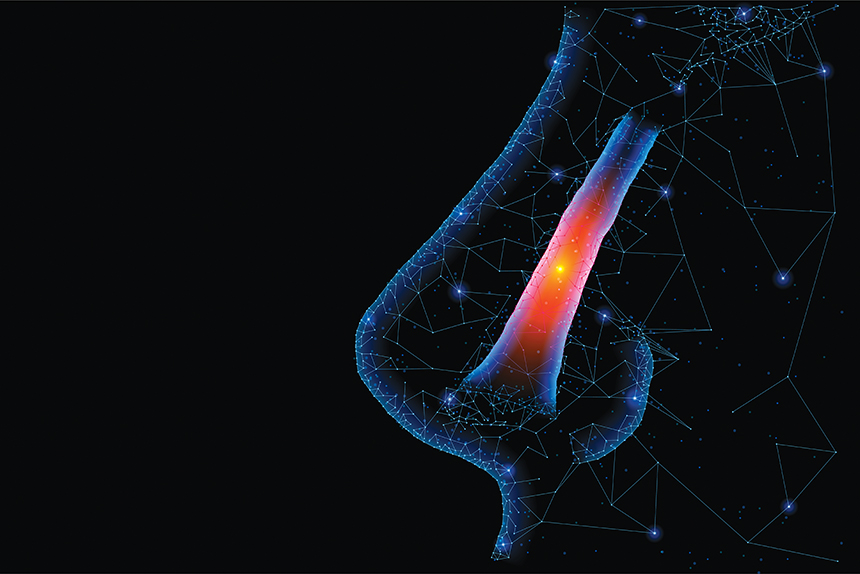





اترك تعليقاً