
لا يمكن لمتابعي الساحة الروائية العالمية من القرَّاء والكتَّاب والسينمائيين وناشري الكتب الأكثر مبيعاً، ولا حتى المراهنين على جوائز نوبل كل عام، أن يتجاهلوا اسم الروائي التشيكي العتيق: ميلان كونديرا.خفته السردية التي لا تحتمل، ضحكه وسهواته، حياته التي هي في مكان آخر، مزحته الثقيلة أدبياً، لقاؤه النقدي والستارة التي تحيط خشبة مسرح الأدب، بطؤه وخلوده وحكايته عن الجهل، ومؤخراً: «حفلة التفاهة» التي ترجمها إلى العربية معن عاقل، وصدرت عن المركز الثقافي العربي..
كونديرا ساخر كبير. سخر من نفسه، من مواطنيه، من تقنيته الروائية، من طرق الكتابة، من قارئه، مني شخصياً في «الحياة في مكان آخر»، من الأوطان التي تزول، تضمحل وتختفي في طيات ثوب التاريخ السابغ، من المنافي التي تتلبس الروح واللغة والقلب. يشترك كونديرا مع العملاق الروسي دوستويفسكي في تلبيس قارئه شخصيات الحكاية، في إيهامه أنه المعني بنقطة القنص النصي، في أن يقوم القارئ فزعاً، يبحث عن مرآة يستمري ملامحه: أكل هذا الشبه الملامحي الحكائي محض حكاية؟ كونديرا درس ودرَّس السينما طويلاً قبل أن يجرفه تسونامي الحكاية الكتابية.
في حفلته الأخيرة، المعنونة بـ «حفلة التفاهة»، أو «صخب اللامعنى»، يسخر كونديرا أيضاً، يسخر من الولادة والموت، من مقاييس الجمال والقباحة، من سلطات الإغراء ومنابع الفتنة، من التاريخ كيف ينتقل من العجائبية إلى الاعتيادية، يسخر من الحروب والطغاة الكبار، من ستالين تحديداً، وقصص الأكاذيب الساذجة، التي ما كان جمهور البطانة الصالحة يجد أمامها سوى الضحك الصاخب، لتكتمل حفلة التفاهة.
ولأن ستالين يمر في ثنايا الحكاية، فإن الكاتب المنزوع من بلده ولغته – يكتب كونديرا بالفرنسية منذ السبعينيات – بسبب هذا الطاغية ومجايليه، ولكونه في البلد واللغة التي شهدت ميلاد حقوق الإنسان، يقدِّم هجاءً لاذعاً ومتهكماً لحقوق الإنسان التي لا يختار المرء أبسط أبجدياتها: حقه في الولادة، وحقه في تحديد زمانها ومكانها، وحقه في الرحيل أيضاً: الانتحار، مشيراً إلى أن «الجميع يهذون حول حقوق الإنسان. ويا لها من طرفة! لم يتأسس وجودك على أي حق، ولا حتى يسمح لك فرسان حقوق الإنسان أن تنهي حياتك بإرادتك. انظر إليهم جميعاً، نصف هؤلاء الذين تراهم قبيحون إلى حد ما. أن يكون المرء قبيحاً، هل هذا أيضاً جزء من حقوق الإنسان؟ وهل تعرف أنه يحمل قبحه طيلة حياته؟ من دون أي راحة؟ جنسك أيضاً، أنت لم تختره، ولم تختر لون عينيك، ولا الزمن الذي تعيش فيه، ولا بلدك، ولا أمك، ولا أي شيء مهم. الحقوق التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان، لا تتعلق إلَّا بتفاهات، وليس ثمة سبب للصراع حولها أو كتابة إعلانات شهيرة عنها».
يعرَّف كونديرا في الموسوعات الأدبية بالكاتب والفيلسوف، وبصفته هذه، فهو يفاجئك. مرت عليه الرؤى والحكايات، بزوايا لا يأخذها العابر على محمل اللَّاخفة. في هذه الرواية، نراه يناقش مركز الجمال الذي يجب أن تلتفت إليه دور ترويج الجمال والتصميم، أو توجيه الأعين نحوه، بعد مرور قرون طويلة على اعتبار الخصور والصدور والنحور والثغور مصادر الجمال، ومحط رحال العيون.
ما بين الولادة والموت
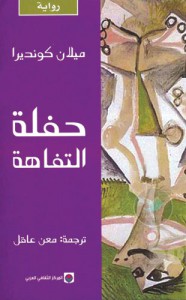 يتفق كونديرا مع سيوران، الذي شاركه الأمرين – يمكنك تشديد الراء – الهروب من شرق أوروبا، والمكوث في لغة دخيلة، في نظرتيهما إلى عموم الحياة، وإلى مسألة العبور إليها تحديداً: الولادة، فبعد أن كتب سيوران، كتاباً كاملاً يهجو به الولادة «مثالب الولادة»، – تُرجم مؤخراً على يد المختص فيه دائماً: آدم فتحي – يأتي كونديرا فيقول: «سأكون صريحاً. يبدو لي دائماً، أنه من المرعب أن ترسل شخصاً إلى عالم لم يكن يطلبه»، مما يؤدي بحدّ رؤية روايته إلى انعدام جدية حقوق الإنسان.
يتفق كونديرا مع سيوران، الذي شاركه الأمرين – يمكنك تشديد الراء – الهروب من شرق أوروبا، والمكوث في لغة دخيلة، في نظرتيهما إلى عموم الحياة، وإلى مسألة العبور إليها تحديداً: الولادة، فبعد أن كتب سيوران، كتاباً كاملاً يهجو به الولادة «مثالب الولادة»، – تُرجم مؤخراً على يد المختص فيه دائماً: آدم فتحي – يأتي كونديرا فيقول: «سأكون صريحاً. يبدو لي دائماً، أنه من المرعب أن ترسل شخصاً إلى عالم لم يكن يطلبه»، مما يؤدي بحدّ رؤية روايته إلى انعدام جدية حقوق الإنسان.
وإثر الولادة التي تأتي من دون إذن الإنسان، يأتي الفصل النهائي متمثلاً بالموت. والذي برغم جديته، يهجو كونديرا به حس الجمهور العام، وكيف يحكمه النسيان والتجاهل. نسيان ناسه الموتى وحقوقه الحية، حتى يغدو النسيان نمط حياة، ومصدراً ليكمل المرء حياة اللامعنى التي مهما امتدت، بين الفصلين اللامختارين، تبدو ضئيلة وقصيرة.
يكتب كونديرا هذا العمل وعمره جاوز الثمانين، أي في سنٍّ يسعى الناس لتمضيتها في أي شيء، «إنهم مستعدون للذهاب إلى أي مكان، لفعل أي شيء، فقط ليقتلوا الوقت الذي لا يعرفون ما يفعلون به»، قائلاً: «الزمن قصير. وبفضله نحن أحياء أو لا، أي: متهمون وقضاة. ثم نموت، ونظل لبضع سنوات أيضاً مع أولئك الذين عرفونا، لكن سرعان ما يحدث تغير آخر: يصبح الأموات أمواتاً قدامى، ولا يعود أحد يتذكرهم، ويختفون في العدم، بيد أن بعضهم، وهم قلة نادرة، يتركون أسماءهم في الذاكرة، وهؤلاء يتحولون إلى دمى بعد تجريدهم من أية شهادة صادقة ومن أية ذكرى واقعية».
في معناه للتفاهة
يفلسف كونديرا التفاهة، يقول عنها بحس المتهكم الخبير: «اللامعنى، يا صديقي، هو جوهر الوجود. وهو معنا دائماً في كل مكان. إنه موجود حتى حيث لا أحد يريد أن يراه: في الأهوال وفي الصراعات الدموية وفي أخطر المآسي. ولكن ليس المقصود هو التعرف إلى اللامعنى، بل التعلق به وتعلّم كيفية الوقوع في حبه، صديقي، تنفس هذه التفاهة التي تحيط بنا، إنها مفتاح الحكمة، مفتاح المزاج الجيد والرضا»، في زمن أصبحت فيه حتى «المُزح خطرة» على حد حكايته.
من يعرف أجواء كونديرا الكتابية، الدروس التي يمنحها بين سطوره الغزيرة، في مروياته، أو في نقدياته، يلمح تفاصيل الجد العدمي، وهو يأتي هزلاً ضاحكاً، يشبه الدمعتين اللتين توشكان الهطول إثر نكتة تُلقى على روح بائس. يرى كيف يوقف الحكّاء الكبير تدفق الرواية السلس، ليطلب بتهكم إذن القارئ المجهول، في أن يغيِّر مجرى الحكاية، بالتخلص من البطل الممل، بقتله أو تحويله إلى كومبارس، أو تقديم فصل على فصل، وإبدال حدث بحدث.
وفي حفلته الأخيرة، يرى المرء كيف أن كونديرا يحس باللاجدوى مؤخراً، بعد نصف قرن من الكتابة – بدأ الاهتمام الفعلي بعالم كونديرا كتابياً عام 1963 -، فتبدو حفلة التفاهة حتى في طريقته السردية، في وصف «حفلة التفاهة»، في تركه للشعر مبكراً وعدم نشره منذ بدايات عمره الكتابي. يقول عن أحد أبطال حكايته الجديدة «وسمح لنفسه بأن يفتحها يوم عيد ميلاده، للاحتفال مع أصدقائه على شرفه، شرف شاعر كبير أقسم ألَّا يكتب بيتاً شعرياً واحداً، بفضل تبجيله المهذب للشعر».
بسيطة هي حكاية كونديرا الأخيرة، لا تزيد على 111 صفحة، ولا ترتقي إلى سماء تحليقه الكتابي. تُقرأ ربما في محطة عبور أو انتظار، لا تحتاج إلى تركيز طويل ولا لتملّي أحداثاً وصوراً كثيرة، لكأنه تعب، أو لكأنه يجذر معنى العنوان الاعتباري لها، تمضي حكايات شخوصها بسلاسة وتدفق أخاذ لتجيء خلاصة ما يكتب هذا الحكيم الذي درّسته المنافي قبل الأوطان التي غادر، الحروب التي خاض قبل السلام الذي يعايش، اللغات التي صمت عنها واللغات التي يكتب بها اليوم، بتنهيدة كتابية طويلة يقول في آخرها: «أدركنا منذ زمن طويل، أنه لم يعد بالإمكان قلب العالم، ولا تغييره إلى الأفضل، ولا إيقاف جريانه البائس إلى الأمام، لم يكن ثمة سوى مقاومة وحيدة ممكنة: ألا نأخذه على محمل الجد».