
حين نشرت صحف ووسائل إعلام قبل نحو ستة أشهر نص وصية حنا مينة، لم يدرك أغلبها أنها في الواقع تعيد نشر ما كتبه بخط يده قبل نحو عشر سنوات، ونشرته وقتها بعض الصحف السورية. وفي المرتين، لم يعتن أحد بالبحث في الأسئلة التي يثيرها نص الوصية التي كانت عبارة: “لا تذيعوا خبر موتي” أبرز ما فيها وأكثرها مدعاة للتفكير. أسئلة من قبيل: ما المعنى الذي يريد حنا أن نعرفه من وصيته تلك؟ ما هي دوافعه ومسوغاته؟ هل يحقّق المعنيون بالوصية ما أراده الرجل، وظل مصراً عليه طوال عشر سنوات؟
بعد عشر سنوات على تاريخ كتابة الوصية مات حنا مينة عن أربعة وتسعين عاماً. وبعد ثلاثة أيام نقض الجميع؛ كل في ما يخصه، وصية الرجل، وبفجاجة ظاهرة خالفوا أهم ما فيها، غير مكترثين باعتذاراته واستغاثاته.
هكذا طالعتنا الصحف والفضائيات ومختلف وسائل الإعلام بهذه التفاصيل من دمشق: “ألقت شخصيات رسمية وأدبية وفنية يوم الخميس 23 أغسطس/ آب نظرة الوداع على جثمان الكاتب والروائي الراحل الكبير حنا مينة في المشفى الفرنسي بدمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن موكب جثمان الكاتب السوري الراحل انطلق إلى مسقط رأسه في مدينة اللاذقية لأداء صلاة الجنازة ومواراته الثرى.
رغبة الرجل بحسب وصيته كانت مشروعة ومقبولة وفق أي اعتبار إنساني أو ديني أو أخلاقي، هكذا طلب: “عندما ألفظ النفس الأخير، آمل، وأشدد على هذه الكلمة، ألا يُذاع خبر موتي في أية وسيلةٍ إعلامية، مقروءة أو مسموعة أو مرئية،(…)، أعتذر للجميع، أقرباء، أصدقاء، رفاق، قُرّاء، إذا طلبت منهم أن يدعوا نعشي، محمولاً من بيتي إلى عربة الموت، على أكتاف أربعة أشخاصٍ مأجورين من دائرة دفن الموتى، وبعد إهالة التراب علي، في أي قبر مُتاح، ينفض الجميع أيديهم، ويعودون إلى بيوتهم، فقد انتهى الحفل، وأغلقت الدائرة. لا حزن، لا بكاءٌ، لا لباس أسود، لا للتعزيات، بأي شكلٍ، ومن أي نوع، في البيت أو خارجه، ثمّ، وهذا هو الأهم، وأشدد: لا حفلة تأبين، فالذي سيقال بعد موتي، سمعته في حياتي، وهذه التآبين، وكما جرت العادات، منكرة، منفّرة، مسيئة إليّ، أستغيث بكم جميعاً، أن تريحوا عظامي منها”.
 أيا كانت الدوافع والمسوغات لم يطلب الرجل شيئاً منكراً، لكن مقتضيات عاندت رغبته الأخيرة، وكأن هناك تواطؤاً من الجميع على معاندته والتأكيد له للمرة الأخيرة أن الواقع أكثر طغياناً من إرادة الفرد، طغيان أقسى لأنه هذه المرة لا يملك له دفعاً.
أيا كانت الدوافع والمسوغات لم يطلب الرجل شيئاً منكراً، لكن مقتضيات عاندت رغبته الأخيرة، وكأن هناك تواطؤاً من الجميع على معاندته والتأكيد له للمرة الأخيرة أن الواقع أكثر طغياناً من إرادة الفرد، طغيان أقسى لأنه هذه المرة لا يملك له دفعاً.
في الوصية، يعيد حنا مينة الإشارة سريعاً إلى بعض ما سبق له أن ذكره مرّات كثيرة تستعصي على الحصر، من سيرة حياته الشخصية والسياسية والأدبية، سيرة قدّمها في أشكال تعبيرية مختلفة: قصص، روايات، ومقالات. وفي الثمانين من عمره أصدر كتاباً بعنوان “الرواية والروائي” تضمَّن عدة فصول، من بينها فصل بعنوان: “عن الحياة والكتابة” تطرق فيه إلى سيرة حياته، وكأنه يستوحي البيتين الشعريين المشهورين لأبي العلاء المعري:
مَن كان يَطلبُ مِن أيّامِهِ عَجباً
فلي ثمانونَ عاماً لا أرى عَجبا
الناسُ كالناسِ والأيامُ واحدةٌ
والدّهرُ كالدّهرِ والدنيا لِمَن غَلَبا

الوصية، إذاً، رجع صدى لموقف ثابت كرّره حنا مينة مرات كثيرة. فعن الحياة والكتابة ذكّر بحكمة المعري فكتب: “لم أكن أتصور، حتى في الأربعين من عمري، أننى سأصبح كاتباً معروفاً. فقد ولدت، كما هو معروف عني، بالخطأ، ونشأت بالخطأ، وكتبت بالخطأ أيضاً. (…) والدتي اسمها مريانا ميخائيل زكور، وقد رُزقت بثلاث بنات كنَّ، بالنسبة لذلك الزمان، ثلاث مصائب..شاء القدر أن تحمل وتلد البنات الثلاث بالتتابع، الأمر الذي كان يحمل إليها مرارة الشقاء، بالتتابع أيضاً. إن وعي الوجود عندي، ترافق مع تحول التجربة إلى وعي، وكانت التجربة الأولى في حي “المستنقع” الذي نشأت فيه في اسكندرونة، مثل التجربة الأخيرة، حين أرحل عن هذه الدنيا. (…) أمي وأخواتي الثلاث، عملن خادمات. عملت أنا الصبي الوحيد، الناحل، أخيراً، كذلك عمل الوالد، سليم حنا مينة، الخائب في كل أعماله ونواياه، حمّالاً في المرفأ، بائعاً للحلوى وللمرطبات، مرابعاً في بستان قاحل إلا من أشجار التوت، ومربياً لدود القز، ثم عاود بين كل هذه الأعمال وأثنائها سيرته في الترحال.(…) من اللاذقية، حيث ولدت، تشرد الوالد، وجر العائلة معه إلى متاهة الضياع، وهذا التشرد فرض علي البحث عن اللقمة أولاً، وفرض علي ثانياً العمل الشاق في السياسة، وأمنيتي الآن أن أتشرد من جديد، لأننى أكاد أتعفن بين الجدران الأربعة في مكتبي في الوظيفة، ومن مكتبي في البيت، الذي أعمل فيه وسط شروط لا إنسانية!”.
بدايته الأدبية مع القصة القصيرة
بدأ حنا مينة حياته الأدبية ككاتب قصة قصيرة. ففي مجموعته القصصية “الأبنوسة البيضاء” (منشورات اتحاد الكُتَّاب العرب في دمشق 1976م) كتب في تقديم قصص المجموعة: “هذه عشر من قصصي القصيرة تنشر لأول مرة. ويرجع تاريخها كلها إلى ما بعد عام 1969م، باستثناء قصتين: “النار” التي كتبت عام 1949م، ونشرت لأول مرة في جريدة “التلغراف” اللبنانية، و”جمرة السنديان” التي كتبت عام 1956م ونشرت في العام نفسه. لقد بدأت حياتي الأدبية بكتابة القصة القصيرة عام 1945م، ونشرت أقاصيصي في صحف ومجلات سوريا ولبنان، ولكنني لم أجمعها ولن أجمعها، وبعضها ضاع وأنا، كما قلت في مناسبات عديدة، غير آسف عليها”.
وفي مقدمة قصة “على الأكياس”؛ التي سبق له أن نشرها في مجلة “المعرفة”، عدد أبريل 1970م، كتب هذا الإهداء: “إلى الصغير العزيز (و.ع) الذي سألني: “كيف، ومتى، بدأت الكتابة؟” وفي القصة يحكي بعض تفاصيل مرحلة صعبة جداً في حياته حين بدأ يعمل حمالاً في الميناء وهو في سن الثانية عشرة، وكيف أصبح كاتباً صغيراً يقيّد في السجلات حسابات مخازن الميناء. وفي المجموعة قصة أخرى بعنوان “رسالة من أمي”، يستعرض فيها جوانب من حياته الأسرية بعد أن أصبح كاتباً روائياً معروفاً تنشر الصحف صوره.
وقبل نشر “الأبنوسة البيضاء” بعام، كان حنا مينة قد نشر روايته “بقايا صور”، وهي بحسب نقّاده ودارسيه، وبحسب تأكيده هو أيضاً جزء أول من سيرة ذاتية- روائية، وقد كتب في الإهداء:
“إلى مريانا ميخائيل زكور، أمي.. حنّا”
ففي قصصه القصيرة، وفي “بقايا صور”، وروايات أخرى، صور حنا أمه على أنها امرأة تجتمع فيها كل الفضائل، على عكس الصورة التي يرسمها لوالده.
واضح أن حنا مينة رأى منذ بدايته الأدبية أن سيرته الذاتية جديرة بأن تقّدم للقراء، فعبرها لن يقّدم فقط سرداً ذاتياً عنه وعن أسرته فقط، لكنه سيقدم أيضاً رؤيته لطبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية التى صيغت حياته في إطارها.
في تفسير الوصية المنقوضة
 في وصيته، يحرص حنا مينة على إعادة تأكيد صورته كما تمنى أن تظل عالقة في ذاكرة القراء، فكتب: كل ما فعلته في حياتي معروف، وهو أداء واجبي تجاه وطني وشعبي، وقد كرَّست كل كلماتي لأجل هدف واحد: نصرة الفقراء والبؤساء والمعذبين في الأرض، وبعد أن ناضلت بجسدي في سبيل هذا الهدف، وبدأت الكتابة في الأربعين من عمري، شرّعت قلمي لأجل الهدف نفسه، ولما أزل”. صورة الروائي هذه في كلماته الأخيرة، هى صدى ما قاله مراراً منذ أن أضحى روائياً مشهوراً. ففى حديث له نشرته جريدة الجمهورية العراقية (4 / 4 / 1974م) قال: “أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين، وقد أثبتت الأيام أن تفاؤلي وثقتى مبنيان على صخرة.. “. هذا الوصف البالغ البذخ في تقدير دور الكاتب ومكانته ومهامه في الحياة جزء أصيل من شخصية حنا مينة. لذلك، كان من المنطقي أن يسأل القارئ المتابع لمنجزه الإبداعي عن مسوغات الوصية وغاياتها، فهل يعترض الكاتب على الواقع ويشهر في وجهه موقفاً رافضاً، أم إنه يتماهى مع نرجسية غير واعية تتعالى على الواقع وتريد أن تتشكل في مفارقة صارخة؟
في وصيته، يحرص حنا مينة على إعادة تأكيد صورته كما تمنى أن تظل عالقة في ذاكرة القراء، فكتب: كل ما فعلته في حياتي معروف، وهو أداء واجبي تجاه وطني وشعبي، وقد كرَّست كل كلماتي لأجل هدف واحد: نصرة الفقراء والبؤساء والمعذبين في الأرض، وبعد أن ناضلت بجسدي في سبيل هذا الهدف، وبدأت الكتابة في الأربعين من عمري، شرّعت قلمي لأجل الهدف نفسه، ولما أزل”. صورة الروائي هذه في كلماته الأخيرة، هى صدى ما قاله مراراً منذ أن أضحى روائياً مشهوراً. ففى حديث له نشرته جريدة الجمهورية العراقية (4 / 4 / 1974م) قال: “أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين، وقد أثبتت الأيام أن تفاؤلي وثقتى مبنيان على صخرة.. “. هذا الوصف البالغ البذخ في تقدير دور الكاتب ومكانته ومهامه في الحياة جزء أصيل من شخصية حنا مينة. لذلك، كان من المنطقي أن يسأل القارئ المتابع لمنجزه الإبداعي عن مسوغات الوصية وغاياتها، فهل يعترض الكاتب على الواقع ويشهر في وجهه موقفاً رافضاً، أم إنه يتماهى مع نرجسية غير واعية تتعالى على الواقع وتريد أن تتشكل في مفارقة صارخة؟
في تقديمها لرواية “بقايا صور”؛ التي عنوانها “جدليّة الخوف والجرأة”، تذكر الدكتورة نجاح العطار أن حنا مينة في كتابه “ناظم حكمت وقضايا أدبية وفكرية”، الذي يعرض فيه لحياة وأفكار الشاعر التركي ناظم حكمت وقضايا أخرى، يذكر حكاية عن تيمورلنك القائد المغولي المشهور، وقد أخذه العجب بنفسه وسأل الشاعر كرماني: يا كرماني، بكم تشتريني لو عُرضت في سوق البيع؟، فيجيبه كرماني: بخمسة وعشرين ديناراً، فيقول تيمورلنــك: ولكن حزامـي وحده يساوي هذه القيمة، فيقول كرماني: إنَّما كنت أفكر بحزامك وحده، لأنك أنت نفسـك لا تساوي فلساً واحداً”.
ثم تذكر العطار: “ولهذا علق غوركي (الكاتب الروسي الشهير) على هذه الحكاية بقوله: “هكذا خاطب الشاعر ملك الملوك، رجل الهول والشر تيمورلنك، فليرفع مجد الشاعر، صديق الحق، فوق مجد تيمورلنك”، وعلق حنا على الحكاية قائلاً: “إن الحق في شرف الكلمة هو الشعار الذى يرفع على سارية عالية، مغروزة في زنّار الذين أعطوا أن يقولوها، ثم يتقدّمون ولا يهابون”.
المدهش أن الدكتورة العطار عرفت حنا مينة جيداً، فهما قد اشتركا في عام 1976م في كتابة مجموعة قصصية عنوانها “من يذكر تلك الأيام”، ودراسة بعنوان “أدب الحرب”، وتعاونا في كثير من المجلات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية الرسمية والشعبية، وجمعتهما صداقة ظاهرة للغاية، ومع ذلك لم تجد غضاضة في كسر سارية حنا مينة الأخيرة، فوقفت تتلقى العزاء.
النظير العربي لمؤلف “موبي ديك”
حنا مينة صاحب أكبر وأشجع سيرة ذاتية كتبت باللغة العربية حتى الآن، ووصيته رجع صدى لموقف ثابت كرّره مرات كثيرة
في الفصل المعنون “الرواية العربية والبحر” من كتابه “أدب البحر” (دار المعارف، القاهرة، 1981م)، يَعُدُّ أحمد محمد عطيه أن حنا مينة هو “روائي البحر العربي”، ويؤكد أنه “إذا كان هرمان ملفل (1819-1891م) صاحب “موبي ديك” هو روائي البحر الأول في الأدب العالمي، فإن حنا مينة، مبدع “الشراع والعاصفة” وغيرها من روايات البحر، هو روائي البحر الأول في الأدب العربي الحديث”.
ويذكر، عطيه، أن البحر كان “مجالاً خصباً للتفسيرات الأدبية والأسطورية، من إلياذة هوميروس وإنياذة فرجيل إلى حكايات السندباد البحرية وقصص ألف ليلة وليلة البحرية الشعبية، وما تضمنته من حكايات عرائس البحر وجنيات البحر ومن تصوير أسطوري لعالم البحر”.
ويَعد عطيه، أن “أدب البحر هو ذلك الأدب الذي يستهدف التعبير عن عالم البحر، والذي يكون البحر موضوعه الرئيس المؤثر في الأحداث والشخصيات، وفي الرؤية الكلية للعمل الأدبي. وهو أدب مهم يشكل جزءاً أساسياً من تراث البشرية وحضارتها. إذ يضم أدب البحر الأسطورة والملحمة والشعر والحكاية الشعبية وأدب الرحلات البحرية والقصة والرواية”.
 وفي حين يحاول بعض الباحثين والنقاد أن يجدوا سمات تأثر في روايات حنا مينة التي يكون البحر والبحارة موضوعاً رئيساً له بروايات وقصص لكتَّاب أجانب، بخاصة “موبي ديك” لملفل، و”الشيخ والبحر” لأرنست همنجواي وغيرهما، فإن الناقد محمد دكروب، في تقديمه لكتاب حنا مينة: “حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية” (دار الفكر الجديد، 1992م) في معرض حديثه عن السؤال التقليدي الذي يوجّه إلى حنا مينة عن علاقة روايته “الشراع والعاصفة” برواية همنجواى “الشيخ والبحر”، يقول إنه يعرف من خلال علاقته بحنا مينة، أنه “أنجز كتابة “الشراع والعاصفة” في العام 1954م. وأنه لم يتح له في حينه أن ينشرها، وفي العام 1956م، رحل حنا عن بلاده مشرداً، دار العالم تقريباً، بحثاً عن العمل والعيش: من بلادنا إلى الصين، ومن الصين إلى بلدان أخرى، فإلى بلغاريا وغيرها، سنوات وصل تعدادها إلى العشر. ومخطوطة الرواية دارت في البداية معه، ثم أرسلها إلى صديقه القاص سعيد حورانية، وكان مشرداً أيضاً في بيروت، فضلت الرواية طريقها، وضاعت زمناً، ولم تصدر “الشراع والعاصفة” إلا في العام 1966م. إلى جانب ذلك، فإن رواية همنجواي “الشيخ والبحر” صدرت في العام 1952م، وحنا مينة لا يطالع بأية لغة أجنبية، وقراءته الفرنسية صعبة جداً، والرواية هذه لم تنقل إلى العربية إلا بعد سنوات من صدورها”.
وفي حين يحاول بعض الباحثين والنقاد أن يجدوا سمات تأثر في روايات حنا مينة التي يكون البحر والبحارة موضوعاً رئيساً له بروايات وقصص لكتَّاب أجانب، بخاصة “موبي ديك” لملفل، و”الشيخ والبحر” لأرنست همنجواي وغيرهما، فإن الناقد محمد دكروب، في تقديمه لكتاب حنا مينة: “حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية” (دار الفكر الجديد، 1992م) في معرض حديثه عن السؤال التقليدي الذي يوجّه إلى حنا مينة عن علاقة روايته “الشراع والعاصفة” برواية همنجواى “الشيخ والبحر”، يقول إنه يعرف من خلال علاقته بحنا مينة، أنه “أنجز كتابة “الشراع والعاصفة” في العام 1954م. وأنه لم يتح له في حينه أن ينشرها، وفي العام 1956م، رحل حنا عن بلاده مشرداً، دار العالم تقريباً، بحثاً عن العمل والعيش: من بلادنا إلى الصين، ومن الصين إلى بلدان أخرى، فإلى بلغاريا وغيرها، سنوات وصل تعدادها إلى العشر. ومخطوطة الرواية دارت في البداية معه، ثم أرسلها إلى صديقه القاص سعيد حورانية، وكان مشرداً أيضاً في بيروت، فضلت الرواية طريقها، وضاعت زمناً، ولم تصدر “الشراع والعاصفة” إلا في العام 1966م. إلى جانب ذلك، فإن رواية همنجواي “الشيخ والبحر” صدرت في العام 1952م، وحنا مينة لا يطالع بأية لغة أجنبية، وقراءته الفرنسية صعبة جداً، والرواية هذه لم تنقل إلى العربية إلا بعد سنوات من صدورها”.
ثم يذكر أن هناك “اختلافاً أساسياً بين الروايتين: اختلاف تام في الحدث، وفي المناخ، وفي الشخصيات، فليس من تشابه أبداً بين “سانتياغو” همنجواي و”طروسى” حنا مينة، والقضية نفسها مختلفة كلياً، ومسار كل من العملين الروائيين مختلف أيضاً، وكذلك الهدف والموضوع”.
في كتابه “الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية” يخصص جورج طرابيشي قسماً لدراسة أدب حنا مينة، يبدأ بفصل عنوانه “من مثال الأنا إلى الأنا المثالي”، تتصدره عبارة حنا “مباركة رجولة الرجال ثلاثة”، ويفتتحه بهذه الفقرة الدالة نقدياً: “أكثر ما يلفت النظر في نتاج هذا الكاتب القفزة النوعية الكبرى التي تفصل رواياته الأولى: المصابيح الزرق (1954م) والشراع والعاصفة (1958م)- تاريخ كتابتها لا تاريخ نشرها- والثلج يأتي من النافذة (1969م) عن رواياته التالية: الشمس في يوم غائم (1973م) والياطر (1975م) وحكاية بحار (1981م). فنسبة الروايات الأولى إلى الروايات الثانية أشبه بنسبة ما قبل التاريخ إلى التاريخ. فما نطالعه في المصابيح الزرق أو الشراع والعاصفة هو الرواية التأسيسية بكل ما تعنيه هذه الصفة من تقليد وتجريب وعدم امتلاك لأسلوب فني مميّز وشخصي؛ أما الشمس في يوم غائم أو الماطر أو حكاية بحار فتضعنا في مواجهة روائي استطاع أن يجتاز في سنوات قليلة، وبتجربته الشخصية، كل المسافة الفاصلة بين التأسيس والنضج..”.
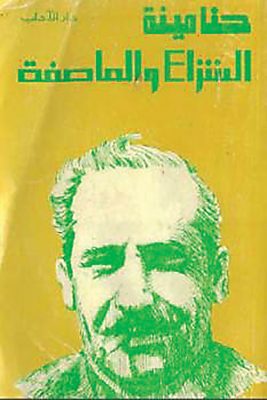
أشجع سيرة ذاتية
لطالما ارتحل حنا مينة: تشرّد في طفولته في قرى لواء الإسكندرون مع والديه وأخواته بحثاً عن لقمة العيش. ناموا في العراء وفي حقول الإقطاعيين. طردوا واستغلوا وأُهينوا، وقد عبّر عن ذلك بوضوح في “بقايا صور” (1975م)، وفي “المستنقع” (1977م)، وعرف التهجير القسري والتشرد في أعقاب ضم تركيا للواء الإسكندرون (1939م)، فذاق طعم التشرد والفاقة والحرمان، والعمل في حقول الإقطاعيين بما فيه من ذل وهوان، وعبّر عن تلك المعاناة في رواية القطاف (1986م)، وهي الرواية الثالثة، التي تكتمل معها “سيرته الذاتية- الروائية” التي وصفت بأنها “أكبر وأشجع سيرة ذاتية كتبت باللغة العربية حتى الآن”، كما جاء في بيان لجنة التحكيم المكونة من: هدى وصفي وعبدالعزيز حمودة وصلاح فضل، التي منحت حنا مينة جائزة الكاتب العربي (2005م) التي خصصها اتحاد كتاب مصر لمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على إنشائه. كما تضمنت حيثيات الجائزة إشارات إلى التلازم بين سمات فارقة في مسيرة حنا مينة الشخصية ونتاجه الأدبي، حين ذكرت أنه “منذ روايته الأولى “المصابيح الزرق” استطاع على مدى أكثر من نصف قرن أن يقدّم نموذجاً فريداً للمبدع العصامي الطموح الذي يتعلم الكتابة على كبر ويحاور الأوراق في سن الرشد ويتقلب في مدارج الحياة في شتى المهن المتنوعة والمتواضعة حتى يستخلص خبرة عميقة بالحياة ووعياً أصيلاً بنبل العمل فيها”.
بعيداً عن أنه كاتب وروائي، أو إنسان خبر الحياة جيداً، عاش حنا مينة في بقعة جغرافية وفي مجتمع وواقع قادر على أن يعيد إنتاج الزمن، ليرجع ويرى في أيامه الأخيرة ما رآه في أيامه الأولى
من التشرّد إلى الاستقرار
وحتى بعد أن أضحى صحفياً وروائياً معروفاً، عاود حنا مينة الارتحال مضطراً للمرة الثالثة إلى خوض تجربة الغربة مرة ثالثة لكن خارج سوريا هذه المرة (1959-1967م)، ليعود إلى الوطن من جديد، بعد هزيمة يونيو، على أمل بداية أفضل تضع حداً للتشرّد والهزائم، ولكن ما إن حطّ قدميه في مطار دمشق حتى اعتقل، كما أشار إلى ذلك في خاتمة روايته الربيع والخريف (1984م)، وذلك “في السابع عشر من سبتمبر عام 1967م.
لكن عمر السجن هذه المرة كان قصيراً، وعاد حنا حراً إلى مسقط رأسه، لكنه عاش شهوراً عديدة في مدينة اللاذقية حياة نفسية مضطربة، من دون عمل يتكفل بمتطلبات الحياة حتى أوشك أن يفتح محله “صالون الأمل” للحلاقة، لكن بعض أصدقائه اقترحوا عليه أن يقوم بتحويل “الشراع والعاصفة” إلى مسلسل إذاعي، فبدأت الأحوال تعتدل، ثم في نهاية 1969م عُيّن “خبيراً في التأليف والترجمة بطريق التعاقد” في وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ليعرف لأول مرة استقراراً وظيفياً واجتماعياً وينتقل للإقامة الدائمـة في دمشق.
منذ خط حنا مينة وصيته قبل وفاته بعشر سنوات، كان شبه محتجب عن الإعلام والأوساط الثقافية. لكن بعد أن استعرت المأساة السورية أصبح صمته موضع جدل كبير، فالأفرقاء جميعاً كانوا يفسِّرون ذلك الصمت تفسيرات شتى، وربما لهذا السبب لم يلتفتوا إلى الوصية.









اترك تعليقاً