يَصعبُ على مؤرِّخي الفكر تحديد الانطلاقة الأولى للفكر العربي الحديث، غير أن المرجّح أن بداياته تزامنت مع سقوط الدولة العثمانية بسبب مواقفها الرافضة للتجدّد والتحديث، إذ كانت السمة الطاغية على تلك الحضارة رفض آلة الطباعة وغياب الحركة الفكرية عن المشهد الثقافي عامة. فكيف انطلق الفكر العربي الحديث؟ وما هي التحوُّلات التي شهدها ما بين أواسط القرن التاسع عشر واليوم؟
في كتابه “رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية”، (1999م)، يوصف المفكِّر البحريني محمد جابر الأنصاري (1939م -) المشهد الانتكاسي العثماني فيقول “لم يكن للدولة العثمانية غير المجد العسكري، أما سجلها الحضاري والفكري فمتواضع جداً، ويكفي أننا لا نعثر على مفكِّر واحد، عربي أو مسلم، له وزن يذكر من طراز الكندي والفارابي وابن سينا في التاريخ العثماني كله”.
لقد أشعلت هذه النكسة المفاجئة بين العرب والمسلمين أسئلة النهضة والحضارة، فبرزت في تلك الأجواء كتب بعناوين تساؤلية ككتاب شكيب أرسلان (1869 – 1946م) “لماذا تأخّر المسلمون وتقدّم غيرهم”، (1930م) وكتاب أبي الحسن الندوي (1914 – 1999م) “ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، (1950م)، وانطلقت إثر ذلك البعثات الدراسية إلى الغرب وعاد الطلبة محملين بهموم التغيير، وعلى رأسهم الطهطاوي والتونسي والشدياق وطه حسين وغيرهم كثير.
يُمكن القول إن هذه العودة الطلابية أسهمت في بلورة المرحلة الأولى للفكر العربي الحديث، على أن الطروحات التي قُدِّمت إبّانها كانت تأخذ صفة الخاطرة والرسالة لا المنهج والدراسة. ففي تلك المرحلة، راجت تصريحات مثيرة من أبرزها تصريح طه حسين (1889 – 1973م) ودعوته لاتباع الغرب جملةً وتفصيلاً، “علينا أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقتهم لنكون لهم أنداداً ونكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرِّها، حلوها ومرِّها”، وتصريح محمد عبده (1849 – 1905م) “رأيتُ إسلاماً بلا مسلمين ومسلمين بلا إسلام”.
ومنذُئذ، تنوّعت اهتمامات الفكِّر العربي وتعدَّدت أسئلته وإشكالاته وقضاياه وأزماته.
“إذا صح لنا بكثير من التبسيط أن نختزل الحضارة في بُعد واحد من أبعادها لصح لنا أن نقول إن الحضارة المصرية القديمة هي حضارة ما بعد الموت، وإن الحضارة اليونانية هي حضارة العقل، أما الحضارة العربية الإسلامية فهي حضارة النص”.
المفكِّر المصري نصر حامد أبو زيد
نقد العقل
استحوذ العقل (reason) كآلة إنتاجية للثقافة والفكر على كثير من كتابات الفكر العربي، وكان أبرز من تناولها المفكر المغربي محمد عابد الجابري (1936 – 2010م) في مشروعه الضخم “نقد العقل العربي” (1984 – 1990م) في أربعة أجزاء، حيث شرّح العقل العربي وقسَّمه إلى ثلاثة أنواع: (1) “عقل البيان” ويهتم باللغة والبلاغة، و(2) عقل “البرهان” ويهتم بالمنطق والاحتجاج، و(3) عقل “العرفان” ويهتم بالسفسطة والخرافة. ويخلص الجابري من دراسته إلى أن عقل العرفان الذي صدّرته الثقافة الفارسية الغنوصية إلى العرب قد شلَّ عقل البرهان وقضى عليه حتى تلاشت إثر ذلك الحضارة الإسلامية.
أشعل مشروع الجابري المغربي جدلاً في المشرق العربي ولقي نقداً واسعاً، من أهمه نقد المفكِّر السوري جورج طرابيشي (1939 – 2016م) الذي سمّى مشروعه “نقد العقل العربي” (1996 – 2010م) وطرحه في خمسة أجزاء بيّن فيها مغالطات الجابري الفكرية، بالإضافة إلى زلاته الأكاديمية في النقل والاستشهاد. ويؤكد طرابيشي على أن استقالة العقل العربي لم تكن بسبب عقل العرفان، وإنما بسبب “عامل داخلي هو المعجزة ومنطق المعجزة في الموروث العربي الإسلامي. إنه عامل غائب كل الغياب عن شبكة القراءة الجابرية ذات المنزع البرّاني في التعليل، ولكنه حاضرٌ كل الحضور في مأساة سقوط العقل العربي الإسلامي من داخله”.
امتدت هذه الاهتمامات بالعقل لتصل إلى العقل الإسلامي، فكتب المفكِّر الجزائري محمد أركون (1928 – 2010م) أطروحته “نقد العقل الإسلامي” (1991م) مطالباً بـ”إعادة تقييم نقدي شامل لكل الموروث الإسلامي منذ عصر الرسالة حتى اليوم”، كما دفعت هذه الاهتمامات المفكِّر السوري مطاع صفدي (1929 – 2016م) فأسهم بدوره في “نقد العقل الغربي” (1996م) مسلطّا الضوء على نشأة الحداثة في الغرب، ومؤكداً على أن فهم العقل الغربي لا يكون إلا بفهم “صراعه مع الحداثة. فقصة هذا الصراع تعني قصة نقد العقل الغربي لذاته باعتباره هو العقل. ولعل نقد النقد يشكل أهم خصوصية لهذا العقل الغربي”.
نقد الحداثة
جذبت “الحداثة” كتيار عالمي يدعو إلى التجدد والتحديث للأفكار والمواقف الفلسفية عموماً، انتباه المفكِّرين المغربيين على وجه الخصوص، فكان من أبرز المنشغلين بها المفكِّر المغربي عبدالله العروي (1933م -) إذ كتب في سبيل تشريحها مشروعه “الحداثة المفاهيمية” في خمسة أجزاء متناولاً “مفهوم الحرية والإيديولوجيا والعقل والتاريخ والدولة” (1980 – 1996م). ويُسلّم العروي بالحداثة ويقبل بها كون “الحداثة مثل الاستعمار، حالة قائمة، إما مفروضة ومرفوضة قولاً وعقائدياً وإما معترف بها متحكّم فيها”، وبالتالي يُهيب بالعرب بإعادة قراءتها والاستفادة من فضائلها والبعد عن رذائلها.
في المقابل، يرفض مواطنه المفكِّر المغربي طه عبدالرحمن (1944م -) هذه الحداثة مطالباً بالاستقلال الكلي عنها بتأسيس حداثة إسلامية، “حداثة ذات توجه معنوي بديلة عن الحداثة ذات التوجه المادي التي يعرفها المجتمع الغربي”. وقد بسط القول في تفاصيلها في كتابيه “روح الحداثة” (2006م) و”الحداثة والمقاومة” (2007م) خالصاً إلى أنه “كما أن هناك حداثة غير إسلامية، فكذلك ينبغي أن تكون هناك حداثة إسلامية”.
وبين هذا وذاك، مارس المفكِّر المغربي عبدالإله بلقزيز نقداً تاريخياً للكتابات الحداثية في مشروعه “العرب والحداثة” (2006 – 2016م)، الواقع في أربعة أجزاء، داعياً إلى الانفتاح الإيجابي نحوها، “ففكرة الأصالة لم تتنزّل منزلة البديل من الحداثة، فالحداثة ليست وراءنا، إنما أمامنا. إنها المستقبل الذي نُخطئ كثيراً إن تردَّدنا في اقتحام أفقه بدعوة الخشية على ذاتيتنا الحضارية. إن أكبر خطر يهدِّد ذاتنا الحضارية وأصالتنا ليس الحداثة إنما مزيد من التشرنق على الذات والانكفاء إلى فكرة الأصالة”.
ولا تزال الحداثة تهم المغربيين على وجه التحديد إلى هذا اليوم، فقد ألهمت المفكِّر التونسي عبدالمجيد الشرفي (1942م -) فقدّم أطروحته “الإسلام والحداثة” (1991م) كما حازت اهتمام المفكِّر المغربي محمد سبيلا (1942م -) فأسهم في تفكيكها بأطروحاته “مدارات الحداثة” (1987م) و”الأصولية والحداثة” (1998م) و”الحداثة وما بعد الحداثة” (2000م).
صاغ المفكِّر الجزائري مالك بن نبي معادلته الشهيرة عن كل ناتج حضاري، إذ يرى أن أي “ناتج حضاري = إنسان + تراب + وقت” قاصداً أن “أي حضارة تقوم على الإنسان العامل الذي يُدافع عن أرضه ويستفيد من وقته”.
نقد النص
يُعنى هذا الاتجاه بدراسة النصوص والكتابات التاريخية وإعادة قراءتها وتفسيرها وتأويلها فيما يُسمى “علم التأويل أو الهرمنيوطيقا” (Hermeneutics) وأبرز من رَادَ فيه المفكرُ المصري نصر حامد أبو زيد (1943 – 2010م) بأطروحتيه “مفهوم النص” (1990م) و”النص والسلطة والحقيقة” (2006م). يرى أبو زيد أن الثقافة العربية وعلومها قامت “على أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه” لذلك – وعلى خلاف الجابري الذي وصف الحضارة الإسلامية بأنها “حضارة فقه” – يصف أبو زيد الحضارة الإسلامية بأنها “حضارة نص” قائلاً: “إذا صح لنا بكثير من التبسيط أن نختزل الحضارة في بُعد واحد من أبعادها لصح لنا أن نقول إن الحضارة المصرية القديمة هي حضارة ما بعد الموت، وإن الحضارة اليونانية هي حضارة العقل، أما الحضارة العربية الإسلامية فهي حضارة النص”.
على المنحى نفسه، يغوص المفكِّر اللبناني علي حرب (1939م -) في دهاليز النصوص في كتابيه “نقد النص” (1993م) و”نقد الحقيقة” (1993م) مؤكداً أن “نقد الحقيقة هو الوجه الآخر لنقد النص، ونقد النص هو المدخل الأصلي لنقد الحقيقة”، مطالباً “أن يتحوَّل النص إلى ميدان معرفي مميز وأن يصبح منطقة من مناطق عمل الفكر، بالنظر إليه من دون إحالته لا إلى مؤلفه ولا إلى الواقع الخارجي. ففي منطق النقد يستقل النص عن المؤلف كما يستقل عن المرجع لكي يغدو واقعة خطابية لها حقيقتها وقسطها من الوجود”.
كما سار في هذا الاتجاه المفكِّر الفلسطيني إدوارد سعيد (1935 – 2003م) في كتابه “العالم والنص والناقد”، (1983م) مستهدفاً نصوص الغربيين في دراساتهم الاستشراقية، ومؤكداً على أن ثَمَّة صبغة سياسية فيها. فرغم أن “الشرط الحاسم الذي تصطدم به معظم ألوان المعرفة المنتجة في الغرب المعاصر … هو أن تكون منزهة عن السياسة، بمعنى أن تكون علمية أكاديمية محايدة، تعلو على مستوى المعتقدات المذهبية”، إلا أن الدراسات الاستشراقية التي تناولت التاريخ الإسلامي والعربي وقعت في كثير من التصورات الحزبية المغلوطة.

المفكِّر البحريني محمد جابر الأنصاري 
المفكِّر المغربي محمد عابد الجابري 
المفكِّر الفلسطيني إدوارد سعيد
نقد المثقف
بالتوازي مع نقد النص، ناقش المفكِّر اللبناني علي حرب والمفكِّر الفلسطينـي إدوارد سعيـد أدوار المثقف (intellectual) وانتقداه تبعاً لنصوصه، فكتب علي حرب “أوهام النخبة ونقد المثقف” (2008م) عائباً عليه أن يكون تقديسياً تبجيلياً، مؤكداً على أن أبرز معائب المثقف اليوم أنه “يشتغل بحراسة الأفكار. ومعنى الحراسة التعلّق بالفكرة كما لو أنها أقنومٌ يُقدس أو وثنٌ يُعبد، فمثل هذا التعامل هو مقتل الفكرة”.
كما يشير إدوارد سعيد في كتابه “السلطة والمثقف” (1994م) إلى عيوب المثقفين الغربيين المتأثرين بالتوجهات الإمبريالية ممن تُشترى ذممهم ومواقفهم الأخلاقية، مشدداً على أن “الخطر الخاص الذي يهدِّد المثقف اليوم، سواء في الغرب أم في العالم غير الغربي، لا يتمثل في الجامعة ولا في الطابع التجاري البغيض الذي اكتسبته الصحافة ودور النشر، ولكن في موقف سوف أطلق عليه صفة الاحتراف المهني. وأعني بالاحتراف المهني أن ينظر المثقف إلى عمله الثقافي باعتباره شيئاً يؤديه لكسب الرزق”.
وعلى النحو نفسه، سدَّد بلقزيز سهام نقده لوظائف المثقف في الوطن العربي وذلك في كتابه “نهاية الداعية” (2000م)، آخذاً عليه أدواره التبشيرية، إذ بات المثقف مع الأسف “مسكوناً بهاجس رسالي! إنه صاحب رسالة: هكذا يعرف نفسه ليضفي الشرعية عليها… وبسبب هذا الهوس الرسولي الذي يستبد بقطاعات عريضة من المثقفين العرب، وبسبب تضخم النزعة الخلاصية لديهم، تزدهر في أوساطهم ثقافة دعوية تبشيرية، ثقافة مصممة تصميماً لأداء دور معلوم: التحشيد والتجييش وصناعة الجمهور: جمهور الدعوة”، وهذا الضرب من الثقافة – بحسب بلقزيز – “لا ينتمي إلى ميدان المعرفة على نحو ما تعرفه نظرية المعرفة الحديثة”.
نقد الحضارة
لقيت الحضارة سواء الغربية والإسلامية مراجعات ونقودات عدة، وكان من أشهر الدارسين لمسألة الحضارة المفكِّر الجزائري مالك بن نبي (1905 – 1973م) حيث وضع “شروط النهضة” (1957م) واستعرض مسألة “الصراع الفكري في البلاد المستعمرة” (1959م). ففي حديثه عن المنتجات الحضارية، صاغ مالك بن نبي معادلته الشهيرة عن كل ناتج حضاري، إذ يرى أن أي “ناتج حضاري = إنسان + تراب + وقت” قاصداً بذلك أن “أي حضارة تقوم على الإنسان العامل الذي يُدافع عن أرضه ويستفيد من وقته”. وفي هذا المضمار، ناقش بن نبي مسألة الاستعمار مؤكداً قيامه على عاملين، العامل الأول يأتي من المستعمِر الخارجي، ولكنه لا يُقارن “بعامل آخر ينبعث من باطن الفرد الذي يقبل على نفسه تلك الصبغة، أعني عامل القابلية للاستعمار”، فالفرد القابل للاستعمار هو سبب تفشي الاستعمار في البلدان العربية.
في الاتجاه نفسه، يكرِّس المفكِّر المصري عبدالوهاب المسيري (1938 – 2008م) مطالعاته لمناقشة الحضارة الغربية المادية مسلطاً الضوء على القضية الفلسطينية والجماعات الصهيونية على وجه الخصوص، وذلك في كتبه “الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ” (1997م) و”مقدِّمة لدراسة الصراع العربي-الإسرائيلي (2002م)، فيعيب على الحضارة الغربية أن “المادية تسود فيها، أي إن الإنسان يتم تفكيكه وردُّه إلى عالم الطبيعة والمادة ويتم استيعابه تماماً فيها، فتختفي المنظومات القيمية والمعرفية الإنسانية فيه”.
كما استحوذت مسألة الحضارة على اهتمام المفكِّر السوري برهان غليون (1945م -) فاقترح تفاعلاً إيجابياً مع الحضارات عموماً وذلك في أطروحته “اغتيال العقل” (2005م)، حيث أشار إلى أن “مصير النهضة في الوطن العربي ليس مُعلَّقاً بإحياء التراث وحده، ولا باستيعاب الحضارة وحده. وإنما بالاحتفاظ بهذا التناقض الحي بينهما، أي بهما معاً… ولهذا فنحن ندعو إلى إحياء أكثر ما يمكن من التراث، واستيعاب أكثر ما يمكن من الحضارة والارتماء أكثر ما يمكن في حركة التاريخ الكونية العامة. ولا نعد أن هناك تناقضاً بين إحياء التراث واستيعاب الحضارة، بل العكس هو الصحيح. ومن هنا نقول: نأخذ من الحضارة ولا نؤخذ بها، ونحيي التراث ولا نحيا به”.
“طبيعة الإنسان تقوم على ثلاثة مبادئ، وهي: أن الإنسان بفطرته شخصية أنانية عاطفية لا تعاونية عقلانية، ويُولد حين يولد فاقداً للحس الأخلاقي”.
المفكِّر السعودي نايف الروضان
نقد الفلسفة
شاع الاهتمام بالفلسفة (philosophy) بين المفكِّرين والفلاسفة العرب وسارت المطالبات نحو الاستقلال التام عن الفلسفة الغربية وإنشاء فلسفة عربية خالصة، وكان حامل لواء هذه الدعوة المفكِّر اللبناني ناصيف نصار (1940م -) حيث نشر أطروحته “طريق الاستقلال الفلسفي” (1975م)، مطالباً بالإنتاج والإبداع لا التقليد والاتباع. ورغم دعوة نصار إلى الاستقلال، إلا أنه يؤكد دوماً بأنه لا يرى الاستقلال التام إبداعاً، فالاستقلال الذي ينشده هو “المشاركة الإبداعية في الفلسفة والإسهام في تغيير حياة الإنسان العربي من الداخل. ولا نقصد بالطبع انطواءً على الذات وانقطاعاً عن الآخرين واكتفاءً بالنفس. استقلال من هذا النوع في هذا العصر يعني الانتحار. وإنما المقصود هو الاستقلال السليم الذي يقوم على الانفتاح والتفاعل الدائم والمشاركة الإيجابية، ولكن انطلاقاً من الذات”.
ويتلمّس المفكِّر المغربي طه عبدالرحمن ملامح هذا المشروع النصّاري، ويعيد تشييده بأطروحته “الحق العربي في الاختلاف الفلسفي” (2002م). فبعد أن ينقض المسوغات الرائجة لانتهاج الفلسفة الغربية، يقيم عبدالرحمن على تلك الأنقاض أركان مشروع فلسفي عربي يراعي: (1) الابتكار، و(2) الاختراع و(3) الإنشاء. وحجته في ذلك أن “لا إبداع في الفلسفة إلا إذا بنينا ذلك على حقائق ثلاث، إحداها أن القول الفلسفي خطاب، وكل خطاب يضع في الاعتبار المتلقي؛ والثانية أنه بيان، وكل بيان يضع في الاعتبار لسان المتلقي؛ والثالثة أنه كتابة، وكل كتابة تضع في الاعتبار بلاغة هذا اللسان”.
ويُقـدم الفيلسـوف السعــودي نايف الروضان (1959م -) نفسه في هذا المضمار مشاركاً ومُبدعاً ومراجعاً للفلسفات الغربية، منتقداً تعريفات الفلاسفة الغربيين للطبيعـة البشريــة. يطرح الروضان نظرية مستقلة عن تلك التعريفات يُسمّيها “الأنانية العاطفية الفاقدة للحس الأخلاقي” (emotional amoral egoism)، مجادلاً بأن طبيعة الإنسان تقوم على ثلاثة مبادئ، وهي: أن الإنسان بفطرته شخصية أنانية عاطفية لا تعاونية عقلانية، ويُولد حين يولد فاقداً للحس الأخلاقي. ويخالف الروضان الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632 – 1704م) الذي يرى بأن الإنسان “صفحة بيضاء”، مؤكداً على وجود أفكار غرائزية أصلية في الإنسان مقترحاً فرضية بديلة يسميها “الصفحة البيضاء الناجزة”.

المفكِّر السوري مطاع صفدي 
المفكِّر المغربي عبدالإله بلقزيز 
المفكِّر المصري عبدالوهاب المسيري 
المفكِّر اللبناني علي حرب
نقد التراث
لا يزال التراث بشقه الديني وغير الديني يحظى باهتمام المفكِّرين العرب جميعاً إلى هذا اليوم، وقد لقي اهتماماً واسعاً لدى المفكِّر المصري حسن حنفي (1935م -) حيث قدَّم في سبيله “مشروع التراث والتجديد” (2000 – 2009م) في تسعة مجلدات سعى من خلالها أن ينطلق بالتراث العربي “من النقل إلى الإبداع” (2000م) و”من النص إلى الواقع” (2005م)، و”من الفناء إلى البقاء” (2009م). ويهدف حنفي من مشروعه إلى إحياء التراث لا استبداله، وتحريكه لا تسكينه، ووَصْله بغيره لا تحييده، وتوظيفه للناس والجماهير خادماً، لا تبجيله عليهم مخدوماً. كما يؤكد حنفي أن “التراث والتجديد يمثلان عملية حضارية هي اكتشاف التاريخ، وهي حاجة ملحّة في وجداننا المعاصر. كما يكشفان عن قضية البحث عن الهوية عن طريق الغوص في الحاضر، وعن طريق تحديد الصلة بين الأنا والآخر”.
وفي المسار نفسه، يهتم المفكِّر اللبناني حسين مروّة (1910 – 1987م) بالتراث في مشروعه الضخم ذي الأربعة أجزاء “النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية” (1978م) دارساً كيفية تشكُّل الطبقات الاجتماعية ودورها في تشكيل إيديولوجيات أسهمت في حراك الأمة التاريخي. إن “كل معرفة عن هذا التراث نفسه صدرت من مؤرِّخ أو مفسِّر أو دارس، قديماً أو حديثاً، إنما يكمن وراؤها موقف إيديولوجي. والموقف الإيديولوجي هو – بالأساس – موقف طبقي”. لذلك يطرح مروّة “المنهج المادي” كطريقة جديدة في دراسة التراث فهو “وحده القادر على كشف تلك العلاقة ورؤية التراث في حركيته التاريخية”، فينتقد بذلك قراءات كقراءة حسن حنفي للتراث إذ تقوم على “قسر أفكار الماضي على التطابق والتماثل بينها وبين أفكار الحاضر”، فهذه القراءة – بالنسبة لمروّة – أحق بتسمية “بدعة تحديث التراث”.
ويواصل المفكِّر السوري طيب تيزيني (1934 – 2019م) مسيرة مُعلّمه حسين مروة باحثاً على الصلة “فيما بين الفلسفة والتراث” (1980م)، فيرى في الدين معيناً نابضاً – لا ناضباً – يمكن الاستعانة به في مد العصر باللمسات الإنسانية، وشَرْطُ ذلك النظر في التراث لا من حيث كونه ماضياً بل من حيث كونه علاقة اتصال بين الماضي والحاضر، وعلاقة غير اتصال من حيث إن كل فترة تحقيبية فيه هي فترة لها مكوناتها الاجتماعية الخاصة.
على إثر هذه الدراسات، اتسعت رقعة الاهتمام بالتراث، فظهرت اهتمامات بشقه الاجتماعي كدراسة المفكِّر المغربي علي أومليل (1940م -) لـ “منهجية ابن خلدون” (2005م) ودراسة المفكِّر العراقي علي الوردي (1913 – 1995م) لـ “منطق ابن خلدون” (1950م)، كما لقي جانب التراث السياسي اهتماماً موازياً، فتناوله المفكِّر الأردني فهمي جدعـان (1940م -) في أطروحة “المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام” (1989م)، كما تناوله المفكر التونسي هشام جعيط (1935م -) في أطروحة “الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر” (1992م).


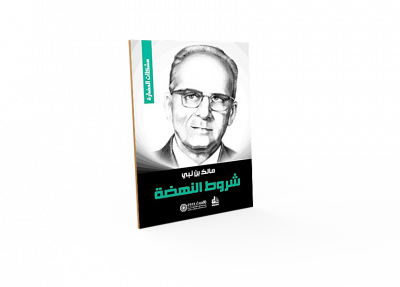



اترك تعليقاً