 برز في السنوات الأخيرة اهتمام بعض دور النشر الفرنسية بترجمة مختارات من الروايات السعودية المعاصرة، إلى جانب غيرها من الروايات العربية. ورغم النجاح الذي حققه بعضها، فإن التدقيق في المدى الذي بلغه هذا الاهتمام، يؤكد أنه لا يزال دون ما تلقاه الروايات المعاصرة العائدة إلى ثقافات عديدة أخرى. فالرواية السعودية، كما هو حال الرواية العربية عموماً، لا تزال تعاني من بعض التهميش لأسباب عديدة، تتشابك فيها العوامل التجارية بقدرات دور النشر.
برز في السنوات الأخيرة اهتمام بعض دور النشر الفرنسية بترجمة مختارات من الروايات السعودية المعاصرة، إلى جانب غيرها من الروايات العربية. ورغم النجاح الذي حققه بعضها، فإن التدقيق في المدى الذي بلغه هذا الاهتمام، يؤكد أنه لا يزال دون ما تلقاه الروايات المعاصرة العائدة إلى ثقافات عديدة أخرى. فالرواية السعودية، كما هو حال الرواية العربية عموماً، لا تزال تعاني من بعض التهميش لأسباب عديدة، تتشابك فيها العوامل التجارية بقدرات دور النشر.
يفرض الحديث عن حال الرواية السعودية المعاصرة المترجمة إلى الفرنسية الانطلاق من حال الرواية العربية عموماً في المجال نفسه، ولربما من حال سوق ترجمة الرواية ككل.
ففي كل عام، وخلال موسم استعادة دور النشر الفرنسية لنشاطها بعد العطلة الصيفية، ما بين منتصف أغسطس ومطلع أكتوبر، تصدَّر هذه الدور عدداً كبيراً من الروايات الفرنسية والمترجمة، يصل إلى ما معدّله 600 رواية. يتراوح عدد المترجم منها عن العربية بين العشر والاثنتي عشرة. كما يمكن أن تغيب الروايات العربية تماماً عن هذا الموسم، لأن الناشرين يفضلون تأجيل نشرها إلى الأشهر اللاحقة كي لا تضيع في زحمة الإصدارات الجديدة.
واستناداً إلى إحصاءات نقابة الناشرين الفرنسيين، تأتي الرواية العربية المعاصرة في المرتبة الثامنة بين إجمالي ما تشتريه دور النشر من حقوق ترجمة الروايات. أما المراتب الأولى فهي على التوالي للإنجليزية، ثم الألمانية، فالإيطالية والصينية والفنلندية…وتحتل الرواية السعودية المرتبة الثالثة بين الروايات العربية المترجمة إلى الفرنسية، بعد الرواية اللبنانية، ومن ثم الرواية المغربية (التي تشمل إصدارات تونس والجزائر والمغرب)، والرواية السورية في المرتبة الرابعة.
الرواج مقبول
ولكن كان يمكنه أن يكون أفضل
يتضح من مئات الترجمات الناجحة استعداد القرّاء الفرنسيين لاستكشاف عوالم الأدب العربي، خاصة وأنهم استساغوا هذه العوالم من خلال روايات نجيب محفوظ ومحمد شكري وعبدالرحمن منيف وأحمد أبو دهمان الذي كتب روايته الأولى بالفرنسية مباشرة وعبده خال وغيرهم.
وكان للنجاح الكبير الذي حققته ترجمة رواية علاء الأسواني “عمارة يعقوبيان” في عام 2002م، في دار “آكت سود”، التي أنشأت مجموعة “سندباد ” المتخصصة في ترجمة النصوص السردية العربية، أثر في البحث عن نصوص عربية مماثلة. وبدأ الناشرون الفرنسيون يهتمون بالأدب العربي أ كثر من ذي قبل. ولكن هذا الاهتمام اقتصر على دور نشر صغيرة كانت تغامر بفكرة الترجمة على حسابها مثل دار “فيرتيكال” و” إنفانتوري”.
وبينما غرق الناشرون الكبار في البحث عن ملحمات نصية، على غرار “عمارة يعقوبيان”، توجَّهت دور النشر الصغيرة إلى البحث عن نصوص صغيرة، لكنها تتضمَّن إبداعاً جديداً على القارئ الفرنسي.
وإذا كان الناشر الفرنسي “آكت سود” استطاع أن يبيع 200 ألف نسخة من رواية “عمارة يعقوبيان”، فإن باقي الروايات ما عدا رواية “مدن الملح ” التي حققت مبيعات كبيرة، لم تحقق الرواج نفسه، وهذا ينطبق على روايات عبده خال وأحمد أبو دهمان وإلياس خوري وإبراهيم نصر الله وغيرهم.
فهل الرواية العربية المترجمة إلى الفرنسية في تقهقر أم في تحسُّن؟
يقول أرنو فلات من نقابة الناشرين: ” لا أدري إذا كان بإمكاننا أن نتحدَّث عن تقهقر أو تقدُّم في أرقام ترجمة الأدب العربي إلى الفرنسية لأن الإحصاءات شبه منعدمة مقارنة باللغات الأخرى كالإنجليزية والألمانية. والأرقام ضعيفة جداً بحدّ ذاتها”.
أما فاروق مردم بك مدير مجموعة “سندباد” فيقول: “ترجمات الروايات العربية قليلة. ومن غير الطبيعي ألَّا تنشر الدور الكبيرة مثل “غاليمار” او”لوسوي” غير رواية واحدة كل سنتين أو ثلاث”.
وفي تفسير هذه المحدودية، تقول الإدارة المكلَّفة بالأدب الأجنبي في دار “لوبلون” التي ترجمت ونشرت رواية بنات الرياض لرجاء الصانع: “نحن نعاني من تضخم الإنتاج في قطاع النشر، ففرنسا تُصدر سنوياً كثيراً من الروايات بحيث لا تترك مجالاً واسعاً للآداب الأجنبية، سواء أكانت عربية أم أمريكية. وإذا حدثت طفرة في بعض الروايات، فهذا يعود إلى أنها تسبَّبت في إثارة جدل حول مضمونها، أو فتحت عالماً غير معروف عند القارئ الفرنسي”. وهذا ما حصل بالفعل بالنسبة لرواية رجاء الصانع التي حققت مبيعات جيدة، توقعها الناشر.
وإلى ذلك، يضيف المتخصصون في دار النشر ملاحظتين: أولاهما، تردّد الناشرين في ترجمة الروايات العربية غير مضمونة الرواج التجاري، بسبب ارتفاع تكلفة الترجمة، على الرغم من المساعدة المحدودة التي يقدِّمها مركز الكتاب الفرنسي. والملاحظة الثانية، ولربما تكون نابعة من الأولى، هي افتقار دور النشر الفرنسية إلى لجان القراءة بالعربية التي يفترض فيها أن تطلع وتختار ما يصلح للترجمة. مما يضطر الناشرين إلى البحث عن وسطاء لاكتشاف النصوص الجديدة، على الرغم مما يحمله الأمر من مجازفة.
حداثة عهد ترجمة الرواية السعودية
بدأت دور النشر الفرنسية بترجمة الرواية العربية المعاصرة في سبعينيات القرن الماضي، أي بعد ربع قرن على ترسّخ تقاليد ترجمة الأعمال الأدبية المعاصرة من الإنجليزية والألمانية وغيرها. ولمدة ربع قرن آخر، اقتصرت الروايات العربية المترجمة إلى الفرنسية على الأسماء الكبيرة مضمونة النتائج مثل نجيب محفوظ، وتميّزت بالتركيز على الأعمال الأدبية الجزائرية والمغربية واللبنانية والتونسية، الأمر الذي يربطه المستشرق والمترجم ريشار جاكمون بفترات الاحتلال السابقة، فيقول: “إن تركيز الفرنسي على ترجمة الأعمال الأدبية في مرحلة معيَّنة هو تطور طبيعي لمرحلة الاستعمار والتحرر. ومن الجهة المقابلة، هو بمثابة ردة فعل ثقافية يتحمس لها أهل المستعمرات السابقة، بهدف إطلاع المستعمر على ما فاته من معرفة الحضارة والشخصية الحقيقية لهذه الأوطان”. ثم كان النجاح الكبير الذي حققته رواية الأسواني “عمارة يعقوبيان” التي سبقت الإشارة إليها، فانفتحت الأبواب بشكل أوسع أمام الرواية العربية عموماً، لتدخلها الرواية السعودية المعاصرة.
قرأ هواة الرواية الفرنسيون في بدايات الألفية ترجمة “فخاخ الرائحة” ليوسف المحيميد الصادرة عن دار “آكت سود”، فكانت بذلك أول رواية سعودية متاحة للفرنسيين، منذ أن نشر أحمد أبو دهمان “الحزام” في عام 2000م، والمكتوبة أصلاً باللغة الفرنسية. ومن ثم كرّت السبحة، فتُرجمت إلى الفرنسية عدة روايات سعودية، من أعمال غازي القصيبي إلى محمد حسن علوان مروراً بعبدالرحمن منيف ورجاء عالم وبدرية البشر ورحاب أبو زيد…
المحفّز الأول:
الفضول الثقافي
 حتى ظهور الروايات السعودية الأولى المترجمة إلى الفرنسية، لم يكن في ثقافة القارئ الفرنسي عن السعودية غير ما يقرأه في الصحافة ووسائل الإعلام. وكان لباكورة الترجمات التي تمَّت في السنوات الأولى من الألفية الجديدة وقع إيجابي على هذا القارئ، الذي أبدى استعداده للاطلاع على مزيد منها. وفي هذا الصدد، يقول أستاذ الأدب المعاصر في جامعة السوربون إيريك غوتييه: “على الرغم من أن الروايات السعودية المترجمة إلى الفرنسية ليست كثيرة، ولا تلك التي كُتبت أصلاً باللغة الفرنسية، إلا أنها استجابت إلى حدٍّ ما لذائقة القارئ والناقد على حدٍّ سواء. واستُشف من تلك النصوص توسيع دائرة التيمات المطروحة في الرواية العربية والسعودية بشكل خاص”.
حتى ظهور الروايات السعودية الأولى المترجمة إلى الفرنسية، لم يكن في ثقافة القارئ الفرنسي عن السعودية غير ما يقرأه في الصحافة ووسائل الإعلام. وكان لباكورة الترجمات التي تمَّت في السنوات الأولى من الألفية الجديدة وقع إيجابي على هذا القارئ، الذي أبدى استعداده للاطلاع على مزيد منها. وفي هذا الصدد، يقول أستاذ الأدب المعاصر في جامعة السوربون إيريك غوتييه: “على الرغم من أن الروايات السعودية المترجمة إلى الفرنسية ليست كثيرة، ولا تلك التي كُتبت أصلاً باللغة الفرنسية، إلا أنها استجابت إلى حدٍّ ما لذائقة القارئ والناقد على حدٍّ سواء. واستُشف من تلك النصوص توسيع دائرة التيمات المطروحة في الرواية العربية والسعودية بشكل خاص”.
ويلاحظ المتخصِّصون في المشهد الثقافي الفرنسي أن مرحلة التحولات في النصوص السردية السعودية، أو ما اصطلح على تسميته برواية التحولات التي بدأت بأعمال غازي القصيبي وعبدالرحمن منيف وتركي الحمد وعبده خال في منتصف التسعينيات، ربطت مشروعهم الروائي بمواضيع استلهمت الواقع وحركت الرواكد الأدبية واستثارت المجتمع. وعلى الرغم من أن تلك الإصدارات واجهت كثيراً من الصعوبات المرتبطة بالنشر وأخرى بإثارة الجدل حول شرعية الكاتب في الكتابة عن موضوع دون غيره، بقيت كتابة الرواية مرتبطة بعدد من التحديات”.
لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن القارئ والناقد الغربي لم ينتبه في مرحلة أولى لهذه الأعمال إلا في شقها الجريء على الخوض في مساحات محظورة على مجتمع محافظ. ولم تقرأ تلك النصوص المترجمة ضمن سياقات وجدت فيها على ضوء التحولات الاجتماعية والتاريخية.
فالمترجم فيليب ميشكاوسكي، وفي ندوة حول تجربته في ترجمة النصوص السردية السعودية، في معرض الكتاب بباريس، قال إنه يرى أن القارئ الفرنسي والفرنكوفوني بشكل عام، غالباً ما يستقبل تلك النصوص ضمن سياق يحمل كثيراً من الأفكار المسبقة، على أنها جاءت من مجتمع محافظ ظل لفترة طويلة غريباً عن العربية”.
وإلى ذلك يضيف المدير السابق لدار “فلاماريون” هنري بونيي: “إن الرواية السعودية بدَّدت الضباب الذي كان يلف صورة المجتمع السعودي في الغرب. فتعرف القارئ ولو جزئياً على بعض الموضوعات التي أتاحت المجال للتعرف على الثقافات التاريخية والإنسانية المتشابهة أو المتناقضة، كما هو الحال في أي مجتمع إنساني”. ولربما كانت هذه النقطة بالذات، إضافة إلى ما قاله ميشكاوسكي، هو ما يفسر حضور المرأة بشكل كبير في الروايات التي اختارت ترجمتها بعض الدور مثل “آكت سود” و”غاليمار” و”لوسوي” وغيرها… ولقيت هذه الترجمات إقبالاً متفاوتاً من واحدة إلى أخرى، تتصدره أعمال عبدالرحمن منيف ورجاء عالم.
المحفّز الثاني:
النهضة الروائية السعودية
بعد الانطلاقة الواثقة، وإن كانت محدودة كمّاً، التي عرفتها الرواية السعودية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ظهرت الطفرة الروائية الكبيرة في مطلع الألفية الجديدة، التي تميزت بالحيوية والتنوُّع واتخذت أحياناً طابعاً صدامياً. وانتبه الناشرون في الغرب إلى هذا الحراك الأدبي بشكل خاص بعدما انتزع أدباء سعوديون جائزة “البوكر” ثلاث مرات. فاستنتجوا من ذلك أن مركز الرواية العربية قد تزحزح من القاهرة وبيروت شرقاً باتجاه الرياض، وكان لهم في عقر دارهم باريس، ما يعزَّز هذا الانطباع، بفوز محمد حسن علوان بجائزة معهد العالم العربي في باريس، على روايته “القندس” التي ترجمتها ستيفاني ديجول، وصدرت عن دار “آكت سود”. وهذا ما يعزِّز آفاق التعاون والبحث عن نصوص ترقى إلى المستوى اللازم للترجمة والنشر. الأمر الذي يعزِّز بدوره التفاؤل بصدور مزيد من الترجمات لاحقاً.

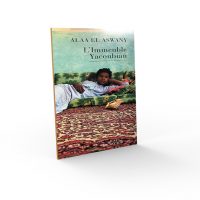






اترك تعليقاً