 ثمة علاقة ما بين الرواية والسيرة الذاتية، ظلت مثار جدل بين كثير من الكتَّاب.. قد تتكئ الرواية على السيرة الذاتية، أو تتخفَّى تحت تسمية الرواية.
ثمة علاقة ما بين الرواية والسيرة الذاتية، ظلت مثار جدل بين كثير من الكتَّاب.. قد تتكئ الرواية على السيرة الذاتية، أو تتخفَّى تحت تسمية الرواية.
وإذا كان الخيال الأدبي البعيد عن الواقع، قد أضفى على بعض الأعمال الروائية صقيعاً كئيباً، فإن الحياة بصدقها وواقعيتها وتناقضاتها وحرارتها وأحداثها المتصاعدة قد منحت كثيراً من الروايات السيرية لهيباً ووميضاً واشتعالاً ظل متقداً حتى عصرنا هذا، وأنتجت لنا كثيراً من الأعمال الخالدة التي استلهمت الحياة واتكأت على السرد الذاتي الواقعي.
روسو.. الإنسان في أصدق صوره
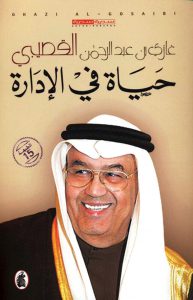 «إنني مُقْدم على مشروع لم يسبقه مثيل، ولن يكون له نظير، إذ إنني أبغي أن أعرض على أقراني إنساناً في أصدق صور طبيعته.. وهذا الإنسان هو: أنا! أنا وحدي!…». بهذا الوضوح التام، الصادم – حينها -، استهلّ الكاتب والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو أول سطر في كراسات اعترافاته، التي قدَّمت نمطاً مبكراً جداً من السِيَر الذاتية، التي ينحاز فيها الكاتب إلى واقعه – مباشرةً – يكون فيها هو الحاكي والمحكي عنه. ينقل سخونة أحداثه تماماً كما هي، دون أن يُخضع ذلك إلى صقيع الخيال والسرد الأدبي الذي قد يكون قاصراً، وربما باهتاً – أحياناً – في نقل تجربة إنسانية إذا ما قورن بسرد أحداث حقيقية واقعية، يكون الخيال فيها ضمنياً، لا كلياً.
«إنني مُقْدم على مشروع لم يسبقه مثيل، ولن يكون له نظير، إذ إنني أبغي أن أعرض على أقراني إنساناً في أصدق صور طبيعته.. وهذا الإنسان هو: أنا! أنا وحدي!…». بهذا الوضوح التام، الصادم – حينها -، استهلّ الكاتب والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو أول سطر في كراسات اعترافاته، التي قدَّمت نمطاً مبكراً جداً من السِيَر الذاتية، التي ينحاز فيها الكاتب إلى واقعه – مباشرةً – يكون فيها هو الحاكي والمحكي عنه. ينقل سخونة أحداثه تماماً كما هي، دون أن يُخضع ذلك إلى صقيع الخيال والسرد الأدبي الذي قد يكون قاصراً، وربما باهتاً – أحياناً – في نقل تجربة إنسانية إذا ما قورن بسرد أحداث حقيقية واقعية، يكون الخيال فيها ضمنياً، لا كلياً.
نقل روسو في اعترافاته كثيراً من جوانب حياته الشخصية بكل صراحة، كان مؤمناً منذ وقت مبكر بأن الكتابة عن الذات تستلزم قدراً من الجرأة والصراحة والشفافية، وتتطلب نقل التجربة الحياتية بكل تداخلاتها وإخفاقاتها وإنجازاتها، وتستعير من زخم الحياة تلك السخونة الكامنة في مسرح أحداثها.
 الجرأة في الحكاية عن الذات، عن الواقع، وكشف أدق الأسرار الحميمة في حياة الكاتب، بما يصاحب ذلك من سيناريو واقعي ساخن وحقيقي، يعجز عن صياغته أعظم الخيالات الأدبية، كل ذلك المزيج الساطع وهب اعترافات روسو الخلود والجاذبية.
الجرأة في الحكاية عن الذات، عن الواقع، وكشف أدق الأسرار الحميمة في حياة الكاتب، بما يصاحب ذلك من سيناريو واقعي ساخن وحقيقي، يعجز عن صياغته أعظم الخيالات الأدبية، كل ذلك المزيج الساطع وهب اعترافات روسو الخلود والجاذبية.
لقد ذكر روسو في تلك المذكرات قصة حبه الكبيرة لمدام دي فاران التي ظل يلهج بذكرها في تلك المذكرات، بل ولآخر لحظة في حياته. كتب تلك الاعترافات على مدى خمس سنين من 1765 حتى 1770م. وهذه الاعترافات بدورها كان لها دور كبير في تعليم أجيال من الكتَّاب الفرنسيين كيفية الكتابة الأدبية الشفافة، خصوصاً، الكتابة الرومانسية. ويدخل في عداد هؤلاء لامارتين وفيكتور هوغو وأسماء كثيرة.
 فمن بين الكتب المهمة التي ألّفها روسو في مجالات عدة وشكَّلت منعطفات تاريخية كبيرة، تتميز اعترافاته هذه بكونه ينساب فيها كالماء المتدفق. تجده عاشقاً حيناً، وطفلاً يعاني الفقد واليتم والمرض حيناً آخر، وفيلسوفاً أديباً موسيقياً كذلك. إنه يجمع كل هذا المزيج بين دفتي كتاب خالد، ولا يمكن لقارىء أن يفهم مؤلفات وكتب وأفكار روسو ما لم يمر على اعترافاته الساخنة تلك. إن الكاتب حين ينزع إلى هذا النوع من الكتابة فإنه يقدِّم للقارئ نمطاً مختلفاً عن حياته، إنه يشارك القارئ كل تفاصيلها، مكوناً بذلك علاقة صادقة تتيح لكليهما الثقة بالآخر، وذلك ما يفسر الرواج الكبير لمثل هذه النوع من الكتابة.
فمن بين الكتب المهمة التي ألّفها روسو في مجالات عدة وشكَّلت منعطفات تاريخية كبيرة، تتميز اعترافاته هذه بكونه ينساب فيها كالماء المتدفق. تجده عاشقاً حيناً، وطفلاً يعاني الفقد واليتم والمرض حيناً آخر، وفيلسوفاً أديباً موسيقياً كذلك. إنه يجمع كل هذا المزيج بين دفتي كتاب خالد، ولا يمكن لقارىء أن يفهم مؤلفات وكتب وأفكار روسو ما لم يمر على اعترافاته الساخنة تلك. إن الكاتب حين ينزع إلى هذا النوع من الكتابة فإنه يقدِّم للقارئ نمطاً مختلفاً عن حياته، إنه يشارك القارئ كل تفاصيلها، مكوناً بذلك علاقة صادقة تتيح لكليهما الثقة بالآخر، وذلك ما يفسر الرواج الكبير لمثل هذه النوع من الكتابة.
«وكنت مكروباً، معذباً، حطمتني العواصف من كل نوع، وأضنتني التنقلات والاضطهادات خلال سنوات عديدة، وأصبحت أشعر شعوراً طاغياً بالحاجة إلى الراحة التي اتخذ أعدائي – الغلاظ القلوب – ملهاةً من حرماني منها…».
وكما بدأ روسو بهذا الوضوح التام، يختتم اعترافاته الشخصية كذلك، تاركاً خلفه نافذةً مفتوحة أطل من خلالها كثيراً للتعرف على سيرة هذا الكاتب الفيلسوف الكبير.
سيلين.. سوداوية الواقع
وبياض الحرف
دخل سيلين الشهرة الأدبية من بابها الواسع بعد نشره روايته الأولى «رحلة في أقاصي الليل» سنة 1932م، حيث ينتقد الكاتب بنمطه الأدبي الفريد، رعب الحرب، قسوة الرأسمالية، وإلى حدٍّ ما الاستعمار، من خلال الشخصية الرئيسة للرواية فرديناند باردامو (المستوحاة من التجارب الشخصية لسيلين).
ينحاز الكاتب الروائي والطبيب الفرنسي لويس فرديناند سيلين في روايته «رحلة في أقاصي الليل» إلى الحقيقة والواقع كثيراً، الواقع بشقيه: النفسي والمحيط، مشكِّلاً ثورةً أسلوبية جمالية، موازيةً للثورة التي أحدثتها مؤلفاته العديدة.
تبدو حروفه هنا قناديل محتشدة، برغم السواد الذي كان يلفّ واقعه وحياته.
 يصف بؤسه في أحد منعطفات حياته، حاملاً مخطوط روايته «سيرته» إلى إحدى دور النشر من أجل أن يعتاش من مكافأتها، لا من أجل أن يصير أديباً مشهوراً. لكن مخطوطة الرواية ضاعت، فضاع أمل سيلين في أخذ ما طمح إليه كي ينتشل نفسه من عجزها، ويبعدها عن حالات القهر الاجتماعي التي واجهته. وبمحض الصدفة النادرة، تتهيأ لـ «سيلين» فرصة سانحة لنشر هذه الرواية التي أحدثت – لاحقاً – عاصفةً مدوية في فرنسا، ما لبثت أن انتقلت إلى لغات أوروبية عديدة.. لم تكن لتلقى كل هذا الرواج لولا أنها جسّدت جوانب شخصية في حياة الكاتب، ورسمت واقعه بوضوح متناهٍ، مستحضرةً تفاصيل دقيقة لا تخطر على بال الخيال الأدبي مطلقاً.
يصف بؤسه في أحد منعطفات حياته، حاملاً مخطوط روايته «سيرته» إلى إحدى دور النشر من أجل أن يعتاش من مكافأتها، لا من أجل أن يصير أديباً مشهوراً. لكن مخطوطة الرواية ضاعت، فضاع أمل سيلين في أخذ ما طمح إليه كي ينتشل نفسه من عجزها، ويبعدها عن حالات القهر الاجتماعي التي واجهته. وبمحض الصدفة النادرة، تتهيأ لـ «سيلين» فرصة سانحة لنشر هذه الرواية التي أحدثت – لاحقاً – عاصفةً مدوية في فرنسا، ما لبثت أن انتقلت إلى لغات أوروبية عديدة.. لم تكن لتلقى كل هذا الرواج لولا أنها جسّدت جوانب شخصية في حياة الكاتب، ورسمت واقعه بوضوح متناهٍ، مستحضرةً تفاصيل دقيقة لا تخطر على بال الخيال الأدبي مطلقاً.
إن الحياة الحافلة، والتجارب المريرة التي مرَّ بها سيلين ألقت بظلالها على روايته «رحلة في أقاصي الليل»، فاتساع التجربة وامتدادها ما بين الخدمة في الجيش، والعمل في مهنة الطب، والكتابة، والسجن، والاضطهاد.. كل ذلك السواد، أنتج لنا «الليل» الذي غاص في أعماقه سيلين، بكل مهارة واقتدار، ليأخذنا في رحلة إلى أقصاه، كانت أنفاسه أنفاسَنا، وعزلته عزلتنا، وشقاؤه شقاءنا، وتلك الحرارة التي كانت محتشدة ما بين السطور، هي حرارة الأيام في أصدق صورها.
«الأيام».. نافذة أولى
«ومن ذلك الوقت حرّم على نفسه ألواناً من الطعام لم تبح له إلى أن جاوز الخامسة والعشرين، حرّم على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق، لأنه كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة، وكان يكره أن يضحك عليه إخوته، أو تبكي أمه، أو يعلمه أبوه في هدوء حزين».
لم تكن هذه الرواية تجربةً عابرة، ولا حدثاً عادياً. ربما لم يكن عميد الأدب العربي طه حسين – حينها – يفكر أن «الأيام» التي عاشها وكتبها، ستصبح باكورة الرواية السيرية في الأدب العربي. فقد انحاز فقط إلى الجمال، وترك للموهبة الفذّة إكمال المهمة.
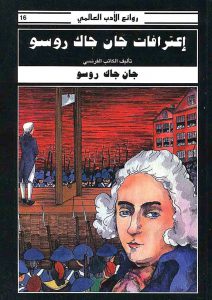 لم تكن تجربة ذلك الفتى الضئيل الضرير، وهو يغادر الريف نحو المدينة طلباً للعلم، هارباً من ضيق القرية إلى اتساع المدينة، تجربة تدوّن بفتور وتقليدية.. أن تكون كفيفاً بين كل تلك الأضواء، غريباً وسط كل تلك الحشود، بعيداً بين تقارب الأشياء، أن تعيش كل هذه «الأيام» دون أن تكون لك القدرة على حكايتها، واسترجاع كل تفاصيلها الدقيقة، أنْ تعجز ذاكرتك عن الرجوع إلى تلك الأيام، فأنت تفوّت فرصةً سانحةً للجمال، وذلك ما لم يحدث مع طه حسين، حيث أهدى للأدب العربي تجربةً ظلت في موقع الريادة حتى يومنا هذا.
لم تكن تجربة ذلك الفتى الضئيل الضرير، وهو يغادر الريف نحو المدينة طلباً للعلم، هارباً من ضيق القرية إلى اتساع المدينة، تجربة تدوّن بفتور وتقليدية.. أن تكون كفيفاً بين كل تلك الأضواء، غريباً وسط كل تلك الحشود، بعيداً بين تقارب الأشياء، أن تعيش كل هذه «الأيام» دون أن تكون لك القدرة على حكايتها، واسترجاع كل تفاصيلها الدقيقة، أنْ تعجز ذاكرتك عن الرجوع إلى تلك الأيام، فأنت تفوّت فرصةً سانحةً للجمال، وذلك ما لم يحدث مع طه حسين، حيث أهدى للأدب العربي تجربةً ظلت في موقع الريادة حتى يومنا هذا.
وإنْ كانت لخصوصية تجربة طه حسين باعتباره ينقل تجربة الفتى «الضرير» الذي كان يبصر بقلبه، أثرٌ في هذا العمل الخالد، فإنه عاش إضافة إلى ذلك مرحلةً مهمة في تاريخنا العربي، وحياةً حافلةً بالتجارب الموجعة حيناً والمشرقة حيناً آخر. لقد عاش أياماً كفيلة بأن تُروى وتُحكى، استطاع بموهبته الفذة، وبقلمه الجريء أن يقدِّم للأدب العربي والعالمي تجربةً جديرةً بالبقاء والديمومة.
حياة في الإدارة.. سيرة مغايرة
حينما نتحدث عن الروايات السيرية، لا يمكن تجاوز «حياة في الإدارة»، هذا الكتاب الذي قفز به الدكتور غازي القصيبي من التناول الأكاديمي الجاف لمفهوم الإدارة، إلى أفق السرد الإبداعي الرحب.
لقد تناول الوزير الأديب سيرته الإدارية بقلم الشاعر والروائي، أهّله إلى ذلك الحس الفني الإبداعي ممزوجاً بالخبرة الإدارية العريضة، ليخرج بهذا المزيج الرائع «حياة في الإدارة»، كسيرة أدبية إدارية لا تخلو من الفائدة العلمية والمتعة الأدبية كذلك.
 «إذا كان ثمة سر فهو أنني كنت دوماً أعرف مواطن ضعفي بقدر ما أعرف مواطن قوتي».. يلامس «القصيبي» في هذا السرد الماتع لجانب عملي في حياة الإنسان، جانباً إنسانياً مهماً، لا يتسنى للمؤلفات العلمية التطرق إليه، إنه يكتب «نفسه» إدارياً قبل كل شيء.. يدير كتابة «نفسه» هذه المرة، يتحدث عن أسراره الشخصية الكامنة خلف كل قراراته الإدارية، وهذا ما أضاف إلى هذه السيرة الروائية الزخم الحياتي الإنساني المكثّف..
«إذا كان ثمة سر فهو أنني كنت دوماً أعرف مواطن ضعفي بقدر ما أعرف مواطن قوتي».. يلامس «القصيبي» في هذا السرد الماتع لجانب عملي في حياة الإنسان، جانباً إنسانياً مهماً، لا يتسنى للمؤلفات العلمية التطرق إليه، إنه يكتب «نفسه» إدارياً قبل كل شيء.. يدير كتابة «نفسه» هذه المرة، يتحدث عن أسراره الشخصية الكامنة خلف كل قراراته الإدارية، وهذا ما أضاف إلى هذه السيرة الروائية الزخم الحياتي الإنساني المكثّف..
يعدّ «حياة في الإدارة» وثيقة تاريخية مهمة لحقبة إدارية أكثر أهمية في المملكة، كما أنه مرجع إداري في مجاله. إضافة إلى ذلك فهو يُعد عملاً أدبياً بامتياز. لقد كان الحديث عن الإدارة من بوابة الأدب، السرد تحديداً، هو الطريق الممهد الذي جعل من هذه السيرة الأدبية الإدارية عملاً يلامس كوامن النفس، وينفذ إلى الأرواح بانسيابية مدهشة.
 «أستطيع أن أقول إن حصيلة السنوات الخمس الأولى في حياتي كانت وحدة مشوبة بالحزن، وطفولة تنمو تحت عين أبٍ حازم صارم وفي كنف جدة رؤوم حنون، هل تركت هذه الطفولة في عقلي الباطن ميراثاً وسم بسماته حياتي الإدارية؟»..
«أستطيع أن أقول إن حصيلة السنوات الخمس الأولى في حياتي كانت وحدة مشوبة بالحزن، وطفولة تنمو تحت عين أبٍ حازم صارم وفي كنف جدة رؤوم حنون، هل تركت هذه الطفولة في عقلي الباطن ميراثاً وسم بسماته حياتي الإدارية؟»..
هكذا اختار «القصيبي» الحديث عن حياته الإدارية، ومن هذه النافذة تحديداً، نافذة السرد الذاتي، أو الرواية السيرية، أطل ليضمن لكتابه مكاناً مرموقاً في التراث الأدبي العربي.