الأسماء الشخصية ظاهرة ثقافية عالمية، ويؤكد علماء الأنثروبولوجيا أنهم لم يجدوا مجتمعًا واحدًا إلا ويستخدم الأسماء بوصفها عنصرًا أساسًا لتحديد الهوية الفردية المستقلة. فمنذ لحظة الولادة، يُسمِّي الآباء والأمهات أطفالهم كأول علامة غير بيولوجية للفردية وسط المجموعة البشرية. ومنذ تلك اللحظة، تصبح أسماؤنا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فتشكّل تصوراتنا عن أنفسنا، وتؤثر في كيفية نظرة الآخرين إلينا، وتتحول إلى الشارة التي نقدّمها إلى العالم، أو “علامتنا التجارية الخاصة” التي تحدّد هويتنا الاجتماعية والثقافية والقانونية أيضًا. وهذا الإحساس بالهوية الشخصية والتفرد، الذي تمنحنا إياه أسماؤنا، هو في جوهر الأسباب التي تدعونا إلى الاهتمام بها والغوص في تأثيرها علينا من حيث الإحساس بذواتنا وتحديد مساراتنا المهنية والشخصية، فضلًا عن سماتنا الشخصية.
“ما الذي في الاسم؟ هذا الذي نسميه وردة، بأي اسم آخر ستكون رائحته طيبة؟”. هكذا تتساءل جولييت في مسرحية شكسبير الشهيرة “روميو وجولييت”، مشيرة إلى أن الاسم لا يحمل قيمة ولا معنى بحد ذاته، وأنه ببساطة مجرد كلمة تُطلق لتمييز شيء أو شخص عن آخر. تطبّق جولييت استعارة الوردة هذه على روميو لتؤكد أنه سيظل الرجل الذي تحب حتى لو كان له اسم مختلف. ولكن على الرغم من استخفاف جولييت بأهمية الاسم، فإن له في الحقيقة دلالات كبيرة في حياتنا. فهو يبقى “أهم دعامة لهويتنا الذاتية طوال الحياة”، كما يقول أحد أبرز مؤسسي علم نفس الشخصية، عالم النفس الأمريكي، جوردون ألبورت، في كتابه “النمط والنمو في الشخصية”، الصادر عام 1963م.

أسماؤنا رمز لذواتنا
إلى جانب الجينات والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والخبرات الشخصية والمستوى الثقافي، والدور الذي يؤديه الفرد في مجال العائلة أو العمل، فالاسم هو بطاقة التعريف الأساس التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهويتنا. إذ نجد هذا الارتباط في حديثنا اليومي، وفي الطريقة التي نقدّم بها أنفسنا لكل غريب نلتقيه، وفي كل مكالمة هاتفية نجريها مع شخص نخابره أوَّل مرَّة، وفي كل مرَّة نستجيب بها عندما نسمع من ينادي باسمنا حتى عندما يُهمس به وسط حشد من الناس. نحمله معنا طوال حياتنا، فيرتبط بنا ونرتبط به؛ حتى يصبح الاسم بالنسبة إلى كل فرد منا “عنصرًا أساسًا في شخصه، وربَّما جزءًا من روحه”، بحسب ما ذكره عالم النفس سيغموند فرويد في كتابه “الطوطم والحرام”. وكل ذلك يجعله من العوامل المهمة التي تسهم في إحساسنا بذواتنا، ويؤدي إلى تشكيل صورتنا الشخصية الذهنية بطريقة غير واعية، ولا سيّما الصورة التي نظن أن الآخرين يروننا بها.
وخلافًا للأرقام والرموز، فالأسماء مثقلة بالمشاعر والدلالات التي يمكن أن يتردد صداها على المستوى الشخصي. لذلك، نجد أننا في كثير من الأحيان نحاول أن نرتقي إلى مستوى أسمائنا، وفي أحيان أخرى نحاول الهرب منها. ومن المؤكد أن تؤثر الصفات التي تنطوي عليها أسماؤنا، في الكيفية التي يعاملنا بها الآخرون، وطبيعة شعورنا نحن، حيال أنفسنا أيضًا. ولمَّا كان الاسم يشكّل رمزًا للذات، فقد يؤدي شعورنا بعدم الرضا عن أسمائنا إلى قلة الثقة بالنفس واحترام الذات؛ وذلك إمَّا لأنها أسماء قديمة مقارنة بالأسماء التي تُعدُّ حديثة في نطاق معين، وإمَّا لأنها تحمل دلالات سلبية. ويرجع ذلك أساسًا إلى سببين: فمن ناحية، يمكن أن تشعر “الأنا” بالأذى؛ لأننا لا نحب الاسم أو ما يمثله بالنسبة إلينا. ومن ناحية أخرى، قد لا يحبها الآخرون، وسيجد معظم الناس طريقة مباشرة أو غير مباشرة لإعلامنا بذلك. وعلى أساس نظرية “مرآة الذات”، التي وضعها عالم الاجتماع الأمريكي تشارلز كولي، ويقول فيها إن الذات، شأنها شأن الصور التي تنعكس على المرآة، تعتمد على ما يصل إليها من استجابات الآخرين، أو كما صاغها كولي بعبارته هو: “كل فرد للآخر كالمرآة، تعكس ما يعرضه عليها هذا الآخر”. وعلى ذلك، يمكن لأسمائنا تلوين علاقتنا بالآخرين، وعندما تكون الاستجابة لأسمائنا سلبية، فقد ينعكس ذلك علينا بشكل سلبي أيضًا.
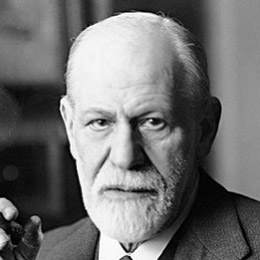
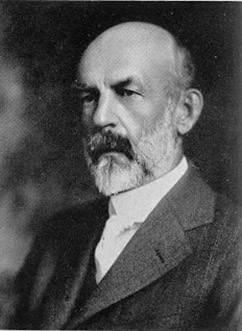
دلالاتها السلبية وتدني الثقة بالنفس
على مدار الأعوام السبعين الماضية، حاول الباحثون استكشاف مدى تأثير الاسم غير العادي أو الغريب، أو الذي يحمل دلالات سلبية على الفرد، ومن أبرز تلك الدراسات دراسة عنوانها: “الرغبة في الاسم الأول وتعديله.. الرضا عن النفس وتقييمات الآخرين والخلفيّة العائلية”، التي نُشرت نتائجها في مجلة “علم النفس الاجتماعي التطبيقي” في عام 1998م، وأعدَّها عالما النفس جون توينج وملفين مانيس. فقد كشفت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين لا تروقهم أسماؤهم، تتدنى قدرتهم على التوافق النفسي مع الآخرين، وذلك مع تثبيت العوامل الأخرى المرتبطة بالخلفية الأسرية والإحساس بعدم الرضا عن الحياة بوجه عام.
وهناك دراسة أخرى أجريت في عام 2010م، ونُشرت نتائجها في المجلة الطبية “علم النفس الاجتماعي وعلم الشخصية” تحت عنوان: “الأسماء الأولى السيئة.. تأثير الاسم في تقدير الشخص وعلاقته بالآخرين”، وجمع القيّمون عليها بيانات من 12 ألف مشارك من البالغين الذين لديهم أسماء تُعدُّ سيئة في ثقافة مجتمعهم. وقد أوضحت تلك البيانات أن الشخص صاحب الاسم السيئ أو المرفوض من المجتمع أو الغريب، يكون معرضًا لفقدان احترامه لنفسه والشعور بالوحدة، حتى إن الأمر يمكنه أن يؤثر في قدرته على الاستيعاب ومستوى ذكائه.
جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي
من جهة أخرى، تروي الأسماء جزءًا من قصتنا حتى قبل أن تُتاح لنا فرصة التحدث بأي كلمة، فهي مصدر معلومات مهم عنا لأنها تُرسل إشارات عن هويتنا وأصولنا العرقية وخلفيّاتنا الاجتماعية والدينية. إذ بمجرد سماعنا لاسم “هيروشي”، مثلًا، ندرك أن صاحبه من اليابان، أو اسم “محمد” فنعلم أن صاحبه مسلم، أو “فولفغانع” فنقدّر أن حامله ربما يكون من أصول ألمانية. فمن الناحية الثقافية، الأسماء هي أكثر من مجرد مجموعة من الكلمات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص، فهي جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي، حتى إنه يمكننا القول إن التراث الثقافي لا يقتصر على المتاحف أو كتب التاريخ فحسب؛ بل يزدهر في الأسماء التي تنتقل عبر العائلات، ويتردد صداها عبر العصور. فهي بمنزلة حلقة وصل بين الأفراد وتراثهم؛ لأنها تربطهم بجذور أسلافهم، وتشكّل شعورهم بالانتماء، وفي أحيان كثيرة تعزّز لديهم شعورًا قويًا بالهوية والفخر، مما يؤثر بدوره في تنمية شخصيتهم.

يؤثر العِرق والثقافة في اختيارات التسمية بطرق عديدة. فعلى سبيل المثال، تتبع بعض الثقافات تقليد التسمية الأبوي، حيث يُشْتَقّ لقب الطفل من اسم الأب. وفي المقابل، يتبع آخرون تقليد التسمية من ناحية الأم، حيث يُشْتَقّ اسم الطفل من اسم الأم. وفي ثقافات أخرى، تُختار الأسماء لتكريم الأسلاف، كما في عالمنا العربي حيث جرت العادة أن يُسمَّى الطفل الأول، إذا كان ذكرًا، على اسم جدّه. كما يعدُّ الدين أيضًا عاملًا مهمًا؛ إذ إن العديد من المجتمعات الدينية لديها مبادئ توجيهية محددة لتسمية أطفالها. فمثلًا، غالبًا ما يختار المسلمون الأسماء التي تؤكد العبودية لله تعالى، مثل عبدالله وعبدالرحمن، وكذلك تلك التي تتيمَّن بأسماء الأنبياء والصالحين، كاسم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وفي حالات أخرى، تُختار الأسماء بناءً على معانيها أو ترتيب ميلاد الطفل في العائلة. وفي بعض الثقافات، يُسمَّى الأطفال بعد عدة أيام أو أسابيع من الولادة، بحيث إن الأسرة قد تنتظر ملاحظة سمات شخصية الطفل أو خصائصه الجسدية قبل اختيار اسم يعكس صفاته الفريدة. إضافة إلى ذلك، قد تشير الأسماء إلى الجنس والحالة الاجتماعية؛ إذ إنه في بعض الثقافات الإفريقية، تشير الأسماء التي تبدأ بالحرف “O” إلى الثروة والرخاء. بينما في ثقافات أخرى، تشير الأسماء التقليدية إلى الموارد المالية المحدودة.
وفي عالم يحفل بالتحيّزات، يمكن للأسماء أن تمثّل عائقًا أمام التقدّم المهني أو الاجتماعي، لا سيَّما في الدول والثقافات التي تُوجد فيها أسماء غريبة. وفي هذا الإطار، أُجريت العديد من الدراسات التي كشفت عن هذه التحيّزات التي كانت لها جذور اجتماعية وثقافية ودينية وحتى لغوية. وكان آخرها دراسة أُجريت في أوروبا بعنوان “جيمم” أو GEMM (التي تعني النمو وتكافؤ الفرص والهجرة والأسواق)، ونُشرت نتائجها في “المجلة الاقتصادية – الاجتماعية” في 2018م، وهي دراسة ميدانية امتدت على فترة خمس سنوات، وشملت خمس دول تقدّم المشاركون فيها لآلاف الوظائف الفعلية باستخدام مجموعة من الأسماء المختلفة. وكانت النتائج صادمة: فقد احتاجت الأقليات العرقية إلى إرسال طلبات أكثر بنسبة %60 من الأغلبية البيضاء للحصول على عدد من ردود الاتصال على طلباتهم.
بين الحتمية الاسمية والأنانية الضمنية
يقول عالم النفس السويسري كارل يونغ: “في بعض الأحيان، تكون هناك مصادفة غريبة تمامًا بين اسم الرجل وخصائصه”. وكان قوله هذا، أساسًا للنظرية التي وُضعت منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن، والتي باتت تُعرف بـ”الحتمية الاسمية”.
تقول هذه النظرية إن اسم الشخص يمكن أن يكون له نوع من التأثير في تحديد وظيفته ومهنته وحتى شخصيته. ومن المؤكد أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأعمال الخيالية التي تعتمد التلاعب بالحتمية الاسمية. ففي روايات هاري بوتر الشهيرة، كان الاسم الأخير للمستذئب “ريموس لوبين” معناه “الذئب” باللغة اللاتينية؛ واسم “كاتنيس”، رامية السهام الماهرة في سلسلة روايات “مباريات الجوع”، مشتق من نبات “رأس السهم”؛ وفي رواية الكاتبة هاربر لي الكلاسيكية “أن تقتل طائرًا محاكيًا”، فإن اسم المحامي الأرمل “أتيكوس فينش”، هو إشارة إلى رجل الدولة والخطيب الروماني “هيرودس أتيكوس”.

النظرية في عالم الواقع
أُجريت العديد من الدراسات في هذا الصدد، وكان من بينها دراسة أجراها في عام 2015م، فريق من الأطباء من المملكة المتحدة لتحليل وثيقة تحتوي على أسماء جميع المتخصصين الطبيين المسجلين أطباء، ووجدوا أن “تواتر الأسماء ذات الصلة بالطب والتخصصات الفرعية كان أكبر بكثير مما تتوقعه الصدفة”. لذلك، نجد أن “د. باين” الذي يعني “مسكن الألم” بالإنجليزية، متخصص بالتخدير؛ وأن “د. تشايلد” الذي يعني “الطفل” باللغة الإنجليزية، مختص بالتوليد؛ وأن “د. سيزورز” الذي يعني “المقص” بالإنجليزية، مختص بالجراحة، وهكذا. وبطبيعة الحال، هذا لا يعني بالضرورة أن الأسماء أثرت في المسارات المهنية لهؤلاء الأطباء، ولكن من الصعب تفسير الارتباطات بطريقة أخرى.
هناك من يقول إن هذه الروابط ربَّما تكون جزءًا مما يسميه الباحثون بـ”الأنانية الضمنية”، وهي الرغبة اللاواعية التي تجعلنا ننجذب إلى الأشياء التي تذكرنا بأنفسنا، سواء أكان ذلك الزواج بشخص يشاركنا تاريخ ميلادنا، أم الانتقال إلى مكان يحمل اسمًا مشابهًا لاسمنا، أم اختيار وظيفة تشبه تسميتها أسماءنا. ولكن، على الرغم من أن كل هذه البراهين ليست قاطعة من الناحية العلمية، فإنها تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى كيفية إدراكنا لأنفسنا فيما يتعلق بأسمائنا.
وأخيرًا، يمكننا القول إن أسماءنا هي أكثر من مجرد تسميات وأبعد من مجرد كلمات، فهي شعارنا الفريد الذي يعرّفنا، وبصمتنا الاجتماعية التي تفرض وجودنا، والعنوان الذي يروي جزءًا من قصتنا، في الوقت الذي تتشابك فيه مع هويتنا، وتشكّل وتتشكّل من خلال إحساسنا بذواتنا. كل ذلك قد يدعو الآباء والأمهات إلى التفكير مليًا قبل تسمية أطفالهم والذهاب إلى أبعد من اعتبارها اختبارًا لقدراتهم الإبداعية أو وسيلة للتعبير عن شخصياتهم أو هوياتهم من خلال ذريتهم؛ لأن هذا الاسم الذي سيهبونه إلى مولودهم الجديد، ربَّما سيحدد نوع الشخص الذي سيصبح عليه مستقبلًا، ويؤثر في سماته الشخصية، وقد يرسم أيضًا مساره المهني والاجتماعي.




اترك تعليقاً