كان التقاء الكلمة -النص الأدبي- مع الصورة السينمائية والسينما في سنواتها المبكرة أشبه ما يكون بالتكرار والامتداد لالتقاء الكلمة والصُوَر “الرسومات”، التي نحتها الإنسان في الأزمنة الغابرة على جدران الكهوف، وكان وراء التقائهما حاجة الإنسان إلى التعبير عن مشاعره ومخاوفه وتوثيق تجربته التي لم تكن سهلة في مواجهة الطبيعة. ويمكن القول إن الحاجة لدى السينمائيين الرُوّاد أيضًا كانت وراء نشوء العلاقة القديمة والمتجددة بين السينما والأدب.
الحاجة إذًا هي المفتاح إلى استكناه جوهر العلاقة بين السينما والأدب وظروف نشأتها وتطورها. وعندما أذكر الحاجة فإنني أشير في الحقيقة إلى حاجات، أو بتعبير آخر، إلى حاجة واحدة مُركَّبة، كما آمل أن يظهر بوضوح خلال المقالة.
السينما والأدب.. قصة الارتباط القديم الجديد
ربما لا يتطلب الأمر تقديم أدلة على أن السينمائي في البدايات، في السينما الأمريكية على وجه التحديد، لم يستغرق وقتًا طويلًا ليدرك ألَّا غنى له عن اللجوء إلى النص الأدبي ليدعم به انطلاق واستمرار مشروعه السينمائي. بيد أن الحصول على أفكار ونصوص ذات قيمة فنية وجمالية عالية، بمقابل ماديٍّ أو مجانًا، لم يكن الدافع الوحيد وراء التفات السينمائي إلى الأديب المعاصر له أو الأديب القديم. فقد كانت هناك أسباب أخرى، بنفس الدرجة من الأهمية، منها حاجته إلى كسب الاعتراف و”المشروعية” للفلم، الشكل الفني الجديد، عن طريق دمجه بالشكل القديم، النص الأدبي، حسب الناقد والمُنَظِّر السينمائي تيموثي كوريغان، في كتابه (الفلم والأدب).
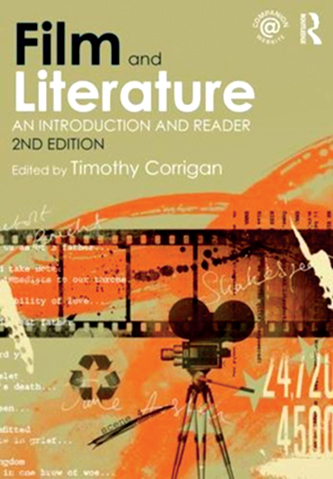
كان كسب الاحترام الشعبي للفلم والسينما عمومًا، يوضّح كوريغان، هدفًا آخر سعى السينمائيون الرواد إلى تحقيقه من خلال توظيف المشهديات الأدبية مادةً للأفلام في محاولة لتمييز السينما والنأي بها عن إرثها الـ “فودفيلي”، ولكسب الاحترام الاجتماعي لفنٍ ميكانيكي. فالسينما، حسب قوله، كانت في بداية تاريخها فنًا ترفيهيًّا موجّهًا إلى الفئات الدنيا. لكن بالاستعانة بالروائع الأدبية والشخصيات الأدبية الشهيرة، اقتربت السينما من الفن التقليدي والممارسات الثقافية المحترمة، واستطاعت جذب المشاهدين من طبقات أخرى. يُضاف إلى ذلك أن إنتاج أفلام مترجمة من أعمال أدبية شهيرة يضمن للاستديوهات والمنتجين جمهورًا جاهزًا.
لا يعني ما سبق أن العلاقة بين السينما والأدب هي دائمًا بين مُسْتَغِل ومُسْتَغَل، بين طرفٍ يأخذ وآخر يُؤخذ منه. إنما كانت، ومن البداية، علاقةً بين طرفين يُفيد كل منهما الآخر؛ فعلى الشاشة الكبيرة يحيا النص الأدبي حياةً جديدةً، يكون فيها نصًا مختلفًا عن ذاته الأصلية، إذا صح التعبير، وينتقل إلى نوعين مختلفين أيضًا من الإيصال والاستقبال من جمهور كبير واسع باتساع العالم، قلّصَته ثورة تقنية الاتصال إلى قرية صغيرة. ليس هذا فحسب، بل إن نجاح الفلم ورواجه غالبًا ما يؤدي إلى وضع النص الأدبي في بقعة الضوء من جديد، ويُلفت الانتباه إليه ويُثير اهتمامَ الجموع، وربما أجيال جديدة من القراء.
يقول كوريغان إن صورة الطوابير الطويلة أمام المكتبات لشراء جزء جديد من رواية “هاري بوتر” تشبه صورة الطوابير أمام دور السينما لمشاهدة جزء جديد من الفلم “هاري بوتر”.
اللافت في تطورِ العلاقة بين الطرفين أن الأدب لم يعد منفردًا بكونه المَصْدر والمُرْسِل للنصوص والسينما هي المُسْتَقْبِل، فقد أصبحت الأخيرة مُرْسِلًا ومَصْدَرًا للنص الروائي فيما يعرف بـالـ “نوفِلايزيشن/novelization”، وهو تحويل سيناريوهات بعض الأفلام إلى روايات. وسبق ذلك، منذ الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير، استعارة الرواية لبعض تقنيات السرد السينمائي ومكونات الشكل السينماتوغرافي، كما يوضح آلان سبيغل في كتابه “التخييل وعين الكاميرا: الوعي البصري في الفلم والرواية الحديثة – 1976م”.

ثمة شيء آخر مهم، وهو أن بعض الروائيين وكُتّاب القصة دخلوا عالم صناعة السينما، تحت وطأة “الحاجة المالية”، ومن أشهر تلك الأسماء الروائي الأمريكي “النوبلي” ويليام فوكنر، الذي عمل “كاتب سيناريو” خلال ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي لـ “مترو غولدوين ماير” و”تونتيث سينتشوري فوكس” و”وارنر برذرز”، حسب مؤلف سيرته جوزيف بلوتنر”ويليام فوكنر: سيرة غيرية – 1974م”. ومن المسرح جاء ممثلون وممثلات نجوم ليكونوا عامل جذب للفن الجديد؛ وجاء الممثل الذي أصبح مخرجًا قام بدور ريادي كبير: ديفيد وارك غريفيث، الذي أحدث نقلة مهمة في السينما، من البدايات إلى ما يعرف بالسينما السردية الكلاسيكية بتوظيفه العناصر السردية للرواية، أو كما قال المُنَظِّر والمخرج الروسي سيرجي آيزنشتاين في كتابه “الشكل الفيلمي”: “من هنا، من ديكنز، من الرواية الفيكتورية، تنبثق البراعم الأولى لجماليات الفلم الأمريكي، المرتبط إلى الأبد باسم ديفيد وارك غريفيث”.
ولعل ديكنز هو الأول عالميًّا، ليس في السينما الأمريكية فقط، بعدد رواياته التي شقت طريقها إلى الشاشة الكبيرة مرات عدة من 1909م إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. أما روايته “آمال عظيمة”، فهي المفضلة والمغناطيس الجاذب لصُنّاع الأفلام من فترة السينما الصامتة إلى 2016م، حيث أخرج ابهيشيك كابور ترجمتها البوليوودية “جنون/Fitoor”.


صانع الأفلام السعودي لا يحتاج إلى الأدب المحلي
عند تأمل وضع السينما السعودية الراهن في ضوء الخلفية السابقة عن تاريخ السينما الأمريكية واعتمادها على النص الأدبي، تشخص صورتان لوضعين مختلفين تمامًا، فما حدث هناك وحينذاك ليس حتميًّا أن يحدث هنا؛ فالسينمائي السعودي لا يحتاج إلى الأدب المحلي أو غير المحلي، لكن ولتخفيف القطعية أضيف الكلمة “مرحليًّا” أو “الآن”، فلربما يجد نفسه في المستقبل وجهًا لوجه مع الحاجة إلى الأدب المحلي ليستلهم منه أفكارًا وحكايات لأفلامه. أما في الوقت الراهن، فلا حاجة تلوح على الأفق، وقد ننتظر لزمن غير قصير قبل أن تلوح.
يُمكن عزو غياب الحاجة إلى أسباب عدة منها أن السينمائي السعودي لا يواجه الآن الظروف والتحديات التي كانت تعترض طريق السينمائيين الرواد؛ فهو ليس مضطرًا، مثلًا، إلى كسب الاعتراف والاحترام الجماهيريين لأفلامه، أو إلى استمالة الجماهير باللجوء إلى الأدب السعودي لخلق حالة من التقبل والإقبال على مشاهدتها، كما أنه لا يواجه ضرورة إضفاء “المشروعية” عليها. فبعد قرن ونيف في الوجود، لم تعد السينما، حتى في بداياتها المتأخرة جدًا عبر العالم، في حاجة إلى انتزاع الاعتراف بها. لقد أصبحت واقعًا وحقيقةً، صناعةً وترفيهًا، وإنجازًا بشريًّا مهمًّا.

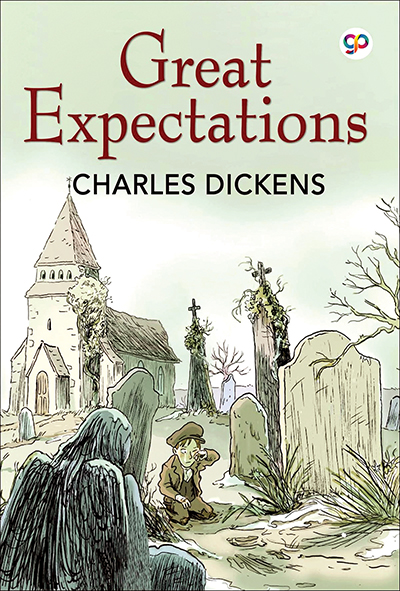
لكن هذا لا يعني أنه ليس للسينمائي السعودي والسينما السعودية نصيبهما من الصعوبات والإشكاليات. فالسينما السعودية الناشئة تواجه أنواعًا من التحديات الخاصة بها، لكن لا يبدو أن من بينها مطلب جذب الجماهير في الداخل، كما كان الحال في البدايات السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما في دول غيرها.
السينمائي السعودي غير حريص، في رأيي، على كسب المشاهد السعودي، لا يضع ذلك على قائمة أولوياته. السينمائي السعودي يصنع فِلمه وعيونه على الخارج، وفي ذهنه المشاركة بفلمه في هذا المهرجان أو ذاك. يُلْمَسُ هذا في تصريحات البعض أنه يصنع فلمًا، أو يضع اللمسات الأخيرة على فلمٍ ينوي المشاركة به في مهرجان كذا وكذا. هذا ما يجعل التفات السينمائي إلى الأدب المحلي كإحدى الطرق لاجتذاب المشاهد في الداخل أمرًا غير وارد في اعتباره، على الأقل ليس الآن. وليس واردًا أيضًا في اعتبار المؤسسة الرسمية الراعية لصناعة الأفلام، التي تحرص على تذليل الصعوبات في طريق الفلم السعودي إلى شاشات العرض في الخارج، بينما لا تفعل ذلك في الداخل، فكأن حضوره في الداخل ليس مهمًا.
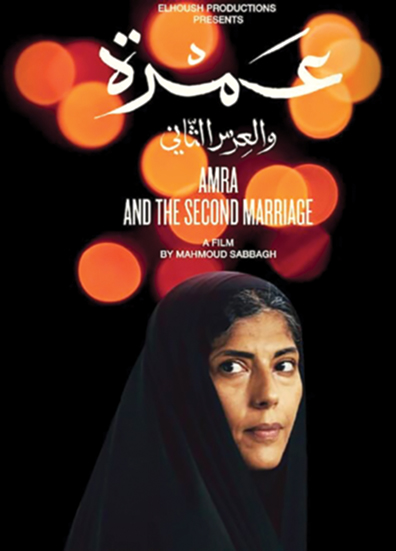

أعتقد أيضًا أن أحد العوامل التي تجعل السينمائي السعودي لا يفكر في الاعتماد على الأدب السعودي كمصدر قصص لأفلامه هو أن الغالبية العظمى من الأفلام المصنوعة محليًّا الآن أفلام قصيرة. فإذا كان صانع الفلم لا يهمه المصدر الذي يستقي منه الثيمات لأفلامه، وأنه غير قارىء للقصة السعودية، فإن أمامه عدة خيارات تحرره من عبء البحث عن نص قصصي سعودي. ومن الخيارات: توفير القصة من فكرة يطوّرها بالتعاون مع أصدقائه أو من يشتغلون معه، أو عبر ورشة، أو أن “يُسَعْوِد” سيناريو من السيناريوهات المنثورة في قارعة الطريق الإلكتروني. كما أتوقع أنه لا يفكِّر في خوض التجربة الصعبة لترجمة رواية إلى فلم قصير، حتى وإن يكن من ذوي الاطلاع على الإبداع الروائي.
أما الرواية فوضعها لا يختلف كثيرًا، وهو أشد تعقيدًا وصعوبة. إن عدد الأفلام الروائية الطويلة المنتجة محليًّا ضئيل وقد يستمر كذلك إلى أجل غير مسمّى. ولا أظن أن إنتاجًا بهذه الضآلة يخلق الحاجة إلى الالتفات إلى الإبداع الروائي المحلي كأحد المصادر لـ”الثيمات” والحكايات.


ليس في ذاكرتي عنوان فِلم روائي طويل يكون ترجمة سينمائية لرواية سعودية. فآخر فلم طويل شاهدته هو “سكة طويلة، Route 10″، من بطولة فاطمة البنوي وبراء عالم، مع ظهور قصير للفنان عبدالمحسن النمر، وهو من قصة وإخراج عمر نعيم. وكتب فهد الأسطاء والمخرج عبدالمحسن الضبعان قصة “آخر زيارة”. أما فلم “عمرة والعرس الثاني”، فقد تكفل محمود صبّاغ بكتابة قصته وإنتاجه وإخراجه. هذه العينة من الأفلام تكشف إما اكتفاء صانع الأفلام ذاتـيًّا وبالتالي عدم حاجته للرواية المحلية أو عدم قراءته واطلاعه عليها، أو صعوبة ترجمتها إلى أفلام سواء قصيرة أم طويلة.

العامل الأخير الذي له أثر في تأجيل توجه صانع الأفلام إلى الإبداع السردي السعودي، هو عدم وجود المطلب الجماهيري نتيجة لعدم وجود قاعدة جماهيرية عريضة للسينما المحلية، يُمكن أن تشكل ضغطًا على صُنّاع الأفلام للاتجاه إلى الأدب السعودي، أو ليس بالضرورة ممارسة الضغط، بل الاكتفاء بالتعبير عن رغبتها في مشاهدة أفلام سعودية مُستلهمة من أعمال سردية لأدباء سعوديين.
هذا مطلب غير موجود الآن، مثلما أن مشاهدة الأفلام السعودية غير موجودة على قائمة مشاهدات الأغلبية من المواطنين: أولًا، لعدم توفر فرص عرضها ومشاهدتها، وثانيًا، لأن المواطن لديه البديل من أفلام ومسلسلات الدراما الأجنبية والعربية والخليجية.
يقابل هذا الغياب للضغط الجماهيري غيابُ الحرص لدى صانع الفلم على كسب هذا الجمهور سواء لحرصه على أضواء الشهرة التي تحققها المشاركات في المهرجانات السينمائية الخارجية، أو لِما تُعَبِّر عنه تصريحات وتلميحات البعض بأن أفلامهم نخبوية، وغير تجارية؛ والجمهور المحلي بأغلبيته شغوف بأفلام هوليوود. المفارقة هي أن لا أحد من المُصَرِّحين أو المُلَمِّحِين سوف يُفَوِّت فرصةَ عرضِ فلم من أفلامه في هوليوود، وإن تحت سقف خيمة في زقاق من أزقتها.

في الحقيقة لا يقلقني عدم التفات صُنّاع الأفلام إلى الأدب السعودي، فهم إن لم يلتفتوا اليوم فسيلتفت البعض منهم في الغد. وإن لم يلتفتوا، فلن يكون في ذلك نهاية السينما أو نهاية العالم. المهم الالتفات إلى أهمية الجمهور في الداخل كشرط ومطلب ضروري لتطور صناعة الأفلام وتحولها إلى صناعة سينما.
ذاتَ ليلٍ، كنت أجوب “غوغل” باحثًا عن موادٍ للقراءة عن راهن السينما البريطانية والفرنسية. عثرث على تقرير أعدَّته لجنة من ثمانية من الخبراء البريطانيين في صناعة السينما، تاسعهم رئيس اللجنة وزير الثقافة والإعلام والرياضة في حكومة توني بلير.
يتضمن التقرير نتائج مراجعة اللجنة لسياسة الحكومة الخاصة بالسينما في 24 مايو 2011م. عَبَرْتُ التقرير مسرعًا لأنه طويل جدًّا (111 صفحة)، لكن وقفت لدقائق على عنوانه؛ إذ إنه يعبّر عمّا كنت أفكر فيه، وما أنا مقتنع به بخصوص صناعة الأفلام المحلية، “مستقبل الفلم البريطاني يبدأ بالجمهور”. حفظت التقرير، وتذكرته وأنا أفكر فيما أختم به هذه المقالة.




اترك تعليقاً