 يقول التفسير الشائع للاقتباس إنه العودة إلى قول أو فكرة ظهرت في وقت سابق عند شخص آخر، وذلك لهدف معيَّن، كأن يكون السعي في التأكيد على وجود من يشارك المقتبِس رأيه، أو تبيان خطأ ارتكبه هذا الآخر، أو غير ذلك.. ولكن فعل الاقتباس هو في جوهره أعمق من ذلك، وقد يتخذ أشكالاً غير كتابية. وما هو أهم من ذلك، تفلّته في عصرنا هذا من كل الضوابط والمقاييس التي كانت تحيط به، عندما كان شأناً من شؤون المفكرين والكتّاب بشكل شبه حصري.
يقول التفسير الشائع للاقتباس إنه العودة إلى قول أو فكرة ظهرت في وقت سابق عند شخص آخر، وذلك لهدف معيَّن، كأن يكون السعي في التأكيد على وجود من يشارك المقتبِس رأيه، أو تبيان خطأ ارتكبه هذا الآخر، أو غير ذلك.. ولكن فعل الاقتباس هو في جوهره أعمق من ذلك، وقد يتخذ أشكالاً غير كتابية. وما هو أهم من ذلك، تفلّته في عصرنا هذا من كل الضوابط والمقاييس التي كانت تحيط به، عندما كان شأناً من شؤون المفكرين والكتّاب بشكل شبه حصري.
قَدَر الكلمات أن تسافر في ترحال لا ينتهي. فهي الوسيلة تارة لمعنى منتقل، وهي الغاية تارة أخرى التي لا بدّ أن تصل. لذا، كان من المستحيل أن تظل الكلمات لصيقة بقائلها الأول وحبيسة وجوده. فقد قيلت لكي تغادره، لكي تطوف في الآفاق ما كُتب لها أن تطوف. وهي في تطوافها هذا تتحوَّل، تتبدَّل، تأخذ أشكالاً جديدة ولا تظل على حال واحدة أبداً. ومن أشكال ارتحال الكلمات اقتباسُ مقاطع نصية أو جمل أو عبارات قيلت في وقت ومكان سابقين للوقت والمكان اللذين استُخدمت فيه.
 الاقتباس بهذا التصوّر هو ممارسة شائعة نعمد إليها لأسباب شتى. أهمها أنه يستخدم لدعم كلام المقتبس بكلام قيل سابقاً، أو أنه يشكِّل مدخلاً للتحاور معه والتفاعل مع وجهة النظر التي يحملها. وفي المجال الأكاديمي مثلاً، ما يزال الحرص على التوثيق، بردّ النص المقتبس إلى منتجه الأول، قائماً على أشدّه في سبيل حفظ الحقوق. ومن أجل هذا الغرض وُضعت طرق وأساليب متعدِّدة لتقنين الاقتباس والحفاظ على سلامة البحث الأكاديمي، مما يُعد سرقة علمية. إلا أن الاقتباس هو أحياناً مجرد محاولة لأن نوهم أنفسنا أن الكلمات لم تتغيَّر منذ أن قيلت أو كُتبت، أو محاولة لإضفاء نوع من الصدقية بردّ القول إلى قائله.
الاقتباس بهذا التصوّر هو ممارسة شائعة نعمد إليها لأسباب شتى. أهمها أنه يستخدم لدعم كلام المقتبس بكلام قيل سابقاً، أو أنه يشكِّل مدخلاً للتحاور معه والتفاعل مع وجهة النظر التي يحملها. وفي المجال الأكاديمي مثلاً، ما يزال الحرص على التوثيق، بردّ النص المقتبس إلى منتجه الأول، قائماً على أشدّه في سبيل حفظ الحقوق. ومن أجل هذا الغرض وُضعت طرق وأساليب متعدِّدة لتقنين الاقتباس والحفاظ على سلامة البحث الأكاديمي، مما يُعد سرقة علمية. إلا أن الاقتباس هو أحياناً مجرد محاولة لأن نوهم أنفسنا أن الكلمات لم تتغيَّر منذ أن قيلت أو كُتبت، أو محاولة لإضفاء نوع من الصدقية بردّ القول إلى قائله.
 الاقتباس أكبر مما نتوهَّم
الاقتباس أكبر مما نتوهَّم
تنبّه الكتّاب منذ وقت مبكر إلى هذه الممارسة، واتخذوا منها مواقف مختلفة ومتضادة في بعض الأحيان. ففي حين دعا إليها بعضهم ذمها بعضٌ آخر، ووقف البعض الآخر منها موقفاً محايداً، يدعو إلى الاقتباس مع الملاءمة والتكييف، عوضاً عن الاقتباس المفرط. فعلى سبيل المثال، يقول الكاتب الأمريكي رالف والدو إيمرسن إننا نميل إلى تقدير التقليد المتراكم عبر القراءة والمحادثة أكثر من ميلنا إلى تقدير الإضافات الفردية، مما يجعلنا نتحدَّث باطمئنان عن أنه لا أصالة محضة، فكل العقول تقتبس. ويضيف الكاتب نفسه: “بحكم الضرورة، بحكم الميل، بحكم المتعة، جميعنا نقتبس. لا نقتبس الكتب والأمثال فحسب، وإنما الفنون والعلوم والتقاليد.” ووفق هذا التصور لا تكون الأصول أصولاً، بل إن كل كتاب يطغى فوق الثاني، وكل فكرةٍ موثوقة تعود إلى سابقتها وهكذا.. وهذا يقدّم في نظر إيمرسن تفسيراً لنشوء الأساطير التي تنشأ من قصة يضيف إليها كل من يعيد كتابتها ما يعيد تشكيلها، فتتخلص من عيوبها وتكتسب أشكالاً جديدة، حتى تكتسب حقيقة مثالية لا تقبل الجدل.
 يقول إيمرسن إن كثيراً من الأمثال التاريخية هي ذات مصادر مشبوهة سابقة، ويقدِّم لدعم صحة هذا الرأي أمثلةً من الشعر. كما أن وجود الخرافات والأساطير في كل اللغات مستعار من بعضها بعضاً، ويتفق على ذلك العقل البشري. ويَعُد الطبيعة عالم الحقيقة الذي أصبح الإنسان يشير إليه ويقتبس منه بدلاً من أن يعيشه. وبهذا يكون قد جعل من سكنه منفى. يحدث هذا عبر الكتب، حيث يقتبس الإنسان الأفكار، مما يعني أنه يتبرأ منها، وهنا “الاقتباس اعتراف بالدونية” حسب وصفه.
يقول إيمرسن إن كثيراً من الأمثال التاريخية هي ذات مصادر مشبوهة سابقة، ويقدِّم لدعم صحة هذا الرأي أمثلةً من الشعر. كما أن وجود الخرافات والأساطير في كل اللغات مستعار من بعضها بعضاً، ويتفق على ذلك العقل البشري. ويَعُد الطبيعة عالم الحقيقة الذي أصبح الإنسان يشير إليه ويقتبس منه بدلاً من أن يعيشه. وبهذا يكون قد جعل من سكنه منفى. يحدث هذا عبر الكتب، حيث يقتبس الإنسان الأفكار، مما يعني أنه يتبرأ منها، وهنا “الاقتباس اعتراف بالدونية” حسب وصفه.
الاقتباس بين مؤيد ومعارض ومحذِّر
 من جانب آخر، يقول كليفتون فاديمان في مقالته المعنونة “في مديح الاقتباس” المليئة بالاقتباسات والإحالات، إننا “في العموم نخالف الرجل الذي يقتبس كما نخالف الرجل الذي يتحدَّث إنجليزيةً مثالية، على أساس أنه “متفوق”. ويرى فاديمان أن زيَّ الرجلِ اقتباس، بل وربما كان الإنسان نفسه اقتباساً من اقتباس. “نفضّل الاعتقاد بأن غياب علامتي تنصيص يضمن أصالة الفكرة، بينما يمكن أن يعود الأمر إلى أن قائلها أو كاتبها نسي مصدرها. ويضيف: “نحن قلقون بشأن الاقتباس، ليس لأننا نظن أن الاقتباس قد يفشل في التأثير، بل لأننا نخشى أن يكون أثره سيئاً. يُعرف المرء بقرينه، وقلائل هم الذين يحتملون اتهامهم بمصادقة الشعراء والحكماء الموتى.” ثم أشار إلى أن أبرز الآراء المدافعة عن الاقتباس والمهاجمة له قالها رجل واحد، ويقصد إيمرسن الذي كتب مرة في مذكراته: “تخلص من الاقتباسات. قل لي ماذا تعرف؟”
من جانب آخر، يقول كليفتون فاديمان في مقالته المعنونة “في مديح الاقتباس” المليئة بالاقتباسات والإحالات، إننا “في العموم نخالف الرجل الذي يقتبس كما نخالف الرجل الذي يتحدَّث إنجليزيةً مثالية، على أساس أنه “متفوق”. ويرى فاديمان أن زيَّ الرجلِ اقتباس، بل وربما كان الإنسان نفسه اقتباساً من اقتباس. “نفضّل الاعتقاد بأن غياب علامتي تنصيص يضمن أصالة الفكرة، بينما يمكن أن يعود الأمر إلى أن قائلها أو كاتبها نسي مصدرها. ويضيف: “نحن قلقون بشأن الاقتباس، ليس لأننا نظن أن الاقتباس قد يفشل في التأثير، بل لأننا نخشى أن يكون أثره سيئاً. يُعرف المرء بقرينه، وقلائل هم الذين يحتملون اتهامهم بمصادقة الشعراء والحكماء الموتى.” ثم أشار إلى أن أبرز الآراء المدافعة عن الاقتباس والمهاجمة له قالها رجل واحد، ويقصد إيمرسن الذي كتب مرة في مذكراته: “تخلص من الاقتباسات. قل لي ماذا تعرف؟”
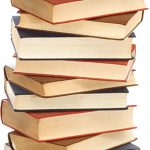
يفرّق فاديمان بين شكلين من أشكال الاقتباس. أولهما عام، حيث نقتبس طوال الوقت، مثل أن نغني مع التلفزيون، وأن يكون معظم حديثنا اقتباساً لحديث آخرين. هذا الشكل مقبول اجتماعياً، بل وإجباري أحياناً، مما يجعله شكلاً عابراً وتافهاً. أما الشكل الثاني فهو تقليدي أكثر، وهو الذي نعني به اقتباس كلام شخص آخر ضمن كلامنا. ودعا إلى تأثيث الكلام بقليل من الأثاث الفكري الزائد عن الحاجة، بحسب تعبيره، والمأخوذ من مخازن العظماء. ورأى أنه على الرغم من أن الاقتباس زُخرف، إلا أن للزخرف قيمته، فهو يُذهب رتابة النثر ويجعله مثيراً للاهتمام.
إلا أن الاقتباس هو أحياناً مجرد محاولة لأن نوهم أنفسنا أن الكلمات لم تتغير منذ أن قيلت أو كُتبت، أو محاولة لإضفاء نوع من الصدقية بردّ القول إلى قائله
أما فرانك مور كولبي فقد تناول في مقالة “الاقتباس والإحالة” استخداماتِ الاقتباس، وقال إنه يعطي الكلام صبغة أدبية، ويعزِّز ثقة القارئ بالنص، حيث تخذله كلمات الكاتب المقتبِس، ويُبدي الكاتبَ في حلة القارئ واسع الاطلاع، بحيث إن كل اقتباس يُعدّ بمنزلة “شهادة دبلوم” بأنه “تخرّج من ذلك الكتاب”. ويضيف أنه في البدء كان أساتذة الجامعات يعيدون كل شيء إلى القدماء لإظهار الإعجاب والإكبار بتعدد ألسنتهم. لكنه حذَّر من اعتبار الاقتباسات الثمرة التي يجنيها القرّاء من القراءة، وشبّهها بحفر بذور البطاطس، العقل الذي يُزرع في عقول أفضل المؤلفين، عليه أن ينتظر طويلاً حتى تنمو أفكاره. ويقول: “لا يعرف المرء عن أحدهم من مفاخر ذاكرته الأدبية أكثر من مفاخر قناته الهضمية إلا قليلاً.”
 الاقتباس وقنوات التواصل الجديدة
الاقتباس وقنوات التواصل الجديدة
لكن الاقتباس قد لا يكون دائماً إضافة تُضمَّن داخل المتن بحيث تخدم وظيفة محدَّدة. اليوم، وبفضل التدوير الهائل للنصوص، وتكاثر المواقع الإلكترونية المخصصة للاقتباسات حصرياً، لا يعني الاقتباس بالضرورة رفقة الحكماء والقرب من أفكارهم. بل على العكس، فقد ينبئ اجتزاء الجمل والعبارات من سياقها دون وضعها في سياق جديد عن انعدام الحساسية تجاه الأفكار التي تولد في سياقاتها، وقد لا تدل هذه الممارسة بالضرورة على معرفة ولا تنبئ عن حكمة. إن العبارات المقتبسة بإفراط تبدو أحياناً وكأنها تحفٌ صماء يرمى بها في الفراغ كل حين، دون أن تنال حظها من الاهتمام والتقدير.
إننا نميل إلى تقدير التقليد المتراكم عبر القراءة والمحادثة أكثر من ميلنا إلى تقدير الإضافات الفردية، مما يجعلنا نتحدَّث باطمئنان عن أنه لا أصالة محضة، فكل العقول تقتبس
هنالك ما يصف اقتباس عبارة أو أكثر باقتلاعها من سياقها الذي ولدت فيه، والذي من دونه قد تعني العكس. وهذه ممارسة تكون في الغالب مقصودة، وإن كانت تحدث عن غير عمد أحياناً. في المرات التي تكون فيها مقصودة، يكون غرض المقتبِس منها أن يظهر كاتب النص الأصلي في موقف ضعيف وربما متناقض، وفي المرات التي لا تكون فيها مقصودة، يكون المقتبِس قد أخطأ التقدير في ترك ما هو مهم أو ضروري واقتباس ما هو عكس ذلك. وهذا هو السبب الذي جعل هناك من عدّ هذه الممارسة فناًّ لأنها، بغض النظر عن شرعيتها، تنمّ عن براعة في قراءة النص المقتبَس وقدرة على تحريف المعنى الأصلي المقتبَس منه.
 الاقتباس أسهل من أي وقت مضى
الاقتباس أسهل من أي وقت مضى
مع القيود المساحية التي تقوم عليها وسائل التواصل الاجتماعي تغيَّر الاقتباس باعتباره ممارسة نصية، تقلَّصت فرص الاستفاضة في التعبير والاستطراد التي تتيحها أشكال الكتابة العادية، واختلفت الظروف التي كانت تحيط بممارسة الاقتباس التقليدي اختلافاً جذرياً. وقد ترك هذا التغير تأثيراً في الطريقة التي يقتبس بها مستخدمو اللغة إضافة إلى مغزى الاقتباس. فمثلاً، لم يعد هناك سياق تُقتلَع منه العبارات والجُمل والفقرات، بل أضحت العبارات والجُمل المقتبَسة هي السياق في حد ذاتها. لقد أصبحت تتمتع باستقلال فريد تحقق من خلاله وجودها وقابليتها للاستهلاك العريض.
“في العموم نخالف الرجل الذي يقتبس كما نخالف الرجل الذي يتحدَّث إنجليزيةً مثالية، على أساس أنه “متفوق”
في البدء أصبح كثير من مستخدمي هذه الوسائل يشعر بأنه مضطر إلى تبيان موقفه مما يقتبس. ولذا بحث عما يوفره التنصل من المسؤولية حيال ما يعيد الفرد تدويره من أقوال. والنتيجة أن أمست عبارة “إعادة التدوير (التغريد) لا تعني الموافقة” شعاراً يتمثله كثيرون. لكن مع الوقت، لم تعد هناك مناسبة مواتية لأن يقتبس الفرد. كذلك لم يعد  شرطاً أن تكون العبارة المقتبسة ذات قيمة خاصة تستلزم لفت الانتباه إليها باعتبارها وعاءً مملوءاً حكمة أو قولاً نابهاً أو أثراً فذاً استحق أن ينتقل من جسد نصّي إلى آخر. وأصبح الاقتباس المفرط شيئاً مقبولاً، وغدا القول المقتبَس كاليتيم الذي فقد أهله واغترب حتى لم يعد أحد يسأله عن أصله ومن أين جاء. ولذا لم يعد مهمّاً أن يتأكد المرء من حقيقة القول وقائله. والشيء نفسه ينطبق على الصوت والصورة والفديو. صار اقتباسها بسهولةِ اقتباس الكلمات وتدويرها مسألة ضغطة زر، مما جعل كل أشكال المحتوى الرقمي تسافر بسرعة هائلة. وهنا يحق للمرء التساؤل: هل تفقد الكلمات والصور في ترحالها السريع قيمتها؟ هل يعدم المرء وهو يقابل هذه الكلمات والصور المرتحلة فرصةَ التأمل والتدبّر الذي تسمح به فضيلة البطء؟.
شرطاً أن تكون العبارة المقتبسة ذات قيمة خاصة تستلزم لفت الانتباه إليها باعتبارها وعاءً مملوءاً حكمة أو قولاً نابهاً أو أثراً فذاً استحق أن ينتقل من جسد نصّي إلى آخر. وأصبح الاقتباس المفرط شيئاً مقبولاً، وغدا القول المقتبَس كاليتيم الذي فقد أهله واغترب حتى لم يعد أحد يسأله عن أصله ومن أين جاء. ولذا لم يعد مهمّاً أن يتأكد المرء من حقيقة القول وقائله. والشيء نفسه ينطبق على الصوت والصورة والفديو. صار اقتباسها بسهولةِ اقتباس الكلمات وتدويرها مسألة ضغطة زر، مما جعل كل أشكال المحتوى الرقمي تسافر بسرعة هائلة. وهنا يحق للمرء التساؤل: هل تفقد الكلمات والصور في ترحالها السريع قيمتها؟ هل يعدم المرء وهو يقابل هذه الكلمات والصور المرتحلة فرصةَ التأمل والتدبّر الذي تسمح به فضيلة البطء؟.