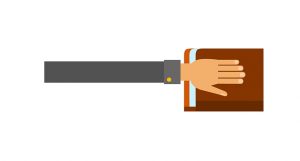 يُقال لنا إن الحقيقة نسبيّةٌ، وإنها تبعاً لذلك متغيّرةٌ، كما أنها ربما تحمل نوعاً من تجريد الوقائع وسلخها عن ظروف نشأتها الأولى والأساسية. على هذا الاعتبار السائد، غير المشكوك في صوابيته ورجحانه على غيره من الاعتبارات، حول قوة الحقيقة وظرفيتها المتبدلة وتغيّرها، سواءٌ في إطارها الاجتماعي أو الأدبي، وهو الاعتبار الذي يملك في ظاهره حجةً منطقيةً، لها ما يبررها عقلياً، كيف يمكنُ للروائي اختيارُ الحقيقة سنداً لكتابة الرواية، وهل هي كافية بحدّ ذاتها كي تشكِّل قيمة أدبية وإبداعية إضافية وجديدة؟
يُقال لنا إن الحقيقة نسبيّةٌ، وإنها تبعاً لذلك متغيّرةٌ، كما أنها ربما تحمل نوعاً من تجريد الوقائع وسلخها عن ظروف نشأتها الأولى والأساسية. على هذا الاعتبار السائد، غير المشكوك في صوابيته ورجحانه على غيره من الاعتبارات، حول قوة الحقيقة وظرفيتها المتبدلة وتغيّرها، سواءٌ في إطارها الاجتماعي أو الأدبي، وهو الاعتبار الذي يملك في ظاهره حجةً منطقيةً، لها ما يبررها عقلياً، كيف يمكنُ للروائي اختيارُ الحقيقة سنداً لكتابة الرواية، وهل هي كافية بحدّ ذاتها كي تشكِّل قيمة أدبية وإبداعية إضافية وجديدة؟
تحمل الحقيقة في جوهرها طابع الكشف عما هو مستور، إنها عمل ضد الكذب وضد ما هو مزيَّف، كما أنها تحيل ضمناً على ما يتفادى ويتجنب كل ما هو غير حقيقي. يقتضي الكشف هنا إزالة اللبس عن حادثة أو وقائع محدَّدة، وبذلك يحتاج الكشفُ لغةً وأسلوباً إلى التوضيح والشرح والتفسير. كما أن هذا الطابع الكشفي للكتابة الروائية المفترضة، يجعل من الروائي واحداً من الذين يقفون داخل فئة العارفين بالحقيقة، إزاء طرفٍ ثانٍ هو القارئ والمتلقي الذي يعد لذلك منضوياً داخل فئة الجاهلين بالحقيقة المروية، الذين ينبغي نقلها إليهم حتى يتجاوزوا الجهل إلى المعرفة.
على هذا الأساس تحمل الرواية المعتمدة على الحقيقة وحدها، رسالة مضمرة مفادها أن الروائي عارفٌ وأن القارئ جاهلٌ. ليس هذا وحسب ما يُخشى منه في هذا الصدد، بل إن العلاقة بين القارئ والروائي تحمل سمات العلاقة بين الأستاذ والتلميذ، فالأخير تابعٌ، فيما الأول متبوعٌ، وعلى أساس هذه العلاقة تُبنى سلطةٌ معرفيةٌ كامنةٌ، تكون فيها الغلبة للكاتب على حساب القارئ، فالأول منتج فيما الثاني مستهلك، كما أن للأول حصانة المقام الأدبي، فيما الثاني واحد من بين كثيرين، أي إنه ذاتٌ نكرةٌ أمام ذاتٍ معرفةٍ. من جهة ثانية تحمل لغة الرواية، التي تعتمد على الحقيقة وحدها، طابعاً تقريرياً توضيحياً، أي إنها تعتمد لغةً ذات مستوى تركيبي واحد لا تخرج عنه، إلا فيما ندر، عدا إخلاصها للزمن التتابعي الفيزيائي بما هو توالٍ منطقي لا يقيم حساباً للزمن النفسي الذي قد يعكّر من جريان مياه الحقيقة على صفحات الرواية، إذ إن الزمن النفسي الذي قد يكون عبارة عن تداعياتٍ وتشققات وفراغات، يجافي طابع الحقيقة ذات الكتلة النفسية الواحدة المتينة، التي لا تقبل التقطع والتمزق والمفارقة. كما أن الرواية على هذه الحال بالتأكيد تكون خارج الزمن الذي يتراكب وينقطع ويتداخل، كما هو الحال في الكتابة التي تعتمد على طابع حلميّ، حيث يمكن للحلم بما هو فسحة خيال مشرعة أبداً لكل ما هو خارج السيطرة والانضباط والمنطق، أن يبرز ويتشكَّل.
هكذا ترتبط الرواية ذات المرجعية المنطقية، أي اعتمادها على مبدأ الحقيقة هنا، بالسلطة والسطوة من جهةٍ، وبلغة لا تتجاوز ما هو مألوف من جهة ثانية، كما أنها تبني علاقة تبعيّةً مع القارئ يكون فيها الكاتب الروائي هو السيد والمسيطر، طالما أنه هو العارف بالحقيقة، وهو الذي يقوم بنقلها إلى القارئ الجاهل.
ما يجدر بنا التحذير منه في هذا المقام ليس الحقيقة بما هي جوهر متعالٍ ومبدأ أخلاقي وإنساني. إنما ما يتسرب تحت ثياب الحقيقة إلى لغة الرواية، فالأخيرة تخسر فرصة كتابة مختلفة، وإبداع لغة غير مستهلكة، ليست بالضرورة ضد الحقيقة. إنها تخسر ما هو مفاجئ وغريب لصالح ما هو شائع وأليف، فآلية المراقبة والدقة تتسرَّب إلى الأسلوب، وهذا ما يعيدنا إلى البداية التي تشكك في صواب نقل الحقيقة عبر الرواية.