 في إطار العلاقات الوثيقة ما بين مختلف العلوم الإنسانية، ثمّة علاقة خاصة ما بين الأدب والتاريخ. فقد قيل “إن التاريخ هو الرواية التي حصلت، والرواية هي التاريخ الذي كان يمكن أن يحصل..”. وفي دراسة التاريخ لا بدّ من استنطاق الأدب بمعناه الواسع الذي لا يقتصر على الرواية والشعر، بل يمتد إلى كل ما أنتجه الفكر في مرحلة معيَّنة، لفهم أوسع لما شهدته من حوادث وتحولات.
في إطار العلاقات الوثيقة ما بين مختلف العلوم الإنسانية، ثمّة علاقة خاصة ما بين الأدب والتاريخ. فقد قيل “إن التاريخ هو الرواية التي حصلت، والرواية هي التاريخ الذي كان يمكن أن يحصل..”. وفي دراسة التاريخ لا بدّ من استنطاق الأدب بمعناه الواسع الذي لا يقتصر على الرواية والشعر، بل يمتد إلى كل ما أنتجه الفكر في مرحلة معيَّنة، لفهم أوسع لما شهدته من حوادث وتحولات.
حسين الإسماعيل
قبل ثلاثة أعوام، حين كنت على مقاعد الدراسة في مرحلة البكالوريوس، تابعت مادة “تاريخ الولايات المتحدة” كجزء من المقرر الخاص بتخصصي. وعلى الرغم من أنها مادة التاريخ الثانية في المقرر، إلا أنني كنت ما أزال حينها أعيش الفكرة التقليدية عن التاريخ، بوصفه مجموعة من الأحداث التي وقعت في زمن غير الحاضر. لكنني فوجئت بأن هناك رواية ضمن الكتب المقررَّة: “الراغتايم” للروائي إدغار لورنس دوكتورو.
 بدا الأمر غريباً بالنسبة لي، فما علاقة الروايات بالتاريخ؟ وبمرور الأيام، تكشفت لي أهميتها شيئاً فشيئاً. ولذلك حين اعتزمت أخذ مزيد من المواد في التاريخ، لم يصبني العجب حين احتوت مناهج أغلبيتها على رواية أو اثنتين. وشكّلت تلك المواد بوابة جديدة لفهم التاريخ كعلم متعلِّق بتغير المجتمعات البشرية. ولأن المجتمعات البشرية بالغة التعقيد، فلا شك أن التغيير فيها (في أي جانب كان) سيكون معقداً هو الآخر. ونظراً لاهتمامي المتزايد بتاريخ الفكر البشري، فقد كان لذلك الاكتشاف وقعٌ عظيم.
بدا الأمر غريباً بالنسبة لي، فما علاقة الروايات بالتاريخ؟ وبمرور الأيام، تكشفت لي أهميتها شيئاً فشيئاً. ولذلك حين اعتزمت أخذ مزيد من المواد في التاريخ، لم يصبني العجب حين احتوت مناهج أغلبيتها على رواية أو اثنتين. وشكّلت تلك المواد بوابة جديدة لفهم التاريخ كعلم متعلِّق بتغير المجتمعات البشرية. ولأن المجتمعات البشرية بالغة التعقيد، فلا شك أن التغيير فيها (في أي جانب كان) سيكون معقداً هو الآخر. ونظراً لاهتمامي المتزايد بتاريخ الفكر البشري، فقد كان لذلك الاكتشاف وقعٌ عظيم.
 استشهادات إدوارد سعيد مثلاً
استشهادات إدوارد سعيد مثلاً
في كتابه” المثقف والسلطة”، وفي معرض حديثه عن الدور الاجتماعي للمفكر أو المثقف تحديداً، لا يجد إدوارد سعيد بداً من الاستشهاد ببعض الأعمال الأدبية التي تمكنت من تحديد ملامح ذلك الدور بنجاح على حد تعبيره. فيورد سعيد مثلاً رواية “الآباء والأبناء” لتورجينيف و”صورة الفنان في شبابه” لجويس لما تحتويان عليه من شخصيات تجسِّد رؤية كاتبيها حول الأمر. ففي رواية تورجينيف، تمثِّل شخصية بازاروف الإيمان المطلق بالعقل والعلم والانكسار مع القيم الأبوية، وهي من الهواجس التي كانت مهيمنة في بيئة توريجينيف في أواخر القرن التاسع عشر. ولا تختلف كثيراً عن ذلك شخصية ستيفن في رواية جويس. فالرواية تتبع سيرة هذا الشاب الذي ينشأ في بيئة مليئة بالاضطرابات على جميع الصعد، وترصد تحولاته الفكرية واختلاجاته النفسية في رحلته التي تنتهي بمغادرة البلاد كي يصبح فناناً.
 ولا يخلو كتاب إدوارد سعيد “الاستشراق” من إشارات مشابهة لرواياتٍ مثل “الرجل الذي سيصبح ملكاً” للإنجليزي كبلنغ، أو أدباء مثل فلوبير وفورستر. ويكمن الفارق الجوهري في أنه لا يستشهد هذه المرة بالنص ذاته بقدر ما يتجاوزه ليكشف النفس الاستشراقيّ الكامن فيها بطريقة أو بأخرى. ويمكن أن تُعزى هذه الاستشهادات لكون إدوارد سعيد متخصصاً في الأدب الإنجليزي وحسب، أي إن ضلوعه في هذا المجال جعله يستحضر ما اعتاد عليه من النصوص والكتّاب الذين يكملون وجهة نظره. ولكن، برأيي، ما فعله إدوارد سعيد يتجاوز ذلك بكثير. فاستشهاده بتلك الأعمال عملية واعية من استنطاق الأدب، ومرحلة أساسية في أي قراءة تاريخية.
ولا يخلو كتاب إدوارد سعيد “الاستشراق” من إشارات مشابهة لرواياتٍ مثل “الرجل الذي سيصبح ملكاً” للإنجليزي كبلنغ، أو أدباء مثل فلوبير وفورستر. ويكمن الفارق الجوهري في أنه لا يستشهد هذه المرة بالنص ذاته بقدر ما يتجاوزه ليكشف النفس الاستشراقيّ الكامن فيها بطريقة أو بأخرى. ويمكن أن تُعزى هذه الاستشهادات لكون إدوارد سعيد متخصصاً في الأدب الإنجليزي وحسب، أي إن ضلوعه في هذا المجال جعله يستحضر ما اعتاد عليه من النصوص والكتّاب الذين يكملون وجهة نظره. ولكن، برأيي، ما فعله إدوارد سعيد يتجاوز ذلك بكثير. فاستشهاده بتلك الأعمال عملية واعية من استنطاق الأدب، ومرحلة أساسية في أي قراءة تاريخية.
 تشكِّل القراءة التاريخية خطوة البداية لفهم أي منظومة فكرية ولفهم أي تعاقبٍ زمني للأفكار. لا أعني بالقراءة التاريخية القدرة على استذكار نقاط الانعطاف الفكري ووضعها ضمن خط زمني وحسب، فهذا لا يعدو كونه عملاً موسوعياًّ. هناك فارقٌ بين الفكر وتاريخ الفكر، كما أن هناك فارقاً بين الفلسفة وتاريخ الفلسفة. عملية التأريخ مرتبطة بالتغير، أي إن تأريخ الأفكار مرهونٌ برصد تغيرها. أما الفكر نفسه فهو أكثر تعقيداً، ويتطلَّب معرفة عميقة بالإنسان وما يحيط به. وما القراءة التاريخية إلا مقاربة لهذه المعرفة؛ والقدرة على قراءة الأفكار في سياقيها الزمني والمكاني. بعبارةٍ أخرى، القراءة التاريخية هي الإلمام بالظروف التي أنتجت فكراً ما من أجل الأخذ بملكة ذلك الفكر والقدرة على البناء عليه أو تفكيكه أو تقويضه بشكلٍ حقيقي. إذاً، الغاية من القراءة التاريخية هي جعل الفرد محيطاً بالفكر كما لو كان يعيشه في زمنه.
تشكِّل القراءة التاريخية خطوة البداية لفهم أي منظومة فكرية ولفهم أي تعاقبٍ زمني للأفكار. لا أعني بالقراءة التاريخية القدرة على استذكار نقاط الانعطاف الفكري ووضعها ضمن خط زمني وحسب، فهذا لا يعدو كونه عملاً موسوعياًّ. هناك فارقٌ بين الفكر وتاريخ الفكر، كما أن هناك فارقاً بين الفلسفة وتاريخ الفلسفة. عملية التأريخ مرتبطة بالتغير، أي إن تأريخ الأفكار مرهونٌ برصد تغيرها. أما الفكر نفسه فهو أكثر تعقيداً، ويتطلَّب معرفة عميقة بالإنسان وما يحيط به. وما القراءة التاريخية إلا مقاربة لهذه المعرفة؛ والقدرة على قراءة الأفكار في سياقيها الزمني والمكاني. بعبارةٍ أخرى، القراءة التاريخية هي الإلمام بالظروف التي أنتجت فكراً ما من أجل الأخذ بملكة ذلك الفكر والقدرة على البناء عليه أو تفكيكه أو تقويضه بشكلٍ حقيقي. إذاً، الغاية من القراءة التاريخية هي جعل الفرد محيطاً بالفكر كما لو كان يعيشه في زمنه.
السؤال الذي يمكن طرحه هنا: كيف يمكن لمن يعيش في القرن الواحد والعشرين أن يعيش ظروف عصر النهضة في القرنين الرابع والخامس عشر مثلاً؟ ومع الهوة التي تسببت فيها الثورات العلمية، لأي حدٍّ يمكن الارتباط بتلك الأفكار؟
 استنطاق النص لإدراك روح العصر
استنطاق النص لإدراك روح العصر
نزعم أن بإمكان الأدب أن يعين على إدراك ما يُعرف بروح العصر وقتما يتم استنطاقه كما يجب. ويكمن الإشكال في تكوين أسس هذا الاستنطاق. فمن الضروري التنويه بأن مفردة الأدب تشمل هنا كل النصوص التي تتناول قضية إنسانية، ولا تقتصر على الرواية أو الشعر مثلاً.
وبما أن النص الأدبي في حدّ ذاته وثيقةٌ تاريخية، فمن البديهي أن تكون عملية استنطاقه مرتبطة بالمنهج التاريخي، ومن المنطقي البدء بتحديد موقعها من هذا المنهج. حسبما أشارت إليه المؤرخة ماري لن رامبولا، فإن المصادر التاريخية هي من نوعين رئيسين: مصادر أولية، وهي كل نتاجٍ حسّي من العصر المراد التأريخ له؛ ومصادر ثانوية، وهي كل تأريخ مبني على المصادر الأولى. و أسلفنا قبل قليل، فإن الغاية من استنطاق النص هي إدراك روح العصر، أي الإحاطة بمنتجات العصر الفكرية. وبناءً على ذلك، فإن النص الأدبي في هذه الحالة يُعامل كمصدرٍ تاريخي أولي. بعبارةٍ أخرى، لا تكمن أهمية المصدر في النص نفسه وحسب، بل تتجاوزه لتشمل ما بين السطور، كالأفق المعرفي للنص، وطبيعة المفردات المستخدمة، والخلفية الاجتماعية التي نشأ فيها الكاتب وغيرها. وبحكم ذكر عصر النهضة الأوروبية في السؤال الافتراضي، فيمكن أخذ كتاب الأمير لنيقولا ماكيافيللي كمثال.
استشهاد إدوارد سعيد بالأعمال الأدبية عملية واعية من استنطاق الأدب، ومرحلة أساسية في أي قراءة تاريخية
كثيراً ما يُقال إن ماكيافيللي أحد رواد تجريد السياسة من الأخلاق، بل بلغ الحد بالبعض أن أطلق عليه “ظل الشيطان في الأرض” عطفاً على كتابه. وبغض النظر عن الأحكام الشخصية حوله، لا أظن أن من الإنصاف إغفال الوقائع المتلازمة مع نشر الكتاب. كتب ماكيافيللي “الأمير” بينما كان منفياً على يد عائلة الميديتشي التي عادت للحكم في فلورنسا. وحاول ماكيافيللي عبر “الأمير” أن يثبت جدارته وأن يحظى بمنصبٍ في الحكومة  الجديدة، وهو ما أفصح عنه في رسالة لصديقه فرانشيسكو فيتوري (الكتاب نفسه مهدى للورينزو دي ميديتشي). بالإضافة لذلك، لم يكن ماكيافيللي يحاول الإجابة عن سؤال ما يُفترض أن يكون بشكلٍ مثاليّ، بل اتخذ فلسفةً أقرب إلى المدرسة الواقعية إن صح التعبير. فشخصية الأمير نفسها مبنية على سيزار دي بورجيا، ابن ألكسندر السادس الذي انتُخب عام 1492م وحاول، بالتعاون مع ابنه سيزار، تأسيس إمبراطورية في إيطاليا الوسطى. بعبارة أخرى، ما قام به ماكيافيللي هو تحليل ذلك الواقع الذي عاصره. الشاهد من ذكر كل ذلك أن الزمن الذي كُتب فيه “الأمير” مليء بالمحن السياسية، وقد حاول ماكيافيللي إثبات قدرته على قراءة ذلك الواقع والتنظير له، ومن المستحيل فهم “الأمير” دون الإحاطة بظروفه.
الجديدة، وهو ما أفصح عنه في رسالة لصديقه فرانشيسكو فيتوري (الكتاب نفسه مهدى للورينزو دي ميديتشي). بالإضافة لذلك، لم يكن ماكيافيللي يحاول الإجابة عن سؤال ما يُفترض أن يكون بشكلٍ مثاليّ، بل اتخذ فلسفةً أقرب إلى المدرسة الواقعية إن صح التعبير. فشخصية الأمير نفسها مبنية على سيزار دي بورجيا، ابن ألكسندر السادس الذي انتُخب عام 1492م وحاول، بالتعاون مع ابنه سيزار، تأسيس إمبراطورية في إيطاليا الوسطى. بعبارة أخرى، ما قام به ماكيافيللي هو تحليل ذلك الواقع الذي عاصره. الشاهد من ذكر كل ذلك أن الزمن الذي كُتب فيه “الأمير” مليء بالمحن السياسية، وقد حاول ماكيافيللي إثبات قدرته على قراءة ذلك الواقع والتنظير له، ومن المستحيل فهم “الأمير” دون الإحاطة بظروفه.
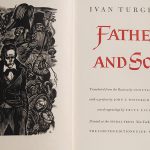 من الجلي إذاً أن معاملة النص الأدبي كمصدرٍ تاريخي تتجاوز النص نفسه إلى ما هو أكثر من ذلك. ومن الجلي كذلك أن كتب التأريخ السردية التقليدية وحدها لا تعطي صورة كافية للحياة الفكرية في أي عصر. فلن تُجدي قراءة تاريخ “حضارة النهضة في إيطاليا” لجاكوب بوركهاردت دون مقارنته بأدب النهضة، مثل “الديكاميرون” لبوكاشيو، وكوميديا دانتي الإلهية، ورسائل بيترارك وماكيافيللي، و”بيان عن كرامة الإنسان” لميراندولا، وإخضاع جميع هذه الكتب لعملية استنطاق تاريخي. فمن أجل أن يُدرك الفرد أفكار النهضة، لابد أن يبني في ذهنه الإطار الفكري الذي يحتويها. وكلما ازداد الإطار الفكري تكاملاً ازداد عمق الأفكار المتداولة في فضائه.
من الجلي إذاً أن معاملة النص الأدبي كمصدرٍ تاريخي تتجاوز النص نفسه إلى ما هو أكثر من ذلك. ومن الجلي كذلك أن كتب التأريخ السردية التقليدية وحدها لا تعطي صورة كافية للحياة الفكرية في أي عصر. فلن تُجدي قراءة تاريخ “حضارة النهضة في إيطاليا” لجاكوب بوركهاردت دون مقارنته بأدب النهضة، مثل “الديكاميرون” لبوكاشيو، وكوميديا دانتي الإلهية، ورسائل بيترارك وماكيافيللي، و”بيان عن كرامة الإنسان” لميراندولا، وإخضاع جميع هذه الكتب لعملية استنطاق تاريخي. فمن أجل أن يُدرك الفرد أفكار النهضة، لابد أن يبني في ذهنه الإطار الفكري الذي يحتويها. وكلما ازداد الإطار الفكري تكاملاً ازداد عمق الأفكار المتداولة في فضائه.
بات من الضرورة اليوم استكشاف دور الأدب كحلقة وصل فكرية، كرابط بين واقعنا وواقع الماضين من البشر
فلو عدنا الآن لإدوارد سعيد، نجد أنه قام بعملية استنطاق مزدوجة. ففي كتابه “المثقف والسلطة”، يستشهد بدايدلوس وبازاروف، بحكم كونهما شخصيتين تمثِّلان القضية المطروحة، أي دور المثقف في عصرهما. أما في الاستشراق، فقد وُضعت استشهاداته في إطار تعريفه الثالث للاستشراق، أي كونه أسلوباً غربياً للهيمنة وإخضاع المشرق. فكشك هانم عند فلوبير تمثل ذلك الشرق “الإكزوتيكي”، وهذا الشرق مقارب للمشهد  الافتتاحي في الفلم المبني على رواية “الرجل الذي سيصبح ملكاً”. فإحدى الأفكار المحورية في كتاب الاستشراق هي أن الصورة المخيالية عن الشرق عند المستشرقين لا تتطابق والواقع، أي إنها هي الأخرى نتاج غربي بحد ذاتها. استنطاق إدوارد سعيد للنصوص الأدبية والتاريخيــة التي تناولت المشرق مكنته من إدراك هذه الظاهرة ووضعها في قالب تنظيري.
الافتتاحي في الفلم المبني على رواية “الرجل الذي سيصبح ملكاً”. فإحدى الأفكار المحورية في كتاب الاستشراق هي أن الصورة المخيالية عن الشرق عند المستشرقين لا تتطابق والواقع، أي إنها هي الأخرى نتاج غربي بحد ذاتها. استنطاق إدوارد سعيد للنصوص الأدبية والتاريخيــة التي تناولت المشرق مكنته من إدراك هذه الظاهرة ووضعها في قالب تنظيري.
لطالما لعب الأدب دوراً محورياً في إخراج الفرد من قوقعته وجعله يرى العالم بمنظور إنسان آخر. فالأدب، بحسب تعبير ماريو فارغاس يوسا، هو ما يربط بيننا وبين سيرفانتس وشكسبير ودانتي وتولستوي، أي إنه يجعلنا نستشعر إنسانيتنا. وبات من الضرورة اليوم استكشاف دور الأدب كحلقة وصل فكرية، كرابط بين واقعنا وواقع الماضين من البشر. وبما أنه لا بديل عن القراءة التاريخية لفهم أي منظومة فكرية، فمن البديهي أن يكون الأدب أيضاً أحد دعائم بناء أي فكر حقيقي.