
منذ انطلاق الألعاب الأولمبية الحديثة في عام 1896م، صارت الفعاليات الرياضية الكبرى من بين أبرز المناسبات التي تجمع العالم، وتُعدُّ فرصة فريدة للمدن المُضيفة لعرض صورتها على الساحة العالمية. وتوسعت هذه الفعاليات بشكل كبير على مر السنين بإضافة رياضات جديدة، وزيادة عدد الدول المشاركة والرياضيين، وهو ما بات يستلزم إنشاء بُنًى تحتية إضافية واحتلال مساحات حضرية أكبر. لكن خلف هذه المنشآت الرياضية الباهرة، تتكشف قصة أعمق تتعلق بالتخطيط الحضري وفنون العمارة وصناعة المكان. إذ إن الفعاليات الرياضية، حتى إن لم تصل في ضخامتها إلى مستوى الألعاب الأولمبية، تحفّز تحولات عمرانية كبيرة، وتُثير تساؤلات مهمة حول دورها في تطور المدن وعمرانها.
تشهد المملكة في إطار “رؤية السعودية 2030″، استثمارات ضخمة في مشاريع بنية تحتية رياضية غير مسبوقة، تجعلها تنافس على استضافة بطولات عالمية مثل: كأس العالم، والألعاب الآسيوية، ودوري المحترفين السعودي الذي أصبح حديث العالم باستقطابه للنجوم العالميين. ويبرز مشروع “المسار الرياضي” في الرياض بوصفه جزءًا من هذه الرؤية، وهو أكبر حديقة خطية في العالم بطول 135 كيلومترًا، تمتد عبر المدينة لربط وادي حنيفة في الغرب بوادي السلي في الشرق. ويشمل هذا المشروع “البرج الرياضي”، وهو أعلى برج رياضي في العالم بارتفاعه 130 مترًا. وفي مدينة الخُبر في شرق المملكة، يُبنى “ملعب أرامكو” ليستوعب 47,000 متفرج، وهو من تصميم مكتب “بابيولس”Populous العالمي الذي استلهم حركة الأمواج ليعكس موقع المدينة الساحلي على الخليج العربي، وهو ما يجعله معلمًا بارزًا عالميًا.
لكن، إلى أي حد يُمكن لهذه الصروح الرياضية، بما تتميز به من ضخامة ونبوغ في التصميم، أن تدفع حدود العمارة وتطوير النسيج الحضري للمدن؟
جدوى الاستثمار في الرياضة
عالميًا، تتباين الآراء بشكل واضح حول جدوى استثمار المدن والدول في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل الألعاب الأولمبية. إذ يرى البعض أن هذه الفعاليات تُمثِّل عبئًا ماليًا، حيث تتكبد المدن المُضيفة تكاليف باهظة مع مخاطر اقتصادية قد لا تعود بفائدة تُذكر. وفي المقابل، يعتقد آخرون أن هذه الفعاليات تُعدُّ فرصًا ذهبية لتحسين البنية التحتية، وإنشاء مساكن جديدة، وجذب الاستثمارات والأعمال إلى مناطق غالبًا ما تكون غير متطورة.
وبمرور الوقت، باتت استضافة الفعاليات العالمية تحديًا ضخمًا لا تستطيع مواجهته سوى قلة من المدن. فعلى سبيل المثال، في عام 2004م، تنافست 11 مدينة على استضافة الألعاب الأولمبية، ولكن بحلول عام 2020م، تراجعت المدن المترشِّحة إلى خمس مدن فقط. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الحماس لاستضافة هذه الفعاليات بسبب ارتفاع تكاليفها، وهو ما يُثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات.
على الرغم من تلك المخاوف الاقتصادية، تظل استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى فرصة لا ينبغي تفويتها؛ إذ تتيح للمدن المُضيفة عرض ثقافاتها وإنجازاتها على الساحة العالمية. فعندما تستضيف مدينة ما حدثًا رياضيًا عالميًا، تتجه أنظار العالم إليها، وتتحوَّل إلى مركز حيوي يعج بالنشاط السياحي والإعلامي والرياضي، وهو ما يعزِّز التفاعل الثقافي ويمنح الدولة المُضيفة منصة فريدة لتقديم نفسها للعالم.
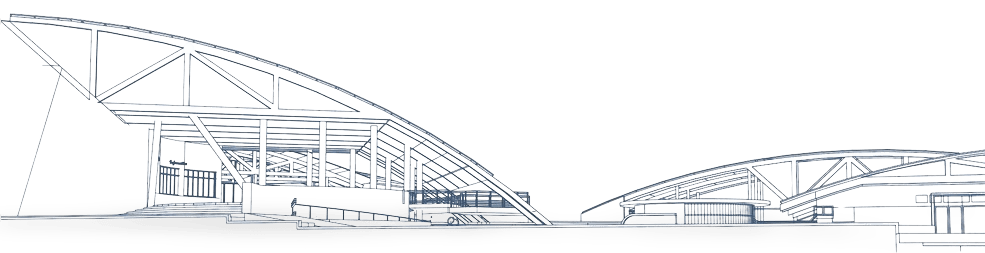
ومع ذلك، تظلُّ القرارات التخطيطية المرتبطة بعمارة الصروح الرياضية العامل الحاسم في تحديد تأثيرها الطويل الأمد على المدينة واقتصادها ومشهدها الحضري. فالمدينة المُستضيفة، إمَّا أن تستثمر هذه الفرصة لتحقيق تطوُّر عمراني مُستدام، أو تجد نفسها مُحاطة بهياكل ضخمة ذات استخدام محدود بعد انتهاء الحدث. لذا، فإن المرونة والقدرة على التكيُّف في التخطيط تُعدَّان ضروريتين لضمان تحوُّل هذه المباني إلى إرث إيجابي يدوم سنوات طويلة. إذ إن الفعاليات الرياضية الكبرى غالبًا ما تأتي مع تحديات مُعقَّدة، تختلف نتائجها بشكل كبير من مدينة إلى أخرى بناءً على كيفية التخطيط والتنفيذ.
فيل أبيض في المدينة!
أحد أكبر التحديات التي تواجه المدن المُضيفة للألعاب الأولمبية هي مشكلة ما يُسمَّى بـ”الفيلة البيضاء”، وهي المنشآت الرياضية الضخمة التي تُترك مهجورة بعد انتهاء الحدث. ففي أثينا 2004م وبكين 2008م، بُنيت منشآت ضخمة تُركت من دون استخدام بسبب تكاليف الصيانة الباهظة.
كما تُظهر تجربة مونتريال عام 1976م، جوانب سلبية أخرى من استضافة الألعاب الأولمبية. فبسبب التصاميم المُعقدة وسوء الإدارة، عانت المدينة ديونًا ضخمة من جرَّاء بناء إستاد “بيغ أو” (Big O)، الذي أصبح رمزًا للفشل المالي؛ إذ تأخرت عمليات البناء وازدادت التكاليف إلى حدٍّ بعيد، وهو ما أدى إلى إرث مالي سلبي يُثقل كاهل المدينة حتى اليوم. وتُشير تجربة ريو دي جانيرو في دورة الألعاب الأولمبية إلى فشل مشابه. فعلى الرغم من الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية مثل خطوط المترو الجديدة وترميم الميناء، فإن الأثر الإيجابي لم يكن طويل الأمد كما كان متوقعًا.
إرث يبقى وحلول مبتكرة
أحد أبرز النماذج المبتكرة في إرث العمارة الرياضية هو فكرة القرى الأولمبية التي تتحوَّل لاحقًا إلى وحدات سكنية. وكانت بدايتها في دورة هلسنكي 1952م، وتبنَّتها جميع الدورات الأولمبية لاحقًا. وتهدف هذه القرى إلى توفير مساكن للرياضيين خلال الألعاب، لتتحوَّل بعد ذلك إلى أحياء سكنية متكاملة. ويعتمد نجاح هذا النموذج على التخطيط المسبق والقدرة على دمج هذه الأحياء بشكل فعَّال في النسيج الحضري للمدينة.
“ينبغي أن تكون الصروح الرياضية أكثر من مجرَّد “فيلة بيضاء” تضيق بها المدن دون فائدة كبيرة بعد انتهاء لحظة الحدث الرياضي!”
وتُعدُّ دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة 1992م، نموذجًا يُحتذى به في كيفية استغلال الفعاليات الرياضية الكبرى لتحفيز تجديد حضري شامل. إذ أعادت المدينة استخدام النسيج التاريخي وتطوير الشاطئ، وهو ما أسهم في تحويله إلى عنصر اقتصادي مهم. كما أن إنشاء الطرق الدائرية أدَّى إلى تقليل الازدحام في وسط المدينة. وكان من القرارات المحورية توزيع المنشآت الأولمبية عبر منطقة كتالونيا بدلًا من تركيزها في منطقة واحدة مركزية، وهذا ما أتاح مستقبلًا مستدامًا لهذه المنشآت.
كما استلهمت لندن في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012م من تجربة برشلونة، وركَّزت على تحويل منطقة ستراتفورد غير المتطورة إلى حي نابض بالحياة. وتضمَّنت الخطة بناء قرية أولمبية تحتوي على مرافق تسوق وحدائق وبنية تحتية للنقل. وصُمِّم الملعب الأولمبي ليكون مرنًا، بحيث يمكن تقليص حجمه بعد الألعاب لاستخدامات مستقبلية، وهو ما ساعد على تفادي مشكلة “الفيلة البيضاء” التي عانت منها مدن أخرى.
وقدَّمت بكين نهجًا جديدًا في التخطيط والتصميم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022م. فبدلًا من التركيز فقط على بناء منشآت رياضية تقليدية، استخدم معهد التصميم بجامعة تسينغخوا أساليب مبتكرة تشمل التخطيط الشامل للمساحات، والدمج بين الوظائف المتعددة، وضمان استدامة البنية التحتية على المدى الطويل. ونُظّمت المواقع والمنشآت لتعمل معًا بشكل متناغم، وهو ما يعزِّز الكفاءة ويُقلِّل من الأثر البيئي.
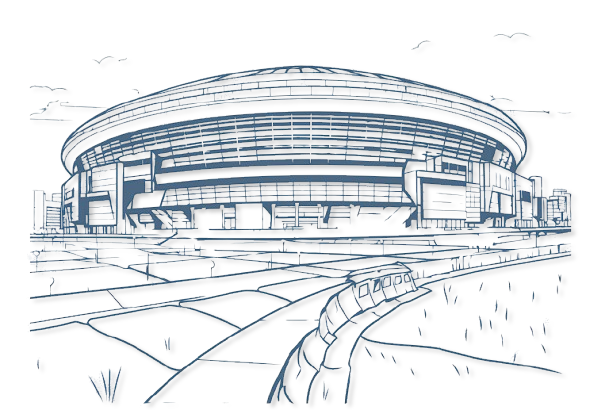
وجسَّدت سوق “واقف” في الدوحة في كأس العالم 2022م مثالًا مميزًا على كيفية دمج الهوية الثقافية المحلية في تجربة جماهيرية عالمية. فوسط أجواء احتفالية غامرة، أصبحت السوق محورًا لاحتفالات الجماهير التي جاءت من مختلف أنحاء العالم. وعلى الرغم من وجود مناطق حديثة جُهِّزت لاستقبال الزوار، مثل: كتارا واللؤلؤة والوسيل، فإن سوق “واقف” تفوَّقت عليها بجاذبيتها الأصيلة، وهو ما يعكس القوة الكامنة في المواقع المرتبطة بالهوية والتاريخ المحلي. ولم تقتصر جاذبية سوق “واقف” على عناصرها الثقافية، بل امتدت إلى تصميمها العمراني الذي يعزِّز التفاعل الاجتماعي من خلال توفير مساحات مخصصة للمشاة وسهولة الوصول عبر شبكة نقل عام فعالة، حيث منعت المدينة حركة المركبات الخاصة.
تحديات تطوير الصروح الرياضية في السعودية
بينما تتطلع المملكة إلى استضافة فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم والبطولة الآسيوية، تستمر خطاها الحثيثة نحو تطوير صروح رياضية تليق بهذه التطلعات. غير أن المسار ليس خاليًا من التحديات، فهناك مسائل تستوجب وقفة تأمل ومعالجة متأنية لضمان نجاح هذه المشاريع واستدامتها.
تُعدُّ الفجوة الحضرية من أبرز هذه التحدياتخلال تطوير الصروح الرياضية بتخصيص مساحات حضرية لإقامة المشاريع عليها، وتكليف هيئات مستقلة بتخطيطها وتنفيذها. فهذا الأسلوب قد يؤدي إلى عمران متقطع لا يتجاوز حدود قِطَع الأراضي المخصصة لهذه المشاريع، وعادةً ما يُسهم في تفاقم ظاهرة “التوسع الحضري”، حيث تصبح هذه المشاريع محاطة ببحر من البنية التحتية ومواقف السيارات، وهو ما يعزلها عن النسيج الحضري الشامل للمدينة. فما يجعل المدينة جيدة هو التكامل بين الاستخدامات المختلفة للأراضي والقدرة على المشي بينها.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الصروح الرياضية إلى دفع حدود التصميم المعماري، فإنها تواجه تحديًا آخر يتمثَّل في التعبير عن الهوية. إذ إن التباين بين الأكواد والمعايير المعمارية المعتمدة من مختلف الجهات، قد يُفضي إلى مشهد بصري ومعماري غير متجانس في المدن. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإبراز الهوية الوطنية والمحلية من خلال تصاميم مستوحاة من التراث السعودي، فإن غياب التنسيق الفعَّال قد يُهدِّد هذه الجهود في مشهد حضري متباين. ومع أن هذه المنشآت تهدف إلى الابتكار ودفع حدود المعمار، إلا أن التحديات المتعلقة بالتعبير عن الهوية قد تُسهم في خلق مدن ذات تصاميم غير متناسقة، تفقد القدرة على تقديم صورة معمارية موحدة تُجسِّد الهوية الوطنية.
“في لندن حوَّلت القرية الأولمبية منطقة ستراتفورد إلى حي نابض بالحياة. وفي ريو دي جانيرو لم يكن الأثر الإيجابي لدورة الألعاب الأولمبية كما كان متوقعًا على المدى البعيد“.
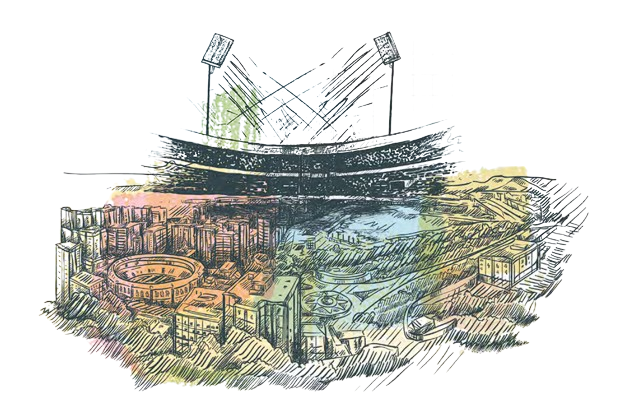
أكثر من مجرد هياكل!
ولكن عندما ننظر الى الجزء الممتلئ من الكوب، يمكننا أن نرى هذه الصروح بشكل مختلف، وأن نستفيد من التجارب الناجحة السابقة لتجاوز هذه الفجوات، حتى تكون الصروح أكثر من مجرد أماكن للفعاليات. فهي تُمثِّل فرصة لدفع حدود العمارة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال تصاميم مبتكرة، واحتضان الوظائف المتعددة، والتركيز على الاستدامة والتكامل الحضري، إضافة إلى تعزيز تجربة المشجعين. ويعكس هذا التحول أهمية هذه الصروح بوصفها معالم معمارية بارزة ومراكز مجتمعية مميزة.
وللمباني الأيقونية عدوى إيجابية قد تنتشر في أنحاء المدينة! فقد كان تأثير “متحف غوغنهايم” في بلباو، الذي صمَّمه فرانك جيري، ملحوظًا في إطلاق موجة من التجديد في المدينة بأسرها. مثال آخر، هو مركز “حيدر علييف” في باكو، الذي جعلت منه زها حديد أيقونة معمارية ألهمت تطورًا معماريًا جديدًا على نطاق واسع في المدينة.
وقد تُمثِّل الصروح الرياضية الجديدة في المملكة فرصة لدفع حدود العمارة في المدن السعودية. فهذه التحف المعمارية، التي تتنوع في أساليب التجريد واستخدام مواد البناء، وتستكشف عبقرية الثقافة المحلية بطرق معاصرة، يمكنها أن تؤدي إلى “تأثير كرة الثلج” على النمط المعماري والابتكار. ويمكن لهذه العدوى أن تكون أكثر تأثيرًا إذا ما استطاع المعماريون النجوم التقاط جوهر العمارة المحلية والتكامل مع البيئة المحيطة بشكل جيد، وهو ما قد يحفز حركة معمارية جديدة في المدن السعودية، تدفع بالعمارة إلى الابتكار والخروج عن المألوف في التصميم وأساليب البناء، ووسيلة لإعادة التفكير في هوية المدينة السعودية.
احتضان الوظائف المتعددة الأثر والإرث المستدام
لتحقيق أقصى استفادة من الصروح الرياضية، ينبغي أن تتجاوز هذه المنشآت دورها التقليدي بصفتها أماكن للفعاليات الرياضية فقط، وأن تتحوَّل إلى مراكز حضرية متعددة الاستخدامات تدعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
لتحقيق أقصى الفائدة، ينبغي أن تتحول الصروح الرياضية إلى مراكز حضرية متعددة الاستخدامات تدعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
فمن خلال دمج هذه الصروح في الأحياء المحيطة بها على نحو التجارب المذكورة في هذا المقال، يُمكن تحويلها إلى محاور حيوية تجذب السكان والزوَّار على مدار العام. ويُمكن أن يشمل ذلك إضافة مرافق مثل: مساحات العمل والمتاجر والمطاعم، وهو ما يعزِّز من دورها بوصفها محركات للتنمية الحضرية.
ولضمان استدامة هذه الصروح وجعلها نماذج عالمية في كفاءة استخدام الموارد، يمكن اعتماد تقنيات البناء المستدامة مثل: الأنظمة الذكية لإدارة الطاقة والمياه، واستخدام مواد محلية تقلل من البصمة الكربونية، تمامًا كما هو الحال في “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ. فهذا التكامل بين تعدد الوظائف والاستدامة يُتيح لهذه الصروح أن تكون مراكز للنشاط الرياضي ومحاور للتنمية الحضرية، وأن تكون بمنزلة الإرث المستدام للمدينة.
ويمكن أن تؤدي الصروح الرياضية دورًا كبيرًا في تعزيز التجربة الشاملة للمشجعين. فكما حقَّقت سوق “واقف” في الدوحة خلال كأس العالم 2022، بيئة تفاعلية تمزج بين الثقافة المحلية والاحتفالات الرياضية، يُمكن لربط الصروح الرياضية الجديدة في المملكة بالمناطق الثقافية والأسواق التاريخية أن يوفر مساحات تحفز التفاعل الاجتماعي والثقافي. ومن خلال توفير مناطق تجمُّع مفتوحة ومسارات مشاة وشبكة نقل عام تربط الصرح بالمناطق المحيطة، يُمكن خلق تجارب لا تُنسى تُسهم في تعزيز الانتماء المجتمعي وتسويق الهوية الثقافية السعودية.
يستشعر قادة وطننا والقيّمون على المشاريع الجاري تنفيذها أن الصروح الرياضية ليست مجرد هياكل ضخمة، أو أماكن لتجمع الجماهير أو ممارسة الرياضة، أو لتحقيق مكاسب قصيرة، بل هي نبض جديد في عروق المدن السعودية وأداة للتنمية وتحسين نمط الحياة. فالرياضة بطبيعتها تعني الحركة والديناميكية والتغيير، وهذه هي الروح التي تحتاج إليها مدننا لتتخطَّى حدودها التقليدية. فلا بدَّ لنا من أن ندرك أن قفزات اللاعبين وركضهم السريع في هذه الصروح الرياضية توازيها قفزة حضرية وعمرانية تُعيد تشكيل الصورة الذهنية عن المدن، من نمط حياة يعتمد على السيارة إلى مجتمع ينبض بالحياة والحركة.
