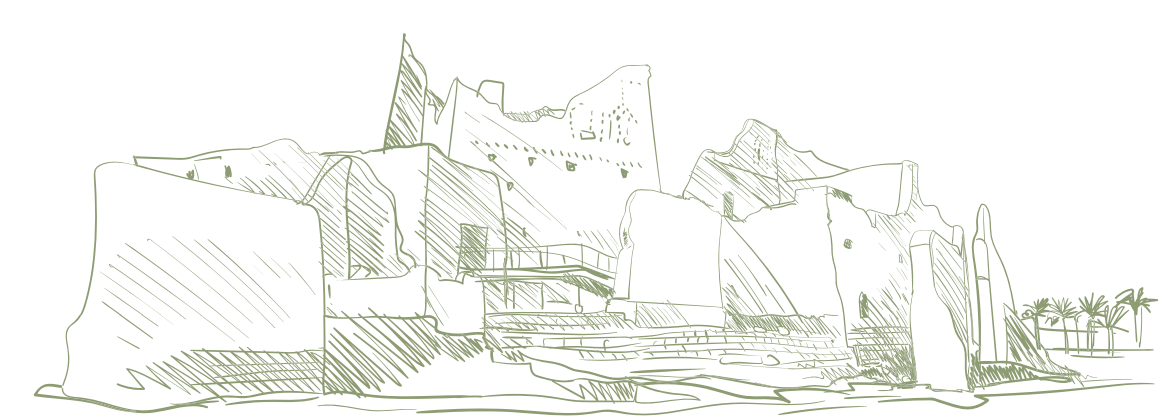
في ظل النمو السريع والتضخم الذي تشهده المدن الكبيرة، ومع تراجع مساحة التفاعل مع الطبيعة، تتضاءل أهمية القرية ويخفت تقديرها لدى كثير من الناس. لكن من جرَّب العيش في قرية، قد يجد نفسه مشدودًا إلى الحياة فيها، حتى لو جرفه تيار الزمن بعيدًا عنها لظروف التعليم أو العمل أو غيرها.
نستطلع هنا رأي بعض من خاض تجربة العيش في قرية عما تمثِّله الحياة في القرية لهم. ماذا تعني لك القرية؟ كيف تختلف الحياة فيها عن المدن؟ هل ما زال للعيش فيها مساحة؟ ما الذي تحتفظ به في ذاكرتك عنها؟

زيارتي للقرية.. منبع للسكينة
تبحر السفن بعيدًا ثم تعود إلى مرساها، مدفوعة بأمواج الحنين ورياح الشوق واللهفة، كذلك ابن القرية أو المدينة الصغيرة، فمهما ابتعد وجرفه تيار الزمن ومشاغل الحياة وزحام المدن الكبيرة، يحنُّ دائمًا للعودة لمجتمعه الذي ترعرع وسطه، ولبيوت القرية التي نشأ فيها، ولجاره وكافة أصدقاء الحي، ولتراب النخيل، وللسِّيف!
تشكّل القرية ابنها بما يشبه تضاريسها وطبيعتها، لينطلق إلى عالم أوسع مغاير، بهوية محلية متفردة، تحدّه ظروف الدراسة أو العمل للعيش في مدينة كبيرة لا تشبه قريته التي ألفها. فلا المكان هو المكان، ولا الزمان هو الزمان. فالتنقل داخل المدينة أصبح يستغرق وقتًا أطول، ونمط الحياة والجدول اليومي أصبح متسارعًا، والعلاقات الاجتماعية باتت تحكمها معادلات مغايرة. من هنا يبدأ صراع الاستقرار والاندماج مع هذه المتغيرات، الذي وإن نجح فيه فستبقى زياراته للقرية منبعًا للسكينة ومصدرًا للسعادة.
لن أتحامل على المدينة الكبيرة على حساب القرية، غير أنني سأدّعي أن جمال المدن الكبيرة قد يأتي من تعددية سكانها، حيث تجتمع شتى الهويات الفرعية قادمة من القرى وصغار المدن، لتجتمع تحت مظلة المدينة الكبيرة الجامعة لمختلف الأطياف.
حضن يسع الجميع

لا توجد بقعة جغرافية يمكن أن تستولي على وجدان صاحبها مثل ما تفعل القرية! القرية ليست مجرد ماء وهواء وتراب وكائنات حيّة كما تعلمنا الفلسفة الأولى، بل روح ومعنى يختبئان خلف كل تلك المكونات الطبيعية. من عاش سنواته الأولى في القرية (بحُبٍّ)، يُدرك كم هو معذَّب حينما يغادرها إلى غيرها من المدن الكبرى والعواصم العالمية.
في القرية يتحدث القروي مع المساء مثلما يفعل مع الصباح. ويغنّي القروي مع الطير ويتمايل مع الأغصان! في القرية تبدأ القصة مبكرًا جدًا قبل موعد الشمس التي تعيب على القروي بقاءه نائمًا إلى حين طلوعها! وفي المساء يصمت القروي بسكينة لتتحدث مخلوقات القرية الليلية. حينئذٍ يستمتع ذلك البسيط بخرير الماء في الجدول القريب، وصوت الرياح وهي تداعب نوافذ منزله بلطف، وكأنها تتلو على صاحبها قصة النوم!
في القرية، ذات زمن ليس بالقريب، كان كل الكبار آباءنا، وكل الكبيرات أمهاتنا. كانت مدرسة القرية تشبه كامبريدج وهارفارد، وأساتذتها في أعين الصبية نسخة أصلية من أرسطو وكانط ورينيه ديكارت في حزمهم وعزمهم! في القرية، ذات زمن، كان همّ الواحد هو همّ الجميع، وأمل القروي هو مقصد صلوات الجميع، وخسارة الفرد هي هزيمة للجميع!
لم تكن القرية بيوتًا صغيرة وأناسيَّ قليلين، بل حضنًا كبيرًا وقلوبًا كبيرة أحبَّت الجميع، واحتوت الجميع؛ فأضحت وطنًا للجميع!
هناك.. كل البيوت بيت واحد!

القرية ذاكرتنا وحنيننا والحب الأول..
القرية التي أحنُّ فيها “لخبز أمي” كما قال درويش. وكأن درويش يعقد مقارنة بين خبز القرية المعجون بالحب ومن صنع الجدات والأمهات، وخبز أفران المدينة المصنوع بالمُنكّهات.
القرية المسكونة بالذكريات وبتلك البيوت النابتة في عروق الجبال، التي تضرب موعدًا مع السحاب وملامسة الغيم، ومداعبة الضباب لجبالها. وأصوات رجالها في غنائهم اليومي، ودعائهم الباكر مع كل إشراقة شمس وصياح ديك “يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم”.
في القرية كل البيوت بيت واحد، يتشاركون الفرح والحزن.. فرحهم واحد، ومصابهم واحد.. يد واحدة في الخير، و “فزعة” وقت الزرع ووقت الحصاد ووقت البناء وحفر الآبار.
ولكل موسم ومطلع نجم أغنيته التي يرددونها ويحفزون بعضهم بعضًا، في طقوس تراثية خاصة بهم.. يغنون للأرض التي استجابت وجادت عليهم بخيرها.
في تلك المشاهد، المرأة حاضرة أيضًا، تشارك في الزراعة والحصاد والسقاية والقطاف، حتى في الألعاب الشعبية. وعند “نقع” الزير وضرب الدفوف يتشارك الجميع الفرح، في لعب يُسمَّى “الشبك”، تشبك المرأة يدها بيد الرجل في مشهد عائلي مبهج.
القرية “بوح السنابل” و “الغيوم” و “منابت الشجر” كما جاءت في عناوين الروائي عبدالعزيز مشري، رحمه الله، الذي كتب عن القرية وأحداثها وعن “صالحة” و “عطية” وأحاديثهم في العباد والبلاد.
القرية هي موقع الخلاص من ضجيج المدن وصخبها وتلوثها. إنها في هذه الأيام موطن استرخاء واستجمام، وهرب من مدن الإسمنت، أو كما وصفها الروائي عبده خال “مدنٌ تأكل العشب”.
الهدوء وبساطة العيش

العودة للذكريات وللمكان القديم، سواء أكان منزلًا أم حيًا أم قرية، والحنين إلى الماضي الذي عاش الإنسان فيه بداياته وقضى فيه سنوات عمره الأولى، هي طبيعة بشرية قد تتفاوت من شخص لآخر، ولكن يبقى الرابط هو ذكرى المكان الذي جمعه بعائلته وجماعته وجيرانه، وكان له التأثير في نشأته وتربيته وشخصيته.
كانت القرية أو المدينة الصغيرة في الماضي، الحضن والمحطة الأولى لبناء الشخص وإعداده للانطلاق والبحث عن فرص الحياة وتحقيق الأهداف، سواء لعمله أو لاستكمال دراسته؛ وذلك لندرة وجود المدارس أو الجامعات آنذاك.
قد يكون اختلاف الحياة ما بين القرية والمدينة عاملًا مهمًا لسعي البعض للانتقال للمدينة؛ إذ اعتاد الناس في القرية الهدوء وبساطة العيش، والمحافظة على التقاليد والعادات والموروث، وحبهم للتعايش في مجموعة، وأداء الواجبات العائلية والاجتماعية، بعكس المدن التي تتميز بالصخب والازدحام واهتمام أقل بالعادات والتعــايش مع فئات مختلفة من البشر، وهو ما قد يتسبَّب أحيانًا في انصهار الهوية واختلاف الشخصية والتأثر بثقافة الأسلوب العصري الحديث.
نجد كثيرًا ممن ابتعـدوا عن قراهم، وغادروها للعيش في المـدن بسبب تعدُّد الفرص فيها، سواء العلمية أو الوظيفية، تظلُّ القرية بالنسبة إليهم ملاذًا يلجؤون إليها بالرغم من اختلاف ظروف الحياة والمعيشة، وكلَّما طالت بهم الأيام عادوا إليها من وقت لآخر؛ لاستذكار الماضي والبحث عن الهدوء. وكلنا نرى عودة كثير من الناس إلى قراهم في فترة الإجازات أو المناسبات أو للاستقرار بعد نهاية الحياة الوظيفية.