للغة “حياتها”: فوق الألسنة، في الكتابات، في النطق والتدوين، في احتياجات تاريخية واجتماعية وغيرها. وهو ما يصح في العربية كذلك، خصوصًا أن بعض الناظرين إليها يفتكرون في أنها ثابتة، وخارج التغير والتحول. وفي هذا المقال نقف عند لفظ لامع في العربية: “الأدب”، وما أصابه في الاستعمالات والمعاني.
لا يتردد ابن منظور في تعريف المصدر “أدب” في أول المدخل المعجمي، بالقول: “الأدب: الذي يتأدب به الأديب من الناس”، ثم يتوسع في الشرح: “سُمِّيَ أدبًا لأنه يَأْدِبُ الناس إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح”. واللافت أن سرعته في التعريف تؤكد تأكده من صحة ما يفيد في زمنه. فلا يعود المعجمي إلى الجذر أو الفعل، ولا إلى استعمالات متوسعة في هذا الصدد. بل تبدو مادة هذا المدخل المعجمي محدودة، مقتضبة، لو قيست بغيرها من المداخل المعجمية، التي حوت، عند ابن منظور، كثيرًا مما بلغَه من سابقيه من المعجميين. ثم لا يلبث ابن منظور أن يتوسع في عرض التعريفات المناسبة: “الأدب: أدب النفس والدرس”، و”الأدب: الظُرف وحسن التناول”.
لو طلب المتابع إيجاد ما يفيد عن سابق هذا اللفظ، فسيجد ما يشير إلى “ترويض” الحيوان: “يقال للبعير إذا ريض وذُلل: أديب مؤدَّب”. ثم يخص ابن منظور بقية التعريف في المدخل للحديث عن: “المأدبة” في الطعام؛ ومن المعجميين واللغويين من جعلها متفرعة من الجذر نفسه، ومنهم من جعلها متعينة في لغتين.
المادة المعجمية مقتضبة جدًا، ولا يقوى المتابع بالعودة إليها على العرض والتخمين والاقتراح. إذ ما يرد في “لسان العرب” لا يعدو كونه يفيد عما “استقر” عليه معنى “الأدب”، وهو ما بلغ معنيين ليس إلا، وهو ما يجتمع في التعريف المذكور آنفًا: “الأدب: أدب النفس والدرس”.
إلا أن ما يستوقف في مادة المعجم المقتضبة، هو هذا التباين بين التحديد الدقيق لـ”الأدب”، وبين معانٍ مادية أو قَبَلية سابقة عليه بالتالي. وهذا يعني، أن ما بلغ اللفظ من ماضيه الجاهلي محدود على الأرجح؛ في حين يعني القسم الثاني، الإسلامي بطبيعة الحال، توسعًا وتدقيقًا ثقافيين أكيدين. هذا القسم الثاني يشير مؤكدًا إلى الاندفاعة الثقافية الحادثة بعد قيام ثقافة الكتاب الديني، واحتياجات التعليم والتعلم، والعلوم الواجبة لذلك. وهو ما يَظهر في التوليدات الاشتقاقية البينة: أديب، أدباء، تأدب، متأدب وغيرها.
بيْدَ أن نقلة إلى القرن التاسع عشر تُظهر، منذ “خطبة في آداب العرب” للمعلم بطرس البستاني (1859م)، أن معنى “الأدب”، بل “الآداب”، قد تغير؛ وهو ما يبدأ به “خطبته” الشهيرة: “الموضوع آداب العرب، وإذا شئتم فقولوا علوم العرب، أو فنون العرب، أو معارف العرب”. والبستاني احتاج – كما يبدو منذ مستهل الخطبة – إلى تأكيد التعريف؛ أي لزوم تمييزه عما هو معروف ومتداول.
في تعريف البستاني “توسعة” لما كان متعينًا في العربية الثقافية القديمة، حيث بات ما يتعلمه المتأدب لكي يصبح متأدبًا يشمل مجموعة من الإنتاجات الثقافية، ما يتعين في: علوم وفنون ومعارف، وغيرها. غير أن هذا التفسير ليس بالتاريخي، ما دام يعني – في واقع العمليات الثقافية الجارية في زمن البستاني – الانفتاح والأخذ بما كان قد تعين في مدارك أوروبية، باتت ثابتة وأكيدة (في حينها). النقلة أكيدة، ويزيد منها كون التعريف لدى البستاني يشير إلى ما بات متعينًا في إنتاجات ثقافية وحدها تحديدًا، من دون أي إشارة إلى “تأديب النفس” والسلوك والتصرف وغيرها. والنقلة هذه تعني كذلك أن ما كان يتعين في “الأدب” قديمًا كان يتعين واقعًا في “المتأدب”، وفي “الأديب”؛ أي في بناء عقله ونفسه، ما يعني الارتقاء به. بينما بات التعريف، مع البستاني، يشير إلى ما بات مستقلًا عن متحَصِّل الأدب، ليشمل الإنتاجات بنفسها، ومن دون غيرها.
الجمع، الذي بات يصيب “الأدب” مع البستاني، نتحقق منه بعد عقود قليلة منذ عنوان كتاب جرجي زيدان: “تاريخ آداب اللغة العربية”. ومن يطلب المزيد فيما ساقه زيدان، وبنى عليه مجموع كتابه – الرائد في تآليف العربية – يتحقق من أنه يحافظ على ما قاله البستاني، ويتوسع فيه بالعرض والشرح: “المراد بتاريخ آداب اللغة تاريخ علومها، أو تاريخ ثمار عقول أبنائها، ونتائج قرائحهم، فهو تاريخ الأمة من الوجهة الأدبية والعلمية”.
لا يختلف ما يقوله زيدان عما قاله البستاني، مع إبداء الملاحظة التالية، وهي أن لفظ “الأدب” اختفى تمامًا لصالح لفظ: “الآداب”، وأن هذا الأخير بات يعني مدونة عامة ومدونة خاصة في آنٍ؛ أي بات يجمع ما هو “أدبي” بما هو “علمي”، فيما يعني “الأدبي” جزءًا من “الآداب”؛ وهو ما يشير إلى ارتباك في التحديد والتعريف.
قد يكون من الأسلم تتبع ما يحيل إليه اللفظ العربي في حمولاته المستجدة. يكتب جوناثان كلر في كتابه: “مدخل إلى النظرية الأدبية” (المترجم إلى العربية في القاهرة عام 2003م): “كتبَ الناس، لمدة خمسة وعشرين قرنًا، أعمالًا نطلق عليها اليوم أدبًا، لكن المعنى المستحدث لم يظهر إلا منذ قرنين فحسب. ويعني الأدب – أو المصطلحات المماثلة – في اللغات الأوروبية الأخرى، قبل عام 1800م، أيَّ كتاب في المعرفة”. وما يعمل الدارس على إبرازه هو أن لفظ “الأدب” كان يعني المعرفة تحديدًا، قبل القرن التاسع عشر، وبات يعني إنتاجات الشعر والنثر، من دون المعرفة.
ولعلنا نجد في مقال للأب خليل إده (منشور في مجلة “المشرق”، بيروت، 1904م)، ما يشير بشكل أبين على نقلة المعنى الحادثة – المستمرة حتى أيامنا هذه؛ فهو “يقسم الأدب إلى فرعين: منظوم أو موزون وهو الشعر، وغير منظوم وهو النثر البليغ”.


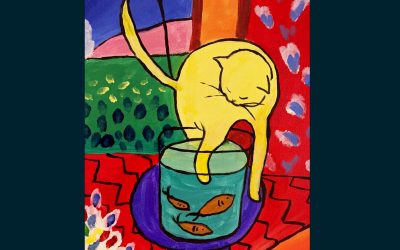

اترك تعليقاً