في طريقي إلى الدخول لعرض فِلْم “طريق الوادي”، بالدورة التاسعة لمهرجان الأفلام السعودية، اقتعدتُ مقاعد للحضور، وتنبهتُ للجمهور الكثيف المتراصّ في خطٍّ منتظم، ولشابَّين تعتلي شفاههما ابتسامة مسترخية، وقد انتدبا لتنظيم الدخول.
النِّسَبُ العمرية للشباب هي الأعلى وبفارق كبير، وكان سبق الوصول إلى طابور الدخول بالتواصي على حضور الفلم.
تعمدت الوصول إلى مقعدي متأخرًا ليس لشيء، سوى “للبحلقة” في وجوه الداخلين، وتتبع خطواتهم، والتربُّص بنظراتهم الموزَّعة بين ما يصادفهم باهتمام يشي بأننا مقدمون على عالَم نحبه.
أصوات خفيضة، وعيون تستلهم ما مرَّ بها من تجارب، كلَّت عيناي من العتمة التي حلَّت بالمكان، فغابت تفاصيل ملامح الوجوه، وحلَّت خيالات الجمهور المنعكسة على شاشة العرض. وعندما رفع مُرافقي صوته بغية التحدث إلي، مِلتُ إليه هامسًا: “هنا يحرم الكلام”، فنوى صمتًا. ومع وميض شاشة العرض إيذانًا ببدء الفلم، استعدت حواسي كلها نفسيًا لتتجه إلى تلك الشاشة.

سيل الوعي
في منتصف العمر قرأت رواية “الصخب والعنف”، للروائي الأمريكي العالمي “وليام فوكنر”، الحاصل على جائزة نوبل للآداب فى عام 1949م. شهرة الرواية وفوزها بجائزة نوبل، أوجبا عليَّ قراءتها، وما إن شرعت في ذلك، حتى وجدت نفسي عازفًا عن إكمالها، إذ إني تعودت الإقلاع عن أي أمر لا يتسق مع ذائقتي، فضربت صفحًا عن قراءة هذه الرواية لصعوبة ترابط الأحداث، وتفلتها عن الإطار السردي المنطقي.
بعد سنوات، وقعت الرواية نفسها، في طبعة أخرى، بين يدي ضمن مشتريات معرض الكتاب الذي أقيم في لبنان آنذاك، وكنوع من معاودة اختبار تنامي ذائقتي، أو كنوع من التحدي، إذ لا يمكن أن فوز رواية بجائزة عالمية جاء من فراغ. بدأت بقراءة الرواية التي قدَّم لها المترجم تقديمًا كشف الحجب عما حدث في تجربتي القرائية السابقة، إذ أشار إلى أن الراوي “بنجي كومسون”، أحد الشخصيات الرئيسة، كان مريضًا ومعتلًا وصاحب قدرات عقلية ضعيفة، وكان سرد الفصل الأول من الرواية سردًا على لسان ذلك المعتل، لهذا لجأ الروائي إلى أسلوب سيل الوعي بلسان كومسون، وهو أسلوب التداعي الحر المستخدم لدى الأطباء النفسيين، إذ يمكن للطبيب استنباط أفكار المعالج من خلال أحاديثه التي يتم تجاهلها من قِبل الآخرين، فيما يقبض عليها الطبيب النفسي. ولقد لجأ الروائيون والسينمائيون لهذا الأسلوب في وقت لاحق.
ورواية “الصخب والعنف”، تدور أحداثها حول عائلة تنوَّعت انشغالاتها وهمومها، فتذكرت هذه التفاصيل وأنا أشاهد فِلْم “طريق الوادي”، للمخرج وكاتب السيناريو خالد فهد، إذ تدور أحداث الفِلْم حول عائلة تكاد تكون متنافرة، وإن لم يكن هناك تصريح بذلك التنافر البيِّن.

الإعجاب المعاكس
تذكَّرت “الصخب والعنف” فيما كنت أشاهد “طريق الوادي”، ومع نهاية الفِلْم كان البال مشتتًا بين الإعجاب وبين المعاكس لذلك الإعجاب، فقد كانت الفراغات السردية تُنغّص تلك المتعة، ومع ظهور التتر نهضت لمغادرة الصالة، إلا أنَّ مدير العرض أعلن عن حوار سوف يُجرى مع مخرج “طريق الوادي”، فعدت إلى مقعدي لأسمع ما سيقوله خالد فهد. وبعد سرد ما قاله، يمكن القول إنَّ حديثه رمَّمَ أجزاءً عديدة كانت معلَّقة في الهواء، لم أستطع استحضارها أثناء مشاهدتي للفِلْم، فلقد أبان حديثه خريطة الفضاء السينمائي الذي تحركت الأحداث من خلاله، فالمخرج وكاتب العمل سلك طريق سيل الوعي في إخراجه لفِلمه “طريق الوادي”، بيد أن ذكر حالتي مع رواية عالمية، ومشاهدة فِلْم محلي، لا يعني مقارنة الجودة بجودة، وإنما هو تطابق لحالتين في مخيلتي للتذكر بين القبول والرفض.
وتماشيًا مع رؤية “جان لوك غودار”، في البحث عن التموجات التجديدية الحديثة، وبحثًا عن حُبِّ السينما في نفسها، ندرك قوله: “لقد أحببنا السينما قبل أن نُحب النساء والمال والحرب”. لقد كان ذلك الحُب الذي بحث عنه في الأفلام التي قدَّمها، بينما نحن كمشاهدين نبحث عن ذلك الحُب الموجود والمشاهد الذي يؤكِّد لنا حقيقة أننا ما زلنا نحب.
أي أن القاعدة في بحثنا عن الحُب هي تأكيد وجودنا كذوات تتجسَّد أمامنا بصريًا.
نحن الآن نصنع قواعد الأدبيات السينمائية المحلية، وننقش مفاهيم سيتم توريثها، وننطلق من المستويات الفنية العالمية للسينما.
اجتثاث الصورة المستهلكة
لقد أطلق جيل المخرجين الفرنسيين المعاصرين الباحثين، ثورة سينمائية اجتثت ما ران من احتلال المنتج السينمائي الأمريكي على ذائقة المشاهد الفرنسي. كان على اللاحقين من المخرجين في جميع أنحاء العالم اجتثاث الصورة المستهلكة لماهية الأفلام المقدَّمة والراسخة في ذهنية المشاهد والمستسلم لاستهلاكية ما يُقدَّم له، والحركة السينمائية الشابة في المملكة مهمتها أصعب لأنها مستحدثة في صناعة السينما، وليس لديها إرث سينمائي خاص، ومع ذلك تكون الثورة على المستهلك مهمة رئيسة لدى هذه الحركة، وذلك من خلال الأدوار الكتابية والإخراجية.
فالحالة الإبداعية هي قفزة على من يجايلها زمنيًا بإحداث بصمة معزَّزة ومتفوِّقة على ما سبق.
وفِلْم “طريق الوادي” أحدث قفزة فيما يعرض من أفلام سعودية، وهذا التأكيد ليس مطلقًا، وإنما مرتبط، زمنيًا، بما هو حادث في السينما المحلية، إذ أعُدّه قفزة لما يجاوره من تجارب المخرجين السعوديين الحاليين. كما أن الفلم يؤسِّس تجربة مختلفة تعتمد على تدخُّل الصورة في معمل ذهنية المشاهد، وذلك بغية أن تتجادل الصورة مع الخيال مع المعرفة السينمائية الخاصة بالمشاهد.
ويُحمد لصُنَّاع الفلم عدم الثرثرة الكلامية في إيضاح جوهر أزمة بطل العمل، الطفل “علي” (يقوم بدوره حمد فرحان)، المصاب بمرض التوحُّد.
والفلم يحتاج إلى حالتين من المشاهدة، حالة الاستمتاع، وحالة فتح مغاليق الفلم كحكاية، مع التنبه إلى تفاصيل ما يبث كصورة مثل سطوة المكان، وتحركات الأبطال، وإعطاء مساحات واقعية في ذهنية المشاهد، فاللغة السينمائية تأخذ لنفسها مواقع متناثرة وفق المرسل إلى المشاهد من صورة وحوار وأداء، وبالتالي تصبح الحالة المرضية للبطل صورة سينمائية صافية عما يسبق المعرفة بالحالة المرضية، فالأساس الإقناع بالصورة وليس بما يعلل بالكلام.

بين القرية والعالم
كما كانت ذاكرة مريض التوحُّد مسرفة في المتخيل، كانت بيئة المكان (القرية) متخيلة في براءتها بما تجسِّده القرية من “أحاديتها” في كل شيء. فالذاكرة الجمعية لسكان القرية تعتمد على المألوف والعادة، وهكذا كان الأب (يمثل الدور نايف خلف) لا يرى علاجًا لابنه المريض إلا في الطب الشعبي القادر على إخراج السحر والجن من ذلك الطفل. بينما كانت نافذة النور كمتعلمة هي أخت المريض (الممثلة أسيل عمران)، التي غادرت القرية للتزوُّد بالعلم، والتي تعود لتأكيد احتياج مرض أخيها إلى أطباء علم نفس، وليس إلى مشعوذين أو إلى علاج بدائي أدواته الكي والزيوت. كما أن حضور السياح الأجانب كسر أحادية القرية في رؤيتها الثابتة أو الحدية والسكون للمألوف، و“الحدوتة” هذه هي غلافا القصة من المبتدأ إلى المنتهى، وبينهما دارت قصص متداخلة لإنماء الأحداث والشخصيات مع إشارات عمد إليها المخرج لاستحضار زمنية الأحداث كجنون البقر، أو نوعية السيارات المستخدمة، أو السياح الأجانب، والإشارة الأخيرة تمنح الطفل المريض تعاملًا مختلفًا عما يجده في القرية، بمعنى اختلاف الناس في مستوياتهم المعرفية، وكيفية احتواء هذا الطفل المريض.

نواة الحكاية الأم
إن غلبة الجوانب الفنتازية في مشاهد الطفل المريض، لم يتم ترميمها إلا بالحديث المتأخر للمخرج بعد عرض الفلم. كما أنك حين تشاهد الفلم، يمكن أن يداهمك الملل. على الرغم من الحشو السردي المضاف، إلا أن تشكلات المكان وانتقال الصورة بينها، ويقظة الممثلين في أداء أدوارهم باقتدار، كل ذلك أوجد نوعًا من شد خيط الفلم، مبتعدًا عن ترهل الأحداث. كما أن أداء الممثلين المتميز ساعد المخرج في إبقاء حالة الجذب مستمرة بين تنوُّع وإيقاع الصورة المتجدِّد، وبين الحدث الأفقي في مستوى واحد، أي أن الحدث لم يكن به محطات ارتفاع وانخفاض على حالة الطفل المريض، كما أن الزوائد الحكائية، رغم ضرورتها لتحريك الحدث، أوشكت على تهشيم نواة الحكاية الأم، وقولي هذا لا أعده انتقاصًا لتلك الزوائد، وإنما لشعوري بأنها أوشكت على الابتعاد عن نواة الحدث.
ولطالما كنت مغرمًا بأداء الطفلة المقابلة للبطل المريض علي، فلقاؤهما في المشاهد يؤكد جانبًا دقيقًا في النفس البشرية، حيث كان الطفل سويًا متجانسًا مع من هم في سنه، من غير تلوث عقلية الطفل المقابل بالأحكام السابقة في تحديد الخطأ من الصواب.
الأحكام الحدية أو التفضيلية في الفن ليس لها وجود، وفي السينما يكون المحرِّك الأساس هو الصورة، بحيث تكون مقدرته في الجذب أو التنافر من خلال انسيابية الحدث مقرونة بتفاصيل المؤثرات السينمائية المصاحبة.

طور صناعة القواعد
مساحات الأفلام السينمائية قائمة على الصورة وجدلية المشاهد معها، وهذا هو التيار الكهربائي لإضاءة أي فِلْم، لذا سأقف عن الثرثرة الكلامية مع تأكيد الإعجاب بفِلْم طريق الوادي إعجابًا بالممثلين، وبالصورة، وبحركة الكاميرا، وبالإضاءة، وبالموسيقى التصويرية المصاحبة، فضلًا عن إجادة الممثلين لأدوارهم بما في ذلك التلوين المضاف للون المكان والحكاية بتفاصيلها وجزئياتها المتباعدة والمتقاربة.
أقول، سأقف بعد كل هذا الهذر لأحمل تحية كبيرة إلى المخرج، وإلى الممثلين الذين أجادوا في تقديم أدوارهم بما منح الفعل حالة الاختلاف.وتحية للطفل الأكثر من رائع حمد فرحان، وإلى نايف خلف، وإلى أسيل عمران، وإلى محمد الشهري وإلى البقية الرائعين المشاركين في ذلك الفلم.
وتساورني خشية ما، فنحن الآن في طور صناعة القواعد، أي أننا نصنع قواعد للأدبيات السينمائية المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صياغة مفاهيم يتم توارثها لاحقًا. وهذا لا يعني وضع قواعد ثابتة، فالعالم متحرك، وكل ذرة فيه متحركة منذ بداية الخليقة، أما القواعد التي أعنيها فهي تلك المستويات الفنية العالية التي وصلت إليها السينما عالميًا،، وصانعو السينما لدينا هم ورثة كل تقنية وكل مفهوم أنتج عالميًا، ومن التقاعس ألا يحدث بناء أفلام قادرة على المنافسة في حدودها الطبيعية، ومع وجود الطاقة البشرية وقوة الإنتاج تصبح المطالبة بتجويد الأفلام أمرًا لازمًا.

الفن السابع
يبدو أنني انحرفت بالمقالة عن تحليل فِلْم “طريق الوادي”، إلى خانة الدرس “يجب أو لا يجب”، وفي يقيني أن الفن خارج عن كل واجب، فالفنان هو من يخطُّ الطريق.
بالنسبة إلى الثقافة التي مجَّدت الشعر، ورسَّخت مقولة “الشعر ديوان العرب”، فأنا سأتملص من ذلك الشعار لأرفع شعار “السينما ديوان العرب”، ولأنها كذلك فهي حاوية وهاضمة لكل أنواع وحقول الفنون، لذا يستوجب عليها توسيع مساحة الإبداع بما يتلاءم مع كونها ديوان العرب، ولأنها حصاد لقب “الفن السابع” فهي تقود إلى ختامية رقم 7، وهي السر الأزلي الحاوي لما قبله.
فِلْم “طريق الوادي” خطوة مباركة، إلا أنَّ التحفيز واجب، ومع كل هذا ما زال أمام السينما السعودية تحديات كبيرة، ومطالبات بالتجويد والقفز عاليًا لإحداث فلم محلي نفاخر به. ما زال في الغيب متسع للروعة.


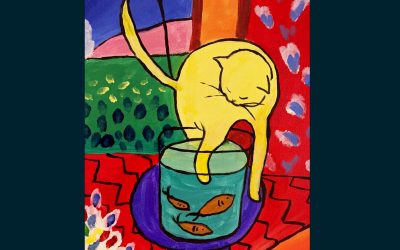

اترك تعليقاً