“أيام مثالية” هو عنوان الفيلم الأخير للمخرج الألماني فيم فندرز، الذي يعرض بهدوء وكلام قليل تفاصيل حياة الشخصية الرئيسة، الياباني هيراياما، بخاصة روتينه الصباحي وما يليه. وهذا ما يدفع المشاهد إلى الالتفات صوب روتينه الصباحي الخاص، وإلقاء نظرة مدققة عليه، ويمكن أن تكون ناقدة، نظرًا لما للخطوات الروتينية الأولى التي نبدأ بها يومنا من تأثير في تسيير أمور حياتنا اليومية.
من المرات القليلة التي تحتفي فيها السينما بالصباح وروتينه ما نراه في فيلم “أيام مثالية”، الذي يحافظ بطله “هيراياما” على روتين صباحي هادئ، متكرر بشكل طبيعي وعضوي حتى في طريقة استيقاظه من النوم. فهو يستيقظ قبل شروق الشمس عند سماعه لصوت مكنسة رجل عجوز يُنظِّف الشارع المقابل لنافذة غرفته في الوقت نفسه كل يوم؛ صوت ناعم يمشِّط خصلات الطريق ويزيح أوراق الشجر بحنو. ربَّما يفكِّر البعض خلال هذه المشاهد في أصوات المنبهات التي تُعلن على رؤوسنا بدء المعركة اليومية حين نستيقظ على رنينها أو زعيقها، بحسب النغمة المختارة لرنين المنبه؛ لنتأهب بالفزع ونتجيش بطاقة الانزعاج منذ لحظة اليوم الأولى، تلك اللحظة التي نشعر فيها أننا انتُزعنا من هنيء نومنا وأحلامنا، فنودُّ لو نضيف عليها عشر دقائق أخرى، ثم عشرًا أخرى إلى ما لا نهاية.
لحظة الاستيقاظ هي اللحظة التي يتصارع فيها العقل والجسد، والواجبات، وقائمة المهمات، والوظيفة. فكم يا تُرى عدد مَن يستطيعون الاعتماد على تنبيه الساعة البيولوجية في الاستيقاظ، أو حتى صياح الديك أو تغريد العصافير، بعد أن أصبحت البصمة إلزامية في أكثر المؤسسات والشركات؟ ثم كم يا تُرى عدد الذين لم يُدمنوا عادة تفقد الرسائل النصية والإيميلات ومحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي في أول لحظات الصباح، ونحن بين النوم واليقظة، طالما أن أجهزة الجوال هي أول ما نمسك به لإسكات المنبه أو لمعرفة الوقت بعد اختفاء الساعات من الجدران!
على النقيض من هذا الصداع الصباحي، الذي أصبح أمرًا اعتياديًا لكثير من البشر، يُبرز الفيلم حالة رومانسية للروتين الصباحي لـ”هيراياما” ونعومة بدايات أيامه. فحالما ينهض يطوي فراشه بتلقائية، ويمارس طقوس العناية الشخصية بترتيب متكرر لا يتبدل، ويعتني بنباتاته المنزلية، ثم يستعد للعمل ويلتقط المفاتيح والمحفظة المصفوفة بعناية على رف صغير بجوار الباب. يخرج ويتنفس هواء الصباح الغزير، يشتري مشروبًا من آلة البيع المجاورة، ثم يقود السيارة إلى موقع العمل وهو يستمع من مشغِّل الكاسيت لأغانٍ من روائع الستينيات والسبعينيات أثناء المرور بالشوارع نفسها. ينظر هيراياما في طريقه إلى الأبراج والمباني نفسها في مدينة طوكيو، ثم يقوم بعمله اليومي (تنظيف المراحيض العامة) بحرص وتفانٍ. وفي اليوم التالي يعيد الكرة بالحماس والرضا والنشاط نفسه.
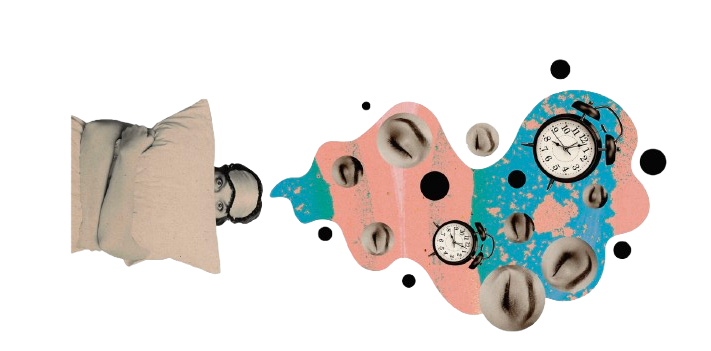
التكرار لضبط الإيقاع
تتكرر مشاهد هذا الروتين الصباحي في الفيلم مرات عديدة، ومع ذلك لا تبدو مُملة بقدر ما تصبح مع التكرار ودودةً أليفةً تحفظها عين المشاهد وتتوقعها ذاكرته. يعيد السيد هيراياما روتينه الصباحي فيبدو عالمه سعيدًا مغمورًا بالهناء، ولا سيَّما حين يستمع للأغاني ذات المزاج النوستالجي مثل “بيت الشمس المشرقة” لفرقة “ذا أنيملز”، أو أغنية “جالس على دكة الخليج” لأوتس ريدينغ.
الرضا الذي لا يفارق ملامح وجه البطل، والحماس البادي في لغة جسده (تحية لقدرات كوجي ياكوشوا التمثيلية العظيمة) يكشف افتتانه بما يقوم به كل صباح وبتكراره للتفاصيل نفسها. ذلك التكرار الغامض للعادات البسيطة، الذي نتصوَّره أحيانا قاتلًا ورتيبًا، يبدو بالنسبة إلى هيراياما مصدرًا للراحة ودافعًا للتجدد والقدرة على الاستمرار. فتثبيت تفاصيل صباحاته البسيطة والحميمة يضبط إيقاعه الهادئ، ويحفظ توازنه، ويحصِّنه من الغرق في العالم الاستهلاكي سريع الإيقاع، الذي يهيم به كل من وما حوله خارج المنزل.
استمرار النظام المعهود مصدر سعادة
يُختتم المشهد النهائي في الفيلم بلقطة مقربة ثابتة على وجه هيراياما، وهو يقود السيارة ويستمع إلى أغنية نينا سيمون: “أشعر بالرضا”، وهي أغنية تحتفي بالفجر وولادة اليوم الجديد بروتينه المستعاد وكائناته من فراشات وأسماك ونسائم تبدأ دورة يومها، وتُختتم الأغنية بعبارة توكيد على الشعور بالأمان لاستمرار الحياة بنظامها المعهود: “إنه فجر جديد، إنه يوم جديد، إنها حياة جديدة لي، وأنا أشعر بالرضا”. كلمات الأغنية ولحنها ينعكسان ببراعة على ملامح هيراياما التي تقول كل شيء عن السعي والرضا والسعادة والمعاناة والألم في وجه واحد. تقول سيمون في نهاية الأغنية: “النوم بأمان عندما ينتهي اليوم؛ ذلك ما أعنيه، وهذا العالم القديم هو عالم جديد وعالم جريء بالنسبة إلي، وأنا أشعر بالرضا”. ربَّما لم يسبق أن قُرئت هذه الأغنية قراءة إيكولوجية، لكنها ملائمة تمامًا لمثل هذه الغاية. فالشعور بالرضا والسعادة نابع من الحقيقة البسيطة التي لا نتوقف عندها كثيرًا، وهي تجدد الحياة، وولادة الفجر، ومشاركة الكائنات هذه السمفونية الأبدية المتجددة.
الروتين الصباحي النقيض
على أن الروتين ليس حالمًا هكذا على الدوام، ولا يعدُّ بالضرورة فاتنًا أو مسليًا أو مدخلًا مضمونًا إلى دوائر الراحة والاسترخاء والاتصال بالطبيعة. ففي نمط الحياة الاستهلاكي السريع المعاصر، من السهل جدًا أن ترتبك جداولنا ويضطرب نومنا، وتتسرب أوقاتنا وأعمارنا في غفلة أمام ملاحقة فيض المحتوى والتحديثات التقنية والمنتجات المتجددة والاستهلاك والموضة المتغيرة والأشخاص العابرين.
ليس من السهل أن نتدرع بالصرامة، ونتمترس خلف عادة يومية تتطلب الصبر والإعراض عن المُلهيات والمشتتات، وإغلاق التنبيهات، ومقاومة الشعور بأنه يفوتنا الكثير ونحن في معتزل العادة والروتين. الروتين الذي يرفع شعار البطء والتأني والتوقف والتكرار والاستعادة في وجه التسارع والتحديث والمنتج التالي و”الترند” الأخير. من السهل في نمط الحياة هذا أن يسيل الوقت، فلا ينتبه العقل لمروره. ويحتاج العقل، كما يقول أرسطو، إلى أن يشعر بالتغيير ليُدرك أن الوقت يمر ويتغير، فلا يدمج لحظة آنية سابقة بأخرى لاحقة.
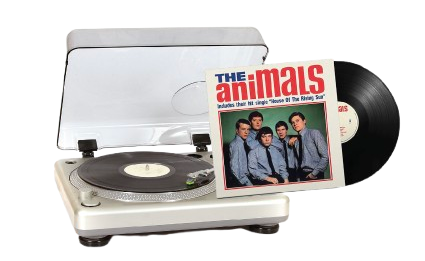
أغاني الصباح قد تكون روتينًا، كما هو الحال مع هيراياما الذي يستمتع بألحان ذات مزاج نوستالجي، كما هي أعمال فرقة “ذا أنيملز”.
الاهتمام الجديد بهذه المسألة
الاهتمام الجديد بالروتين الصباحي، وطقوس المبدعين والمؤثرين والمنجزين فيه، هو مؤشر على محاولة العودة إلى تلك الحالة العضوية من الانسجام مع الطبيعة، أو على الأقل توظيفها والاستفادة منها للوصول إلى أقصى درجات الكفاءة والإنتاجية المتلائمة مع الحياة المعاصرة. ولا أدل على ذلك من شيوع الكلمة في المنصات المتخصصة في التحفيز على نمط العيش الإيجابي. وفي مقاطع أو كتب تطوير الذات، أو جاذبية المحتوى المتعلق بروتين الصباح في حسابات المؤثرين على وسائل التواصل، والخوارزميات التي يمكنها استشراف الغايات والرغبات والاحتياجات بمساعدة البيانات الضخمة؛ ما يفسر تزايد المحتوى الإلكتروني حول روتين الصباح والعادات اليومية التي تُلبي حاجة كثير من البشر للوصول إلى نموذج يوائم بين نمط الحياة المعاصر والنمط العضوي.
تُقدِّم بعض المواقع والمنصات نصائح ووصايا ونماذج جيدة، وأحيانًا مثالية، لكيفية قضاء الساعات الأولى من اليوم في أنشطة وعادات مكررة تعزِّز الإنتاجية وتساعد على الظهور للحياة بطاقة أكبر ومزاج أفضل. لكن، أَيَـكون الروتين بهذه الصيغة هو العادة أو الممارسة الحسنة التي نحقق درجة جيدة من الالتزام بها، أم أنه مجرد إدمان متابعة محتوى المؤثرين والانضمام إلى جحافل المستهلكين للمحتوى الترويجي المُصمَّم من دون مراعاة للفروق الشخصية والفردية وأنماط العيش المختلفة للبشر؟ لا يمكن أن ينكر أحد الطابع الحسن لكثير من الممارسات التي تقترحها تلك المنصات أو الأشخاص الذين يعرضون نمط روتينهم على قنواتهم الخاصة. لكن، لماذا تحتاج امرأة تعيش في الريف، مثلًا، روتينًا صباحيًا مكوَّنًا من وحدات زمنية، قد تمتد إلى ساعتين، موزعة بين ممارسات تُراوح بين العناية الشخصية وإعداد وجبة، ثم الرياضة الثقيلة، وبعدها الانتقال إلى قوائم المهام اليومية بعد فترة استرخاء وتأمل أو يوغا؟ فغالبًا سيكون لهذه المرأة روتينها الصباحي العضوي الذي يتماشى مع طبيعة يومها واحتياجاتها ومهامها التي تُنجزها بشكل يومي أو دوري.
تُقدِّم بعض المواقع والمنصات نصائح ووصايا ونماذج جيدة، وأحيانًا مثالية، لكيفية قضاء الساعات الأولى من اليوم في أنشطة وعادات مكررة تعزِّز الإنتاجية وتساعد على الظهور للحياة بطاقة أكبر ومزاج أفضل. لكن، أَيَـكون الروتين بهذه الصيغة هو العادة أو الممارسة الحسنة التي نحقق درجة جيدة من الالتزام بها، أم أنه مجرد إدمان متابعة محتوى المؤثرين والانضمام إلى جحافل المستهلكين للمحتوى الترويجي المُصمَّم من دون مراعاة للفروق الشخصية والفردية وأنماط العيش المختلفة للبشر؟ لا يمكن أن ينكر أحد الطابع الحسن لكثير من الممارسات التي تقترحها تلك المنصات أو الأشخاص الذين يعرضون نمط روتينهم على قنواتهم الخاصة. لكن، لماذا تحتاج امرأة تعيش في الريف، مثلًا، روتينًا صباحيًا مكوَّنًا من وحدات زمنية، قد تمتد إلى ساعتين، موزعة بين ممارسات تُراوح بين العناية الشخصية وإعداد وجبة، ثم الرياضة الثقيلة، وبعدها الانتقال إلى قوائم المهام اليومية بعد فترة استرخاء وتأمل أو يوغا؟ فغالبًا سيكون لهذه المرأة روتينها الصباحي العضوي الذي يتماشى مع طبيعة يومها واحتياجاتها ومهامها التي تُنجزها بشكل يومي أو دوري.
الأمر لا يقتصر على رفع الإنتاجية
إن مشكلة وصايا الروتين الصباحي ومقترحاته التي توفرها الوسائط الحديثة، على الرغم من جاذبيتها ووجاهتها أحيانًا، تـكمن غالبًا في تركيزها على مفهوم “رفع الإنتاجية”، وهذا من أشنع ما تفعله الاستهلاكية؛ إذ تسعى إلى تسليع الأشياء وإفراغها من قيمتها ومعناها وبعدها غير المادي واختزالها في جانب الإنتاجية وتحقيق المكاسب وتقليل وقت العمل والكدح، والميل إلى السهولة وتبسيط الأشياء وتسطيحها حتى نصبح مستهلكين للروتين من دون ارتباط فعلي بما يعنيه لنا وما يفعله بنا.
هذه ليست نزعة تشاؤمية على كل حال، وليست دعوة لرفض الوسائل والمقترحات التي يمكن فعلًا أن تُسهم في رفع جودة الحياة والإنتاج، لكنه التحفظ على تحويل الإنسان إلى آلة وُجِدت لتعمل وتنتج من دون وعي أو تفكير فيما تعمل وفيما تنتج، وفي أثره على الذات والكائنات والكون.

. والواقع أن هذا قدَّم نماذج حسنة، وأعاد التقدير والمجد للروتين الصباحي تحديدًا. فقد تحدَّث كثير من المبدعين عن الروتين الذي يتضمن الاستيقاظ في وقت يومي ثابت، وممارسة الكتابة لساعات في الصباح المبكر وقت برودة الشمس، يسبقها البعض بممارسة الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى. فيندر أن يكون هناك كاتب جاد وملتزم ومنجز، إلا وكان الروتين جزءًا من أسلوب حياته. أمَّا الفلاسفة والمفكرون، فطالما تحدثوا عن ترويض النفس وإلزامها بالعادة الإيجابية المتكررة، وعن قدرتها الساحرة على إمدادهم بالصبر وتدريبهم على الجَلد والالتزام، ومساعدتهم على تصفية الذهن وشحذ القدرات الخاملة.
في مذكراته التي تُرجمت، أخيرًا، عن دار أدب، تحدث الروائي هاروكي موراكامي عن عادة الجري التي رباها على مدى عقود منذ بدأ الكتابة. يتحدث موراكامي عن قيمة وجود تلك العادة في حد ذاتها، وأن وجودها أهم من طبيعتها. ويتحدث عن التحديات في ترويض العقل والجسد، وعن الأوقات التي لا تطاوعه فيها نفسه على النهوض، فيسعى للبحث عن أعذار كي يستسلم للكسل. يذكر مقابلته مع العدّاء الأولمبي توشيهيكو سيكو، التي جرت بعد اعتزال الأخير للجري مباشرة، حين سأله موراكامي هل كان عدّاء في مستواه يشعر بعدم الرغبة في الجري في بعض الأيام؟ فكانت إجابة العداء الصادمة والمحرجة نوعًا ما لموراكامي: “نعم. طوال الوقت!” بنبرة صوت ثابتة. يقول موراكامي إنه تعلم منها أن “الألم حتمي لكن المعاناة اختيار”.
في مذكراته التي تُرجمت، أخيرًا، عن دار أدب، تحدث الروائي هاروكي موراكامي عن عادة الجري التي رباها على مدى عقود منذ بدأ الكتابة. يتحدث موراكامي عن قيمة وجود تلك العادة في حد ذاتها، وأن وجودها أهم من طبيعتها. ويتحدث عن التحديات في ترويض العقل والجسد، وعن الأوقات التي لا تطاوعه فيها نفسه على النهوض، فيسعى للبحث عن أعذار كي يستسلم للكسل. يذكر مقابلته مع العدّاء الأولمبي توشيهيكو سيكو، التي جرت بعد اعتزال الأخير للجري مباشرة، حين سأله موراكامي هل كان عدّاء في مستواه يشعر بعدم الرغبة في الجري في بعض الأيام؟ فكانت إجابة العداء الصادمة والمحرجة نوعًا ما لموراكامي: “نعم. طوال الوقت!” بنبرة صوت ثابتة. يقول موراكامي إنه تعلم منها أن “الألم حتمي لكن المعاناة اختيار”.
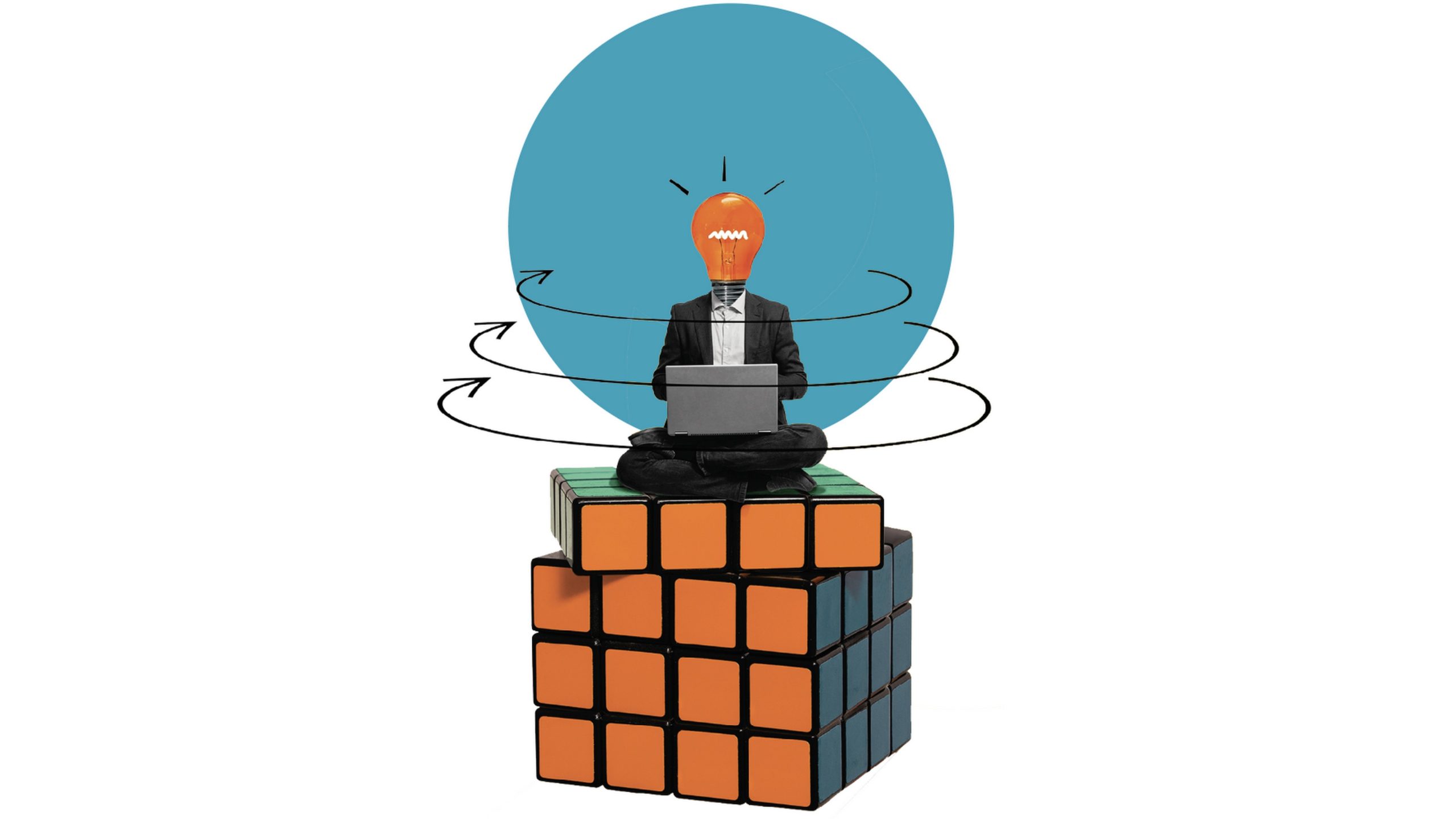



اترك تعليقاً