في كتابه “كتابة الرواية”، يضع الناقد والروائي البريطاني “جون برين” جملة أساسية: “باستطاعة أي إنسان أن يكتب رواية أولى ناجحة”. وهو يخصّص كتابه هذا، الذي صدر أول مرّة بالعربية عن دار الشؤون الثقافية ببغداد في منتصف التسعينيات، لأولئك الذين ينوون كتابة روايتهم الأولى.
يُشير برين، كما يُشير نقّاد آخرون ومؤرخون لفنّ الرواية، إلى حقيقة أن الكثير من الأعمال الروائية الأولى لكتّابها تستند في جزء كبير من مادّتها على الخبرات الشخصية للكاتب، فتبدو هذه الأعمال وكأنها تنويعات على السيرة الذاتية، أو سيرة مبطّنة. وبشكل عام، يتسرّب دائمًا جزءٌ من المادة الذاتية في نسيج الرواية، ولكن الروائي الناجح، بحسب قول “غارسيا ماركيز”، من ينجح في إخفاء غُرَز الخياطة.
إن هذه الرواية الأولى تمتاح من مادة متوفّرة، هي تجربة الكاتب الشخصية، إخفاقه الخاص في الحبّ، تجربته مع الحرب، ملامح أناس عايشهم وتأثر بهم. جوهر المعاناة التي يخوضها بطل الرواية تكاد تكون منتزعة من المعاناة الخاصّة للكاتب. ولكن، ماذا عن الرواية الثانية والثالثة والرابعة؟!
لا يعيش غالبية كتّاب الرواية حول العالم حياة غزيرة التفاصيل ومليئة بالأحداث والمغامرات، على عكس “هيمنغواي” مثلًا، وبالتالي لا توفّر الحياة الشخصية للكاتب مادة ثرية لسلسلة من الروايات. إن الكاتب محكوم بشرط بشري قاهر؛ إنه، مثل البقيّة، أسير خياراته الخاصّة في الحياة. وبالتالي هو يتدرّج في مسار محدّد يوفّر له نوعًا من التجارب، التي تكون محدودة في نهاية المطاف؛ فلا يستطيع هو كشخص أن يخوض في كلّ المسارات في الآن والوقت نفسه.
إن الرواية الأولى، استنادًا إلى كلام جون برين، لا تحدد هوية الكاتب وجدّيته واحترافه، وإنما الثانية وما بعدها، فهناك سيكون أمام تحدٍّ مختلف؛ أن يخرج للناس ويجمع مادته منهم.
في محاججتي الخاصّة حول الأنواع الأدبية، كثيرًا ما قلت إن المحدّد الأبرز ما بين الشعر والسرد، قصّةً وروايةً، هو أن الأول صوتٌ ذاتي، بينما الثاني هو صوت المجموع، صوت الآخرين.
إن الروائي الناجح، أو فلنقل الخبير في مجاله، هو من يتخفّف من أناه وينصت إلى أصوات الآخرين، ويجعل في عمله فسحة لهذه الأصوات كي تعبّر عن نفسها، ولا تكون كل الشخصيات صوتًا للمؤلف، أو لا يكون الصوت المفرد للبطل الأساسي في الرواية طاغيًا على ما سواه.
ولهذا السبب، فإن العديد من الأعمال الأولى تكون ذات مزاج شعري، ونراها تفسح الباب على مصراعيه لصوت البطل الفرد. إن الرواية الأولى هنا هي فسحة التعبير اللغوي المتأنق والحاذق عن صوت الكاتب نفسه. إنها تعبير عن حاجته الملحّة كي يسمع الآخرون صوته.
يكتب الكثير من الكتّاب الموهوبين، بالطبع، أعمالًا أولى ناجحة، حتى وإن امتاحت بشكل أساسي من التجربة الشخصية. وهناك كتّاب يكتبون أعمالهم الأولى ولا ينشرونها، فيحرمون المتتبّع من فرصة التعرّف على فخّ الذاتية المفرطة في الكتابات الأولى.
الوصول إلى سنّ الرشد الروائي، إن جاز التعبير، يكون بإدراك الكاتب أن الرواية صنعة وليست بوحًا. فصاحب البوح لا يرى العالم وإنما يريد أن يُرى. وفي سبيل مسعاه هذا قد لا يهتم لاشتراطات الصنعة الفنيّة، فيكون المهم والثانوي في الأحداث والتفاصيل بالنسبة له ككاتب، ما هو مهم وثانوي بالنسبة له أيضًا كشخص. فيفرض خيارات الشخص على الفنّان.
هناك نصيحة قد تبدو قديمة وشائعة، ولكني أراها فعّالة؛ أن يبدأ المهتم بالتجربة السردية مع القصّة القصيرة، وحين ينال الاعتراف به أديبًا متمكنًا يستطيع بعدها أن يدخل إلى عالم الرواية. وسبب تفضيلي لهذه النصيحة أن فضاء القصّة القصيرة، المحدود لغويًا وقليل الشخصيات والأحداث، لا يتيح للكاتب أن يسترسل ليمتاح من مخزونه العاطفي فيقلّب صفحات الذاكرة على مهل ومن دون عائق. إن الكاتب مع القصّة القصيرة مجبر على الانتباه إلى الجودة الفنية وإبراز القدرة الأدبية في عدد محدود من الكلمات. لذلك، حتى مع عدم رواج فنّ القصة القصيرة اليوم، وإغراء البداية السريعة في كتابة الروايات، فإنها منطقة مهمّة للتدريب واكتساب اللياقة الأدبية لأي كاتب يريد خطّ مسار جدّي مع فن الكتابة الأدبية، والروائية منها تحديدًا.
في الرواية الثانية والثالثة وما بعدها، قد يصل الكاتب إلى بعض المفاتيح الأساسية لعلاقة الكتابة بالتجربة الحياتية، ومنها: أن الكتابة الأدبية تعتمد على التجربة الحياتية ولا شكّ، ولكن ليس الأحداث والقصص والعلاقات الاجتماعية بالضرورة، وإنما تفسيرنا لهذه التجارب، وكيف نستخرج منها تصورات ومفاهيم أساسية. وبالتالي مع أي مسارات درامية متخيّلة، يستطيع الكاتب أن يتمثّل فيها تلك التصورات والمفاهيم التي أنتجها التأمل والتفكّر في التجارب الحياتية الشخصية والعامة. إن العنصر الحيّ في التجربة المتخيّلة المكتوبة سيكون قادمًا من تحليل الكاتب للتجربة الشخصية أو “المُحايَثَة” (تجارب أناس مجاورين ينفعل معها) ليصل إلى جوهرها العام. هذا الجوهر الذي يتبدّى بأشكال مختلفة، لا بشكل واحد جاءت به التجربة التي نعرفها أو خبرناها.
الكاتب مع الرواية الثانية والثالثة وغيرها لن يرى التجارب الشخصية مقدّسة، وأنه مجبر، عاطفيًا بالدرجة الأساس، على تسريبها كقطع كبيرة داخل أعماله الأدبية. إنه منجذب هنا إلى معمار التجربة المتخيّلة التي يبتدعها، ويعبئها بتفاصيل صغيرة قادمة من مداومته على تحليل وتفكيك التجارب، أيًا كانت، شخصية أم عامّة.
إن الرواية، على وفق هذا التأمل، هي مَشغَل معرفي، بقدر ما هي مشغل فنّي وبلاغي. إنها لا تعكس فقط خبرة الكاتب مع اللغة وإمكاناتها، وإنما انشغال الكاتب بالمجتمع وشؤونه ونماذجه البشرية، ومفارقات القدر الإنساني، وتناقضات الحياة.
والرواية في هذا المسار تعكس تواضع الكاتب وتقديره للوجود الممتلئ والمعقّد للآخرين، على قدم سواء مع إدراكه لتعقيد ذاته الشخصية وامتلائها.


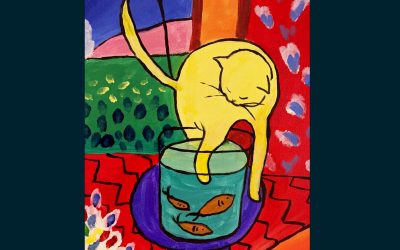

اترك تعليقاً