قبل عدة عقود من تاريخنا الوطني، وقع حدثان مختلفان في الشكل، متكاملان في الدلالة. وأعني بالحدث هنا بُعده الفلسفي الذي يتحقق بشروط ثلاثة أساسية كلها، فلا بُدَّ من أن يكون غير متوقع، وأن يكون أثره عميقًا وشموليًا، وهكذا تولّد الحداثة قطيعة مع ما سبقه (الحدث) مؤسسًا لسيرورة تاريخية جديدة كما يذهب إليه الفرنسي دريدا وغيره. الحدث الأول المقصود هو تشكل الدولة الوطنية في بيئة جغرافية بشرية تهيمن عليها الجماعات القبلية منذ قرون بعيدة، وهي بُنى عتيقة يُعد وجودها الفعال دليلًا كافيًا على غياب الدولة المركزية من هذا الفضاء الصحراوي “الحاف” الجاف في مجمله.
أمَّا الحدث الثاني، فهو اكتشاف النفط بعد أقل من عقد على إعلان الدولة السعودية الثالثة باسمها الحالي. وإذا كان للحدث الأول منطقه التاريخي الداخلي المؤكد، رغم فجائيته، فإن الحدث الثاني يمكن أن يُعد شيئًا من شطح الخيال الأكثر غرابة حينها. فالعلم الحديث كله كان غريبًا تمامًا عن الثقافة السائدة في جميع المناطق التي شملتها الدولة الجديدة بما هي ثقافات شفاهية عتيقة في جوهرها، ولا يوجد تواصل وتفاعل كبير فيما بينها. ولا نظن أحدًا يشك اليوم في أن تلك الشركات الأمريكية لم تكن لتحقق اكتشاف “الكنز المخبأ”، لولا أنها كانت في الطليعة من سيرورة الحداثة العلمية والتقنية، حتى بالنسبة إلى الشركات البريطانية السبَّاقة إلى المنطقة كما نعلم. بناءً عليه، ينبغي لنا أن نستحضر الأبعاد الأخرى لهذه الحداثة الطارئة الفعالة؛ لكي يكتمل المشهد، ويتسع مجال الدلالة.
لم تكن هذه الأبعاد الواضحة مفهومة أو قابلة للإدراك في الوعي الجماعي، رغم فعاليتها الإنجازية التي يراها ويندهش منها كل من يحضر في مجال اشتغالها. وكم هي قليلة كلمة “الصدمة” هنا؛ لأن الفجوة الحضارية بين البيئتين تُقاس بالحقب التاريخية الطويلة حتمًا. لهذا السبب لم يبادر أحد من فضاء الاستقبال إلى مجرد تدوين الحدث وتسلسلاته؛ لأن غالبية الناس في المنطقة كانت تعيش وضعية الثقافة الشعبية المفارقة تمامًا لعصرها. ولو أن أحد ممثلي “النخب” كتب شيئًا عن الحدث، لكرر بصيغة خاصة ما دوّنه الشيخ الأزهري حسن العطار عن تلك الأعاجيب والحيل التي يتقنها “فرنساوية” بونابرت: “ولا تتسع لها عقول أمثالنا”!
نعم، ستبدو عبارة “الصدمة الحضارية” قليلة جدًا هنا؛ لأن علاقات التفاعل توشك أن تكون ذات اتجاه أحادي، بما أن الأثر الأقوى يتجه من الشركة العملاقة إلى الطبيعة الصامتة والبشر بالمنطق نفسه. لقد تطلب الأمر عقودًا من الزمن حتى يتغير الوضع بشكل تدريجي لكنه حاسم. وهنا، تحديدًا، يبرز دور الدولة الوطنية بوصفه فاعلًا رئيسًا في السيرورة الجديدة؛ فبفضل اكتشاف النفط وتزايد عائداته تمكّنت الدولة من تعزيز قدراتها الخاصة كبُنية كبرى مسؤولة عن تنمية مختلف البنى الصغرى في “مجتمعها”. ومع أن أرامكو ساهمت بقسط جيد في سيرورة التعليم والتدريب لمنسوبيها في المراحل الأولى، فإن التغيير الحاسم يتصل بالدولة في المراحل التالية. ولا مجال هنا للخوض في التفاصيل وبين أيدينا اليوم عدد وافر من النصوص التوثيقية المعرفية والأدبية التخييلية عن تلك الفترة. ما ينبغي التركيز عليه يتبلور في ثلاث قضايا مختلفة ومترابطة دونما شك.
القضية الأولى منها أننا لا نجد صدى يُذكر لهذه الحداثة العلمية الفعالة المؤثرة، التي شكلت أرامكو علامتها الكبرى منذ الثلث الأول للقرن الماضي، في خطابنا الأدبي الذي باشرته النخب الحجازية فيما بين الحربين، وكان يمثل طليعة الخطاب الثقافي الوطني بمجمله. وغياب الجدل حول الحداثة في نصوص جيل الرواد ينطوي على مفارقة تعزز ما ذهبنا إليه آنفًا، فممثلوه الأكثر تفتحًا وتأثيرًا، وأعني حسن عواد وحمزة شحاتة وأحمد السباعي، كانوا معجبين تمامًا بالنخب المصرية الطليعية التي أيقظت جدلًا قويًا في العشرينيات حول الحداثة، وإن كانت تحت مسمى “المودرنيزم” الذي نقله توفيق الحكيم هكذا بلغته الأصلية!
القضية الثانية أن الجدل حول الحداثة وإشكالاتها بدءًا من نهاية الثمانينيات، أثاره الجيل الثالث من نخبنا الأدبية. ويمكن القول إن بسيط الضوء الحداثي الذي تسلل إلى خطابنا، لم يكن ليتحول إلى قضية “اجتماعية عامة”، لولا قلق العاطفة الدينية، وقتذاك، من كل جديد مختلف!
القضية الأخيرة أشبه ما تكون بالأطروحة التي توسعت فيها قليلًا ضمن دراسة سابقة عن “ضمور الخطاب العلمي في الثقافة العربية الراهنة”، فلا أعرف أحدًا من باحثينا ونقادنا وعموم مثقفينا توقف عند الدور المركزي الذي أدَّاه العلم الحديث وثوراته المتعاقبة المتسارعة في “صنع” الحداثة الغربية، ثم فرضها على مستوى كوني.
منطقي إذًا ألا يكون دور أرامكو، حتى بعد سعودتها، حاضرًا كما يستحق في الوعي العام إلى يوم الناس هذا. نعم، بدأت “الدولة” ذاتها منذ سنوات تقحم خبرات هذه البنية الحداثية الكبرى في غير مجالات النفط بدافع الحاجة الماسة إليها.. لعلنا في بداية الطريق!
في آخر زيارة ثقافية إعلامية للمؤسسة الحداثية العملاقة، تجوَّلنا في عدد من المباني والأقسام والمواقع، وهنا لن أنسى مشهدين: الأول مجموعة من المهندسين السعوديين الشباب الذين عادوا توًّا من ألاسكا حيث عملوا هناك بضعة أشهر “خبراء” في شركات أمريكية، كما قال مرافقنا الرئيس عبدالله جمعة. والثاني تلك المنشآت البرية والبحرية التي تراها من الجو شبكة هائلة من الأنابيب المتنوعة المترابطة تتوزع في كل اتجاه لتذكرك بأن شرايين الحياة الحديثة في الجسد الوطني كله تبدأ من هنا!
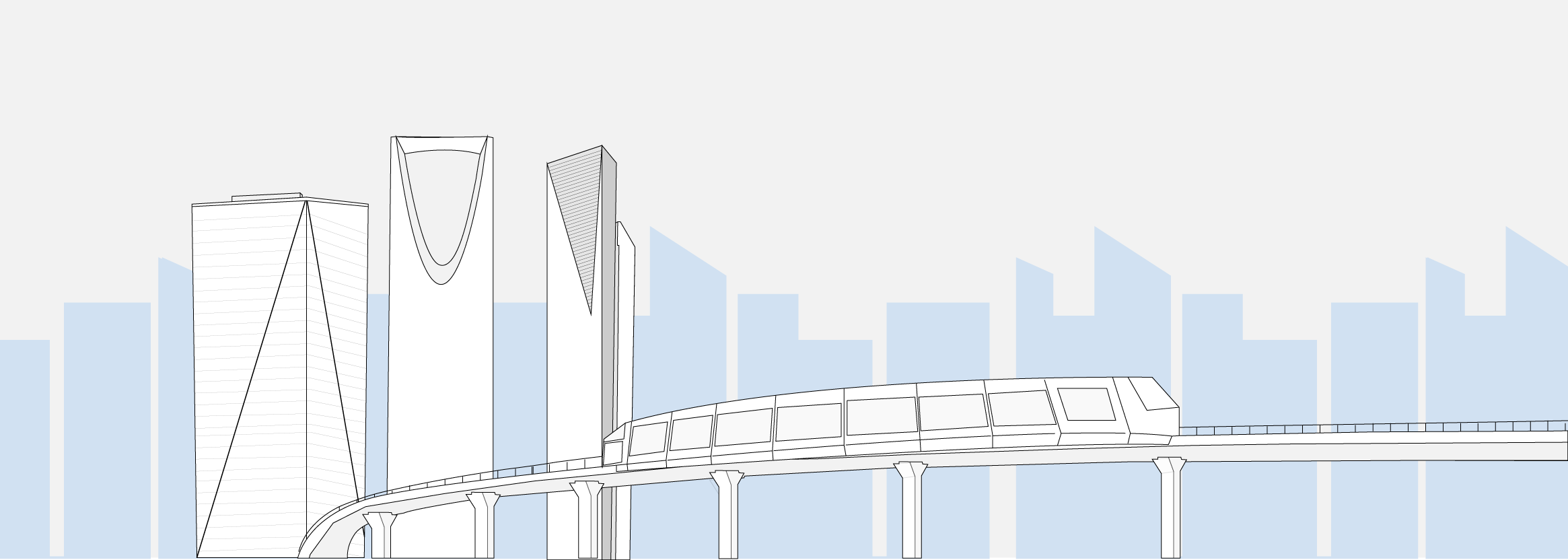

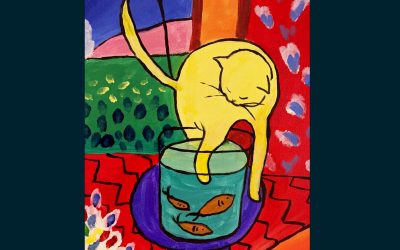

اترك تعليقاً