كيف تتأثر بكتاب لم تلمسه؟
عندما صدر كتاب الفرنسي بيير بايار “كيف تتحدث عن كتاب لم تقرأه؟” بالفرنسية عام 2007م، أتذكَّر أننا بدأنا نتكلم عنه دون أن نقرأه! كان المتاح عن الكتاب مراجعة نقدية مترجمة من الفرنسية لا يمكن أن تنقل كامل محتواه، وتصورنا أن رسالته النهائية هي السخرية من ظاهرة التشاطر الثقافي والغش المرتبط ببعض محترفي الندوات الأدبية من النقاد الذين يذهبون لمناقشة كتب لم يقرؤوها، ربما يُقلِّبون صفحاتها بسرعة في الطريق إلى الندوة: كلمة الغلاف، وفقرة من البداية، وأخرى من الوسط. وبعد هذا التصفح السريع يرون أن بوسعهم التحدث لمدة ساعة يدبرون أنفسهم خلالها كيفما اتفق!
يمكننا القول إن عدم التردد في تأويل كتاب لم نقرأه يُثبت صواب نظرية مؤلفه. ولم تكن الوجهة التي أخذناه إليها سوى نوع من توجيه الكتاب لحاجة في نفوسنا؛ وهذا هو التفكير بالتمني. افترضنا أنه يواجه سلبية ثقافية عربية نيابة عنا، وربما كنا سعداء باكتشاف أننا لسنا وحدنا.
عزت القمحاوي
أثر الكتاب دونما قراءة
وفي مقابل توجيه الكتاب نحو التهكم من اللاقراءة، كانت للروائي الراحل جمال الغيطاني نظرة أخرى حين قال: “وماذا في ذلك؟! لقد تأثرنا جميعنا بـ (عوليس) جيمس جويس دون أن نقرأها”. وهذا يبدو صحيحًا تمامًا؛ فقد بدأ الأدباء ينتبهون إلى السمات الفريدة التي جعلت تلك الرواية إحدى أهم الروايات في تاريخ هذا الفن، ومن بينها الاهتمام باليومي وحس الفكاهة والعبثية والفوضى والتفكير الباطني (تيار الوعي) والجرأة في استخدام اللغة وتعدد مستوياتها.
وقد انتظرنا نحو عشر سنوات حتى صدرت الترجمة العربية لكتاب بايار عن دار كلمات في الكويت بترجمة غسان لطفي، لنكتشف أن الكتاب يتضمن شيئًا آخر عميقًا وحقيقيًا ربما كنا أحوج ما نكون إليه اليوم في عصر وسائط التواصل الاجتماعي، التي جعلت من القراءة سباقًا لتحدي الذات وتحدي الآخرين بعدد الكتب التي يقرؤها أحدهم في شهر أو عام، بينما يدعو بايار إلى أن نحيا مع الكتب لا أن نعدها.
يبدأ بايار باعتراف تهكمي من نفسه، مؤكدًا أنه اضطر كثيرًا للحديث عن كتب لم يقرأها. وبخصوص تحقق الأثر من دون قراءة، يتطابق رأي بايار مع ما قاله جمال الغيطاني ذات يوم عن علاقته وعلاقة جيل الستينيات المصري بعوليس. يقول بايار: “الكثير من الكتب التي نعتقد أننا لم نقرأها تمارس علينا تأثيرًا ليس بالهين من خلال ما يصلنا عنها من أصداء”. ويعتقد بايار أن مفهوم اللاقراءة بحد ذاته مفهوم غامض؛ فبين كتاب قرأناه بتمعن وآخر لم نمسكه يومًا بين أيدينا ثمة درجات من القراءة واللاقراءة. ويستشهد بأحد أبطال رواية روبرت موزيل “رجل بلا صفات”، وهو جنرال أراد أن يتثقف ليحقق التفوق على جماعته، وعندما ذهب إلى المكتبة سأل أمينها عن عدد المجلدات التي تحويها رفوفها فأجابه إنها ثلاثة ملايين ونصف المليون كتاب. وهكذا فإذا أراد أن يقرأها سيحتاج إلى عشرة آلاف سنة. وهنا أدرك أن كل قراءة هي في الوقت ذاته لاقراءة.
هذه هي الحقيقة غير السعيدة التي توصل إليها الجنرال، ولا بد أن كل قارئ يتوصل إليها حتى أمام مكتبته الشخصية، فكلما تقدَّم به العمر وجد أن لديه كثيرًا مما لم يقرأه، بينما في الخارج تمطر المطابع كُتبًا!
المكتبة المنسية داخلنا
لحسن الحظ أن هناك حقيقة أخرى سعيدة يشير بايار إليها وهي “المكتبة المنسية داخل كل منا”، فما قرأناه يومًا ويبدو بعيدًا أو ضائعًا تمامًا هو في داخلنا ويمكن استدعاؤه.
والحقيقة الأهم في الواقع هي أن كل كتاب جزء من سلسلة؛ قائم على كُتب سابقة وسيؤثر بشكل ما في كتب سوف تأتي بعده. ولكي ندرك هذه الحقيقة بشكل أوسع وندرك معنى القراءة واللاقراءة ينبغي أن نتأمل الأثر الباقي في الشعوب من حضارات ما قبل التاريخ وما يؤثر في الأميين الذين لم يمسكوا بكتاب واحد في حياتهم. ألا يشبه ذلك الدوران للمعرفة انتقال العناصر بين النبات والحيوان والبشر في دورة الحياة الطبيعية؟
إدراك هذه الحقيقة يجعلنا ندرك أن مفهوم القراءة ملتبس بسبب عجزنا عن قراءة كل الكتب ومفهوم اللاقراءة ملتبس كذلك بسبب أن القراءة ليست الوسيلة الوحيدة لنقل المعرفة. وهكذا، يمكننا أن نفكر بأن ما أتى به جيمس جويس من سمات صنعت عظمته، مثل صوت الوعي الداخلي، سبقه إليه آخرون مثل دوستويفسكي وماشادو ده أوسيس وغيرهما، بل إن بنيته ذاتها ليست سوى استعادة كاملة لبناء أوديسة هوميروس، وقد امتد أثر جويس نفسه في صف طويل من الكتاب يتأثر لاحقهم بسابقهم واحدًا بعد واحد.
في مقابل هذا التوصيف المنطقي للأثر الأدبي وسلسلته المتواصلة كانت صيحة “نحن جيل بلا أساتذة” الشعار الأشهر الذي ارتبط بجيل الستينيات الأدبي في مصر، دون أن يعرف كثير ممن يتذكرونها من قالها بالتحديد.
صاحب المقولة هو القاص محمد حافظ رجب (1935 – 2021م)، الذي كان في بداية حياته بائعًا متجولًا في مدينة الإسكندرية. لم ينل تعليمًا جامعيَّا، وهذه سمة فارقة لذلك الجيل العصامي في الثقافة المصرية؛ فمعظم نجومه لم ينالوا تعليمًا جامعيًّا، بخلاف جيل الرواد من بداية القرن العشرين الذي حظي معظم كتابه بمنح دراسية أوروبية، من أمثال محمد حسين هيكل وطه حسين ويحيى حقي، فيما كانت عصامية العقاد فريدة بين هؤلاء.
على أي حال ما زالت صيحة محمد حافظ رجب تتردّد إلى اليوم. وعندما نعود إلى الطريقة التي استُقبل بها رجب نفسه ندرك أن ذلك الغضب كان غضبه الشخصي لا غضب جيله كله. لكن الغضب ليس مبررًا لتلك الصيحة التي تجافي طبيعة الأدب وطبيعة التناسخ الثقافي، وهي تنطوي على خطأين رئيسين. أولهما استحالة أن يكون هناك من يبدأ الكتابة من الصفر دون الاستناد إلى تاريخ الكتابة الطويل، وثانيهما الحديث باسم جيل قد لا يوافق كل أبنائه على تلك المقولة.
والأثر الذي تركه محمد حافظ رجب نفسه كأحد مكونات النسغ الذي جرى في ساق شجرة الأدب يُناقض تصوره الغاضب. جاء رجب برؤية سريالية لم تكن بدعة، لكنها كانت غريبة في مرحلة عنوانها الالتزام، وصارت مجموعاته القصصية، مثل “كائنات براد الشاي المغلي” و”الكرة ورأس الرجل” و”اشتعال رأس ميت”، بمثابة هزة كبيرة مضادة للواقعية، والذي حدث بعد ذلك أن ما كان يكتبه أصبح تدريجيًا متوقعًا وشبه مكرر؛ فجف كغصن، لكنه ترك أثره داخل السلسلة أو دورة حياة الأدب.





الوقوف على أكتاف من سبق
هذا الوعي بآلية التأثير والتأثر في الأدب يُحتِّم علينا الانتباه إلى الانقطاعات التي تعانيها ثقافتنا العربية، والعمل على رأب الصدوع التي تنشأ بين الأجيال لأسباب يكمن بعضها في عيوب الصناعة الثقافية وفي المركز منها صناعة النشر، وبعضها يستند إلى نظرة أدباء كل جيل بفخر إلى أنفسهم، والنظر غالبًا إلى السابقين باستهانة أو تقديسهم أحيانًا، وكلتا النظرتين غير صحيحة ولا مفيدة.
ولا بد من الانتباه إلى أنه ليس من العدل مقارنة كاتب من البدايات التأسيسية بكاتب حديث؛ كلٌ يؤدي دوره في حدود واقعه التاريخي. وعندما نفكر بسلسلة الأدب فالكاتب السابق مهما كان “بسيطًا” له على الأقل فضل السبق، ونصه “البسيط” يسهم في تكوين نص أكثر تركيبًا وحساسية، وكان من الضروري أن يوجد النص البسيط ليولد النص الحساس.
كان لا بد من نص زينب فواز ليصبح هناك نص هدى بركات، وكان لا بد أن يكتب محمد حسين هيكل رواية “زينب” لكي نقرأ “حرافيش” نجيب محفوظ. وبالمثل، كان لا بد من عبدالقدوس الأنصاري صاحب “التوأمان” لكي يكون هناك عبدالعزيز مشري وحسين علي حسين، وبعد ذلك رجاء عالم وعبده خال، ثم محمد حسن علوان وعبدالله ناصر، ثم كل كاتبة وكاتب يكتبان اليوم جملتهما الأدبية الأولى في المملكة.
وكل كتاب يجد قارئًا فهو يترك أثرًا لا يجب أن نتعالى عليه أو نغفله. وبالعودة إلى جيل الستينيات بالتحديد، كان إحسان عبدالقدوس كاتبًا بالغ الانتشار في جيله بينما لم يكن ذلك الجيل يحسب له حسابًا كبيرًا، فكانوا يرون أن كتابته هي روايات وقصص صحافية خفيفة. لكن أثر إحسان عبدالقدوس الاجتماعي كان هائلًا، وكان انتشاره الواسع سببًا مهمًا من أسباب تدعيم عادة القراءة، وها هو الجيل الجديد من قراء اليوم يستعيده بكل حفاوة. وقد تكرر الأمر حديثًا مع الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق الذي لم يدرك كثيرون حجم تأثيره في جيل كامل من القراء، بعضهم صاروا كُتَّابًا “أعمق” منه شخصيًّا لكن أثره باق فيهم كتَّابًا، كما أنه ساهم في جعل عادة القراءة مطروحة في المجتمع المصري بشكل كبير.

من أجل شجرة أدب خضراء
هذه الأمثلة التفصيلية أذكرها للتوضيح، ويجب ألا تنسينا أننا نتحدث عن أدب عربي واحد يمثل شجرة دائمة الخضرة؛ تتساقط بعض الأوراق وبعض الغصون، لكن ينمو غيرها على الدوام. والكاتب الذي لا أحبه لذاته لا يمكنني أن أتجنب أثره في كاتب أحبه. كل هذا يجب أن يفتح أعيننا على عيب الانقطاعات المزمن الذي تعانيه الثقافة العربية، حتى أصبحت صيحة “جيل بلا أساتذة” الخاطئة تمامًا فكرة مضمرة في اللاوعي الثقافي، وهكذا تأتي حقب لتلغي أخرى، وهذا بالمحصلة ليس في صالح ثقافتنا.
علينا أن نتأمل حضور الماضي في ثقافات الآخرين. بقاء شكسبير في الإنجليزية وسرفانتيس في الإسبانية وبروست في الفرنسية ليس لعبقريتهم فقط، بل لأن هناك صناعة ثقافية ودور نشر عريقة تجعلهم حاضرين دائمًا، من خلال مسارح قوية تعيد تقديم مسرحيات شكسبير بصفة دائمة، ودور نشر عريقة التقاليد توفر الطبعات الجديدة من كتبهم، بالإضافة إلى التأليف حول حياتهم ونصوصهم بين وقت وآخر، وإصدار كتب مقتبسات من أعمالهم، وتبسيط كتبهم للأطفال والمراهقين.
ليست لدينا هذه التقاليد الثقافية وتقاليد النشر لكي نحافظ على حياة الرواد، باستثناءات بسيطة كما في حالة طه حسين. وللأسف وجد العيب التاريخي سببًا جديدًا ليتفاقم في عصر التسويق، حيث تتفتح الشهية للجديد على الدوام، الأمر الذي أطلق سباقًا بين دور النشر للاندفاع إلى الأمام. ويشارك في هذا السباق القراء أنفسهم والكُتَّاب أيضًا الذين يستخدمون وسائط التواصل للتسويق لأعمالهم الجديدة. وسواء أفعلوا ذلك محبة للحالة التسويقية أم خضوعًا لها؛ فالنتيجة واحدة: كتاب العام الحالي يغطي على كتاب العام السابق ويمحوه!
بالمنطق، لا يمكن إجبار دور النشر الخاصة على السير ضد فلسفة حقبة التسويق الحاكمة، وهذا يعني الحاجة إلى مؤسسات الثقافة الرسمية والمؤسسات غير الربحية لتتولى رأب صدوع الذاكرة الأدبية بنشر النماذج المهمة من تراث الكتابة القريب والبعيد.


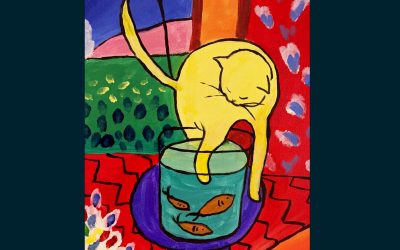

اترك تعليقاً