بين أحلام الصبا ومضامير الأدب
لطالما حلمت في صباي بحصان أدهم مثلما يحلم طفلٌ وحيدٌ بأخ. كان أقراني في المدرسة يحلمون بدرّاجة هوائية، أما أنا فقد رأيت أن الحصان يمكنه أن يكون درّاجةً حيّة وأخًا في الوقت نفسه. كان هذا بالطبع قبل إدراكي أن خلف كل شيء تقريبًا في هذه الحياة قصاصة من الورق المقوى تشير إلى ثمن لا يقبل التفاوض.
عبدالله ناصر
نظريًا، كان ثمة مساحة فارغة في بيتنا القديم تكفي لبناء سياج أو حلبة أو حتى إسطبل صغير لحصاني الأدهم، إذ لم يتجاوز مسطح بناء البيت أكثر من ثلثي مساحة الأرض. فالمالك، الذي لم يكن أبي، كان قد أغفلها إما لشح في المخيلة أو في الميزانية، أو لعله هو الآخر كان يحلم في صباه بحصان أدهم.
كم تخيلت ذلك الحصان يدنو قبل النوم من شباكي فيمد عنقه، حتى إذا أطفأت أمي نور الغرفة ما عدت أستطيع أن أراه لفرط سواده فكأنه صار قطعةً من الليل، قطعة رشيقة وسريعة من الليل. على أني ما كنت لأمانع لو كان عندي حصان بني مثل «ويسل جاكيت»، فرس السباق الذي خلده الرسام البريطاني جورج ستابس، أو أشهب مثل العظيم «سانت برنارد» حصان «نابليون»، أو حتى رمادي مثل حصانه الآخر «مارينغو» العربي. لكني لم أحلم قط بجواد خارق يفتح البلدان، لو كنت كذلك لاخترت أول ما اخترت «بوكيفالوس» جواد الإسكندر المقدوني، وقد زعمت الأسطورة أن بوكيفالوس كان يأكل من لحوم البشر. فإن لم يرغب بي فارسًا، اخترت «الأبجر» جواد عنترة بن شداد. وقد كان جوادًا وكاتبًا لسيرته في الوقت ذاته، إذ كان يدوّن أمجاد عنترة مجدًا تلو الآخر ويشهد على بطولاته، أو ربما اخترت «قرزل» الطفيل الذي كان يصادم الكتائب والكواكب ويفتدي كل مرة صاحبه بنفسه، أو تخيرت على الأقل إحدى خيول سيف الدولة التي يزعم المتنبي أنها تكاد تطوي مسيرة خمس ليالٍ في وثبة واحدة كأنها بساط الريح.
إنما أردت حصانًا ألاعبه ويلاعبني، فلا أخوض على صهوته الحروب، ولا أدفعه إلى العمل في الحقول أو جرّ عربات السيّاح والمتنزهين طوال اليوم. لم أعلم وقتها بالطبع أن ثمن الحصان العادي كان أكثر من ثمن الإيجار السنوي لبيتنا القديم. ما كنت أمتلك حتى ثمن حدوة الحصان، لكن ربما استطعت أن أتسلل ليلًا إلى المطبخ بعد أن ينام البيت لأسرق لحصاني الأدهم قليلًا من مكعبات السكّر فأطعمه بيد وأمسح على قصبة أنفه باليد الأخرى، ليحمحم في شكر وامتنان ثم يعاهدني في كل مرة أن يحفظ السرّ، فلا تعلم والدتي شيئًا عن عمليات التهريب الليلية.
مناجاة مكلوم
لطالما كانت الخيول عندي مثل إخوة، حتى إني قد شعرت بما شعر به أحد شخوص القاص المغربي أحمد بوزفور حين انتقل من القرية إلى المدينة فإذا هم هناك يبيعون لحم الحصان، ما دفع ذلك الرجل إلى التساؤل في اشمئزاز وأسى: “كيف يأكل الإنسان لحم أخيه؟”.
وفي «قدّاس لفلاح أسباني»، وهي رواية قصيرة «لرامون سندر»، اعتاد الحصان أن يدخل الكنيسة فيطوف بين صفوفها على مرأى القس الذي كان ينخرط في البكاء حالما يراه بدلًا من أن يهرع لطرد الحصان إلى الخارج. كان القس قد أخبر رجال الحكومة بمكان الفتى الثائر بعد أن أخذ منهم عهدًا غليظًا ألا يقتلوا الفتى الذي كان قد عمّده بنفسه، فإذا هم يسارعون إلى تصفية الفتى بالرصاص، فيذهب حصانه الساخط وحيدًا إلى الكنيسة ثم لا يكف عن التردد عليها بين الحين والآخر ليلوم القس، ويؤكد أنه لن يغفر وشايته أبدًا. وهذا «كولورادو» حصان «ميغيل بارامو»، في رواية «بيدرو بارامو» للمكسيكي خوان رولفو، يعدو كل يومٍ في مختلف الاتجاهات بحثًا عن صاحبه، حتى إذا علم الناس بمقتل ميغيل شعروا بالأسى على الحصان أكثر من شعورهم بالأسى على والد القتيل.
ألم أقل إنه أخ؟ يمكن أن نشكو له كما فعل حوذي «تشيخوف». كان «إيونا بوتابوف» الحوذي قد فقد ابنه قبل أيام، وما كان يجد أحدًا يشكو له من مرارة الفقد ولوعته فضلًا عن أن يواسيه. ما كان الركاب القلائل يرغبون في الإنصات ولو قليلًا إلى قصص مكلومة حزينة، ولما كان يقضي وقتًا طويلًا في الانتظار بادر بالحديث إلى أحد البوابين فإذا هو يصرفه في الحال. لقد مضى يومه الثقيل دون أن يكسب من الأجر ما يكفي حتى لشراء الشعير. عاد إلى حيث ينام فوجد حوذيًا شابًا فأخبره عن فقدانه لابنه فما كان من ذلك الشاب إلا أن أدار ظهره وغط في النوم. خرج إلى الإسطبل حيث الحصان فأخبره عن الحمى التي أصابت ابنه فقضت عليه في غضون ثلاثة أيام. التفت الحصان نحوه وقد كان ينصت إليه وزفر طويلًا على يدي إيونا بوتابوف حتى اندفع الأب المحزون ليحكي كل شيء من البداية. ربما تكون قصة تشيخوف هذه من أجمل القصص التي تناولت علاقة الإنسان بالحيوان، وإن عن بعد، بل لعلها تشرح ميل بعض البشر إلى امتلاك الحيوانات الأليفة.
لهفة طفل وسكينة ليل
عندما حصلت على المركز الأول في الصف الرابع الابتدائي، سألني أبي على سبيل المكافأة والتشجيع: “أيّ هدية أرغب؟” فأجبت بلا تردد: “أريد أن أركب حصانًا”. لا أتذكر من تلك التجربة غير رائحة الحصان الغريبة وعنقه الطويل الضخم والسرج المؤلم، مع أن المتنبي قد زعم، وما أكثر ما يزعم، أن السروج هي مجالس الفتيان لا تلك المجالس التي في البيوت.
من ذكريات ذلك العام أني رافقت أمي إلى السوق فألححت عليها في نزوة لم تعهدها مني أن تشتري لي حذاء جلديًا أسود. كنا قد مررنا بمحلات الأحذية يومها فرأيت حذاء طويلًا يشبه ما يرتديه الفرسان وإن لم يصل أبعد من منتصف الساق. ما كانت أمي لتقنعني أننا في فصل الصيف، وأن هذا النوع من الأحذية يلائم الشتاء الطويل الماطر، والمدينة الصحراوية التي كنا نقيم فيها لا تكاد تعرف المطر. ثم إن الحذاء الطويل يختفي أصلًا تحت الثوب الأبيض فلا يعود ثمة فرق بينه وبين حذائي الذي ما زال جديدًا، إذ كانت قد ابتاعته قبل أشهر من أجل العيد. ولما لَمَستْ لهفتي الشديدة عادت بالحذاء وسعادة ابنها دون أن تعود بحاجات البيت الضرورية، على أنني لم أنتعل أبدًا ذلك الحذاء الطويل خوفًا من أغدو أضحوكة في المدرسة والحيّ. والأطفال قساة هم أيضًا حين يتنمرون على بعضهم البعض. كان إخراج الحذاء الأسود كل ليلة من تحت السرير والنظر إليه يكفي ابن العاشرة ليعتلي صهوة حصانه الأدهم المتخيل وينطلق به لينهب السهوب عدوًا. حين قرأت “الذكريات الصغيرة” لـ«خوزيه ساراماغو» وجدت بيت الكاتب البرتغالي تمتلئ جدرانه بصور الخيول كما لو كانت مضمارًا، حتى إن من كان يزوره أول مرة يسأله في الحال ما إذا كان فارسًا، ليرد عليه البرتغالي إنه: “ما زال يعاني آثار السقوط من سرج حصان لم يركبه أبدًا”. ويضيف: “ربما لا يلاحَظ هذا من الخارج، لكن روحي تسيرُ عرجاء منذ سبعين عامًا”.
قلت لنفسي مرة إنني لو امتلكت حصانًا في ذلك الوقت لكان قد مات قبل سنوات، فالخيول لا تعيش طويلًا، لأغدو بعد موته مثل أرمل. أقضي الليالي الطويلة في التحديق في عينيه الجميلتين المعصوبتين بالتراب. هذا إذا لم تُكسر ساق الحصان قبل ذلك فيتحتم علي قتله، أو نتعثر في إحدى جولاتنا الجامحة فأسقط عنه ولا يسعفني الحظ لتخليص قدميّ من الركائب ليهوي علي الحصان بوزنه الثقيل فيسحقني.
لكني ما زلت أتخيل حصاني الأدهم منذ ذلك اليوم حرًا من اللجام والسرج والركائب والمهماز والحقول والشوارع والحروب. يعدو مع خيط الصباح الأول فلا يتوقف إلا ليمضغ بعض الحشائش أو ليستريح في قيلولة قصيرة. عندما أتساءل الآن عن سرّ ولعي بالخيول بعيدًا عن تاريخها البطولي في المخيلة الشعبية، وبعيدًا حتى عن جمالها المفرط الذي لا يُمل تأمله مثلما لا يُمل النظر إلى الشروق أو الغروب، أرى أن ما جذبني إليها في الأساس كان طبعها الهادئ الذي يترفع عن الصخب والضوضاء والنزاع. تتجنب الخيول بفطرتها الرزينة كل ما يدعو إلى التوتر فتغادر المكان ببساطة عند الشعور بالانزعاج. بل لو نشب صراع بين جوادين لتدخل على الفور جواد ثالث لفض النزاع. لا تسعى الخيول قط إلى المواجهة وتفضّل على ذلك الهدوء وراحة البال. لعلي أشترك معها في هذا تحديدًا، أو ربما لم أحلم بالحصان الأدهم إلا طمعًا في سكينته وطمأنينته.
ما زلت أتخيل حصاني الأدهم منذ ذلك اليوم حرًا من اللجام والسرج والركائب والمهماز والحقول والشوارع والحروب. يعدو مع خيط الصباح الأول فلا يتوقف إلا ليمضغ بعض الحشائش أو ليستريح في قيلولة قصيرة.


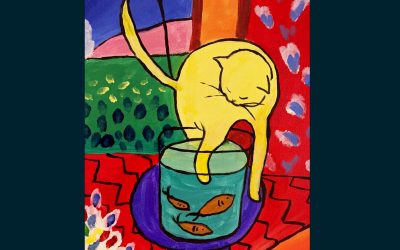

جميل وإنساني هذا المقال