
نُشرت في عدد شعبان 1377هـ (مارس 1958م)
كانت هوايتي الأولى منذ صدر شبابي، التنقيب عن الآثار ومعرفة أخبارها وتطوراتها، وساعدني على ذلك كثرة الآثار بالمدينة المنورة. سواء ما كان منها جاهليًا عريقًا في الجاهلية، أو قريبًا من الإسلام، أو ما كان إسلاميًا في صدر الإسلام، أو بعد ذلك. وكانت أولى خطواتي في هذا الميدان استيعاب الكتب التي بحثت عن آثار المدينة في القديم، مثل كتاب “وفاء الوفاء” للسمهودي، وكتاب المطري والمراغي وغيرهم من قدامي العلماء الإسلاميين الذين عُنوا عناية خاصة بآثار المدينة المنورة في عهودهم المتسلسلة.
ثم كانت الخطوة الثانية الاستقراء العملي، والدراسة الواقعية، لما كتبوا عنه، فكنت لذلك أتجشم مشاق الوصول إلى كل ضاحية وناحية تحدّث عنها أولئك المؤلفون، مشيًا على الأقدام في أغلب الأحيان، وركوبًا على الحمير في بعض الأحيان. فإذا كانت المسافة نائية أو الطريق وعرة، لا يمكّنني المشي على الأقدام من الوصول إلى ما أبتغي الوصول إليه.
والمدينة ذات طقسين متباينين أحدهما حار لافح، ويمثل أغلب نصف العام، وهو فصل الصيف والحرور. وثانيهما بارد قارس شدید البرودة إلى حد نزول الثلج في بعض الفصول، وهذا هو فصل الشتاء. ولكن الهمة الطموح المنبثقة من جوانحي إذ ذاك، لتحقيق هذه المهمة، كانت لا تدع لي مجالًا للتقاعس عن تحقيقها سواء كان الزمن شتاءً قارسًا، أو صيفًا لافحًا. فكنتَ تراني أتجول في شوارع المدينة يستوقفني “حجر مسنّن” مثبت على باب عتیق، أو دار متهدمة عتيقة، أو مسجد قديم. وكنت تراني أتجول في ضواحي المدينة مُحققًا عن مجرى وادٍ مجهول الآن، ذكره قدامى المؤرخين، أو باحثًا عن منازل لقوم من الأنصار في إحدى تلك الضواحي أورد ذكرها المؤلفون الأولون. وكنت تراني بعض الأحيان أتجاوز كل هذا وذاك، مستطلعًا منقبًا عن آثار لم يوردها المؤلفون، كانت تستوقفني عرضًا في أثناء تجولاتي، فأقف مُصرًا على حل طلاسم رموزها. أقف تارة في صيهود الجو الملتهب، وتارة في زمهرير الشتاء.
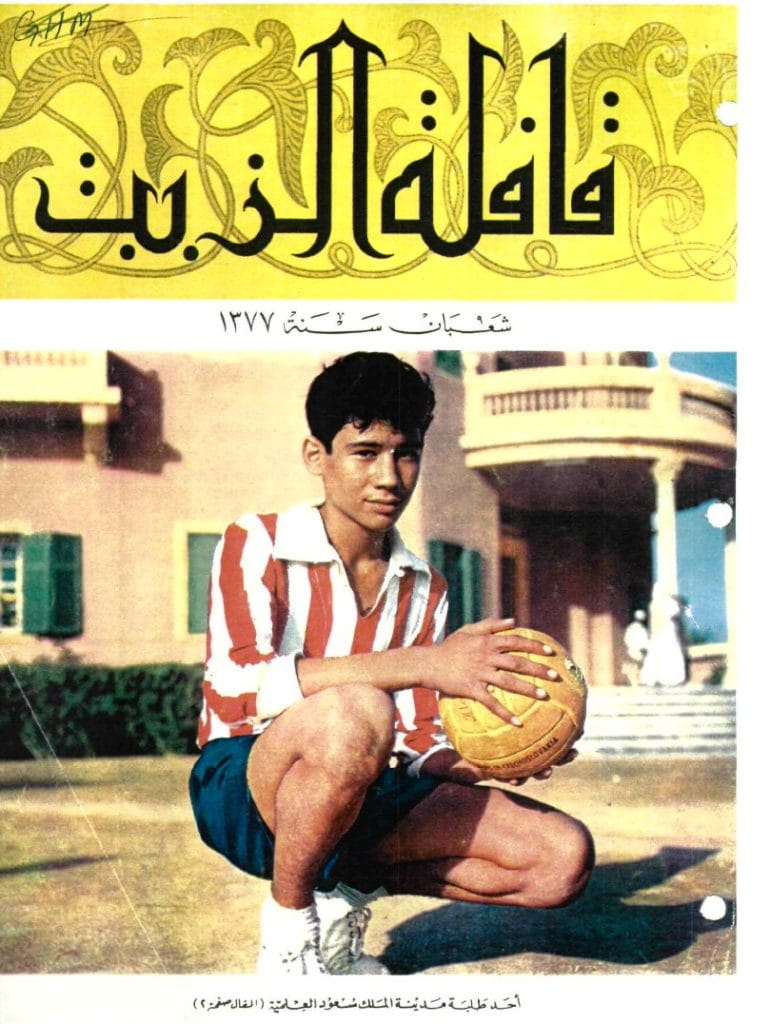

للاطلاع على العدد: 042_58.pdf (qafilah.com)
وكثيرًا ما وُفقت إلى حل طلاسم من الخط العتيق بالمقارنة والبحث والتأمل. مثال ذلك أنه يوجد بقرب السد الواقع جنوب غرب المدينة المنورة، رقعة بيضاء فسيحة من الأرض تحيط بها الجبال من كل ناحية. وبأحد تلك الجبال صخرة ضخمة ملساء استرعى انتباهي إليها وجود نقوش عتيقة مضطربة عليها. فوقفت أمامها في صيهود الشمس الملتهبة زهاء ساعتين حتى وُفقت إلى حل هذا الطلسم من الخط العربي البدائي المنحوت على الصخرة الضخمة الملساء. ويا عجب ما قرأت وحللت! فقد دلني على أن هذه المنطقة الجرداء الملساء كانت في عصر من العصور القديمة عبارة عن رياض غناء، ومنازل أنيقة، ومرتادًا للشبّان في تنزههم وروحاتهم وغدواتهم. ذلك ما عبَّر عنه البيتان المنقوشان بالمسمار على تلك الصخرة الملساء الضخمة التي تمثل جانبًا من جوانب الجبل المثبتة فيه. يقول أحد البيتين عن ذلك الوادي:
وإن الغواني لا يزلن يَرِدنَهُ
وكلُّ فتًى سمحٍ سجيتُّه غضُّ
وقد دفعني حب الاستطلاع يومًا من أيام الصيف اللاذعة إلى أن أمتطي حمارًا من المدينة المنورة وأتوجه إلى طريق “الجصة”. وطريق الجصة اصطلاح لأهل المدينة يعنون به ذلك الطريق الأثري الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، في هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وقلت في نفسي لا بُد لي من استكشاف هذا الطريق بنفسي ورؤية معالمه، لأنه أثر من الآثار التاريخية المهمة، يمثل نقطة تحول عظيمة في تاريخ الحياة البشرية.
ومضَيت على حماري بعد أن وضعت فوقه خرجين للزاد والماء في هذه الرحلة الاستكشافية الغريبة، وحملت عصًا صغيرة من نوع الخيزران، أسوق بها الحمار إذا ما جمح، أو تبلد عن المسير، ومضيت متجهًا صوب جنوب المدينة. لقد مررت على قباء وأخذت الطريق إلى جانبها الأيمن، في اتجاه جنوبي غربي. وتركت بجانبي حديقة “الرفيعة” ومن ورائها شاهدت “أُطم الضَحْيَان”. ذلك الأُطم (الحصن) الأسود الهائل القائم على ذراع الحرة الغربية، وهو الأُطم الوحيد الباقي من آطام الأنصار في عصر الجاهلية. وكان أحيحة ابن الجلاح أحد زعماء “الأنصار” قد بناه في عهد الجاهلية بالحجارة البيض الصغار، فلما رآه عرضة للتهدم أمر بنقضه وبنائه بالحجارة السود الضخام، وما يزال ماثلًا للعيان إلى اليوم، أثرًا خالدًا من آثار العرب القدامى في فن البناء.
بدأت أتوغل في الحرة ورأيت أمامي خطًا دقيقًا باهتًا أكل الدهر عليه وشرب من خطوط الطرق القديمة. إن هذا الخط الدقيق المتفاني يمثل طريق الجصة الأثري. وتتبعته ومضيت لا ألوي على شيء. هذا جبل “عير” حد المدينة المنورة الغربي الجانبي. وتكاثرت الجبيلات عن يميني وعن شمالي، وبدأ حماري يتعثر. إذ كانت الطريق وعرة مهجورة والحجارة بها متوافرة. وقد نفعت العصا فصرت أزجره بها زجرًا هينًا خفيفًا.
ها نحن الآن قد أوغلنا في الجبال، وقد مضت ثلاث ساعات على خروجنا من المدينة المنورة. ولكن فلنمض قُدمًا. ما الذي أريده؟ ما الذي أسعى إليه؟ لا أدري! إلا أنني أزمعت المضي قُدمًا لألبي هاتفًا عميقًا في نفسي، لا يريد لي العودة رغم طول ابتعادنا عن نقطة قيامنا.
ومضيت. وتطامنت الجبال وصغرت، وقلّت، وصارت هضبات وتلالًا غير سامقة، فسجلت هذا الاختلاف الطبيعي. ها نحن الآن قد مضت علينا أربع ساعات في السير، وقد ارتفعت الشمس فوق رأسي حتى توسطت كبد السماء. وكنت قد استعددت لهذا بمظلة تقيني الحر اللافح، ففتحتها فوق رأسي ومضيت. وقد رأيت إلى الأمام عن يساري جبلًا واطنًا يلوح لي من بعيد. يلوح مشرقًا متوهجًا أبيضَ وضّاء، على عکس جميع الجبال والجبيلات التي مررت بها، وكانت كلها سوداء وداكنة ونحاسية الألوان. أما هذا الجبل الذي نقترب منه رويدًا رويدًا، والذي يقع إلى اليسار من طريقنا، فهو أبيض متوهج، يشبه الأضواء الساطعة في الليل الدامس، والشمس المشرقة في فجوات الضباب كالألماس المتلألئ بين الحجارة السود. ألا يكون جبل ألماس؟ لندع الخيال يسرح ويمرح. فإنني مقدم على الجبل، وعمّا قليل سأكون عنده .
بلغت الجبل المتوهج الساطع، فما خانني البصر. وعند سفحه نزلت من على الحمار، وقيدته حتى لا يفر مني. وأخذت عصاي بيميني، وتقدمت للصعود إلى الجبل، فإذا حيوان أخضر ناضر الاخضرار، أكبر قليلًا من القط، وأصغر من الكلب يقف لي فوق سفحه بالمرصاد. فأخذت حجرًا من الحجارة الكثيرة -وكنت رمّاء بالحجارة- وألقيت بالحجر على هذا الحيوان الأخضر الناضر الاخضرار، الذي لم أرَ له مثيلًا من قبل، سِوى الحرباءة الصغيرة التي تتلون بلون ما تقف عليه فيخضر لونها إذا كانت على غصن أخضر. وبمجرد أن وقع الحجر قريبًا منه وثب عليه فعضه. وسرعان ما أتبعت الحجر بحجر آخر مثله في رمية أقوى من الأولى وأعنف، فلما استهدفه الحجر وكاد يصيبه وثب بعيدًا عنه، وما إن هبط على الأرض حتى وثب عليه فعضه. عندها آثرت المهادنة، فقد يكون هذا الحيوان سامًا، وقد يكون مفترسًا عارمًا، وقد يكون.. وقد يكون. الخلاصة أنني آثرت بعدها طريق السلامة، فانتحيت قصيًا عن طريقه. ومضيت في ترقب وحذر له إلى الجانب الآخر من الجبل.
ويا لدهشتي! لقد لاحظت عندئذ أن الجبل كله فصوص ذات بريق مشرق. وعدت إلى حماري، فأخذت الخرجين ووضعت فيهما كمية لا بأس بها من الفصوص ذات البريق الزاهر، ثم عدت إلى الجبل ثانية فاسترعى نظري هذه القبيبات اللاطئة المفعم بها سطحه من كل ناحية. إنها قبيبات من حجارة الجبل نفسه، ولكنها الحجارة السود الكبيرة والمتوسطة. فقد ظهر لي أن الجبل ذو ثلاث طبقات. طبقة الفصوص المتوهجة ذات البريق الخاطف وهي العليا البارزة للعيان. وطبقة الحجارة الكبيرة والمتوسطة وهي سوداء اللون، وتحت الطبقة السالفة طبقة الصخور الكبرى التي تمثل كيان الجبل الداخلي، وهي سوداء وصفراء باهتة اللون يتخللها تراب وطين أحمر.
وقفتُ عند قبيبة من هذه القبيبات اللاطئة المنبثة على الجبل الغريب، ومن باب الاستكشاف، أقدمت على محاولة رفع حجر من حجارة إحداها. وبجهد تمكنت من رفع حجر، ونظرت إلى داخل القبيبة عن طريق الثغرة التي أحدثتها برفعي الحجر. فبهرني ما شاهدت! لقد شاهدت داخل القبيبة هياكل بشرية ممدودة، ثلاثةً وأربعة وخمسة في كل قبيبة. ولكن هذه الهياكل العظمية الضخمة، مجردة عن اللحم تجريدًا تامًا. وهي أضخم بكثير من هياكلنا الحالية، في الجمجمة والأذرع والسيقان والأقدام وفي كل شيء. وذهبت إلى قبيبة أخرى ففتحتها أيضًا بعد جهد، فإذا المنظر نفسه يتكرر. عندها علمت أن هذه مقبرة مجهولة، عريقة في القدم. والشيء الذي حز في نفسي أنني أدركت من وقتها أن هذه المقبرة لا بُد أن تكون جبّانة لمدينة قريبة منها، وكم وددت لو تُمكنني الظروف من استكشاف موقع هذه المدينة القريبة من هذه الجبانة! ولكن الشمس بدأت تميل إلى الغروب، وخشيت البقاء وحدي في هذا القفر الموحش، خصوصًا بعد أن كاد الماء أن ينفد. وسرعان ما عدت لأمتطي حماري وأرجع إلى المدينة من نفس الطريق التي أتيت منها، فوصلت إليها والشمس قد آذنت بالمغيب.
إنها رحلة شاقة ولكنها ممتعة. أما ما التقطته من الفصوص فقد بقي لدي فترة من الزمن، ثم رأيت عرضها في السوق، وبالفعل عرضتها وفهمت أنها ليست بألماس كما توهمت، وإنما هي من هذه الحجارة المعروفة التي تُدعى في المدينة بـ”حجر المدينة”، وهي تُستعمل أيضًا فصوصًا للخواتم كالألماس تمامًا. ولكنها ضئيلة القيمة. قيمتها يومذاك أشبه بقيمة الألماس الصناعي اليوم. لقد بعت كل ما جمعته يومئذ منها بخمسين ريالًا فقط. وكان الذي اشتراها مني بالجملة أحد الصاغة بالمدينة، وقال لي إنه سينحتها وينظمها ويعمل منها فصوصًا ليبيعها للزوار في مواسم الحج. هكذا آل مصير الفصوص التي ظننتها ألماسًا. وذلك كان آخر عهدي بالجبل المتوهج .
*عبدالقدوس الأنصاري: صاحب مجلة “المنهل”، ورئيس تحريرها.
*شرح الصورة أعلى الصفحة: التلال المغناطيسية في وادي الجن، وتقع على بُعد 60 كيلومترًا تقريبًا من مركز المدينة المنورة.