ينعكس التجريد على حياة الفنانة بلقيس فخرو وسلوكياتها. فهي لا ترسم الأشياء، وإنما ذاكرتها. وفي محترفها، تشير إلى نفسها قائلة: “أحب البساطة في الأشياء؛ ملبسي، محترفي، سلوكي، منزلي… إني أجد المعنى فيها”. فالبساطة تقابل، بمعنى ما، التجريد الذي تنتهجه في تخليق لوحاتها، بما فيها من سكون وطمأنينة تتعدى المعاني التي انطلقت منها في إبداعها، إلى معانٍ مدغمة في روح اللوحة التي تتفجر بدلالات مختلفة عند تأملها، في حين تتلاطم أمواج التأويل وفق سيكولوجية الرائي وخلفياته الثقافية والفكرية.
للفنانة البحرينية بلقيس فخرو، قدرة على حمل المتلقي إلى عوالم الرسوم الأولى (رسوم الكهوف)؛ إذ إن لوحاتها ترسم فضاءات تجريدية تتناغم والمتلقي بوصفها “موسيقى بصرية”، كما تسمِّيها، معتمدةً فيها الهدوء أسلوبًا؛ لتضع النفس أوزار حمولاتها من شقاء الحياة والمعيشة في هدأة اللون والتوزيع الهادئ للكتل والتكوينات.
صاحبة الموسيقى البصرية تلك، رائدة من روَّاد التشكيل في مملكة البحرين، فهي من أوائل الفنانات المشاركات في حركة لم يمضِ على نشوئها سوى ثلاثة عقود، بعد أن تشكَّلت على أيدي الروّاد من الرجال. في حين شكَّل دخولها إلى جانب مجموعة من الفنانات ريادة فنية للمرأة، التي لم تنخرط منذ البواكير الأولى في هذه الحركة على مستوى الخليج العربي عمومًا. وكان هذا الانخراط مؤسسًا أكاديميًا؛ إذ عادت بلقيس عام 1975م إلى البحرين تحمل تخصصين من جامعة سان فرانسيسكو، الأول في الفنون الجميلة، والثاني في تاريخ الفن.
بعد عام واحد، شاركت في “معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية”، لِتتوَّج بجائزة تقديرية، شكَّلت إلى جانب تخصصها وافتتانها بالفنون، دافعًا لتخطيط مستقبلها الذي أضحى ماضيًا مُحملًا بإرث ثري على مدى نصف قرن من العطاء الفني والتجريدي بشكل خاص، شاركت خلاله في كثير من المعارض المحلية والدولية، ونالت العديد من الجوائز والتقديرات، وقدَّمت فيه الكثير من القراءات والكتابات والمحاضرات في مجال الفنون.
من الفلسـفة وعـلم النـفس إلى الفنـون الجميـلة

في وقت قريب من عام 1950م، عام ميلادها، تعرَّفت الصغيرة بلقيس على عالم الرسم الذي فُتِنت به، من دون أن تفهم ماهيته: “لم أكن أعلم ما إذا كنتُ موهوبةً أم لا، لكنني وجدتُ نفسي أنغمس في عوالم الرسـم وأنا طفلة”. وتعزَّز هذا الانغماس في بيئة ثقافية: “نشأت في منزل يضم مكتبة ضخمة تعود لأبي، فيما احتوت مكتبة أختي، الدكتورة منيرة فخرو، على مصادر وكتب تتعلق بالفنون التشكيلية”. وهذه الوفرة من مصادر المعرفة، أتاحت لبلقيس أن تطلع على أعمال كبار الفنانين العالميين، ومنهم الفنان الإسباني بابلو بيكاسو.
لم يمضِ وقت طويل حتى حسَمت بلقيس أمرها بشأن اختيار مجال دراستها الجامعية. ففي بيئة سبعينيات القرن الماضي، التي كان يصعب على الشخص اختيار مجال غير المجالات المحددة سلفًا من قبل العائلة، اتَّخذت قرارًا بالسفر إلى لبنان لدراسة الفلسفة وعلم النفس. وفي منتصف دراستها تزوَّجت، فتركت لبنان لتنتقل مع زوجها إلى ولاية “آيوا” الأمريكية. وآنذاك، شعرت بأنها لم تعد مقيدة بما تفرضه العائلة من تخصصات على أبنائها: “شعرتُ بأني حرة من التقيد بدراسة تلفت أنظار والدي وأسرتي. ولهذا اخترت دراسة الفنون”. لكنها، بعد فترة قصيرة من دراستها، انتقلت إلى سان فرانسيسكو، والتحقت بكلية “لون ماونتين” التي ضُمَّت لاحقًا إلى جامعة “سان فرانسيسكو”. وهناك درست بلقيس الفنون الجميلة وتاريخ الفن؛ لتتخرج بشهادتين في هذين التخصصين.
آخرون ينظرون إلى فنك!
بعد أن عادت بلقيس إلى البحرين عام 1975م، كان أول حضور لها على الساحة الفنية، آنذاك، من خلال مشاركتها عام 1976م في “معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية” الذي لم يكن قد مضى على تأسيسه سوى أربع سنوات.
قدَّمت حينذاك لوحةً انطباعية تُحاكي منظرًا طبيعيًا: “لم يكن بمقدوري، وقد تخرَّجت توًّا، أن أقدم عملًا تجريديًا أو سرياليًا. رغم أني تعمّقت في هاتين المدرستين أثناء دراستي، فإني لم أمتلك الجرأة ولا التجربة الفنية التي تؤهلني لفعل ذلك”. ومع ذلك، فازت لوحتها بالجائزة التقديرية للمعرض، مؤذنةً بفنانة رائدة في ساحة يُهيمن عليها الفنانون الرجال. بَيْد أن ذلك لم يستمر، حيث أوقفت الأمومة التجربة الوليدة تلك. لكن معرضًا نُظّم خصوصًا للفنانات، أعاد بلقيس إلى الساحة.
وفي عام 1983م، نشطت بلقيس في ساحة تضم أسماء فنية كبيرة، مثل الفنان عبدالله المحرقي، والدكتور أحمد باقر، وراشد العريفي. كما شهدت الساحة، آنذاك، عودة عدد كبير من الفنانين الدارسين في العاصمة الفرنسية باريس، والمملكة المتحدة وبعض الدول العربية، وهو “ما أحدث نهضة فنية”، كما تؤكد.
على هذه الساحة، استطاعت بلقيس أن تشق طريقها، وتتفرد بأسلوبها، ولم تكن الساحة، كما قد يتصور المرء، مليئة بالتحديات والصعوبات على امرأة: “فلطالما كان المجتمع البحريني منفتحًا، إذ إننا درسنا في نهاية الخمسينيات على أيدي مدرسات عربيات، تلقينا منهن الانفتاح. ونحن كفنانات ظهرن في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لم نواجه أية صعوبات ومضايقات بوصفنا نساءً، ما مكَّننا من التحرك بحرية”.
التجريد.. إظهار روح الشكل
في سبعينيات القرن الماضي، لم يكن للتجريد حضورٌ على الساحة الفنية البحرينية والخليجية، وإنما “كانت هناك أعمال تكعيبية وبعض الأعمال المعاصرة آنذاك، لكن التجريد بمفهوم تخليص الشكل من التفاصيل، لم يكن موجودًا”. هذا ما تؤكده بلقيس التي ترى أن فلسفة التجريد قائمة على “إظهار روح الشكل”. وهي المنهجية الفنية المحددة لاهتماماتها الفنية، التي أخذت منحى تجريديًا مطلقًا، قائمًا على “الإنشاء والتكوين، المكون من كتلة وفراغ، والحد بين الظل والضوء” على حدّ تعبيرها.

“بخلاف اللوحات المنتجة وفقًا للمدارس الأخرى، فإن اللوحة التجريدية قادرة على التجدد والديمومة، لأنها لا تُحدُّ براهن، ولا ترتبط بواقع محدد”.
تصف بلقيس أعمالها بـ”الموسيقى البصرية”، مشبهةً الوقوف أمام لوحتها بالإنصات لسمفونية: “حين نستمع إلى سمفونية ما، فإنما نشعر بها عوضًا عن أن نستمع إليها. وكذلك اللوحة التجريدية، ترتكز على النظر إليها من خلال أحاسيسك، فهي مجردة من التفاصيل، تمكّنك من النظر إليها بناءً على إطارك المرجعي المشكل من خلفية ثقافية، ومزيج من الحالة النفسية والعاطفية. فهذه هي الأدوات التي من خلالها تتأمل اللوحة”. هذا ما يجعل اللوحة التجريدية، بخلاف اللوحات المنتجة وفقًا للمدارس الأخرى عادةً، “قادرة على التجدد والديمومة، لأنها لا تُحدُّ بِراهِن، ولا ترتبط بواقع محدد”.
ربَّما تستعصي هذه المقاربة للوحة التجريدية على كثيرين، فالموسيقى نافذة للروح على اختلاف الأطر المرجعية لمتلقيها، فيما يُستصعبُ فهم اللوحة التجريدية على عموم الناس. بَيْد أن لبلقيس وجهة نظر أخرى؛ إذ ترى أن “بمقدور كل إنسان قراءة الموسيقى البصرية في اللوحة التجريدية، وذلك عندما تحتوي على حدّة بين الظل والضوء، وتُراعي الدرجات اللونية”. فاللوحة، بوصفها كيانًا فنيًا، أشبه بالموسيقى التصويرية التي يوظفها المخرج السينمائي للعب بالمشهد المصور: “الفنان التجريدي يلعب بالكتل والفراغات والضوء والظل والحدة، وكل ذلك بأسلوب متناغم، ليجعل اللوحة قادرة على أن تُعبّر عن نفسها”.
سيدة الفراغ في وسط اللوحة
استطـاعت بلقيس أن تبدع أسلوبها التجريدي الخاص، بحيث لا يخطئ المتلقي في نسبة العمل إليها من دون حاجة إلى الالتفات إلى توقيعها. وهذا الأسلوب هو وليد تراكمات من الاشتغال والتجريب؛ إذ تتضح ملامحه من طبقة التأسيس التي تشكل خلفيةً تعطي ملمسًا خشنًا لأغلب لوحاتها، مع الفراغ الذي يحتل قلب اللوحة، والكتل المتركزة على أطرافها.
يندر أن نرى تفاصيل شيء ما في أعمال بلقيس، خاصة الحديثة. فالتجريد عندها هو “التعمق في جوهر الشيء، وفق نظرتك إليه، بتقنية تشكّل فيصلًا في أسلوبك التجريدي؛ حيثُ الفراغ في وسط اللوحة، واللعب بحدّة بين عناصر الظل والضوء من خلال الألوان البسيطة، فيما تأخذ الكتل منحى يراعي الهدوء والسكينة”. وما يجعل أعمالها تُدخل المتلقي في لحظة من السكينة النفسية: “لا أحبُ أن أُشعِر المتلقي بالفوضى، إذ أحرص على أن تكون لوحاتي موسيقى بصرية هادئة، ليشعر المتلقي بالتصاعد والهبوط فيها، كما لو أنهُ يستمع إلى سمفونية. ربَّما تنقله اللوحة إلى شاطئ البحر، فيسمع صوت الموج، وأصواتًا ديناميكية تعلو، ثم تهدأ. هذه الحالة الشعورية التي تُحدثها الموسيقى، هي ذاتها التي أبتغي لعملي أن يُوصلها للمتلقي”.

وكي لا تُقيد المتلقي، لا تفرضُ بلقيس رؤى مسبقة لقراءة اللوحة، ولا تمنحهُ خيوطًا للقراءة الصحيحة، فهي لا تؤمن بوجود قراءة كهذه. “لوحاتي مفتوحة للتأمل. أنا لا أُقيد المتلقي، بل أحترم تأويلاته وتفسيراته، مهما كانت هذه القراءة متعمقة أو سطحية”. ولهذا، تزعم أن كل مُشاهد لأعمالها سيجد فيها شيئًا يلمسه. صحيحٌ أن العمل في أصله “يمثل نظرة خاصة بي لشيء ما، أو حالة نفسية، لكن المتلقي حرٌّ في فهمه وقراءته كما يشاء”.
واحدية الفنان بمعزل عن الجغرافيا
مضى أكثر من نصف قرن من الاشتغال في التجريد، وعقدٌ إضافي من الاشتغال في عموم الفن. هذه العقود تمنحُ بلقيس رؤى واضحة لقراءة المشهد الفني محليًا وخليجيًا وعالميًا. فقد شهدت العقود الماضية كثيرًا من الانتقالات والثورات الفنية، ومعها لم يعد الفنان القابع في جغرافيا ما من الكرة الأرضية، بمعزل عن أي فنان آخر في عواصم الفن العالمية. وهو ما تؤكده بلقيس بقولها: “أضحى الفنانون في مختلف أنحاء العالم متساوين بسبب التكنولوجيا الرقمية. لم يعد الفنان البحريني أو الخليجي بمنأى عمَّا يقدِّمه أقرانه في الشرق أو الغرب”. وتستدل بلقيس بما يقدِّمه الفنانون البحرينيون والخليجيون الشباب من تجارب فنية حديثة، لا تقل أهمية عمَّا يقدِّمه الفنانون في الغرب.
ترى بلقيس أن الوسائل الرقمية جعلت الفن موحدًا في كل الأمكنة على صعيد المستوى والتجربة: “علاقة التفاعل الفني والتأثر أضحت غير مقيدة بالحدود، إذ يمكن لفنان بحريني أن يتأثر بآخر في أستراليا لم يشهد أعماله على أرض الواقع قط. ولهذا أضحى مفهوم التأثر متداخلًا، وأضحى التوحيد أو مساواة التجارب سمةً تسم فن العصر”. وتشير بلقيس إلى الفنون الحديثة، مثل التركيبي والمفاهيمي والمعاصر، التي “تُقدَّم في البحرين والخليج العربي، والتي لا تقل جودة عن تلك التي تُقدَّم في أي مكان آخر من العالم”.

وتلفت بلقيس إلى ما شهدته المملكة العربية السعودية من حركة ثقافية وفنية كبرى في السنوات الأخيرة، نتج منها ظهور كثير من الفنانين والفنانات الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة إبداعية عالمية: “الفنانون السعوديون أضحوا على مستوى عالٍ من الاشتغال، وهو ما يمكن أن نراه جليًا على مستوى الأعمال المقدَّمة في السعودية أو على الصعيد الدولي”، مشيرةً إلى العمل التركيبي “نطقت الرمال فتحرك الصوت”، الذي قدَّمته الفنانة منال الضويان في “بينالي فينيسيا للفنون”، لِتؤكِّد أن هذا العمل دليل على أن الفنان الخليجي أضحى ندًا للفنان الغربي.


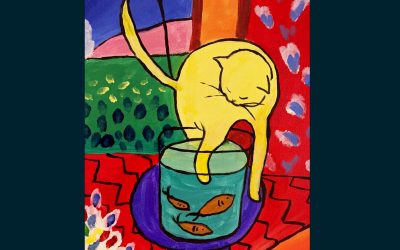

اترك تعليقاً