على الرغم من أن موضوع الحب استحوذ على كثير من الأعمال الإبداعية في معظم الحضارات لفهم كُنهه، فقد ظلَّ عصيًا على ذلك. أمَّا اليومَ، ومع التقدم في علم الأعصاب والمخ، والتطور في أجهزة الرؤية والتصوير الدقيق، تبيَّن للعلماء في المختبرات أن كل نوع من الحب، مثل الحب الرومانسي، أو حب الأبناء والأصدقاء وحتى الحيوانات وما إلى ذلك، يترافق مع تنشيط الدماغ لمناطق محددة وإطلاق ناقلات عصبية كيميائية معيَّنة استجابة لذلك. فهل كشف العلماء سرَّ هذا اللغز، أم زادوه غموضًا؟ مهما يكن، يقول عالم الفلك الأمريكي المعروف كارل ساغان: “بالنسبة إلى مخلوقات صغيرة مثلنا، لا يمكن تحمُّل هذا الاتساع الهائل للكون إلا من خلال الحب”.
لا نبالغ إن قلنا إنَّ الحب واحد من أغرب المشاعر البشرية. نرى المُحب، وإن كان حكيمًا، يتصرف أحيانًا باندفاع وغباء لا يتناسب أبدًا مع شخصيته؛ إذ يهيمن الحبيب على تفكيره تمامًا. وهذا مجرد وجه من وجوه ما يسمّيه علماء النفس “التفكير المقتحم”، فحبيبك يقيم في رأسك لا يغادرها. قد تنشب حروب وتُقدَّم التضحيات بالحياة نفسها بسبب الحب. حتى إن الشخص نفسه قد يتعجَّب من تصرفات قد فعلها وهو تحت ذلك تأثير عاطفته، وكيف كان يرى محبوبه من خلال منظار وردي لا يُبدي عيوبه؛ ولذا سمعنا الشاعر الإنجليزي تشوسر يقول: “الحب أعمى”.
يتعدى التأثير مجرد الحس العابر بالفرح أو الحزن، بل يتمادى في كثير من الأحيان ليسبب تأثيرات جسدية سلبية بسبب الابتعاد عمَّن نحب. ورأينا كيف أن الأساطير كانت تنسج عن الحب في كل الحضارات: روميو وجولييت، باريس وهيلين، قيس وليلى.
والحب في البشر مُتفرد، فليس معتادًا في مملكة الحيوان ذلك الارتباط طويل الأمد بين الذكر والأنثى الذي نراه في البشر، أو حتى علاقة “الصداقة” بين أفراد ليسوا من العائلة نفسها. ولذلك خضع “الحب”، ربَّما أكثر من كل المشاعر الإنسانية الأخرى، إلى دراسات متفحصة من الفلاسفة والعلماء على مرِّ التاريخ.
من أقدم النصوص الفلسفية التي ناقشت الحب على نحو واسع هو نص “الندوة”، الذي يُعدُّ من أهم أعمال أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو مجموعة خطب يُلقيها بعض الحكماء في ندوة تتناول جوانب مختلفة من الحب، مثل نشأة الحب وطبيعته.
وفي القرنين الأخيرين، ظهر علماء كثيرون من مجالات علمية شتى حاولوا فهم الحب، أو على الأقل كان لنظرتهم إلى السلوك الإنساني أثر كبير في فهم أعمق للحب.
ولكن مع التقدُّم الكبير في علوم الأعصاب والمخ وتقنيات التصوير، بدأت العلوم التجريبية تحاول استقصاء ذلك الشعور في منبعه وفهمه على نحو أوسع.

الحُبُّ ليس واحدًا
ليس الحب كما أسلفنا نوعًا واحدًا، بل هناك حب لشريكة الحياة وحب للصديق وحب للأبناء وحب للحيوانات الأليفة التي نعتني بها، بل أيضًا حب بعض المظاهر الطبيعية المحددة، مثل غروب الشمس وغير ذلك. هذا الاختلاف تعيه أدمغتنا جيدًا، وتستجيب على نحو مختلف لكل نوع من تلك الأنواع.
فأخيرًا، أُجريت دراسة حديثة في جامعة ألتو في فنلندا، ونُشرت في مجلة علمية (Cerebral Cortex) أغسطس 2024م، لمحاولة معرفة الاستجابات الدماغية المختلفة لتلك الأنواع من الحب عن طريق قياس النشاط الدماغي الذي يثيره كل نوع من هذه الأنواع؛ وذلك باستخدام التصوير المغناطيسي الوظيفي. وتوصل الباحثون إلى أن النشاط الدماغي المرتبط بحب الأبناء هو الأكبر. ففي هذا النوع من الحب، كان هناك نشاط عميق في نظام المكافأة في الدماغ في منطقة النواة المخططية، أو ما يُعرف بالجسم المخطط (Striatum)، التي لها علاقة بالتخطيط واتخاذ القرارت. ولم يُلاحظ هذا في أي نوع آخر من الحب، حتى الحب بين الجنسين. وهذا النوع من حب الأبناء أظهر أيضًا نشاطًا في منطقة المهاد المسؤولة عن الوعي والانتباه. وهذا يبدو منطقيًا جدًا، فالتخطيط واتخاذ القرارات هي أشياء لازمة لتربية الأطفال.
وبعد هذا الحب الأبوي جاء الحب الرومانسي من ناحية شدة النشاط الدماغي. ويلي كل ذلك النشاط الناتج عن حب غير الأقارب، مثل حب الأصدقاء. ثم يأتي حب الطبيعة الذي أظهر هو الآخر نشاطًا في بعض أجزاء المخ. وكانت المفاجأة كبيرة عندما أظهر الدماغ نشاطًا مميَّزًا في المخ لدى الخاضعين للدراسة ممن اقتنوا حيوانًا أليفًا. فالنشاط الدماغي لم تختلف شدته فحسب، بل تغيرت مناطقه في الدماغ أيضًا.
وقاس العلماء النشاط الدماغي بعد أن أخبروا الخاضعين للتجربة بمواقف لها علاقة بنوع معين من أنواع الحب المذكورة، ليسمحوا لهم بالتفكير في الموقف بعمق وتركيز.
الدوبامين والدماغ
تُعد الدكتورة هيلين فيشر (1945م – 2024م)، واحدة من أشهر علماء الأنثروبولوجيا في العالم، ولها كتاب ملهم في هذا الصدد عنوانه “لماذا نُحب؟”، مترجم إلى العربية. وهي تُقسِّم الحب إلى ثلاث مراحل رئيسة: الرغبة والانجذاب والتعلّق، وفي كل مرحلة منها يتصرف المخ بطريقة مختلفة تجعل العلاقة تتطور من الرغبة؛ لتصل إلى الرغبة في العيش أطولَ فترة مع الطرف الآخر.
فبعد دراسات عديدة في هذا المضمار، وُجِد أن الانجذاب العاطفي يُطلِق في المخ فيضانًا من المواد الكيميائية، ربَّما أشهرها الدوبامين، وهو هرمون مسؤول بدرجة كبيرة عن السعادة والتحفيز، وتفعيل ما يسمَّى بـ “نظام المُكافأة” في المخ. وارتفاعه في المخ يؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرة الإنسان على التركيز على شيء معين، وهذا ما يفسِّر ذلك التفكير المستمر فيمَن نُحب. كما أنه مرتبط بزيادة النشوة والابتهاج.
وترتبط زيادة الدوبامين أيضًا بزيادة الطاقة عمومًا، وبعض الأرق وفقدان الشهية وارتفاع معدل دقات القلب والقلق، وكلها أعراض معتادة لدى الوقوع في بئر الحب العميقة.
بالعودة إلى أنواع الحب العديدة التي أشرنا إليها سابقًا، وجد الباحثون أيضًا أن بعضًا من تلك الأنواع يعزِّز بعضه بعضًا. فهرمون الأكسيتوسين الذي يُفرز في إطار الحب بين الزوجين، له أدوار مهمة في الحمل والولادة والارتباط بالرضيع، وكأن حب الرجل لزوجته يساعد بصورة ما على تعضيد ارتباط الأم برضيعها.
هذا الهرمون نفسه (الأكسيتوسين) يعزِّز مشاعر الرضا والهدوء والأمان. وإضافة إليه، هناك هرمون الفازوبريسين، وكلاهما يرتبطان أكثر بمرحلة الارتباط طويل الأمد بين الشريكين. ووجد العلماء أنَّه عند حقن الحيوانات بهذين الهرمونين، فإن هذا يُساعد على ترابط الأزواج، فيجعل كل زوج أكثر ميلًا للارتباط بشخص واحد، وهذا الارتباط نفسه يزيد، وتزيد معه الرغبة في حماية الشريك.
ويؤثر الحب أيضًا في الأعصاب، فهو يُعطل المسارات العصبية المسببة لبعض المشاعر السلبية مثل الخوف. فعندما ننغمس في تجربة رومانسية، فإن الآلية العصبية المسؤولة عن تقييم الناس تتعطّل، وتحديدًا تقييم مَن وقعنا في حبّه؛ لذلك فإننا نعيد ما قيل قديمًا: “الحب أعمى”.
وكما أن هناك كثيرًا من المواد التي تُطلق في المخ عند الوقوع في الحب، فهناك أيضًا احتمال أن تنقص بعض المواد الأخرى أثناء ذلك. فمثلًا، هناك هرمون السيروتونين، الذي يتسبب نقصه في فقدان الإرادة والتفكير المستمر فيمَن نحب. هذا النقص في السيروتونين قد يُسبب في بعض الحالات شكلًا من الوساوس. فالدوبامين والسيروتونين إذًا، علاقتهما علاقة عكسية إن زاد أحدهما يقل الآخر، والفيضان الدوباميني الناشئ عن الحب يصاحبه انخفاض في مستوى السيروتونين، يغمسنا في تفكير لا ينتهي بمن نحب.
ولكن نود أن ننبّه هنا إلى أن تعامل مخ الذكر وجسده مع فيضان الهرمونات ونقصانها، يختلف بالتأكيد عن تعامل الأنثى معه، حتى الهرمونات نفسها لن تُفرز بالأنواع والكميات نفسها.

القلب المكسور
يمثِّل فقدان الحب عبئًا كبيرًا على المخ، وعلى الجسد عامة. إذ إن أشهر ما يسببه الهجر هو الغضب، والغضب يجهد القلب ويرفع ضغط الدم، ويضعف المناعة؛ وقد يجد المرء نفسه مصابًا بجفاف الحلق أو نزلات البرد بعد أن يهجره مَن يحب! هذا طبعًا بالإضافة إلى مشاعر الإحباط واليأس، بل الاكتئاب الذي يصيب المهجورين، بل إن هناك من يموت من جراء ذلك بسبب توقف القلب أو الجلطات الناجمة عن الاكتئاب. كما يمكن أن يصل الأمر إلى القيام بأعمال عنيفة غير عاقلة ضد الذات أو ضد الآخر.
وكما قلنا مع الحب نقول مع فقدانه. إذ يتعامل الذكر والأنثى مع الهجر بطريقتين مختلفتين نوعًا ما. فالإناث، مثلًا، أكثر ميلًا للإصابة بالاكتئاب، وفقدان الوزن واضطرابات النوم، فيتحدَّثن كثيرًا ولا يستطعن التركيز. في حين أن الذكور أكثر ميلًا لإيذاء الذات من الإناث بعد هجرهم! ومنبع الكثير من تلك الأعراض هو انخفاض إنتاج خلايا المخ من الدوبامين، فيدخل الخمول واللامبالاة والاكتئاب إلى المخ من الباب الكبير.
ظل الحب لغزًا كبيرًا منذ أن وعت البشرية، وكما قلنا دَرَسَه العلماء والفلاسفة منذ آلاف السنوات حتى عصرنا هذا ليحاولوا فك شفرته، وسيستمرون في ذلك. لأن فهم الحب، بقدر ما هو شيء مُلغز، مثير للفضول بسبب تأثيراته العميقة في النفس. إذ إنه مفيد من نواحٍ علاجية ترتبط بالصحة العقلية للأفراد. ويمكن لهذا الفهم أن يساعدنا على سبيل المثال في علاج اضطرابات مثل “اضطرابات التعلق” وغيرها من الاضطرابات.
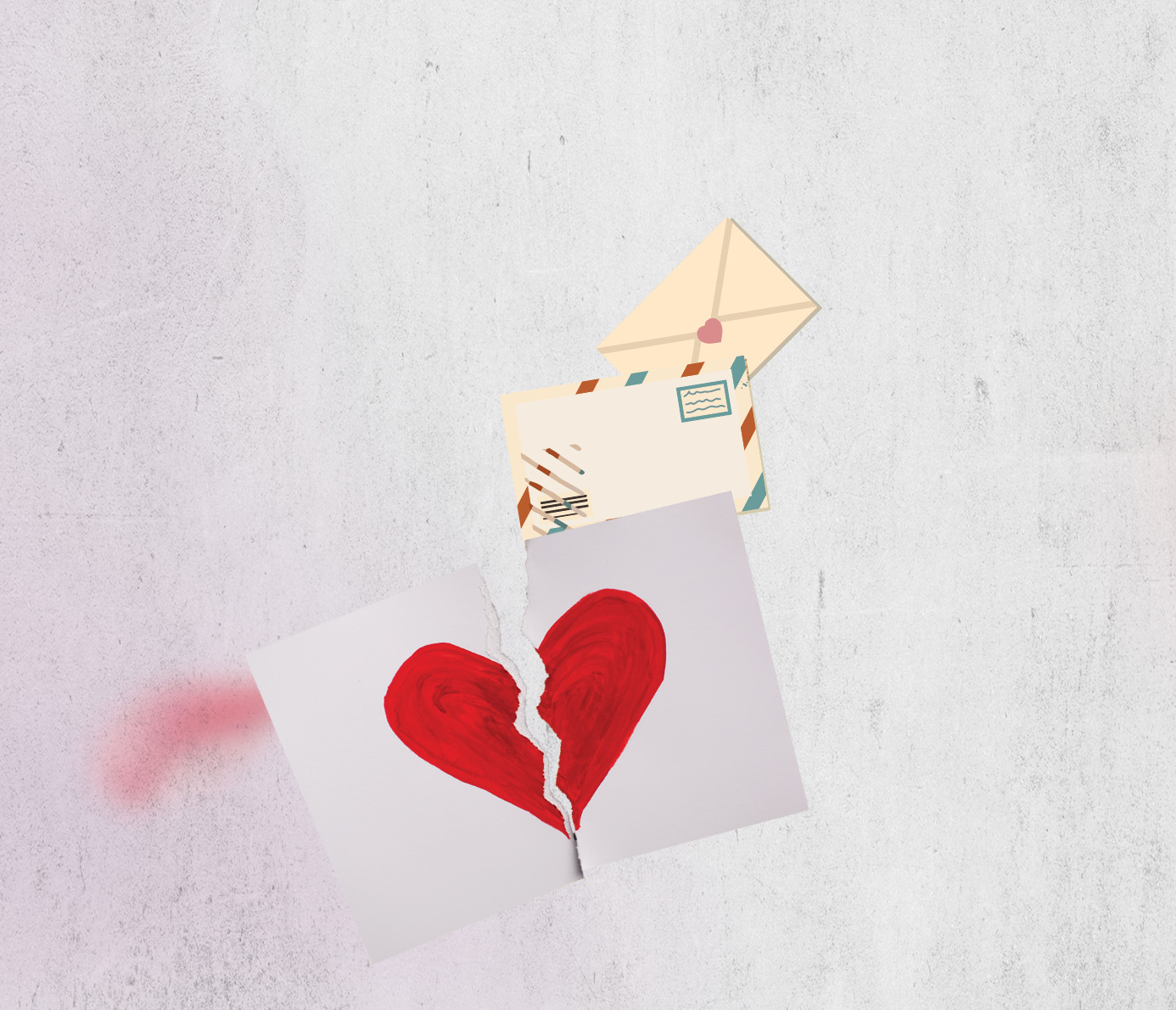



اترك تعليقاً