قدَّم مخرجون شباب من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية عددًا من الأفلام التي تتحدث عن الحياة اليومية وتمسك بأيدينا لتغمرها في الواقع، حتى نستشعر من خلالها حقيقة الأشياء، فيما يشبه وصف روبيرتو روسيلليني للذريعة الأخلاقية التي تدفعه لصناعة أفلامه بالشكل الذي اختاره لها.
من محمد سلمان مع النَّخل الجاف وسائقي التاكسي، إلى البسطة والقرية عند محمد الحمَّادي، وحتى المرض والشقاء مع محمد الشاهين، نماذج مختلفة من الحياة اليومية بالمنطقة الشرقية، من القطيف إلى الأحساء وما بينهما.
واقفًا على صندوق سيارته، يشكو التعب والملل، فيما شمس الظهيرة الحارقة تلفح وجهه وهو يحاول مقاومتها بالشماغ الذي يلف به رأسه. منذ ساعات الضحى حتى غياب الشمس، يؤنس نفسه بمطالعة المارَّة، متأرجحًا بين الغضب والإعياء منتظرًا الزبون القادم، الذي ربَّما لن يشتري منه شيئًا. يهرب فيتأمل العالم الواسع من فوق قارعة الطريق. تتحرك الحياة بسرعة. يتوقف الزمن عنده. أحداث كثيرة تجري في البعيد. يهيمن عليه الانتظار. “الجحُّ” زاهي الخُضرة يبعث في نفسه شعور الفخر “يا لروعة الثمار التي أعرضها”، ويحرِّض قلبه على الخوف والقلق “أنا ما فاعلٌ بهذه الثمار الزاهية وهي باقية عندي؟”. من خلفه تقف حياةٌ كاملة، عائلته التي هي مثله تنتظر، آماله التي تخبو، أصدقاءه الذين افتقدوه حتى ملّوا فقده، وأصوات الطفل داخله: أجئت إلى هذا العالم لأعيش كلَّ هذا الشقاء؟ فيما أصوات الكهل الذي هربت منه سنوات العمر يردد ما قاله الشاعر الأندلسي عمارة اليمني:
صفو الحياة وإن طال المدى كدرُ … وحادث الموت لا يبقي ولا يذرُ
فلا تقل غرّة الدنيا مطامعها … فبائع الموت لا غش ولا غرر
في كل يوم من حياتنا نلتقي بائع البسطة وسائق التاكسي والحمَّال والمريض والمقعد، أو العجوز الذي أعيته سنوات العمر، وربَّما أنا وأنت أحد هؤلاء، أو كنا ذات يوم، أو ربَّما نصير، قد نكون آخرين، نعمل في وظائف أخرى، أو نعمل بحرية دون وظيفة تقيِّدنا، أو قد لا نعمل شيئًا البتة، إننا جميعًا بطريقة ما سواء. حياتنا التي تركض سريعًا تمنعنا من التأمل، تحرمنا من الوقوف على المشهد، لا تعطينا الفرصة حتى لأن نرى أنفسنا. لنقول بوضوح: من نحن، ماذا نريد، إلى أين سنذهب؟ أو ببساطة، أن نفهم هذه العجلة التي تتحرك بنا، أو تجري من تحتنا، أو تمرَّ من فوقنا مشتعلة كما قالت لويز غليك.
السينما والحياة
لماذا نحن بحاجة إلى السينما؟! وما الذي تفعله السينما فينا؟ تجيئنا بالواقع مكثّفًا، ثقيلًا، تلقي به ليجثم فوق صدورنا، دون أن نستطيع الفكاك منه. ننسى العالم حينما نعيشه، ننسى الحياة وهي تركض من بين أيدينا. فيما السينما تعيدنا مرغمين، لنتأمل، ونرى ما خلف الأحداث البسيطة والعابرة، أو التي نظنُّها كذلك. حتى أنفسنا التي نسيناها، تعيدنا السينما إليها. في كتابه النقدي “السينما أو الإنسان الخيالي”، يقول الفيلسوف الفرنسي إدغار موران: “بينما تعكس كل الفنون أحلامَنا ورغباتِنا، تفعل السينما هذا بشكل فريد من خلال العالم المادي نفسه، أو بمزيد من الدقة من خلال مضاعَفة هذا العالم. لذا، فإن كل الأفلام هي عمليات استحضار خارقة تنتمي لنا جزئيًّا، وجزئيًّا فقط”.
هذا الشدُّ والجذب بين ما هو بشري وبين ما هو غريب، بين ما هو شخصي وبين ما هو دخيل، قد استُغِل في كل الفترات، وفي نماذج وأنواع لا حصر لها. إننا بحاجة إلى استحضار هذه الوظيفة الجمالية والسيكولوجية للسينما، لنقرأ الحياة اليومية من جديد، ونحاول إدراك ما فاتنا منها، وعبر الاستفادة من الوظيفة نفسها.


بين النخلة والبحر وماكينة الخياطة
للنَّخلِ روحٌ، وللإنسان روح. وكما نبت النَّخل من طين الأرض، خُلق الإنسان من طين. وما الفلَّاح إنسانٌ دون النَّخل. وما تبقى روحه إن ذهبت روح النَّخل. بهذه المقاربة الشعرية، يقدِّم لنا المخرج محمد سلمان الصفار، فيلمه “مِخيال” الذي أُنتج وعُرض للمرَّة الأولى في عام 2014م. بعيني طفلٍ، يروي لنا قصة قاسية، عما تفعله الحياة بالفلَّاح إن توقف النّخل عن طرح التمر. ينصرف الأبُ إلى البحر، وتنصرف الأمُّ إلى ماكينة الخياطة، وينصرف الجدُّ إلى “المِخيال”، راجيًا أن يُستجاب دعاؤه، وأن يعود نخله يانعًا باسقًا وله طلعٌ نضيد.
المأساة هنا يوميّة. الفيلم يلتقط لنا المشاهد من التفاصيل الأكثر رتابةً، فيما يمنحها الطفل بعينيه وخياله سحرًا. يقول إنه ما عاد يسمع صوت أمه، وأن كل ما يسمعه منها هو صوت ماكينة الخياطة. ويقول إنه اشتاق لأبيه الذي صار بعيدًا، ولا يدري هل سيرده البحر إليه من جديد. ويعيش الأمل مع جدِّه، حالمًا بالنَّخل، الذي إن عاد إلى الحياة انتهت أحزانه، وانتهى ألم جدِّه، وانتهى صمت أمه، وانتهى غياب أبيه.
ستبقى هذه مجرد آمال وأحلام، هكذا هي الحياة. لن يعود الجدُّ لبسمته، وسيموت بكمده على النَّخل. لن يعود الأب ولن تعود الأمُّ. سيذهب الطفل ليكسر “المِخيال” بعد أن خذله وخذل جدَّه من قبله، معلنًا موت الأمل. سريعًا سيدرك أن الحياة لا تكون دون أمل، ويحاول أن يرمِّم ما أفسدته يداه. لتنزل ريشة بيضاء على كتفه، تربت عليه كما كانت يد جدِّه تفعل، هل الريشة هي صوت جدِّه؟ هل يثني عليه لأنّه عاد يؤمن بالأمل، أم أن المشهد يقول بصورة غير مباشرة إن الحياة هي التأرجح بين اليأس والأمل؟!
قد تبدو قصة الفيلم قادمة من عالم خيالي، وهي تعتمد هذا الأسلوب في الطرح إن قمنا بمراجعتها نقديًا، إلَّا أنها في الآن نفسه قصة واقعية جدًا، وإن بحثنا في تفاصيلها فقد نجدها متصلة بالسيرة الذاتية لكاتبها، الذي هو ابن المنطقة التي شهدت هجر الناس للنَّخل حينما هبَّت رياح العصر الحديث. إنها قصة مجتمع برمَّته، قصة أهل النَّخل، قصة إنسان القرية البسيطة، الذي وجد نفسه مكتوف الأيدي فيما تهبُّ رياح التغيير عليه.
ننسى العالم حينما نعيشه، ننسى الحياة وهي تركض، فيما السينما تعيدنا مرغمين، لنتأمل، ونرى ما خلف الأحداث البسيطة.
كيف لعبَ الجميع دورهم على الخشبة؟
واقفًا على بسطة تبيع الخضار طوال النهار، سائقًا لسيارة تاكسي تخوض جولات خارج المكان مقيّدًا بالزمن، أم حمَّالًا يعيش أبعادًا مختلفة بعضها فوق بعض من الغربة. تجاربُ متباينة، يقف في ظلِّها الكدح وقسوة الحياة وصعوبة بلوغ الرزق. تجارب لا يمكن فهمها، أو الشعور بها عن قرب إلَّا بمراجعتها في شكل الحياة اليومية. لحظةً بلحظة، ساعةً بساعة، يومًا بيوم.
البائع داخل إطار محمد الحمَّادي السينمائي كان يقول: “اللي يقعد في الشمس مرتاح؟ في أحد يقعد في الشمس مرتاح؟ خلاص”، في فيلم “أصفر” يروي محمد سلمان قصة سائق التاكسي الذي التقاه وقد أضناه التعب، وصار يعدُّ السنوات التي أفلتت منه خلف مقود سيارته الصفراء: “احسبها انت، من 86 إلى 2000 كم سنة؟ 14 سنة! ومن 2000 إلى 2014 كم؟ 14 سنة؟ 28 سنة واحنا في الحفرة هذه”. أمَّا الحمَّال في فيلم محمد الشاهين، فيقول: “مرّيت بحياة صعبة، الشغل وكل الفلوس دي لأولادي عشان يتعلموا ويطلعوا مرتاحين وشغالين وما يتعبوش زي ما الواحد تعب وشقي”.
على مسرح الحياة الكبير، يرتدي الثلاثة (بائع البسطة وسائق التاكسي والحمَّال) القناع جميعًا، يعاملون زبائنهم مبتسمين، يضحكون معهم ويتجاذبون أطراف الحديث، مغتربين عن ذواتهم وما يعتمل في أنفسهم. زبائنهم يتحدثون عنهم بطيبة كبيرة، يثنون عليهم، يقولون إنهم يوفرون البضاعة الجيّدة بسعر أرخص من السوق، وهذا لا يمنعهم من أن يقوموا بمفاوضتهم على القيمة التي سيدفعونها في النهاية. هذه الصورة السينمائية التي التقطها عدسات المخرجين الثلاثة، بأساليب مختلفة، تقول كل شيء عن الحياة اليومية، وتقدِّم لنا نقدًا متماسكًا لها، كيف ينفصل أفراد المجتمع عن ذواتهم، فيما يصارعون الحياة، وكيف ينفصلون عن الآخر، ليصيروا جميعًا آلات أو ممثلين مهرة، كلٌّ يلعب دوره بحرفيّة عالية، فيما يغيب الإنسان.
الثورة الصناعية
في مقاربة متطرفة بعض الشيء تحيلنا هذه الأفلام الوثائقية وشخصياتها إلى شارلي شابلن وأفلامه التي واجه بها صعود الثورة الصناعية، محاولًا الانتصار للإنسان وروحه التي تذوي شيئًا فشيئًا أمام رياح العصر الحديث. شخصية عامل المصنع الصعلوك في فيلم “الأزمنة الحديثة” (1936م)، تعدُّ تجسيدًا فنيًا لنظريات الاغتراب التي أسس لها كارل ماركس، ثم تبعه إليها عددٌ من فلاسفة الاقتصاد وعلم الاجتماع، مثل الفرنسي هنري لوفيفر، صاحب الأطروحات المهمة في نقد الحياة اليومية بالعصر الحديث. وفي حالة الاغتراب، التي لا يدركها من يعانيها، بشكل آلي يرتدي الإنسان القناع، ويؤدي دوره في المسرحية. أزمة الحياة اليومية الكبرى هي حالة الاشتباك الدائمة بين الذات والموضوع، لدرجة يستحيل فيها الفصل بينهما، حيث التجارب الشخصية من مشاعر وأفكار هي ما تُكوِّن الإدراك الذاتي. أمَّا الموضوع، فهو كل ما يؤثر في الذات من الخارج، مثل الثقافة والاقتصاد والنظم الاجتماعية. وحالة الاشتباك والتداخل الدائمة هذه، تجعل الإنسان لا يدرك القفص الذي هو بداخله، وبالتأكيد، سيؤدي دوره في المسرحية، دون أن يكون مستوعبًا للخشبة التي يقف عليها.
الهدوء الصامت في سياق قرى المنطقة الشرقية، ليس مضادًا للحياة، بل هو مرادفٌ لها.
الشخصيات التي تقدِّمها لنا الأفلام الثلاثة، سواءً أكانت في جانب مقدّمي الخدمة، أم على الجانب الآخر، تعاني انفصالًا غير محسوس عن الذات، وحضور الذات في هذا السياق غير ممكن أصلًا. فالنظام الاقتصادي لا يسمح بحضورها. على السطح يفهم بائع البسطة وسائق التاكسي والحمَّال أن زبائنهم بشرٌ مثلهم، يعانون مثلهم، ويعيشون حياة لها طابعها الصعب مثلهم. زبائنهم كذلك، يدركون التعب والملل والإعياء الذي يعانيه الثلاثة. لكن الجدار بينهم لا يمكن كسره. التعاطف يأتي من بعيد، لا يهيمن على المشهد. علاقة البائع والمشتري تفرض نفسها. والمشهد المسرحي يجب أن يكتمل.
“القرية” من “فوق السطوح”
للقرى في المنطقة الشرقية طابعٌ خاص ومميز، تبدأ ملاحظته من التقارب العمراني بين المباني، فهي ملتصقة بعضها ببعض. الممرات بينها هي أزقة ضيقة، تشكِّل شبكة معقَّدة لا يمكن أن يفهمها إلَّا ساكنوها. وكما هو حال القرى في كل مكان، هناك طابع التقارب الاجتماعي الذي يجعل الجميع يعرفون بعضهم. الحركة الاقتصادية أسهمت في تغيير وجه هذه القرى، فالأبناء لن يعملوا في وظائف آبائهم وأجدادهم، وإنما سيرتحلون بعيدًا، تاركين خلفهم هدوء القرية وصمتها العميق، فيما لا يسير بطرقاتها إلَّا كبار السن وقليل من الأطفال. وهذا الهدوء الصامت في سياق بعض قرى المنطقة الشرقية، ليس مضادًا للحياة، بل هو مرادفٌ لها. حينما تتمشَّى في الأزقَّة قد لا تسمع الأصوات أو تحسُّ بالصخب، لكنك قطعًا ستشعر بالحكايات تحاصرك من كل جانب. كل إنسان تصادفه، كل جدار تمرُّ به، كل بيت، كل شيء يروي قصة، ستشعر بها حتمًا حتى إن لم تفهمها وتعرف تفاصيلها.
يفتتح المخرج محمد الحمَّادي فيلمه “القرية” بمشهد رجل يصدح بقصيدة من شعر أهل القرية النبطي، لتكون استهلالًا لعرض القرية بكاميرا طبيعية، تشبه عين الرائي حينما يتجوَّل ماشيًا بقدميه داخلها. مشاهد عشوائية لمارَّة وباعة وصبية يلعبون. هو فيلم يمكن تصنيفه بأنه وثائقي، فالشخصيات حقيقية تمامًا، ويجري تصويرها فيما تمارس تفاصيل حياتها اليومية بكل رتابتها. غير أن الفيلم روائي كذلك. وبطل الفيلم هنا هو القرية. ليس هناك أحاديث كثيرة تقدِّم لنا القرية، لكنها حاضرة في كل شيء.
وفي جانب آخر من روح القرية، أخرج محمد الشاهين فيلمه “فوق السطوح”، الذي هو عمل تجريبي قصير، يقدِّم قصة أخوين، أحدهما يمارس حياته بكل تفاصيلها، فيما الآخر مريض. لا يشير الشاهين إلى القرية بشكل واضح، لكنها حاضرة تمامًا في الفيلم. اختيار الأبيض والأسود للفيلم هو إحالة إلى القرية. واختيار أن يكون الفيلم صامتًا، هو إحالة أخرى إلى القرية.
بين الصمت والرتابة، والقصص الكامنة في روح المكان، تقاطع الفيلمان. يختلفان في البنية والأسلوب، فيما يشيران بالإصبع نفسها إلى القرية. إلى الزمن الذي يتوقف بداخلها، إلى الحياة التي تبدو أكثر صخبًا ورفاهية خارجها، إلى الروح التي تربط أبناءها بها، حتى وإن مرضوا وأصابهم الملل وهم بداخلها. كلا الفيلمين قصيدة بصرية في حبِّ القرية التي هي أجمل من الأعلى، من فوق السطوح تحديدًا.


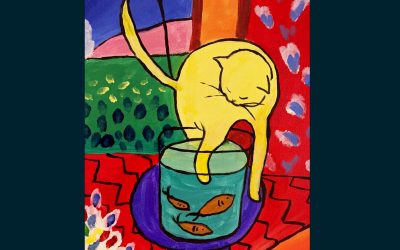

اترك تعليقاً