
كانت الأساطير القديمة تزخر بموضوع التواصل مع الحيوان وعالم النبات، وكان الاستماع إلى الطبيـعة يُعدُّ من الفنون؛ إلا أن هذا الموضوع بدأ يختفي من الأساطير الحديثة التي أُطلق عليها اسم “الخيال العلمي” منذ منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين، بدأ تناول الحيوان في القصص القليلة الصادرة بأسلوب التجسيم؛ فظهرت الحيوانات، خاصة في قصص الأطفال، على صورة الإنسان وبلسانه. لكن التكنولوجيا الذكية، التي اتُّهمت بإبعادنا عن واقع العالم الطبيعي، تُعيد تواصلنا معه من خلال فك رموزلغته. فإذا بهذا العالم يعج بمحادثات رائعة، يتجاوز معظمها نطاق السمع البشري، كما يتجاوز خيال الأساطير القديمة. وأظهرت هذه التكنولوجيا أن الأنواع الأخرى، بما فيها عالم النبات، تعيش احتفالية طبيعية ساحرة، تُقدِّم للمبدعين في الخيال العلمي أفكارًا لا تنضب.
نشأت بين التقدُّم العلمي والخيال العلمي علاقة قوية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر. إذ تأكد أن تقديم الاكتشافات العلمية والتكنولوجية ومآلاتها المستقبلية إلى القرّاء العاديين بأسلوب السرد القصصي، كان له وقع كبير؛ فأقبلت أجيال فتية عديدة على دراسة العلوم وأحدثت ثورة علمية وتكنولوجية واقتصادية كبيرة. المثل الساطع على ذلك هو المراهق ألبرت أينشتاين (1879م – 1955م)، الذي وقع نظره على واحدة من أولى قصص الخيال العلمي للكاتب الألماني فليكس إيبرتي (1812م – 1884م)، عنوانها “النجوم والأرض” أو “أفكار حول الزمن والفضاء والخلود” (1846م)، يسرد فيها أن هناك إمكانية علمية للسفر بين الكواكب والنجوم. واُفتتن أينشتاين بشكل خاص بهذه الجملة التي جاءت في القصة: “فإذا ما حط إنسانٌ على نجم معين بعيد، فإنه قد يرى الأرض في هذه اللحظة كما كانت موجودة في زمن إبراهيم”، فشغل موضوع الزمان والمكان وعلاقتهما بالضوء عقله وخياله. وإعجابًا بهذه القصة الأولى التي قرأها، كتب أينشتاين بقلمه، عام 1925م، مقدمة النسخة التي طُبعت آنذاك، وكان قد أصبح من أشهر علماء التاريخ.
لكن هذا التقدُّم العلمي المذهل جعل كتّاب الخيال في القرن العشرين، يحلِّقون بين الكواكب والنجوم، والتواصل مع الكائنات الفضائية البشعة، متعالين عن عالم الحيوان والنبات البديع. وكان علينا انتظار الخوارزميات ونماذج اللغة المتطورة؛ لتردَّنا إلى الطبيعة التي تبيَّن أن واقعها الغريب يُضاهي غرابة الكائنات الفضائية.
العلم والتواصل مع الحيوان
لم تنطبق العلاقة القوية بين التقدُّم العلمي والخيال العلمي على موضوع إدراك الحيوان والتواصل معه، فتأخر هذا العلم، كما تأخر الخيال المرتبط به. والسبب الرئيس في ذلك، في رأي كثير من الباحثين المعاصرين، يعود إلى سرديات الحداثة الكبرى، ومنها الاعتقاد بمركزية الإنسان في الكون.
في الثقافة الغربية، التي سادت منذ عصر الأنوار، جرى تصنيف الحيوانات وفق هذا التمييز لإدامة المركزية البشرية؛ وذلك من خلال تسمية كل ما ليس إنسانًا بـ”آخر”؛ إذ تُحدِّد الحيوانات البشرية الحيوانات الأخرى من خلال لغة الدونية. إنهم ليسوا حيوانات بشرًا، ومن ثَمَّ، فهم أقل شأنًا وخاضعين لأهواء النوع السائد وتجاربه.
كتب أطفال بياتريكس بوتر.
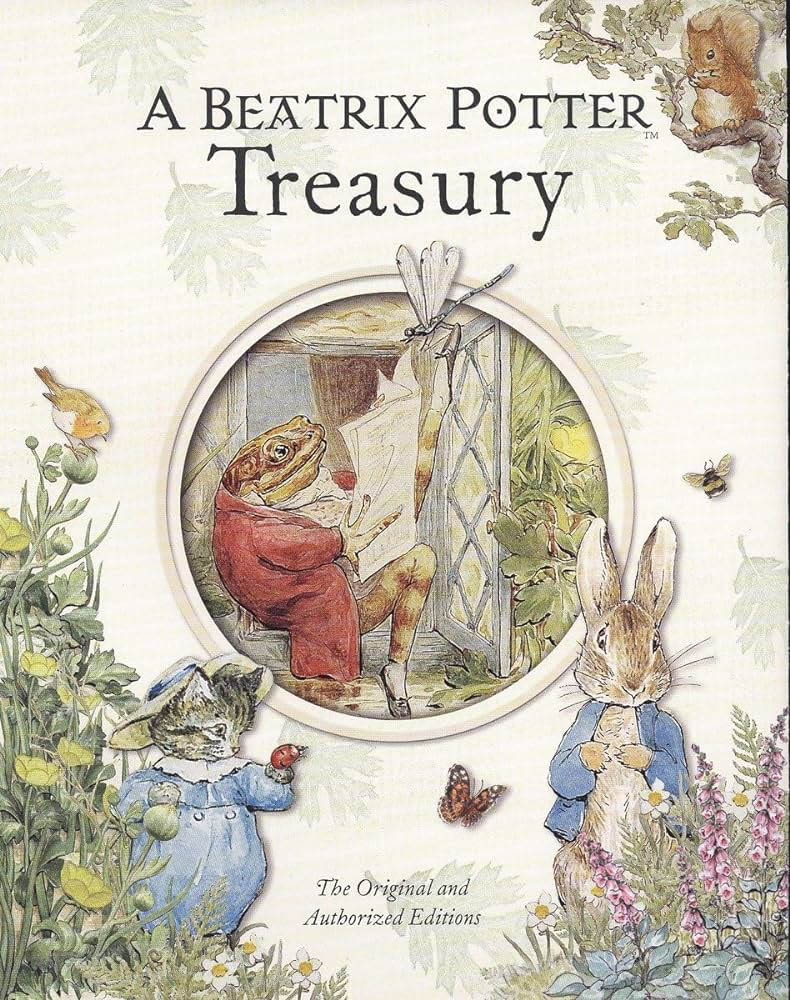
أشار في هذا الصدد كاتب الأطفال البريطاني بيرس تورداي، في الغارديان (1 أكتوبر 2021م)، إلى أن دراسة حديثة أجراها المركز الألماني لأبحاث التنوع البيولوجي التكاملي، من خلال البحث في أرشيف مشروع غوتنبرغ (مشروع للكتب الرقمية المجانية) على الإنترنت، الذي يضم 60 ألف نص مكتوب في الفترة ما بين عامي 1705م و1969م، استنتجت أن الحيوانات تُشطب من الروايات بمعدل مماثل لانقراضها في العالم الحقيقي. ووجدت الدراسة أنه منذ عام 1835م، أصبح استخدام الحيوانات في قصص الخيال، ما عدا الحيوانات المستأنسة مثل الخيول والكلاب، أو الحيوانات “الخطرة” مثل الدببة أو الأسود، تضاءل إلى جزء صغير جدًا من وتيرتها السابقة. ويحذِّر كبير مؤلفي الدراسة، البروفيسور كريستيان ويرث، من أن هذا قد يُعيق جهودنا في مواجهة أزمة المناخ، إذ يقول: “لا يمكننا وقف فقدان التنوع البيولوجي إلا من خلال تغيير جذري في الوعي”.
وليس من قبيل المصادفة أن كتبًا مثل: “كتاب الأدغال” (1894م)، وهو مجموعة قصصية للكاتب الإنجليزي روديارد كيبلينج (1865م – 1936م)؛ و”الريح في الصفصاف” (1908م)، وهي رواية أطفال كلاسيكية للروائي البريطاني كينيث جراهام (1859م – 1932م)؛ ومجموعة كتب أطفال “بياتريكس بوتر” (1866م – 1943م)؛ وهي كلاسيكيات التجسيم للأطفال الأوائل، نشأت بعد الثورة الصناعية، وتشكِّل أول قفزة هائلة في تجاهل الحيوانات الحقيقية، وكيفية تواصلها الفعلي فيما بينها وبين الأنواع الأخرى.
التكنولوجيا تدفع الخيال العلمي لعصر جديد
كان الناس في ثقافات عديدة مختلفة يعتقدون، منذ فترة طويلة، أنه يمكن للحيوانات التواصل عمدًا، وكان الاستماع إلى الطبيعية يُعدُّ من الفنون القديمة. لكن خلال معظم تاريخ البشرية، كانت قدرتنا على الاستماع إلى الأنواع الأخرى مقيدة؛ فالبشر غير قادرين على سماع معظم الأصوات التي تصدرها الأنواع الأخرى. وتقول كارين باكير، في كتابها “أصوات الحياة.. كيف تقربنا التكنولوجيا الرقمية من عوالم الحيوانات والنباتات؟” (2022م): “نحن نميل إلى الاعتقاد بأن ما لا يمكننا ملاحظته غير موجود، ولأن حاسة السمع لدينا ضعيفة نسبيًا مقارنة بالأنواع الأخرى، فهناك الكثير من الاتصالات في الطبيعة التي تمر بنا ببساطة”. كما أن بعض العلماء، خاصة الغربيين منهم، تجنبوا تقليديًا الأبحاث التي تطمس الخطوط الفاصلة بين البشر والعالم الطبيعي؛ خوفًا من اتهامهم بإسباغ صفات ومشاعر وطرق تعبير بشرية على الحيوانات.
وتأتي الصعوبة في السمع البشري، كما يقول عالم الأحياء الأمريكي ديفيد جورج هاسكل، من أن الطريقة التي ترتبط بها كثير من الكائنات البحرية بالصوت، مثلًا، تختلف جذريًا عن التجربة البشرية؛ أي أنها حشوية (من الأحشاء) وعصبية أيضًا. ولهذا السبب، كان معظم العلماء يعتقدون أن المحيطات صامتة. ويضيف: “بالنسبة إلينا، نسمع الصوت بواسطة آذاننا، وقليلًا من خلال أطراف أصابعنا، أو أشياء منخفضة التردد في صدورنا. ولكن إذا كنت سمكة أو حوتًا أو عوالق، فإن الصوت يتدفق إلى كل جسمك، ويصدر صوتًا في كل عضو وخلية بطريقة لا يمكننا أن نتخيلها حقًا. وهذا يتحدى الافتراضات عميقة الجذور حول التواصل المعقَّد بين الكائنات غير البشرية وتعريفنا للغة والعلاقة بين البشر وزملائنا من أبناء الأرض”.


التحوُّل الذي طرأ مع أجهزة الاستشعار
تغيّر ذلك مع دخول التكنولوجيا الذكية والتطور الكبير في أجهزة الاستشعار، ولا سيَّما من ناحية حجمها ووزنها. ومع انخفاض تكلفتها وتحسُّن التقنيات مثل السماعات المائية وتقنية الصوتيات الحيوية، استطاع الباحثون تركيبها في كل مكان من القطب الشمالي إلى الأمازون. فقد وُضِعت هذه الميكروفونات على ظهور السلاحف والحيتان في أعماق المحيط، ورُبِطت بالطيور على قمم الجبال، لتُسجّل الأصوات بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيـام الأسبوع في أماكن نائية يصعب على العلماء الوصول إليها. وأصبحوا يسجلون حتى في الظلام، ودون الاضطراب الذي يأتي من إدخال المراقبين البشريين في النظام البيئي.
فتزايدت كمية البيانات بشكل هائل، وشكّلت تسونامي من المعلومات. فأصبح هناك الكثير مما يتعين على علماء الأحياء فحصه؛ لمعرفة كيف تتشارك المعلومات مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك النباتات، بطرقها الخاصة، إذ يمكن دراسة ذلك بواسطة خوارزميات متطورة وتقنية الصوتيات الحيوية الرقمية.
ثروة من المعلومات الجديدة
كانت الرغبة سابقًا، هي تقييم الذكاء غير البشري، من خلال تعليم الكائنات غير البشرية التحدث مثلما نفعل. في حين كان ينبغي لنا في الواقع أن نفكر في قدراتها على الانخراط في اتصالات معقدة بشروطها الخاصة، وبطريقتها المتجسدة، وفي نظرتها الخاصة للعالم.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، راقب فريق من الباحثين ما يقرب من عشرين من خفافيش الفاكهة المصرية، مدة شهرين ونصف الشهر، وسجَّلوا أصواتها. ثمَّ طوَّروا برنامج التعرُّف على الصوت لتحليل 15 ألفًا منه، وربطت الخوارزمية أصواتًا محددة بتفاعلات اجتماعية محددة التُقطت عبر مقاطع الفيديو، مثل الأصوات التي تُصدرها بعض الخفافيش عند التنافس على الطعام. وباستخدام هذه النتائج، تمكَّن الباحثون من تصنيف غالبية أصوات الخفافيش.
كما أكد جيري كارتر، من جامعة ولاية أوهايو، أن الخفافيش لديها لغة أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقده سابقًا. إذ تتجادل حول الطعام، وتميِّز بين الجنسين، وتستخدم أسماء فردية للتواصل فيما بينها. وتتحدث الأم إلى أطفالها بنبرة لا تشبه أسلوب الأمهات البشريات اللاتي يرفعن نبرة أصواتهن، فهي تعلِّم صغارها بنبرة صوتية مميزة، التحدث “بكلمات” محددة أو إشارات مرجعية. لذلك تشارك الخفافيش في التعلُّم الصوتي.
ونظرًا لأن معظم اتصالات الخفافيش تحدُث عبر الموجات فوق الصوتية، ولأن الخفافيش تتحدث بشكل أسرع بكثير مما نفعل، يتعيَّن علينا إبطاؤها للاستماع إليها، وكذلك تقليل التردد. لذلك، لا يمكننا الاستماع مثل الخفافيش، ولكن أجهزة الكمبيوتر تستطيع ذلك.

وتبيَّن أنه عندما “يتحدث” نحل العسل بعضه إلى بعض، فإن حركات الأجسام، وكذلك الأصوات، هي ما يهم. والآن، أصبحت أجهزة الكمبيوتر، وخاصة خوارزميات التعلُّم العميق، قادرة على متابعة ذلك؛ لأنه يمكننا استخدام رؤية الكمبيوتر جنبًا إلى جنب مع معالجة اللغة الطبيعية. فقد أتقن الباحثون الآن هذه الخوارزميات إلى حدٍّ يمكِّنهم من تتبع النحل الفردي، ومن تحديد التأثير الذي قد يحدثه تواصل فرد ما على نحلة أخرى. ومن هنا تنبثق القدرة على فك رموز لغة نحل العسل.
فقد وجدنا، مثلًا، أن لدى النحل إشارات محددة، وقد أعطى الباحثون هذه الإشارات أسماء مضحكة، مثل: تصفِّر، تقرقر، وهناك إشارة “صمت” أو “توقف”، وإشارة “خطر” بالزَّمير. ولديها إشارات التزمير المتعلقة بالاحتشاد، وإشارات الترَجِّي بالاهتزاز، وكلها توجه السلوك الجماعي والفردي.
ويقول أستاذ الذكاء الاصطناعي تيم لاندغراف، من جامعة برلين، إنه عندما “يتحدث” نحل العسل بعضه إلى بعض، فإنما يكون ذلك من خلال حركات أجساده بالإضافة إلى الأصوات. الآن، أصبـحت أجهزة الكمبيوتر، وخاصة خوارزميات التعلُّم العميق، قادرة على متابعة ذلك؛ لأنه يمكن استخدام رؤية الكمبيوتر جنبًا إلى جنب مع معالجة اللغة الطبيعية.
كانت الخطوة التالية، بالنسبة إلى لاندغراف، تشفير هذه المعلومات إلى روبوت أطلق عليه اسم “روبو بي” (RoboBee) تمكَّن من دخول الخلية، وأصدر أوامر لنحل العسل بلغته، واستطاع أن يطلب من النحل الآخر أن يتوقف، ففعل ذلك. ويمكنه أيضًا جعله يفعل شيئًا أكثر تعقيدًا، وهو رقصة الاهتزاز الشهيرة جدًا، وهو نمط الاتصال الذي يستخدمه النحل لنقل موقع مصدر الرحيق إلى نحل العسل الآخر. لكن ذلك يطرح أسئلة فلسفية وأفكارًا خيالية لا حدَّ لها.
وتمكَّن باحثون في جامعة كارلتون في أوتاوا، على مدار ما يقرب من 20 عامًا، من الاحتفاظ بسجلات مفصلة لأصوات الطقطقة لعشيرتين من حيتان العنبر الخاصة بها، وما كانت تقصده الحيوانات بذلك. ووُجِد أن الحيتان تستخدم أنماطًا معينة من الصوت، تُسمَّى “الكودا” للتعرُّف بعضها على بعض. إنها تتعلَّم هذه “الكودا” بالطريقة نفسها التي يتعلم بها الأطفال الصغار الكلمات والأسماء من خلال تكرار الأصوات التي يصدرها البالغون من حولهم.
نماذج جديدة
هناك نموذجان، على سبيل المثال لا الحصر، ربَّما يؤشران إلى مرحلة جديدة من قصص الخيال اعتمادًا على هذه الاكتشافات الجديدة، ومنها رواية “إسماعيل يحب”، التي كتبها روبرت سيلفيربيرغ (2023م). إسماعيل هو دولفين قاروري الأنف، يقع في حب ليزابيث كالكينز، التي تبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا، وتعمل متخصصة في العلاقات بين الإنسان والحيتان.
وقصة الروائية التركية أليف شافاك، “جزيرة الأشجار المفقودة” (2021م)، التي تدمج بين الواقع والخيال؛ إذ الراوي فيها شجرة تين جاء بها مهاجر قبرصي يوناني عاش قصة حب مع فتاة تركية خلال الحرب الأهلية، ثم أُبعِد إلى لندن. وتختزن هذه الشجرة في عروقها وجع الأجيال المتعاقبة، الذي لا يستطيع أبناء هؤلاء المهاجرين التعبير عنه أو نسيانه. فتسرد هذه الشجرة لاحقًا هذه القصة الأليمة، وتسلّط الضوء على قسوة البشر ونفاقهم.