بين الحزن والغضب والحنين إلى الوطن يعيش النحَّات العراقي أحمد البحراني. وكان لهذه التركيبة من الانفعالات المتضاربة أن تنعكس على أعماله العميقة المتمردة. هو نحَّات جيل تركت رائحة الحرائق وضجيج الحروب بصمتها عليه. لا يفارقه الفرات في حِلَّه وترحاله، فيستمدّ منه قوة التعبير الحاضرة في أعماله التي تبدو إعصارًا يتناقض مع هدوئه وتواضعه. فنانٌّ تجاوزت تجربته الفنية أربعة عقود. الإنسان هو همُّه الأول ومشروعه، سواء أكان العمل تعبــيريًا أم تجريديًا. جمال أعماله وغموضها وتميُّزها وفرحها وحزنها وجرأتها تستدعيك من بعيد.
بدأت علاقة أحمد البحراني بالنحت مُذ كـان طفلًا يلهو على ضفاف الفرات. كان جرف النهر ملعبه الأول وشاهدًا على شغف الطفل الذي وُلِد على ضفافه، ومارس هناك ألعاب الطفولة التقليدية مع رفاقه. كان الرفاق مشغولين بالماء، وكان هو مشغولًا بالطين. يقول: “كان طين جرف الفرات يسحرني بلونه وجماله وكأنني أعرفه ويعرفني”. فصنع أولى منحوتاته منه. “رغم خطورة المياه الجارفة في ذلك الوقت وتحذيرات الأهل، كنت أنزل إلى جرف النهر لأصنع أول منحوتاتي. أتذكر الآن ظهيرة يوم صيفي، أخذني سحر الطين لساعات من دون أن أشعر بالوقت، وإذا بي أنجز مجموعة من الأعمال تمثّل أهم الشخصيات التي كانت بالنسبة إليَّ رموزًا لمدينة طويريج التي أعشقها وتعشقني. وبعد أن أنجزت مجموعة من الأعمال تعدت 14 شخصية، ظهر والدي. هنا كان كل خوف الطفل من عقوبة الأب الذي يخاف على ابنه من الغرق، فبكيت. ولكن المفاجأة أن والدي الحبيب، رحمه الله، احتضنني وفُوجئ كثيرًا بما صنعت، وقادني من يدي وطلب مني أن أشرح له ما صنعت. فرحت أتحدث عن كل شخصية صنعتها بكل صدق الطفولة، وكان ذلك أول معرض شخصي لي”.
لم تنتهِ حكاية المعرض الأول عند هذا الحد. إذ عاد الطفل إلى البيت، وفُوجئ بخوف الأم وغضبها، لكن الأمر انتهى بتوبيخ المُحِبَّة. وبعد العصر، عاد الفتى ليرى مصير منحوتاته، فوجد الماء يُغطّيها؛ إذ كان مستوى مياه الفرات قد ارتفع واسترد النهر طميه: “وهكذا لم يعد النهر مصدر خامتي فقط، بل أول من اقتنى منحوتاتي”.
1
1
بدأ مسيرته الفنية بقولبة الطين وانتهى باستخدام المعادن الصلبة خامات للتعبير العاطفي، وأقربها إلى قلبه الحديد.

من ضفاف الفرات إلى العالم
بعد مسيرة فنية استمرت أربعة عقود من الزمن، يرى بعض النقاد أن البحراني بات من النحَّاتين المؤثرين عالميًا. لكنه يَعدُّ “العالمية” تعبيرًا مطاطًا، فيقول: “ربَّما يعتقد البعض أن انتشار أعمال الفنَّان في عدد من عواصم العالم يكفي لإطلاق هذا المصطلح المطاط عليه. قد يكون هناك جانب كبير من الصحة في ذلك. ولكنني أعتبر (العالمية) إطلالة نتاجك الفني للمشاهد أينما يتم عرضه. فعندما يتفاعل المشاهدون من مختلف الجنسيات والثقافات مع عملك، بغض النظر عن هويته الجغرافية، يمكن أن يكون لهذا المصطلح أهمية بالنسبة إليَّ! ولكنني لم أفكر في هذا أبدًا. فأنا أعمل فقط بما أنا مؤمن به”.
يعيش البحراني اليوم مع فنِّه حياة ذات إيقاع هادئ. يبدأ يومه باكرًا بالذهاب إلى محترفه حاملًا معه كثيرًا من الأفكار التي تولَّدت من خلال مشاهداته اليومية، وما يحمله من ذكريات وأحلام، إضافة إلى الشغف وروح الهواية التي لا يتمنى أن يفقدها أبدًا. فشعاره الذي يرفعه دائمًا هو “أعيش بروح الهواية وأمارس الفن بأدوات المحترف”. وبهذه الروح تأتي الأفكار ويأتي النتـاج الفني، سواء أكان نحتًا أم رسمًا، وربَّما كتابة أو أي نتاج فني يُعبِّر عمَّا بداخله.
وهل يتعارض هذا الولع مع إنجاز أعمال بتكليف؟ وهل يشعر الفنان بالتقييد؟ يقول: “في البدايات، وبكل صراحة، كانت الظروف الشخصية وظروف الغربة المبكرة تفرض شروطها عليَّ. فحاولت أن أوفر وسائل العيش الكريم في غربة قاسية. وكنت غالبًا ما أرضخ لطلبات من يطلب مني بعض الأعمال. ولكن، بعد أن توافرت وسائل العيش بالمعقول وبكرامة، وبعد أن تجاوزت تجربتي الفنية ما يقارب أربعة عقود، أصبح الأمر مختلفًا تمامًا. فلم يعد هناك سبب للحد من حريتي، وأصبحت أستطيع أن أملي شروطي الفنية والمادية على أي تكليف أُكلَّف به، على أن أحترم المكان وطبيعة المشروع الفني، وما يناسب الموضوع. علمًا أنني أعمل بشكل يومي على مشاريعي الشخصية، من دون التفكير في ما أنتجه وأين سيكون مصيره”.


تطويع المعدن للتعبير عن عاطفة
الإنسان هو مشروع البحراني الأول، فيقول: “الفن الحقيقي هو في نظري الفن الذي يعيش حياة الآخرين بفرحهم أو بمعاناتهم. أنا أجد نفسي تحت طائلة مسؤولية كبيرة تجاه التعبير عمَّا يجري من حولي؛ لأنني أعتبر الفنَّان مسؤولًا عن توثيق وترجمة ما يجري في هذا العالم”.
يرى البحراني أن “اختلاف الأدوات وطرق التعبير من فنَّان إلى آخر، أمرٌ طبيعي. وكل فنان جزء مهم من هذا الكون، وخاصة في هذا الزمن الذي أصبح يميل للماديات ويبتعد عن الجانب الإنساني، وهو ما خلق فجوات كبيرة بين شرائح المجتمع، إضافة إلى ما يعيشه العالم من حروب ومآسٍ إنسانية. ولا يمكن أيضًا إغفال قضايا البيئة التي تحوِّل كوكب الأرض يومًا بعد يوم إلى مكان لا يصلح للعيش في أجزاء كثيرة منه. كل هذا يُلقي بظلاله على فلسفة الفنان الحقيقي ونتاجه. وهذا بطبيعة الحال كان جزءًا لا يتجزأ مما أثَّر فيَّ وفي تجربتي الفنية”.
على الرغم من انغماسه بعالمه الفني وانشغالاته الكثيرة، فإنه لا يغفل دوره بوصفه فردًا في مجتمع. وتبدو حساسيته مفرطة من خلال حديثه عن تفاعله مع الناس: “أنا ابن الشارع العراقي بكل أحداثه اليومية، وتربطني عاطفة مع كل قضايا شعبي وشعوب العالم، ولذلك أتخلى عن صفة الفنَّان مقابل صفة الإنسان، وأشعر بالسعادة والفخر عندما أكون كذلك”.
يُلاحظ المتتبع لأعمال البحراني تفضيله للخامات المعدنية في منحوتاته، ويرى أنَّ التعامل معها يحتاج إلى دراية ووعي كاملين بخبايا هذه المواد صعبة المِراس. ولربَّما من هنا كانت جاذبيتها. يقول البحراني: “بطبيعتي أعشق التحدي ولا أميل إلى الاستسهال في العمل. فقد عشت سنوات طويلة وأنا أعمل بمادة الحديد التي روَّضت صلابتها وملأتها عاطفة وأصبحت قريبة للعين والقلب رغم قساوتها. ولذلك، سيبقى الحديد هو الأقرب إليَّ. على الرغم من أنني بِتُّ أُنجز أغلب أعمالي بمادتي البرونز والستانليس ستيل منذ بضع سنوات، فأنا لم أبتعد وأتخلى عن العشق الأول وهو مادة الحديد”.




فنَّان دائم النقد لأعماله
في سجله عدد كبير من المنحوتات والنُّصب والجداريات المعروضة في القارات الخمس. فنسأله عن رضاه عمَّا وصل إليه، فيقول: “لا أبالغ إن قلت إنني ما إن أنتهي من إنجار أي مُجسَّم لي في أي مكان في العالم، ورغم سعادتي والنشوة التي تمتلكني بعد اكتماله وعرضه على الجمهور، فإنه يغمرني شعور مزدوج من الرضا وعدم الرضا. لأنني بعد أن أنتهي من العمل أبدأ بانتقاده فنيًا! نعم، فأنا دائم النقد لأعمالي وأشعر أن هناك شيئًا لم يكتمل فيها. وهذا ما يجعلني أتحاشى زيارة أعمالي التي أنجزها، وأحاول دائمًا أن أكون بعيدًا عنها”.
قادنا ذلك إلى سؤاله عن رأيه في حال الفن في العراق اليوم. فلم يُخفِ عدم رضاه عن بعض الأعمال النحتية القائمة في شوارع المدن العراقية. فهناك، من وجهة نظره، أعمال يجد صعوبة في انتقادها؛ لأنها تحمل تواقيع أسماء فنية كبيرة. ويرى أن “النحت العراقي يمر اليوم بأزمة ولأسباب كثيرة جدًا، أهمها الوضع العام الذي يمر به العراق وعدم الاستقرار في كثير من مفاصل الحياة. والنحت الميداني، بطبيعة الحال، يأتي بعد أن تكتمل البنية التحتية للمدن، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يُلقي بظلاله على كل مفاصل الحياة وأهمها الفنُّ الميداني نحتًا ورسمًا”.
وينتقد البحراني التخبُّط في اتخاذ القرارات بخصوص إنجاز نُصب فنية في بعض شوارع بغداد وساحاتها وغيرها من مدن العراق. بعضها لا يليق بمستوى ما نطمح إلى رؤيته في العراق اليوم. ولا بدَّ من أن تكون وقفة حقيقية لوضع خطط فنية واضحة بهذا الاتجاه؛ لأن في العراق فنانين رائعين قادرين على أن يضعوا لمساتهم الإبداعية لتجميل المدن، ولكن بعد أن تكون المدينة جاهزة لذلك.
أمَّا عن إسهامه في الساحة الفنية في العراق، فمن المعروف أن البحراني هو الفنَّان الذي صمَّم “كأس العراق” لكرة القدم على شكل شجرة تتكوَّن من ثماني عشرة ورقة تمثِّل المحافظات الثماني عشرة في البلاد. وحول هذا العمل يقول: “بحكم وجودي في دولة قطر التي قدَّمت لي كثيرًا من الدعم، وكلَّفتني بكثير من المشاريع الفنية داخل الدولة وخارجها، كنت أحلم أن يكون لي أي عمل في العراق، وقد تمَّ ذلك. وعلى الرغم من أنه عمل صغير الحجم، فأنا أعدُّه من أهم أعمالي وأكبرها؛ لأنه يحمل اسم “كأس العراق”. لقد أعادني إلى الوطن من خلال بوابة كبيرة ورائعة، وهي بوابة جماهير كرة القدم الرائعين وتلك المحبة التي غمروني بها”.

مدرسة الغربة
للغربة أثمانها وعطاياها. رؤية الوطن الجريح من بعيد تختلف كذلك. ويرى البحراني أن المنفى سلاح ذو حدين أو عملة بوجهين. “تعلَّمت الكثير من خلال الغربة. وزادت خبرتي سواء أكان ذلك في العمل الفني، أم في التعامل مع ضروب الحياة بمختلف مجالاتها. لكني حرصت على أن أظل محافظًا على ما تعلَّمته في بلدي من جوانب مضيئة. فليس كل ما تعلَّمناه في بلدنا يجب أن نفرضه على الآخرين، والعكس صحيح؛ إذ لا يجوز لغربتنا أن تفرض علينا ما لا نؤمن به. وهنا يأتي التوازن بين ما تحمله معك قبل هجرتك وبعدها”. الوجه القاسي للغربة الذي رآه البحراني هو فقدان المُغترِب للجوانب العاطفية والاجتماعية التي لا يمكن تعويضها في أي مكان في العالم: “ربَّما يقول البعض إنني أبالغ. ولكن يبقى للمنزل الأول والعائلة والصُّحبة الأولى طعم وخصوصية لا يمكن أن تعوِّضها مكتسبات غربتنا مهما كانت”.
ويظل العراق حُلمه البعيد القريب: “لديَّ أحلام كثيرة، وتتغير بشكل دائم مع التغيرات التي أمر بها. ولكن يبقى حُلمي الحقيقي أن يسمح لي الزمن بأن أقضي آخر سنوات حياتي في مدينتي وبين أهلي”.




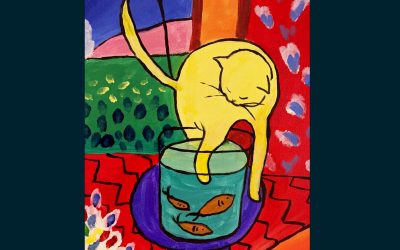

اترك تعليقاً