تشكِّلُ الثقافتان الصينية والعربية ركيزتين عريقتين من أهم ركائز الإرث الثقافي والحضاري للإنسانية، وتُسهمان بفاعلية في أوجه الحياة كافة، والتعاونُ بينهما كان ولا يزال جسرًا للتواصل الإنساني والتفاعل الثقافي من طريق الحرير القديم إلى أحدث مبادرات اليوم.
وفي صميم العلاقات الثقافية الصينية العربية، يأتي التعاونُ الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، ركيزةً لهذه العلاقات، ورافعةً لمجالات ثقافية متعددة تشمل التعليم والفنون واللغة والترجمة. وقد جاءت جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين تتويجًا للجهود المبذولة لتنمية العلاقات الثقافية على جانبيها العربي والصيني. وكان الإعلان عن الجائزة قد حصل عام 2019م، بينما تنطلق دورتها الأولى هذا العام، بعد فتح باب الترشيح لها منذ أكتوبر الماضي حتى نهاية فبراير من العام الحالي.
تُمثِّل الترجمة مجالًا مهمًا في العلاقات السعودية الصينية. ومن أوجهها على سبيل المثال، مشروع وكالة “كلمات” لترجمة الأدب السعودي، بالتعاون مع دار النشر التابعة لجامعة إعداد المعلمين في بكين. ومن الأعمال التي تُرجمت إلى اللغة الصينية رواية “البحريات” للكاتبة أميمة الخميس، ورواية “رحلة الفتى النجدي” للكاتب يوسف المحيميد. إضافة إلى اهتمام دُور النشر الصينية بترجمة الأدب السعودي مثل “مدن تأكل العشب” للكاتب عبده خال، وعقدت الجامعات السعودية ندوات مختلفة عن الأدب والثقافة الصينيين، كما كانت المملكة ضيف الشرف في معرض بكين للكتاب لعام 2024م.

كان الدِّينُ والتجارةُ العاملَين الأشدَّ تأثيرًا في العلاقات بين العالم العربي والصين على مدى قرون طويلة، مع ما رافق ذلك من متطلبات مثل الترجمة.
الدين والتجارة واللغة
كان الدِّينُ والتجارةُ العاملَين الأشدَّ تأثيرًا في العلاقات بين العالم العربي والصين على مدى قرون طويلة، مع ما رافق ذلك من متطلبات مثل الترجمة. وهذا ما أدَّى كذلك إلى نمو العلاقات الثقافية، انطلاقًا، على سبيل المثال، من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ومن حاجة التجَّار إلى التفاهم اللغوي في تبادل الأعمال التجارية.
وكانت الجزيرة العربية في مركز العلاقات العربية الصينية؛ دينيًا، حيث توجد “مكةُ المكرمة والمدينةُ المنورة”؛ وتجاريًّا، إذ توسَّطت شبه الجزيرة العربية طريقَ الحرير القديم بين الشرق الأقصى والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. ومن اللطيف ما قاله الرحَّالة العربي ابن بطوطة عن الصين في كتابه “تحفة النظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”: “وبلادُ الصين آمنُ البلاد وأحسنُها حالًا للمسافر، فإنَّ الإنسان يسافرُ منفردًا مسيرة تسعة أشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليها. وترتيب ذلك أنَّ لهم في كل منزل؛ أي في كل مكان، ببلادهم فندقًا عليه حاكم يسكن به في جماعة من الفرسان والرجال، فإذا كان بعد المغرب أو العشاء الآخرة جاء الحاكم إلى الفندق ومعه كاتبه فكتب أسماء جميع من يبيتُ به من المسلمين وختم عليها، وأقفلَ باب الفندق عليهم، فإذا كان بعد الصبح، جاء ومعه كاتبه فدعا كل إنسان باسمه، وكتب بها تفسيرًا؛ أي شهادة رسمية، وبعث معهم من يوصِّلُهم إلى المنزل الثاني له ويأتيه ببراءة؛ أي شهادة رسمية، من حاكمه أنَّ الجميعَ قد وصلوا إليه”.
وهذا يعني، بحسب رؤية ابن بطوطة، الأمنَ والأمانَ؛ إذ يمكن للأعمال كلِّها بما فيها الأعمالُ التجارية أن تزدهر، ويمكن للتواصل الإنساني بما يتضمنه من ثقافات ومعارفَ أن يكون مفيدًا للجميع.
وإذ تعود العلاقات العربية الصينية إلى نحو ألفي عام، فإنَّ الجغرافيا السياسية لم تكن بتلك الأسماء التي هي عليها الآن، ولا سيَّما من وجهة النظر الصينية. فقد أطلق الصينيون القدماء اسم “المناطق الغربية” على معظم ما يُسمَّى الآن “الشرق الأوسط” الذي يشمل العالم العربي، بينما تُعرَفُ “الصين” باسمها الحالي لدى العرب قديمًا وحديثًا.
وبوجه عام، يمكن تقسيم مراحل الترجمة الدينية والإبداعية من اللغة العربية إلى اللغة الصينية إلى ثلاث مراحل.
في البداية كان القرآن الكريم
ما بين نهاية حكم أسرة مينغ وبداية حكم أسرة تشينغ في القرن السابع عشر الميلادي، ترجم رجال دين مسلمون صينيون معاني آيات من القرآن الكريم، لاستخدامها في عِظاتهم وشروحهم للإسلام. ثم ظهرت الترجمة الكاملة لمعاني القرآن الكريم للمرَّة الأولى عام 1927م، على يد المترجم غير المسلم “لي تييه تشنغ”، الذي ترجم المعاني عن اللغة اليابانية بالاستعانة بالترجمة الإنجليزية.
ثم نُشرت الترجمة الكاملة لمعاني القرآن الكريم عن اللغة العربية مباشرة إلى اللغة الصينية في الخمسينيات من القرن العشرين، على يد المترجم والباحث “ما جيان – محمد مكين الصيني”، وهو عالم دين ومترجم، وكان ضمن أول بعثة صينية تدرسُ في الأزهر الشريف في مصر. وقد نُشِرَت هذه الترجمة داخل الصين، ثم تولَّى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، لاحقًا، طباعة هذه الترجمة في نسخة جمعت بين النصين العربي والصيني. ونسخة محمد مكين الصيني لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية هي المعتمدة لدى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
على الجانب الإبداعي وفي اتصاله بالدين، أتم العلَّامة الصيني “ما ديشين – يوسف ما ديشين” ترجمة قصيدة “البُردة” للبوصيري عام 1867م، عقب عودته من رحلة إلى العالم العربي، ونُشِرَت بعد وفاته عام 1890م، وكانت قصيدة البوصيري من بواكير الأعمال العربية المترجمة إلى اللغة الصينية.
وظهرت أول ترجمة كاملة لكتاب “ألف ليلة وليلة” عام 1941م، وأنجزها المترجم “نا شُون” عن لغات وسيطة، وقدَّم بعض المترجمين الصينيين غير المسلمين إسهامات في الترجمة، مثلما فعل “شِي رُوَه”، الذي ترجم “ألف ليلة وليلة”، التي ازدادت شهرتها، ووصل عددُ ترجماتِها إلى اللغة الصينية إلى أكثر من عشر ترجمات. فيما قدَّم “ماو دون” و “بينغ شين” ترجمةً لمقاطع من كتاب “النبي” لجبران خليل جبران، الذي يُعَدُّ أحدَ أكثر الكتَّاب تأثيرًا في الصين. وترجم الكاتب “تشنغ تشن دوه” من الإنجليزية إلى الصينية بعض المقاطع من قصائد الشعراء المشهورين في العصر العباسي من أمثال: أبي نواس، وأبي العتاهية، والمتنبي، وأبي العلاء المعري، في كتابه “مقدمة في الأدب”. وكان كل ما يُترجم من الأدب العربي في هذه الفترة يأتي من لغات أخرى غير اللغة العربية مثل الإنجليزية.
منذ القرن السابع عشر الميلادي، ترجم رجال دين مسلمون صينيون معاني آيات من القرآن الكريم، لاستخدامها في عِظاتهم وشروحهم للإسلام.

أدب وأيديولوجيا
مع إعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام 1949م، وتأسيس علاقات دبلوماسية بين الصين والدول العربية، بدأت ترجمة بعض الأعمال العربية. وخلال هذه الفترة كان للعوامل السياسية التأثير الأكبر على اختيار الأعمال أكثر من قيمة النص
الأدبي نفسه؛ أي تفوقت المعايير الأيديولوجية السياسية على المعايير الجمالية الفنية في اختيار الأعمال، وصدر في تلك الفترة أكثر من عشرين ديوانًا شعريًا ومجموعات قصصية مترجمة من العربية إلى الصينية من مصر والجزائر وليبيا وسوريا والعراق والأردن وغيرها. وتمحورت النصوص حول موضوع الاستقلال أو النضال من أجل العدالة. ومن الجدير بالذكر، أنَّ تعلم اللغة العربية في الصين خطا خطوة مهمة ودخل في صفوف الجامعات الصينية عام 1946م، وتُرجِمَت أعمال إبداعية من العربية مباشرةً مثل كتاب “كَلِيلَة ودِمْنَة” عام 1959م على يد المترجم لين شينغ خوا. وكانت إحدى نتائج الثورة الثقافية في الصين، أن توقفت حركة الترجمة عن اللغات الأجنبية ومن بينها العربية بين عامي 1966م و1976م.
ما بعد الإصلاح والانفتاح

مع تراجع القيود السياسية والأيديولوجية الناجمة عن الثورة الثقافية في الصين، نشطت مجددًا حركة الترجمة عن اللغات الأجنبية بما فيها العربية، وازداد الاهتمام بالمعايير الإبداعية عند اختيار الأعمال المرشحة للترجمة. كما ازداد عدد المترجمين من العربية إلى الصينية، مع تأسيس أقسام اللغة العربية في أكثر من عشر مؤسسات للتعليم العالي في الصين، التي أدرجت تدريس تاريخ الأدب العربي في مناهجها.
وكان للروائي نجيب محفوظ النصيب الأكبر من الاهتمام؛ إذ تُرجمت معظم أعماله إلى اللغة الصينية، مثل “الثلاثية” و “الحرافيش” و “عبث الأقدار” وغيرها. كما تُرجمت رواية الروائي الطيب صالح “موسم الهجرة إلى الشمال”، وكان ذلك كله في ثمانينيات القرن العشرين.
وحظي الشاعر محمود درويش كذلك باهتمام كبير في ترجمة شعره إلى الصينية، وصدرت ترجمة لأعماله إلى اللغة الصينية بعنوان “عاشق من فلسطين” عام 2016م في بكين، ونظَّمت جامعة الدراسات الأجنبية حفلًا بهذه المناسبة. وفي عام 2000م، صدر كتاب “مختارات من الشعر العربي الحديث”، وضمّ أكثر من مائة قصيدة لأربعين شاعرًا عربيًا. وفي عام 2009م، صدرت المختارات الأولى من شعر أدونيس بعنوان “عزلتي حديقة”، وقد فازت الترجمة بجائزة لوشون في الأدب.
وبشكل عام، ركَّزت حركة الترجمة من العربية إلى الصينية في القرن العشرين على بعض الدول، مثل: مصر وسوريا ولبنان، غير أنَّ السنوات العشرين الأخيرة، شهدت تركيزًا على أهمية الأدب في دول الخليج.
الترجمة ومشاريع المؤسسات
وكما كان الحال قديمًا مع طريق الحرير، الذي جمع الصين والعالم العربي في سياق تجاري واقتصادي وثقافي، فإنَّ الحال نفسه الآن مع مبادرة “الحزام والطريق”، التي تجمع الصين كذلك والعالم العربي؛ تأسيسًا على العلاقات الصينية العربية التي تزداد تطورًا في مجالات متعددة، ومنها المجال الثقافي والإبداعي واللغة. إذ أولت الصين أهمية كبيرة لدعم الترجمة والترويج لثقافتها وتعليم اللغة الصينية بمبادرات متعددة، يأتي في مقدمتها تأسيس معاهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية في أكثر من بلد عربي. كما تنشط مؤسسات رسمية، وخصوصًا في مجال الترجمة، منها على سبيل المثال مشروع “بيت الحكمة” للترجمة من اللغة الصينية وإليها، وقد ترجمت ضمن مشاريع تبادل الترجمة والنشر بين الصين والدول العربية لكُتَّاب عرب، من أمثال: بهاء طاهر، وعزت القمحاوي، ورضوى عاشور، وخيري شلبي، وأمير تاج السر، وصبري موسى، ويحيى الطاهر عبدالله، ورجاء عالم، والمنسي قنديل، وميرال الطحاوي، وعبقريات العقاد.

من الكلاسيكي إلى الحديث
في المقابل، تأخرت الترجمة من الصينية إلى العربية حتى ثلاثينيات القرن الماضي، ولكنَّها أصبحت أكثر اتساعًا مع دخول جيل جديد من المترجمين إلى المجال؛ إذ يمكن القول إنَّ الأعمال الصينية المترجمة من الصينية إلى العربية، بدأت تأخذ مكانها على خارطة القراءة العربية، ليس فقط في الأعمال الصينية الكلاسيكية، وإنَّما كذلك في الأدب الحديث. ويمكن تقسيم ترجمة الأدب الصيني ونشره في الدول العربية إلى أربع فترات:
من الثلاثينيات حتى أواخر الخمسينيات
في رسالته للدكتوراة “ترجمات وانتشار الأدب الصيني المعاصر في الأدب العربي”، يذكر الدكتور يحيى مختار أن العقود الثلاثة من الثلاثينيات حتى نهاية الخمسينيات، شهدت ترجمة الكلاسيكيات الثقافية الصينية والكثير من أعمال الكُتَّاب الصينيين المشهورين إلى اللغة العربية. وتولَّى الترجمة في تلك الفترة مجموعة من العلماء المسلمين الصينيين الذين كانوا يدرسون في الأزهر الشريف، وقد ترجموا الأعمال الأدبية الصينية مباشرة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، مثل المترجم الصيني “ما جيان – محمد مكين الصيني”، فإلى جانب ترجمة كثير من النصوص الدينية والفقهية من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، ترجم خلال السنوات التي قضاها في مصر من عام 1931 إلى 1939م، كثيرًا من الأعمال الكلاسيكية للثقافة والأدب الصيني إلى اللغة العربية، وتشمل ترجماته البارزة “قصص الأساطير الصينية” و “محاورات كونفوشيوس”، ونُشرت كل هذه الأعمال في القاهرة.
من الخمسينيات حتى أواخر الثمانينيات
تولَّى في هذه الفترة مترجمون عرب “غير متخصصين في الدراسات الصينية”، جزئيًا ترجمة الأعمال الثقافية والأدبية الصينية إلى العربية عبر لغة وسيطة. ومن هؤلاء الشاعر السوري سهيل أيوب، والكاتب المصري عبدالغفار مكاوي، والكاتب السوري عبدالمعين الملوحي، والشاعر السوري سلامة عبيد، والباحث السوري فراس السواح، والباحث العراقي هادي العلوي، والمترجم محمد نمر عبدالكريم، وغيرهم.
من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات
وتولَّى فيها الترجمة من الصينية إلى العربية مترجمون متخصصون في اللغة والدراسات الصينية، وقد أسهم ظهور هؤلاء المتخصصين بشكل كبير في تعزيز تطور ترجمة الأدب الصيني في العالم العربي. ومن بين هؤلاء المترجمين البارزين: الدكتور عبدالعزيز حمدي، والدكتورة إسراء عبد السيد، والدكتور محسن فرجاني، والدكتور حسانين فهمي، وعدد من أساتذة كلية الألسن بجامعة عين شمس، مثل: الدكتورة نجاح عبداللطيف، والدكتور وحيد السعيد عبدالحميد، وغيرهما. وتُرجمت أعمال مثل مسرحية “شروق الشمس” للكاتب تساو يو، ومسرحية “المقهى” للكاتب “لاو شه”، وكتاب “تاريخ تطور الفكر الصيني”، و “محاورات كونفوشيوس”، و “الكتب الأربعة المقدسة”، و “سياسات الدول المتحاربة”، وكتاب “الطاو”، و “الذرة الرفيعة الحمراء” للكاتب مويان، وأعمال الكاتب “يوهوا”.
مترجمو الألفية الجديدة
مع تنشيط تدريس اللغة الصينية في الجامعات العربية، مثل كلية الألسن العريقة بجامعة عين شمس المصرية، وأقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية والعربية، ظهر جيل جديد من المترجمين الشباب من أمثال: الدكتور أحمد السعيد، والدكتور يحيى مختار، والدكتور أحمد ظريف، ومي عاشور، وميرا أحمد، وغيرهم، يترجمون مباشرةً أعمالًا إبداعية رفيعة المستوى من الصينية إلى العربية. وأسهم فوز الكاتب الصيني مويان بجائزة نوبل للآداب عام 2012م، في ترجمة مزيد من الأعمال الأدبية الصينية المعاصرة إلى اللغة العربية لكثير من الكتَّاب والشعراء، ومنهم: مويان، يوهوا، وشيو تسي تشن، وسوتونغ، وتشي تزي جيان، وغيرهم. والجدير بالذكر أن الحكومة الصينية أطلقت مشاريع مثل: مشروع “كتب طريق الحرير”، ومشروع “كلاسيكيات الصين”، ومشروع “سلسلة كنوز التراث الصيني”؛ وذلك لترجمة الأعمال الكلاسيكية وتعزيز التبادل الثقافي بين البلاد العربية والصين.
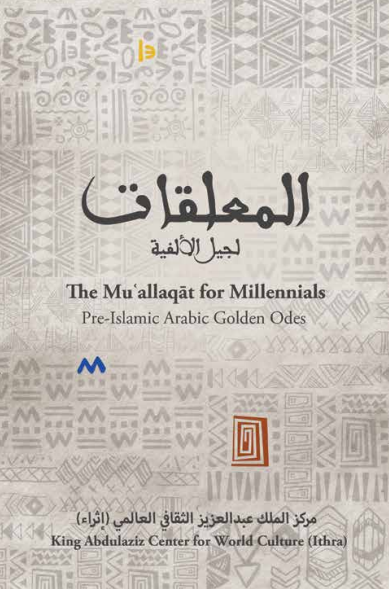
شهد معرض بكين الدولي للكتاب 2024م إطلاق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” للمرحلة الأولى من الترجمة الصينية لكتاب “المعلقات لجيل الألفية”، التي شملت ثلاث معلقات لامرئ القيس والأعشى والنابغة الذبياني. لمعرفة المزيد حول قصة الترجمة، التي تأتي بالتعاون مع جامعة بكين، برجاء الضغط هنا.



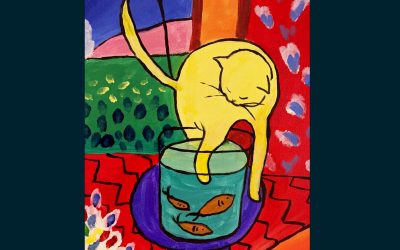

اترك تعليقاً