على مرِّ العصور، كان تعليم الأبناء مهارات الحياة هاجسًا لدى الآباء، بدءًا من تعليمهم كيفية النجاة من الوحوش في العصر البدائي إلى مهارات العيش بين الناس في مجتمع، وإتقان عمل يعتاشون منه ويكتسبون به مكانتهم في المجتمع.
في أوائل القرن العشرين عرَّف عالم الاجتماع الفرنسي، إميل دوركايم، التربية بأنها التأثير الذي يجريه الجيل الراشد في الجيل الناشئ. والتربية ليست علاقة ثنائية بين الأهل من جهة والطفل من جهة؛ بل تـتدخل فيها عوامل المجتمع ومنظومته القيمية وسلوك أفراده الآخرين وأنواع الفن السائدة فيه والرفاق والأقارب، ثم تأتي المدرسة بمناهجها وأنواع الراشدين والأطفال فيها.
وما بين التشدّد في القسوة، سواء أكانت جسدية أم لفظية، التي يمكن أن تكون في ظروف معينة مسيئة أكثر مما هي ضابطة ومحسّنة، والتراخي الذي يترك الطفل والمراهق من دون حسيب أو رقيب وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك؛ هناك مساحة وسطى بالغة التعقيد، تحاول “القافلة” أن تستطلعها هنا من خلال ثلاث مشاركات. ففي البداية، يستعرض أسامة أمين، الممارسة التربوية التي كانت حتى الأمس القريب الأكثر شيوعًا في العالم: الضرب.. ما له وما عليه. وفي المشاركة الثانية تتعرض نعيمة بنعبدالعالي لماهية المنطقة الوسطى التي أشرنا إليها آنفًا، من خلال ما توصَّل إليه المربّون وعلماء النفس والاجتماع في العصر الحديث. ومن ثَمَّ، يُسلِّط د. سعيد هادي وهاس الضوء على جذور قضية التربية التي تمتد عميقًا إلى لحظة زواج الأبوين، وربَّما إلى ما قبلها؛ لضمان أهليتهما لتربية الأبناء المرتقبين.
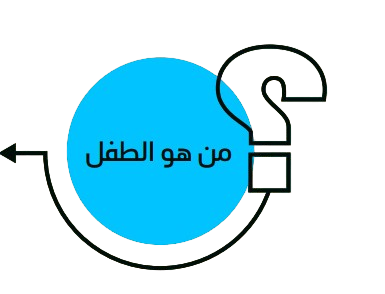
يُطلق توصيف “الطفل” في القوانين والأعراف التربوية والعقابية على المولود حتى يبلغ سن الرشد، التي تدور حول الثمانية عشر عامًا، تزيد أو تنقص عامًا أو عامين بحسب التشريع في كل بلد من البلدان.
وقد بدأت الجهود الدولية الجماعية لحماية الطفل بإعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924م، ثم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959م الخاص بالطفل، والمعترف به ضمن مدوّنة حقوق الإنسان الدولية. وتطوَّرت القوانين الوطنية لرعاية الطفل إلى حدٍّ قد يراه الشرقيون تطرفًا في القوانين الغربية التي تصل إلى حد نزع الأطفال من أسرهم لحمايتهم من الضرب. فتقوم الدولة بدور الأب للآباء، وهذا محل نزاعات قضائية بين المهاجرين والحكومات، خصوصًا ذات الرعاية القصوى للأطفال مثل السويد.
الضرب في ذاكرة الأدباء
على عكس الغالبية العظمى من الذين تعرضوا للضرب في طفولتهم على أيدي والديهم، ونسوا أو تناسوا ذلك بمرِّ السنين، فإن بعض الأدباء قرَّروا أن ينشروا ذلك على الملأ؛ ليقرأه آلاف الأشخاص. وليس بوسعنا أن نحدد هل كان ذلك بدافع الانتقام من آباء وأمهات تلك الحقبة من الزمن، أم لتعريف الناس بتأثير ذلك الضرب على نفسية الطفل.
اكتسبت رواية محمد شكري “الخبز الحافي” شهرتها العالمية من أنها تُقدِّم نموذجًا للحياة العارية أو “الهومو ساكر”؛ إذ يكون الإنسان مجرد مخلوق مجرد من حقوقه، ليس لديه سوى حياته البيولوجية. ففي قلب منظومة الفقر التي تعالجها الرواية، أب غضوب جامح، ومن أفظع مشاهدها وصف البطل لضرب شقيقه الأصغر الذي أفضى إلى موته.
هذا استثناء فظٌّ، تقابله عشرات الشهادات من مفكرين وأدباء في مذكراتهم حول صعوبات طفولاتهم التي اكتنفتها ألوان مختلفة من العقاب. ربَّما لا يذكرون الضرب فيها صراحة، لكن آثاره تظهر في الخوف الشديد من رب الأسرة، وهذا ما يشير إليه عميد الأدب العربي طه حسين بمواربة لطيفة في سيرة حياته “الأيام”. إذ يصف سكونه وإخوته عند استيقاظ الأب، ويستمر ذلك الهدوء حتى يتوضأ ويصلي ويقرأ ورده ويمضي إلى عمله: “فإذا أغلق الباب من دونه، نهضت الجماعة كلها من الفراش، وانسابت في البيت صائحة لاعبة، حتى تختلط بما في البيت من طير وماشية”.
وتناول نجيب محفوظ هذا الأمر في أكثر من موضع في ثلاثيته الشهيرة، “بين القصرين – قصر الشوق – السكرية”. فكان أحمد عبدالجواد، ذلك الأب الصارم الذي يمتلك الصلاحيات المطلقة، يضرب الأبناء بيده الثقيلة. وحين يبكون، كانوا يخفضون رؤوسهم، ولا يتجرؤون على رفع أعينهم في وجهه؛ لأن ذلك يعدُّ تحديًا لا يُغفر. وهذا ما خلق جدارًا من الخوف بينه وبين أولاده.
وفي ألمانيا، وصف كاتب اسمه “أولريش لاند” أحد هذه المواقف على النحو الآتي: “وقفت والدتنا أمامنا، وأشارت إلينا مرة أخرى بإصبعها الممدود ألا نحرك أيدينا الممتدة إلى أسفل. كانت أي حركة لا إرادية لرفع اليدين لحماية الوجه ستؤدي إلى صفعتين إضافيتين. كان هذا جزءًا من القواعد غير المكتوبة لهذا الطقس. ثم انهالت على كل واحد منا بسلسلة من عشر صفعات متتالية”.




اترك تعليقاً