
في نهايات القرن التاسع عشر، سكّ عالم النفس الفرنسي فالنتان مانيان، في محاضراته مصطلح “هوس الشراء” وعدَّه انحطاطًا اجتماعيًا. وفي بدايات القرن العشرين، اعتمد عالما النفس إميل كريبيلين ويوجين بلولر “اضطراب الشراء القهري” بوصفه مرضًا نفسيًّا؛ إذ يندفع الإنسان إلى التسوق بشكل مستمر ومراكمة أشياء تفوق حاجته. وتؤكد إحصاءات أمريكية حديثة أن هذه الحالة تلازم 5.8% من عامة السكان في الولايات المتحدة الأمريكية مدى حياتهم.
على الرغم من أن الاكتشاف كان مبكرًا، فإن الاعتراف بالطبيعة المرَضيّة لظاهرة التسوّق المفرط لا يزال يواجه صعوبة حتى الآن، ربَّما لأن ما اكتشفه ويؤمن به كثير من الأطباء يتعارض مع جوهر الرأسمالية. إذ إن الاقتصاد ينهض بشكل أساس على الاستهلاك، بحسب الفيلسوف والاقتصادي الإسكتلندي آدم سميث (1723م – 1790م). كما أن تحقيق المنفعة الاجتماعية والاقتصادية ينتج في الأساس من المصلحة الشخصية. فكل المبادرات والاكتشافات في العالم بما فيها الرغبة في العمل، أتت من غريزة الكسب. وكل حركة التقدم تأتي من الدوافع الشخصية في المقام الأول، وليست لأجل البشرية، حتى وإن كان فيها ما يصب في مصلحة المجتمع.
وقد أثبتت الرأسمالية من ناحية عملية أنها نظام قادر على تطوير نفسه دائمًا بفضل الحافز الشخصي الذي يتوافق مع طبيعتنا البشرية. فالخبّاز، على سبيل المثال، يوفر الخبز كل يوم، ليس من أجل إطعام الناس، بل لكي يكسب عيشه. والآخرون يستهلكون خبزه، ليس بهدف إعانته على العيش، بل لأنهم بحاجة إلى الخبز.
تحوّل الاستهلاك إلى هوس اجتماعي
على الرغم من وضوح أهمية الاستهلاك لدى منظِّري الرأسمالية، فإنه لم يصبح هوسًا اجتماعيًّا على نطاق واسع إلا في سبعينيات القرن العشرين. فعند انطلاق الثورة الصناعية وخلال قرنين من الزمن، كانت المنتجات تُصنع لتتوارثها العائلة. لكن هذه الوتيرة من الاستهلاك أصبحت عاجزة مع الوقت عن تحقيق نمو الإنتاج الذي يطمح إليه الصناعيون. لذلك، كان لا بدَّ من دفع المستهلكين إلى مزيد من الاستهلاك بشتى الطرق.
ومع أن الاقتصاد عصب الحياة، فإنه لا يعمل بمعزل عن العوامل الأخرى التي تؤثر في الواقع الاجتماعي، ومن بينها الصدمات التاريخية كالحروب الكبرى التي تتسبب في الأزمات وتدهور طبقـات وتقدُّم أخرى. وكذلك أسهم التطور في مجالي الإعلام والإعلان والتسويق في دعم ولع الاستهلاك.

توسّع الطبقات القادرة على الاستهلاك حمل الصناعة على تلبية الطلب بمواصفات تضمن بيعها بسعر أقل، وفي الوقت نفسه تعيش عمرًا أقصر، حتى لا تتشبع الأسواق أبدًا.
فقد كانت الطرازات الأولى من السيارات التي ترافق العائلة عقودًا من الزمن، وأدوات المائدة التي ترثها الحفيدة عن الجدة، متماشية مع التقاليد الاجتماعية التي تحتفي بالعراقة. فكانت الأشياء تستمد قيمتها من قِدمها ومن قدرتها على أن تبقى صالحة للاستعمال حتى أطول وقت ممكن. وكلَّما كانت الممتلكات فريدة وثمينة ومُعمرة، كانت دليلًا على عراقة تلك العائلة.
مرّت الرأسمالية في موطنها الأصلي (أوروبا الغربية وأمريكا)، بحربين كبيرتين في النصف الأول من القرن العشرين، أفقرتا الطبقات النبيلة وخلخلتا مكانتها، وأجبرتاها على التخلي عن تقاليدها الرسمية الصارمة. وفي الوقت نفسه، توسعت الطبقات القادرة على الاستهلاك، وبدأت الصناعة في تلبية الطلب الكبير الذي يُصنَّع بمواصفات تضمن بيعها بسعر أقل، وفي الوقت نفسه تعيش عمرًا أقصر، حتى لا تتشبع الأسواق أبدًا.
دور الإعلان
في مرحلة تالية، نهض الإعلان بدور المبرر. وفي حالات مثل شراء السيارات على سبيل المثال، جرى تصوير تقليل الجودة بوصفه ميزة؛ فجرى الترويج لهيكل السيارة الخفيف بوصفه وسيلة لتحقيق زيادة السرعة وتقليل استهلاك الوقود بتقليل وزن السيارة. لكن النتيجة الأكيدة هي أن المستهلك لم يعد يحتمل السيارة أكثر من خمس سنوات. وهي فترة كانت في أجيال سابقة تُعدُّ فترة التعارف بين العائلة وسيارتها. أمَّا اليوم، فقد صارت السنوات الخمس كافية للفراق، بالنسبة إلى الطرفين وليس لطرف واحد؛ إذ يكون المالك قد ملَّ، وتكون السيارة قد ترهّلت!
جرى هذا جنبًا إلى جنب مع ترسيخ سلطة وسائل الإعلام وحاجتها إلى تدبير موارد من الإعلان، الذي واصل استخدام كل الحيل لإقناع المستهلك بمزيد من الاستهلاك. ولم تعد الميزة في السلعة الفريدة، بل في السلعة التي يستهلكها الملايين. وبينما كانت المجتمعات قد سئمت تقاليد الأرستقراطية ومن ضمنها أهمية التفرّد، واتجهت إلى الاحتفاء بالتشابه، راح الإعلان يروّج التشابه باعتباره ميزة، كأن تأكل الدجاج الذي يأكله الملايين عبر العالم. وقبل أن يُستنفد هذا التوحيد، عاد الإعلان ليزكي التميّز من خلال العلامات التجارية المميزة!
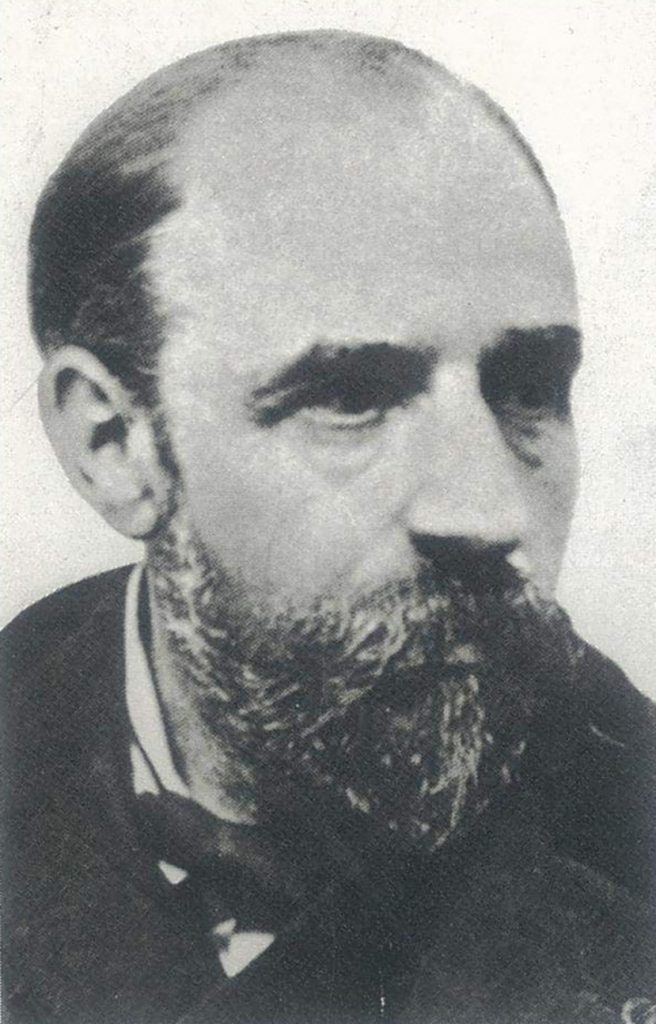

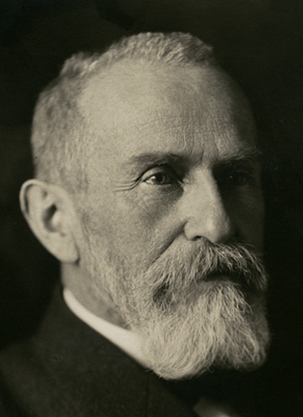
طوال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لم يعد الإعلان محصورًا في الصحف والمجلات المصورة؛ إذ بات التلفزيون ركيزة أساسية في الترويج للاستهلاك بعروض أكثر حيوية من الصور المطبوعة، وصار نجوم السينما، وهم نجوم أحلام الشباب من الجنسين، أبطال الإعلانات. فمن الذي سيقاوم سجائر يدخنها نجم أحلامه، ومَن التي ستقاوم عطر بطلة أحلامها؟
دخلنا في عقد السبعينيات عصرًا جديدًا من التظاهر، سمَّاه المفكر الفرنسي جي دي بيور “عصر الاستعراض”، القائم بشكل كامل على مبدأ “الفُرجة”؛ حيث حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية صور بلا مضمون أو جوهر، وحيث تحوّل العالم إلى مسرح كبير، الجميع فيه ممثلون والجميع متفرجون، كل منهم يمارس الاستعراض على خشبته، وحيث يجب أن يكون المظهر هو الأساس، وحيث نكون بحاجة إلى التسوق دائمًا للحفاظ على مظهرنا.

تطور فن البيع ونموّه
وفي السبعينيات، كان ميلاد ما سيُعرف لاحقًا بحقبة “الرأسمالية المالية” التي بلغت ذروتها الآن؛ إذ نجد أن عائدات المهن غير الإنتاجية هي الأعلى، وأصبح خبراء البنوك ورجال البورصة والدعاية والإعلان، أهم من رجال الصناعة والمبتكرين. وعندما نسأل عن أكبر الشركات في العالم، نجد أن شركات التسويق مثل “أمازون” و”علي بابا”، تزاحم أكبر الشركات المنتجة في العالم على مستوى قيمتها السوقية.
لم يعتمد الصناعيون على الإعلان لتعزيز هوس الاستهلاك فقط، بل كان هناك تغيير ديكور المحال التجارية، التي تزودت بواجهات عرض فسيحة تفتح الشهية للتسوق، حتى في مجال استهلاك الاحتياجات الغذائية. فقد كان تسوق البقالة في زمن البقالات الصغيرة يجري من خلف حاجز يقف وراءە بائع يلبي المطلوب بالضبط، ولكن فتحت سلاسل السوبر ماركت المجال للمتسوق للتجوّل بين صفوف معروضاتها، بحيث يشتري ما يريده وما يجذبه. إنها الحرية وتعدد الخيارات إلى حد التشويش. وإذا لم يُعِد المتسوق قائمة باحتياجاته قبل الخروج من بيته، فلربَّما يعود من السوبر ماركت محمّلًا بغير الضروري وناسيًا الضروري الذي خرج من أجله بالأساس!
وتلقى التسويق دفعًا جديدًا عبر الإنترنت. إذ لم تعد حرية التسوق وسهولته مقصورة على التنزه بين البضائع المختلفة في المعارض الكبرى، بل صارت تشمل رؤيتها في أفضل صورة واتخاذ قرار شرائها من دون أن نتحرك من أماكننا، فبضغطة زر تشتري كل ما تريد، وما عليك سوى كتابة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية، لتصل المشتريات حتى باب البيت.
تطورت وسائل البيع بالتقسيط وعبر بطاقات الدفع الإلكتروني، ومعها تطورت التطبيقات على الهواتف، وهو ما شكَّل قفزة أخرى تُسهِّل التورط في الشراء. فتمرير الهاتف بجوار ماكينة الدفع عمل أقرب إلى الشعوذة منه إلى الدفع النقدي. أحد مستخدمي “فيسبوك” المصريين كتب، مؤخرًا: “لم أنفق هذا الشهر سوى مائتي جنيه… الباقي من بطاقة الائتمان”، وتُعبر هذه المزحة بدقة عن إحساس الكثيرين بأن مال البطاقة لا يخصه، وبسبب هذا المأزق يعرف كل منا في محيطه الاجتماعي حكايات عن مديونيات ضخمة يقع فيها البعض بسبب هذا الوهم.

وبالمثل، تعزّزت قدرة الإعلان مع بدايات القرن الحادي والعشرين. فمع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مجتمع الاستعراض، الذي رفضه جي ديبور في السبعينيات، لا شيء بالنسبة إلى المجتمع الذي خلقته وسائل التواصل، التي أتاحت للجميع ممارسة أحلام النجومية التي طالما تمناها. لم تعد وقفة التأنق أمام الكاميرا حكرًا على النجوم، أصبح كل منا بوسعه أن يلتقط لنفسه اللقطة نفسها، ويستعرض كل لحظة من حياته: في المطعم، فـي السينما، على مقعد الطائرة قبل أن تقلع؛ وأصبح مظهرنا وكل ما نملكه تحت نظر الآخرين.
الخوارزميات.. بائع لجوج
في هذه الوسائل الجديدة، أصبح الإنسان هو المسوّق والمستهلك والسلعة في الوقت نفسه. وبينما يستعرض المستخدم مشترياته مسهمًا في رواجها، تبيع المنصات بياناته لشركات الدعاية والتسويق، ليحللوا شخصيات المستخدمين ويعرفوا ما الذي يؤثر فيهم بالضبط فيندفعون إلى مزيد من الشراء. ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط. ففي الوقت نفسه، أصبحت “الخوارزميات” تشبه الباعة الجوالين في إلحاحهم؛ فإذا بحثت أو فتحت إعلان منتج معيَّن على سبيل الفضول، تنهال عليك إعلانات لمنتجات مشابهة من مختلف المتاجر بمختلف أسعارها وأنواعها. وليس ذلك فقط، فقد وصل الأمر إلى أن التلفظ بكلمة مع صديق على الهاتف قد تُوقعك في هذه المطاردة.
لم يعد البيع والشراء على النحو الذي كان ينشده آدم سميث، من الاعتدال لإدارة اقتصاد حيوي وفعّال؛ لأن الإعلان يتظاهر بأنه لا يبيع السلع، بل يبيع أفكارًا وغايات إنسانية عليا، ويبيع أحلامًا ومخاوف، بينما هو في الواقع يبيع السلع، ويدفعنا إلى الإفراط في الاستهلاك. يغذي الإعلان الخوف من الوقوع في التخلف والعيش في الماضي مع تسارع التطورات التكنولوجية، وهكذا نتسابق لشراء الجيل الجديد من الهاتف حتى لا تفوتنا مزاياه الجديدة، بينما بيدنا هاتف من الطراز نفسه لم نستخدم ربع إمكاناته. وينبغي ألا تفوتك النظرة المميزة للإصدار الجديد من سيارتك، وقد تغيرت رسمة عيونها (كشافات الإضاءة)!
تبيع الإعلانات وهم السعادة، وهي الغاية التي ننشدها في وجودنا. وبينما كنا نستمدها من مساعدة الآخرين في أزمنة العائلة، صرنا في عصر الفرد نستمدها من مظهرنا ومن المزيد من الاستهلاك، أو هكذا نتوهم.
ومع هذا الإلحاح على أهمية الشكل، لم يعد الكثيرون يستمدون قيمتهم من أنفسهم، بل من الأشياء التي يمتلكونها. والطريف أن موقع “أمازون”، أنجح متاجر البيع بالتجزئة في العالم، بدأ مسوّقًا للكتب في منتصف التسعينيات. ويُفترض بالكتب أن تكون حائط الصد ضد قيم الاستهلاك التي تحوّل إليها المتجر فيما بعد!