في عصرية شتاء يزيد من حُمرة الأرض الطينية، دخلتُ قرية “أثيثية” الواقعة في محافظة “مرات” التابعة لمنطقة الرياض، كنتُ حريصًا على زيارتها منذ أن علمت أنها بلد الشاعر جرير. قرية صغيرة، نظيفة، ببيوت جميلة وشوارع هادئة، ربَّما بسبب البرد ذلك النهار. جُلت في القرية سريعًا، أبحث عن مَعلم يحمل اسم شاعر العربية الكبير؛ إذ من المنطقي تصوُّر أن القرية ستفاخر به، وستُزين باسمه الشارع والمدرسة والميدان. لكن لم أجد أي مَعلم يحمل اسم جرير، ولا حتى البقَّالة الرئيسة في القرية!
ومؤخرًا، استهواني أن أقرأ عن “اليمامي” الذي ساهم في بناء (أو توسعة) المسجد النبوي في السنة الأولى من الهجرة، وقال عنه النبي، صلى الله عليه وسلم: “قرِّب اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسًّا، وأشدكم منكبًا”، وأعني به الصحابي طَلْق بن علي، رضي الله عنه، فعلمت أنه أول من أقام مسجدًا في إقليم اليمامة كلها، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة، حين قَلَب بيعة قرّان (بلدة القرينة اليوم) إلى مسجد.
فقلت في نفسي: إن القرينة، بوصفها بلدة الرجل، ومدينة الرياض، بوصفها قاعدة الإقليم منذ عصور سحيقة ومدينة كبيرة جدًا، بسكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، لا بدَّ أنهما خلَّدتا اسم الرجل. لكني لم أعثر على شيء باسمه، ولا حتى على مسجد واحد باسم الرجل الذي بنى أول مسجد في الإقليم كلّه.
وأيضًا لن تجد ذكرًا للشاعر الحطيئة في شوارع المجمعة والغاط والزلفي وميادين هذه البلدات وحدائقها، على الرغم من أن الحطيئة أجرى الشعيب القريب من هذه البلدات، أي “وادي مرخ” على ألسنة العرب قرونًا:
ماذا تقول لأفراخٍ بذي مَرَخٍ زُغبُ الحـواصل لا مــاءٌ ولا شجرُ
ولن تجد ذكرًا لطرفة بن العبد في فضاءات مَلهَم مثلًا، مع أن طرفة الذي ثـبّت اللدانة والليونة لعسبان مَلهم في أذهان العرب:
تظلُّ نساء الحي يعكِفن حوله يقُلن: عَسيبٌ من سَــرارة مَلهَما
ويمكن سحب هذه الملاحظات على المدن والبلدات في واقعنا المحلي. لنلاحظ أن الأمثلة، أعلاه، شملت مدنًا مليونية، مثل “الرياض”، وصولًا إلى قرى صغيرة، مثل “أثيثية”.
كيف حصل هذا؟ أي، كيف حصل أن نظام التسمية للمساجد والشوارع والمدارس والحدائق والميادين، في مدينة أو بلدة، تتنكّر للمذكورين في التاريخ ممن ينتمون إلى هذه الأمكنة؟
الإجابة الأقرب للذهن هي أن التسميات تذهب للأسماء الأكثر تداولًا في كتب التراث. وبناء على ذلك، فإن رجال اليمامة ذهبوا للنسيان. وعندما حلَّت نُظم التسمية المكتوبة، مع التحديث، كان الحاضر للذهن هو الأسماء التي حفلت بها كتب السير.
ولئن كان التفسير المقترح، أعلاه، مناسبًا لشرح إهمال ذاكرة المكان اليمامي لرجل مبرّز من الإقليم لكن أهملَت ذِكره كتب التاريخ، فإن المرء يحار تجاه تجاهل هذه الذاكرة لأسماء شهيرة في المكتوب العربي على مر القرون، مثل طرفة والحطيئة وجرير!
لا تربط مكاننا المحلي (مكان المدينة والبلدة والقرية) ذاكرة ممتدة برموزه. هذه ظاهرة ملاحظة. ذاكرة المكان تقف عند ما قبل ثلاثة قرون تقريبًا.
أهل المكان لا تربطهم وشائج هويّاتية بأعلامه! غالبًا، لا شيء في شوارع “أثيثية” و “القرينة” و “الغاط” وغيرها، يقول لك إن جريرًا من هذه البلدة، أو طلق بن علي من تلك، أو هنا كانت مساكن الحطيئة. يمكن تسمية هذه الظاهرة بالانفصال الشعوري للمكان وقاطنيه عن الأسلاف الغابرين منذ قرون طويلة.
لاحظ أستاذ الآثار بجامعة الملك سعود، د. فهد الحسين، في حديث معه أن لا مشاعر ولا أبعاد هوياتية تربطنا بملوك ددن (مملكة في الحجاز وقاعدتها تيماء منذ القرن السابع إلى الأول قبل الميلاد). أسماء الدادانيين وأبجديتهم غريبتان عنا. لا يتم تقديمهم بوصفهم السلف لذاتنا المعاصرة. ولاحظ أيضًا، بأن لا مشاعر تجمعنا بالعقال العربي فوق رأس الملك، ولا ملامحه التي تشبه ملامحنا، ولا إزاره الذي يشبه “الوزرة”. الأمر في السردية إذًا.
ينشأ المصري على وشائج عاطفية تربطه بالفراعنة. سردية تجعل المطوي في صفحات التاريخ حاضرًا في عالم اليوم، كإبراز التشابه في الملامح بين أخناتون (فرعون مصر قبل 3500 عام) وبين الرجل الذي يحرس مقبرته اليوم، أو الشبه بين الممثلة المصرية سوسن بدر ونفرتيتي. هذا فضلًا عن حضور الأسماء والرموز الفرعونية في شوارع مصر وميادينها.
نحتاج إلى نظام تسمية يستحضر أعلام الأمكنة في العصور القديمة ويربطهم بساكنيها المعاصرين. هذا جهد موزّع على جهات حكومية مختلفة: الأوقاف للمساجد، والتعليم للمدارس، والبلديات للشوارع والميادين والحدائق، والثقافة للمتاحف والمسارح. ولعلَّ إمارات المناطق ومحافظات المدن هي المؤهلة لتوجيه هذه الجهات لوشم الأمكنة بأسماء المبرزين الذين عاشوا بتلك الأمكنة.
وبهذا، فإننا نعيد تشكيل هويتنا المعاصرة، لتستثمر الحمولة التاريخية الثرّة لأمكنتنا ولتُغنى هذه الهُوية بعراقة ماضٍ هو شديد المحلية وشديد الألفة، إن نحن أحسنَّا سرده.


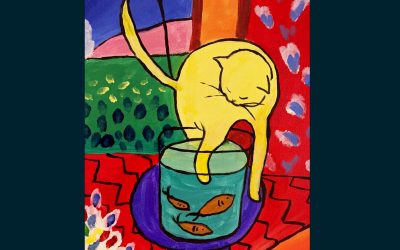

اترك تعليقاً