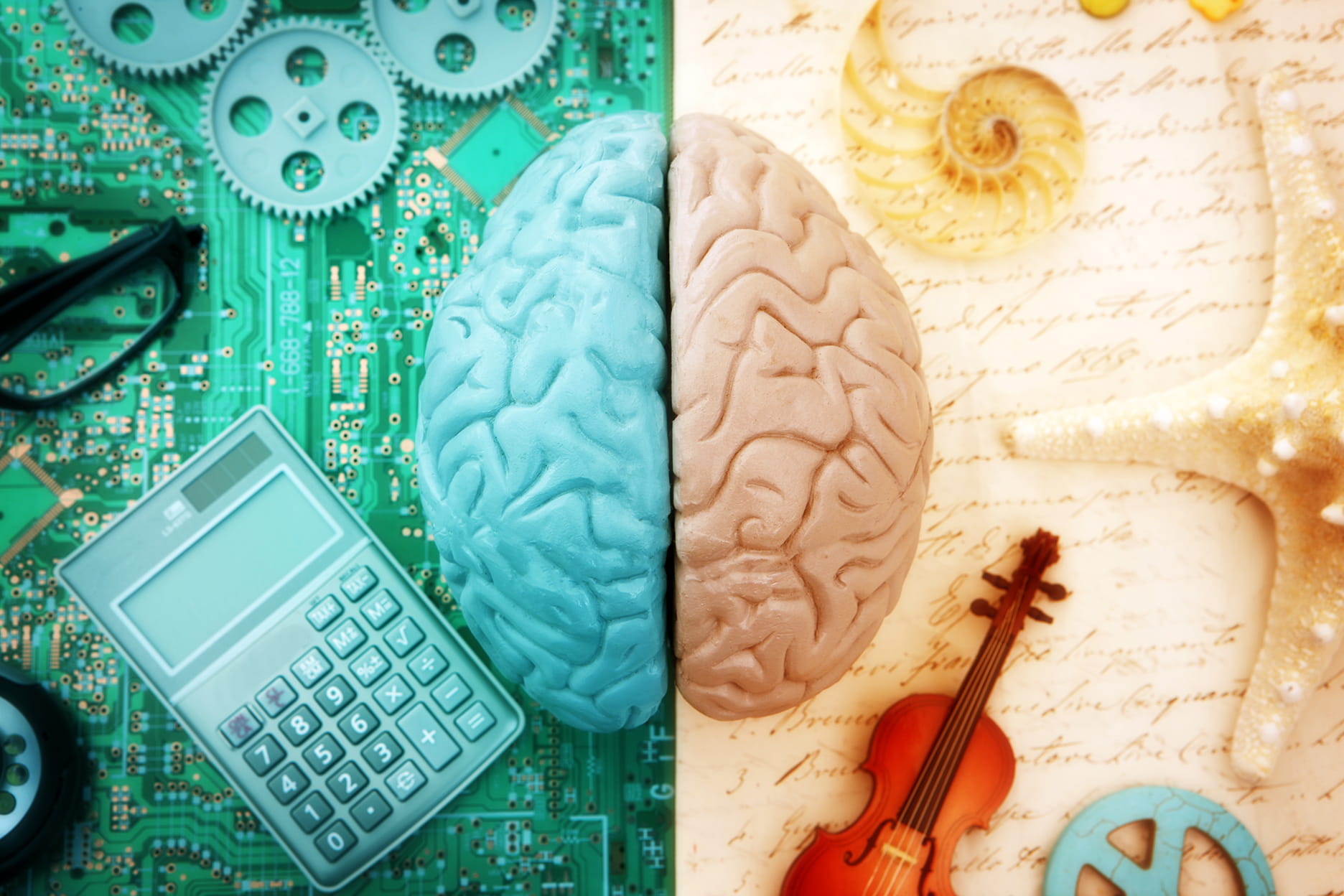
مع التحول العالمي نحو الابتكار والتطور التكنولوجي والتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، اتجه التركيز في مناهج التعليم العالي على موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي باتت تُعرف اختصارًا باسم “ستيم” (STEM)، مما شكل تحديًا لدور العلوم الإنسانية ومكانتها في النظام التعليمي. في قضية هذا العدد، نسأل عن مكانة العلوم الإنسانية في ظل هذا الطغيان “ستيم”، التي راحت تثير اهتمام الطلاب، لا سيما الحريصين على البحث عن موطئ قدم في سوق العمل. وهل يمكن أن تصنع دراسة الإنسانيات والأدب فرقًا عند تدريسها لطلاب العلوم أنفسهم؟
“القافلة” طرحت القضية على ثلاثة من الكتَّاب، الذين يجمعون بين التدريس الجامعي والمسؤوليات الإدارية الجامعية من جهة، وبين الكتابة والانفتاح على الساحة الثقافية العربية من جهة أخرى.
الدكتور محمد الرميحي، يتناول القضية من واقع خبرته الطويلة أستاذًا لعلم الاجتماع بجامعة الكويت ومؤلفًا لأكثر من عشرين كتابًا في علم الاجتماع والتنمية، ويرى أن الفصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية صار غير مقبول اليوم، بعد تجارب وصلت إلى حد خسارة حروب بسبب نقص الخبرة بالعلوم الاجتماعية والثقافة لدى كبار القادة.
ويستقرئ الروائي وأستاذ الرياضيات وعلوم الحاسوب بجامعتي روان وباريس السادسة، حبيب سروري، العلاقة بين العلم والأدب من البداية، فيرى أن كل المنجزات العلمية كانت سيرًا وراء الميثولوجيا والروايات الخيالية.
أمّا أستاذ العلوم السلوكية المشارك في الطب، واستشاري علم النفس السريري والعصبي، الدكتور سعيد وهاس، فاختار أن يتحدث عن أهمية علم النفس عمومًا، والعلوم السلوكية بوجه خاص، للحصول على متخرجين علميين بأفق إنساني ورؤية نقدية.

١- العلم شبكة مترابطة لا غنى عن الاجتماعيات
د. محمد الرميحي
أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت سابقًا
حتى وقت متأخر كان العلماء يفرقون بين العلوم الصلبة والعلوم السهلة، على أن الأولى هي العلوم البحتة والتطبيقية، والثانية هي العلوم الاجتماعية. لم يعد ذلك التصنيف قائمًا اليوم، بل انعكس. فالعلوم الصلبة اليوم هي العلوم الاجتماعية، والعلوم السهلة هي العلوم البحتة والتطبيقية؛ لأن هذه الأخيرة يمكن القيام بهما في المعامل وفي مدخلات محددة من العوامل المنضبطة نسبيًا. أما العلوم الاجتماعية، فإن مدخلاتها كثيرة ومتنوعة وبعضها له علاقة بالمجتمع الذي تعمل في إطاره.
هناك سابقة تاريخية مهمة وهي حروب نابليون في بداية القرن التاسع عشر، حين اجتاحت الجيوش الفرنسية كل أوروبا حتى وصلت إلى موسكو العاصمة الروسية، ولكن تلك الجيوش انهزمت حتى حاصر الأعداء العاصمة الفرنسية باريس. أثارت هذه الهزيمة حيرة العلماء، لأن الجيوش الفرنسية كانت أكثر عددًا وعدة من جيوش أعدائها، وتوصل هؤلاء العلماء إلى أن جنرالات نابليون لم يكونوا مطلعين على ثقافة الشعوب التي اجتاحوها وطريقة حياتهم. وبناء على ذلك، أسس الفرنسيون مدرسة تطورت إلى أن أصبحت اليوم جامعة “سينس بو” التي تعلم العلوم الاجتماعية وثقافات الشعوب المختلفة للنخب الفرنسية التي تُهيأ للعمل السياسي والدبلوماسي. ذلك يأخذنا إلى حقيقة علمية أصبحت شبه ثابتة بأن العسكري والطبيب والمهندس والسياسي والمعلم والطيار وكل المهن تقريبًا يحتاج العامل فيها الإلمام بالعلوم الاجتماعية، إلى جانب التخصص في العلم الذي يدرسه، ولقد أثبتت التجربة الإنسانية ذلك.
في حادثة معروفة في إحدى دول الخليج، اكتشفت الإدارة العليا في قنصلية تقدم خدمة الفيزا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك موظفًا يُقدّم بعض الأسماء في لائحة الطلبات على غيرها. فقُدّم هذا الموظف للتحقيق بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة. ولكن بعد التحقيق، تبين أنه لم يتلقَ أي مبالغ مالية مقابل تقديم أسماء معينة، بل كان يقدم أسماء أبناء قبيلته على غيرها من الأسماء. ولم يكن أولئك الرؤساء يعرفون قيمة العلاقات القبلية في ذلك المجتمع.
على مقلب آخر، فإن الطبيب غير الملم بعلم النفس وأيضًا بالخارطة الاجتماعية في المجتمع الذي يخدمه، فإن خدمته الطبية تكون قاصرة؛ لأنه لا يستطيع أن يتعامل مع الحالة النفسية والاجتماعية لمريضه، كما لا يعرف عاداته الاجتماعية التي قد تؤثر في حالته المرضية. وأيضًا المعلم الذي لا يمتلك المعرفة بعلم النفس الاجتماعي والعلوم الاجتماعية الرديفة وطبيعة تطور مرحلة المراهقة للأولاد والبنات، يفتقد القدرة على تقديم خدمة تعليمية جيدة، فهو إن عاقب طالبًا مشاغبًا أمام زملائه كرّهه في المادة، وأصبح ذلك الطالب أكثر عدوانية مع زملائه.

المهندس الذي تفوته معرفة المجتمع وعادات الناس، لا يستطيع أن يقدم لهم خدمة متسقة مع حاجاتهم. ففي المجتمع الزراعي يجب أن يكون المنـزل مشتملًا على مكان للحيوانات الأليفة التي هي ضرورة للمزارع. أما في المجتمع القبلي، فلا بد أن يضم المنزل مضافة للزوار. أما الطيار الذي يفاجئ الركاب بخبر عاصفة مقبلة أمام مسار الطائرة، فهو يثير الرعب غير المبرر في نفوسهم بدلًا من طمأنتهم. وهكذا في معظم العلوم والمهن التي يعرفها الإنسان.
الثقافة بمعناها الشامل عمود أساس للمهن العلمية وبكل عناصرها الاجتماعية، إنها رافعة أساسية من روافع التنمية المستدامة. ففي دراسة نشرت أخيرًا عن خلفية علماء حازوا جائزة نوبل بين عامي 1901م و2005م، تبيّن أن هؤلاء العلماء كانت لهم خبرة عميقة في تخصصاتهم في العلوم البحتة والتطبيقية، ولكن الدراسة وجدت أن من انخرط منهم في مجال الفنون والآداب، كانوا أقرب بكثير لنيل الجائزة العالمية المرموقة من غيرهم.
تشير الأرقام إلى أن العالِم المهتم بالموسيقى والعزف على الآلة أو التأليف الموسيقي، حظه أكثر مرتين للحصول على الجائزة العالمية؛ أما من يمارس الفنون والرسم والتلوين والنحت، فحظه أكثر بسبع مرات؛ ومن يمارس الحرف اليدوية والأشغال الخشبية حظه أكثر سبع مرات ونصف؛ أما من يمارس الشعر والمسرح والرواية والقصص القصيرة والمقالة، فحظه أكثر 12 مرة بأن يفوز بالجائزة؛ ومن يمارس الفنون الأدائية كالتمثيل والرقص، فحظه أكثر 22 مرة في الحصول عليها. تقول لنا هذه الأرقام بوضوح إن الانشغال بالثقافة العامة والعلوم الاجتماعية حتى لو كنت منشغلًا بالعلم البحت أو التطبيقي، تقدم لك مساحة أفضل للتفوق بين زملائك، ولنيل الجوائز العالمية؛ لأنها ثقافة شاملة تتيح لحاملها نظرة موسوعية للحياة، وهي بذلك تصقل روح الإنسان وتجعل الحياة ذات جودة أفضل.
في مثال آخر، هناك قصة منشورة وموجودة حتى على الإنترنت بروايات مختلفة، تتحدث عن قصة بابلو بيكاسو الفنان الكبير وحلاقه. فقد كان بيكاسو يقوم بحلاقة شعره عند هذا الحلاق، ويرسم بعض الاسكتشات أثناء الحلاقة، وعندما ينتهي من حلاقة شعره، يسلم تلك الورقة المرسومة إلى الحلاق بدلًا من ثمن الحلاقة. وعندما توفّي بيكاسو، أصبحت تلك الرسوم ذات أثمان عالية تكالبت على شرائها متاحف العالم، ولكن الأخير رفض بيعها، وذهب بها إلى قريته وبنى متحفًا متواضعًا وضع فيه كل تلك الرسوم، وأصبحت القرية مكانًا للزوار والسياح على مر الفصول الأربعة، فاستفاد كل أهل القرية من وجود ذلك المتحف وزواره، من وفود السياحة الفنية تلك. ذلك هو الفن والثقافة، فيهما بعد تنموي لا تخطئه العين الخبيرة، وقد أصبحت الثقافة تدّعي أنها “القوة الناعمة”، فالأفلام والكتب والمسلسلات والمسرحيات والأغاني والموسيقى، إن امتلكها مجتمع، فهو يمتلك في الوقت نفسه “قوة التأثير”.

أقرب مثال لدينا هو تأثير “الفنون المصرية” في النصف الثاني من القرن العشرين على الساحة العربية، أو تأثير المسلسلات التركية في الربع الأخير من القرن العشرين على المجتمعات العربية.
الثقافة العامة لصيقة بالتنمية، فالمجتمعات المثقفة تقل فيها حوادث المرور، ويقل استهلاك الأدوية، وتربى الأجيال بشكل أفضل، وتنضج فيه العلاقات السياسية، وتتطور فيه الإدارة العامة وتكثر الصناعات وتجود الزراعة.
الطبيب الذي ينقطع عن القراءة يقف في الطابور المهني دون حراك، ويفوته تطور علم الطب في مجالاته المختلفة، وكذلك المهندس وكذلك المعلم. ومن يتابع القراءة في مهنته ويهتم بتطور العلوم الاجتماعية يكون أكثر دراية من غيره. بل إن المجتمع العربي في السنوات الأخيرة أصيب جزء منه بلوثة “التشدد”، وقد ظهرت دراسة عن قادة ذلك التشدد، فوجدت أن كثيرًا منهم من خريجي الطب والهندسة وغيرها من التخصصات المهنية. بعد تخرجهم من فقرهم لثقافة المجتمع قرؤوا الكتب الصفراء، ولمّا كانت تنقصهم منهجية القراءة الاجتماعية الناقدة اعتقدوا أن ما كتبه الأولون هو ما يجب أن ينطبق على مجتمعاتهم، فعاثوا فسادًا في تلك المجتمعات.
من كل ما تقدم يرى العاقل أهمية دراسة العلوم الاجتماعية وأهمية الثقافة العامة المعاصرة في تكوين الجيل المهني، لأنه من دونها يصبح شبه أعمى في مجتمعه.

٢- عناق العلم والتقنية للأدب والفلسفة والعلوم الاجتماعية
حبيب سروري
روائي وأستاذ علوم الرياضيات والحاسوب
كلُّ من يشتغل بالأبحاث العلمية، ويجاهد ليجدَ تمويلًا دوليًّا أو محليًّا لمشاريع فريق مختبره العلمي (كالتمويل الأوروبي مثلًا، أو تمويل الدول المتطوِّرة)، يعرف جيّدًا أن ثمّة شرطًا جديدًا صار ضروريًّا منذ ثلاثة عقودٍ على الأقل لا تُقبل المشاريع غالبًا من دونه ولا تُموّل. ينصّ الشرط على أن تكون الأبحاث متعدّدة التخصّصات (Interdisciplinary).
السبب جليّ: تعقيدُ الموضوعات الجديدة المفتوحة للأبحاث العلمية في عصرنا اليوم (أو القديمة التي ما زالت بعيدة الحلّ والمنال لفرط صعوبتها)، وتواشجُ أبعادها ومجالاتها وتداخلها، وصل درجةً لم يعد ممكنًا بعدها فكُّ قفل أسراره بالاتكاء على تخصّصٍ أو مجال واحد فقط.
كذلك حال الابتكارات العلمية الكبرى اليوم، وتطوير المعارف الحديثة: تحتاج عضويًّا إلى عناق المعارف والمجالات وفرق البحث المختلفة للخوض فيها.
اتكأت الابتكارات العلمية دومًا، وليس اليوم فقط، على الانطلاق من محاكاة النماذج الموجودة في الطبيعة أو بنات خيال الإنسان لا سيّما في الأدب.
لأضرب مثلاً سريعًا: اختراع الطائرة انطلق من رغبة محاكاة ملَكات الطيور التي عبّرت عنها الميثولوجيا والأدب، منذ الحصان الإغريقي الطائر “بيغاسوس”، وأساطير قومية محليّة في مختلف الشعوب على غرار عبّاس بن فرناس.
بطبيعة الحال، المحاكاة ليست نقلاً آليًّا، وإلا لوجدنا أجنحة الطائرات تتحرك على غرار أجنحة الطيور!
كذلك كلُّ الاختراعات الحديثة مثلًا، من الكمبيوتر الذي يحاكي الدماغ البشري، ونموذج “شبكة العصبونات الاصطناعية” في علوم الكمبيوتر الذي قاد إلى طفرة الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عقد، إلى الروبوت الذي دخل القاموس الدولي انطلاقًا من مسرحية “روسوم” التشيكية، والسيارات من دون سائق، و”الإنترنت” و”العوالم الافتراضية” وغيرها؛ لم تتحوّل تلك إلى ابتكارات إنسانية، إلا لأنها خطرت بخيال الإنسان يومًا ما سبقَ صناعتها بكثير، وغالبًا في أدب الخيال العلمي أو التأمليّ، والأدب والروايات عمومًا، لأنها منجم الخيال البشري بامتياز.
لكن لجوء العلم إلى رؤى الأدب والعلوم الاجتماعية والفلسفة، وعناق التخصّصات، أضحى اليوم جوهريًّا ولا يمكن تجاوزه، بسبب التعقيد الذي وصلت له طبيعة القضايا المفتوحة للبحث اليوم، والحاجة الإستراتيجية لهذا اللجوء لتوجيه مشاريع الابتكارات، كما سنرى لاحقًا.
لذلك، يراقب كبار رؤوس التكنولوجيا الحديثة، مثل إيلون ماسك، جديدَ الخيال العلمي، وتخترعُ مختبراتهم تقنياتها أحيانًا من وحيه. كذلك الحديث عن قرارات بعض وزارات الجيوش بتشكيل فرق تضمّ عددًا من روائيي التخييل العلمي إليها، بهدف تسهيل تجديد الصناعات التكنولوجية العسكرية وتخييلها.
بيد أن دور الأدب لا يختص فقط بتفجير شرارات الاكتشافات غالبًا، لكنه بالتحالف مع العلوم الاجتماعية والأنثربولوجية والتاريخ، يضع رؤى جوهرية حول مستقبل استخدام الابتكارات ومخاطرها. نكتشف بفضل ذلك مخاطر القادم فلو انتبهت الدول إلى ما قاله الفلاسفة وعلماء الاجتماع والأدباء عن مخاطر الغطرسة الإنسانية (Hubris)، وضرورة عدم تجاوز حاجات التوازن البيئي، ومنع تلويث وتدمير الطبيعة؛ لما وصلنا إلى المهلكة الحالية.
لذلك بطبيعة الحال، لم يعد ممكنًا إنشاء مشروع علمي أو معماري أو مدني كحال “المدن الذكيّة” دون حضور المتخصصين بالبيئة وبالطبيعة الإنسانية.
تتفجّرُ في أذهاننا جميعًا عند قراءة الأدب والفلسفة والعلوم الاجتماعية أسئلةٌ وفرضياتٌ حيويّة متداخلة، تدعونا غالبًا إلى عدم الانجراف مع المدّ الأعمى الذي تقودنا غالبًا إليه انحرافاتُ إمبراطوريات أسواق المال والتكنولوجيا في المجال العلمي، وإلى مقاومة جيَشان الرداءة الذي يفرضهُ “المجتمع الاستعراضيّ” والمشتقّات السيّئة للتكنولوجيا المستقبلية، وعدم الوقوع في إغراءات الميثاق الفاوستي نسبةً إلى شخصيّة فاوستْ في الفلكلور الألماني، كما مسرَحَها غوته، حيث تكمن البهجة في استهلاكات المجتمع الاستعراضيّ، مقابل بيع الروح لشياطين الدوائر المالية التكنولوجية.
تتفتّح للجميع، لا سيما للعلماء، عند قراءة الأدب التأملي باقةٌ من الأسئلة الفلسفية الجديدة، على غرار تساؤلات رواية فرانكشتاين قبل قرنين، حول الطبيعة الروبوتية المؤنسنة ومنهج تفكيرها وطبيعة غرائزها التي برمجها الإنسان، ومستقبل العلاقة بين الإنسان وروبوتاته المؤنسنة الذكيّة، وعلاقة الإنسان عمومًا بمستقبل تطوّر التكنولوجيا ومدى استعداده للحياة معها وبها.
نكتشفُ بفضل دور الأدب هنا ذواتَنا، وعلاقتنا بمن سيكونون أقرب لنا من حبل الوريد: كائنات المستقبل التكنولوجية.

لأضرب مثلًا الآن على أحد المجالات التي تتداخل فيها الحاجة لتضافر كل الجهود، بسبب تعقيد المشاريع الذي يزداد يومًا بعد يوم.
نعرف جميعًا منذ ابن سينا أنه لا تفكير من دون كلمات. فالروح كائن لغويّ (مؤثث على نحوٍ لغويّ)، كما يرى العلماء المعاصرون.
“أصول ونشأة اللغة” في تاريخ الإنسان موضوع من موضوعات الأبحاث المعقدة الكبرى المفتوحة منذ أمد. لا يمكن استيعابه دون تعاضد أبحاث علماء حفريات وبيولوجيا يتابعون التطور البيولوجي لدماغ الإنسان منذ ما يُعرف بإنسان “هومو أركتوس” وقبله إلى “هوموسابيانس”. ولا يمكن رؤية ذلك بمعزل عن أبحاث الأنثروبيولوجيين وعلماء الاجتماع الذي يشرحون كيف أدّت صناعة الآلة للاصطياد وغيره، والحاجة للتعاضد بين أفراد المجموعات الإنسانية القديمة، دورًا حاسمًا في سيرورة ذلك التطور.
المتخصصون في اللغة والأدب لهم أهميتهم المركزية في متابعة تطور البنية اللغوية وتاريخ الكلمات خلال هذه السيرورة الزمنية لنشأة اللغات، منذ اللغة البدائية “Proto-language” لأسلاف هوموسابيانس.
الأبحاث المتصلة باللغة اليوم وصلت درجةً هائلة من التعقيد والاتساع تتجاوز علماء اللغة وحدهم، أو علماء الدماغ المتخصصين بمناطق اللغة في خارطة الدماغ البشري وآليات عملها. ولا يمكن التقدّم بها من دون تضافر جهودهم مع قافلة جديدة من الباحثين الذين صارت اللغات زادهم مثل: علماء الكمبيوتر، والرياضيات، ومجالات عديدة أخرى.
فالرياضيات لغة خاصّة، لها مناطقها المحدّدة في الدماغ. قبل الخوارزمي كانت في الجوهر هندسة أقليديسية، ورسمًا لأشكال هندسية في الأساس، تُستخدم لحل هذه الإشكالية العملية أو تلك، لا غير. وقد أدخل الخوارزمي عليها اللغة الإنسانية كما لم يفعل أحد قبله، وحوّلها إلى لغة ومنهج يسمحان بتنظير تجريدي كليّ، بعد اختراعه لعلم الجبر.
شرح الخوارزمي مثلًا نظرية معادلات الدرجة الأولى والثانية في الرياضيات بلغة دقيقة استخدم فيها مصطلحات جديدة: “الشيء”، و”الجذر” (الرقم الذي يحلّ المعادلة)، و “الدرهم” (الرقم الثابت في المعادلة). كما فكرة المتغيّر الرياضي وأسماه “شيء”، قبل أن تصل هذه الكلمة العربية بدورها إلى إسبانيا وتلفظ في لغتها القديمة: “إكسي”، ثم تغزو أوروبا بعد ذلك بصيغتها النهائية: “إكس”.
ما المعادلات الرياضية؟ وما علم المنطق الرياضي؟ بل وما كل العلوم، لو كانت من دون استخدام المتغيرات والمجاهيل ودمج اللغة الإنسانية في مداميكها؟ علوم الكمبيوتر تعجّ بلغات تنطح لغات. بدأت بلغاتٍ بدائية “إلكترونية” ضعيفة جدًا، لا يمكن للعين الإنسانية أن تستوعبها. ثمّ تطوّرت بفضل أبحاث علماء اللغة (مثل شومسكي الذي أدّى معها دور الخوارزمي مع الرياضيات بإخضاعها لـ “قواعد نحوية” على غرار قواعد اللغات الإنسانية، وتطويرها لتصير لغات تعبيرية راقية تسمح بكتابة الخوارزميات بسهولة، وبترجمة لغات الكمبيوتر الراقية من لغة إلى لغة، بما في ذلك اللغة البدائية الإلكترونية.
ثمّ جاء دور الرياضيات لإغنائها بالمنطق الرياضي لتزداد قدرة على التعبير. تلاه دور الفلسفة التي استُسقيَ منها مفهومُ الأنطولوجية الإغريقي القديم (Ontologie)، وكُيِّفَ لنمذجة المعارف بطريقة يستوعب الكمبيوتر دلالتها آليًا.
قادنا كل ذلك اليوم إلى مجالات جديدة للأبحاث العلمية المعقدة جدًا، كتلك التي تهدف إلى الاستيعاب الآلي لدلالات النصوص من قبل الكمبيوتر، وصناعتها آليًا على نحو يتجاوز المقدرات الإنسانية ربما، كما هو حال مشاريع شبيهة بـ “شات جي بي تي” (ChatGPT) ما زالت جميعها في طورها الجنيني!
تحتاج هذه الأبحاث جميعها إلى فرق مشتركة تضمّ علماء الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، وعلماء الدماغ، وعلماء الطبيعة الإنسانية، ولغويين وأدباء وغيرهم.
خلاصة القول: دمج الأدب والعلوم الإنسانية والفلسفة بالدراسات والأبحاث العلمية ضرورةٌ عضوية. لذلك أضحت فرق المختبرات العلميّة الكبرى والمناهج والمؤتمرات العلمية الراقية متعددة الخبرات تربط التخصص الرأسي العميق للباحث بجسور التداخل الأفقي مع باحثين في مجالات أخرى عدّة.
فمجالات المعرفة العلمية واللغوية والاجتماعية والفلسفية “كليّة” (Holistique)، يجب النظر إليها على أنها متكاملة، وليس على أنها مجموعة أجزاء.
لعلّ هذه النظرة أبرز ما يميّز تطوّر المعارف والأبحاث وأهمّها في العقود الأخيرة، وما نحتاجه نحن أيضًا، كعرب، في الصميم.

٣- من النفس إلى السلوك ومن السلوك إلى مجتمع منتج
د. سعيد هادي وهاس
أستاذ العلوم السلوكية المشارك
قطعت الدول المتقدمة شوطًا كبيرًا في تضمين العلوم الإنسانية في كل المراحل التعليمية، وأولت اهتمامًا بالغًا لتطبيقات تلك العلوم في شتى مناحي الحياة، وركزت بشكل كبير على الدراسات والأبحاث السلوكية والإنسانية لتنمية مستدامة، في الوقت الذي ما زالت الدول النامية تركز على العلوم الطبيعية، ولا شك في أهمية مثل تلك العلوم، ولكن الحاجة ماسة بشكل كبير لتدريس الأدب والعلوم الإنسانية لطلاب العلوم الطبيعية، من أجل مخرجات تكاملية تبني إنسانًا ومجتمعًا وأمة سوية ومنتجة وفعالة ومستقلة وممكنة، فهنا سر الحياة.
لبناء الإنسان السوي والمجتمع المنتج تبرز الحاجة إلى رسم مسار سلوكي إنساني سوي. ويُعرَّف السلوك الإنساني في أبسط معانيه بأنه كل ما يصدر من الإنسان من تصرفات وتفاعل، البعض منها قد يكون سلوكًا مرئيًّا (Overt Behavior) مثل: العدوانية والعصبية والاندفاعية والعزلة والاعتمادية كسلوكيات مرضية، ويقابلها ضدًا سلوكيات سوية، منها: اللغة والتذكر والمعرفة. وهناك سلوك غير مرئي (Covert Behavior) مثل: التفكير والوظائف المعرفية والمشاعر والأحاسيس والإدراك والاستبصار والحكم والاتجاهات والميول والرغبات.
تتسم هذه السلوكيات الشخصية بدرجة عالية من الثبات لدى الشخصية السوية، على العكس من الشخصية المرضية.
يظهر السلوك الإنساني في صورة فردية، وفي أخرى اجتماعية تُشكِّل السلوك المجتمعي، وصولاً للثقافة وحضارة المجتمعات. قد يكون السلوك سويًا طبيعيًّا بناء على محكات موضوعية يتفق عليها بقية الأسوياء، وقد يكون مرضيًا وفقًا لمحكات تشخيصية وإحصائية وتوافقية خارجة عن السلوك السوي المتفق عليه.
ويُعتبر السلوك الإنساني ظاهرة مثله مثل الظواهر الكونية والحياتية المختلفة، وما يفرقه عن الجميع أنه من أعقد تلك الظواهر نظرًا لارتباطه بخلفيات متباينة؛ فهو سلوك حيوي (Biological) يرتبط بالبدن والمنظومة العصبية (Neurosciences) وفي الوقت نفسه سلوك نفسي يعود لميكانزمات نفسية ومنظومة معرفية ومشاعرية وحسية وحركية شعورية وغير شعورية. ومن ناحية أخرى، فالسلوك الإنساني نتاج البيئة والتربية والتنشئة الاجتماعية والثقافة والحضارة، وهنا سر التعقيد في فهم الظاهرة السلوكية وشرحها. ومع هذا، فإنه بالإمكان فهم السلوك الإنساني وتحليله والتنبؤ به كبقية الظواهر الأخرى.
يؤدي السلوك الإنساني دورًا حيويًا ومحوريًا في الحياة المُعاشة على الصعيد الفردي والأسري والاجتماعي والمؤسساتي، وهو قاعدة التنمية وأساس الإنتاج ومحور الإبداع ومرتكز الحياة، به تُقيم ثقافة الشعوب والأمم ومن خلاله يُقاس مدى تقدمها وإنجازها وازدهارها.
وللتمثيل وليس الحصر، فالصحة سلوك، والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية سلوك، والسياسة والاقتصاد وعالم المال والأعمال سلوك، والصناعة والاستثمار سلوك، والحرب والسلم والأمن سلوك، والتنمية المستدامة والازدهار سلوك، والمناخ والبيئة سلوك، ومهددات الحياة سلوك، والسعادة والرفاه سلوك؛ لهذا السبب أفردت الحكومة الأمريكية (عام 2000م) عشر سنوات من الزمن أسمتها بـ “عقد السلوك”.
والمتتبع الحصيف لما يدور اليوم في شتى جوانب الحياة المختلفة يعود بشكل مباشر أو غير مباشر إلى السلوك الإنساني، وما هذه التباينات والفروق والاختلافات بين الأفراد والمجتمعات والدول إلا نتيجة معايير سلوكية. فمعيار التقدم على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي والمؤسساتي، وعكسه التأخر والتخلف وما بين ذلك، مرده إلى السلوك الإنساني. من هنا، أولت المجتمعات المتقدمة اهتمامًا كبيرًا بفهم السلوك الإنساني ودراسته وتحليله والتنبؤ به كمسار معرفي؛ ليصبح تطبيقات في شتى جوانب الحياة التنموية. حتى إنه أصبح هناك مؤشر عالمي للسعادة (Index of Happiness) تتسابق فيه الدول لتحقق الدرجات العلا، لتفخر بسعادة شعوبها ومستوى الرفاه الذي ينعمون به.
ويعتبر علم النفس، الذي يُعنى بدراسة السلوك والعمليات العقلية، قاعدة العلوم السلوكية، لأنه يدرس السلوك الفردي بخلفياته الحيوية والعصبية والاجتماعية والحضارية في سُواه واضطرابه بشكله ومضمونه الحسي والحركي والسلوكي والمعرفي والمشاعري؛ ليشكل الهوية والشخصية والفروق الفردية بين الناس. ووفقًا لتعقد السلوك الإنساني وتشعبه، فإنه يتشكل بهوية المجال والغاية والمكان رغم المحافظة على كنهه بأنه “سلوك” يخضع للمعرفة العلمية في مجال علم النفس؛ فهناك سلوكيات الصحة والاقتصاد والصناعة والحرب والأمن والسلم والمناخ والبيئة والتعليم والمجتمع والفضاء والمحيطات والسعادة والرفاه والتنمية.
من هنا كان لا بد من تدريس مقررات العلوم السلوكية لطلاب شتى المعارف والتخصصات. ولعل تعليم التفكير النقدي الذي يقود إلى معرفة رصينة قابلة للتطبيق في أي فرع من فروع المعرفة أمر في غاية الأهمية، قد لا يدركه صناع القرار التعليمي نظرًا للقصور في فهم هذا البعد السلوكي والاعتقاد بأهمية المسارات الطبيعية، فهناك المسار العلمي يقابله المسار الأدبي بشكل ومحتوى مختلفين وكأنما كل مسار آتٍ من كوكب مختلف. والذي استقر لسنوات طوال بمخرجات أقل ما يقال عنها إنها لم تصنع في الغالب فكرًا نقديا نيرًا ولا كفاءات مهنية بالشكل الذي يتطلبه العصر؛ لذا تضمين مسارات العلوم السلوكية والإنسانية في مناهج ما قبل الجامعة في منتهى الأهمية.
يحتاج طبيب الغد والممارس الصحي إلى جرعة كافية من العلوم السلوكية والإنسانية أثناء رحلته في كليات الطب، ولكل مرحلة من مراحل التعليم والتدريب الطبي ما تحتاجه من العلوم السلوكية والإنسانية في صورتها الأساسية (Basic) والطبية (Medical) والسريرية (Clinical). عند ذلك يكون المتخرج طبيبًا بمعرفة علمية ومهارية، وفوق ذلك يكون إنسانًا ومفكرًا ومحاورًا ومهنيًّا.
ما يسري على طبيب الغد يحتاجه مهندس الغد، فالعلاقة ما بين متطلبات الهندسة والمسار الهندسي والسلوك علاقة طردية، فجل مخرجات الهندسة تصب في مصلحة الإنسان، حتى إنه أصبح هناك فرع من الهندسة يُعرف بالهندسة البشرية (Human Engineering) للمزاوجة ما بين الإنسان والآلة (Machine-human Relationships)، وصولًا للعلوم الاقتصادية والسياسية والقانونية والإدارية والتربوية والاجتماعية والبيئة.
ويمكن تحديد مستوى العلوم السلوكية والإنسانية في المراحل المختلفة وفقًا لإستراتيجيات يضعها خبراء تلك العلوم، بحيث تركز مرحلة ما قبل التعليم الجامعي على بناء إنسان ذي تفكير ذاتي، وتركز المرحلة الجامعية وما بعدها على ثلاثة مستويات من العلوم السلوكية والإنسانية الأساسية والتخصصية والمتقدمة. وهذا أمر لا غنى عنه اليوم؛ فلا اقتصادي ولا سياسي ولا قانوني ولا تربوي ولا إداري ولا عالم اجتماعي هو كذلك بحق من دون أن يتلقى جرعات كافية من العلوم السلوكية والإنسانية. هذا مطلب حيوي، وليس ضربًا من الترف، ويحتاج إلى تغيير النظرة، خاصة لدى صناع القرار التعليمي.