منذ فجر الملاحة البحرية، خضع البحَّارة لتراتبية صارمة في عيشهم وعملهم على المراكب. ولذا، كان للبحَّار الموجود على ظهر أي مركب ألف صورة وصورة تبدَّلت بتبدل الأحوال عبر الزمن، من البائس الذي كان يشقى في القيام بأصعب الأعمال وأخطرها في الحضارات القديمة، إلى “قباطنة” اليخوت الفاخرة في عصرنا. ولكن ما بين هذا وذاك، ارتسمت في وجدان الإنسان صورة عامة ونمطية عن البحَّار باعتباره مغامرًا ومستكشفًا وشجاعًا في خوض غمار المجهول، فكان بمنزلة رائد الفضاء في عصرنا الحالي.
تغلب الرومانسية على صورة البحَّارة القدماء بفعل الروايات التاريخية والفولكلور والثقافة الشعبية. فغالبًا ما جرى تصوير العصر الذهبي للقرصنة، من أواخر القرن السابع عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر، على أنه مثالي، مع الاحتفاء بقراصنة مثل “بلاكبيرد” أو “اللحية السوداء”، وهو القرصان الإنجليزي الذي اشتهر في الهند الغربية وفي السواحل الأمريكية والأوروبية، و”كاليكو جاك”، القرصان الإنجليزي الذي اشتهر في جزر البهاماس في أوائل القرن الثامن عشر لمغامراته الجريئة. فقد صُوِّرت حياة البحَّارة على أنها سلسلة من المغامرات المثيرة المليئة بمطاردة الكنوز ومعارك البحر، وهو ما طغى على الحقائق الوحشية والجوانب السلبية للقرصنة.
وأدَّى الأدب دورًا مهمًا في تشكيل الصورة الرومانسية للبحَّارة، وذلك من خلال أعمال مثل “جزيرة الكنز” لروبرت لويس ستيفنسون (1883م)، التي تُقدِّم القراصنة على أنهم محتالون ساحرون يتمتعون بقواعد شرف، و”قصيدة البحار العجوز” لصمويل تايلور كولريدج (1798م)، التي تُصوِّر الجانب الإنساني للبحّارة، فتتحدث عن رحلة البحَّار بوصفها استعارة لاكتشاف الذات والصحوة الروحية. وفي الثقافة العربية، تعدُّ أسطورة “السندباد البحري” من أشهر القصص العربية التي تحكي عن بحَّار من مدينة بغداد قام بسبع رحلات إلى الأراضي والجزر عبر البحار شرقي إفريقيا وجنوبي آسيا، وخاض خلالها مغامرات عظيمة ونجا من أخطار عديدة واكتسب ثروات كثيرة خلال أسفاره.
أمَّا في المجتمع المعاصر، فقد تغيَّرت صورة البحَّار بشكل كبير؛ إذ أصبح بحَّارة اليوم يرتبطون باليخوت الفاخرة بدلًا من قوارب الصيد أو سفن الشحن. وهذا يعكس تغييرات مجتمعية أوسع، حيث أصبح الإبحار الآن نشاطًا ترفيهيًا للأثرياء بدلًا من ضرورة للبقاء أو التجارة. ولا سيَّما أن البحّارة المعاصرين استفادوا من تقنيات الملاحة المتقدمة مثل نظام تحديد المواقع العالمي وأدوات التنبؤ بالطقس المتطورة، وكذلك من التقدُّم في استخدام المواد المركبة في بناء اليخوت، وهو ما جعل الإبحار أكثر أمانًا وأكفأ وأقدر على الوصول إلى جمهور أوسع.
البوصلة.. النجم المرشد وقلب البحَّار وهمسة الأفق ومؤشر القِبلة
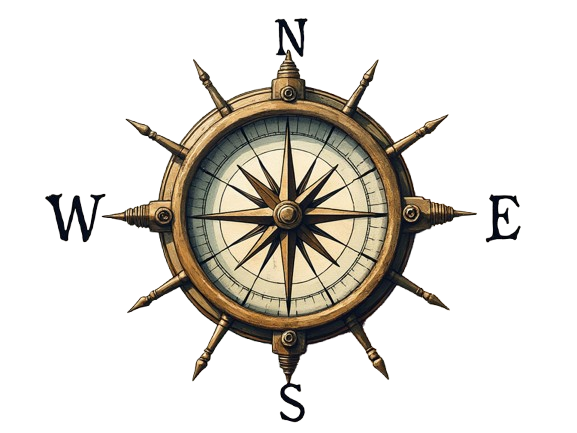
أدَّت البوصلة دورًا حاسمًا في تشكيل التاريخ البحري، فهي لم تُمكِّن المستكشفين من اكتشاف عوالم جديدة فحسب، بل أصبحت كذلك رمزًا دائمًا للملاحة والتوجيه الصحيح طوال التجربة البشرية.
تعود جذور هذه الأداة الملاحية الأساسية إلى الصين القديمة، وتحديدًا إلى عهد أسرة هان (206 قبل الميلاد – 220 بعد الميلاد)، حيث استُخدمت في البداية للتنبؤ وعلم الجيومانسي بدلًا من الملاحة. وكانت البوصلات المبكرة مصنوعة من حجر المغناطيس، وهو شكل ممغنط طبيعي من خام الحديد، وقد أطلق الصينيون على هذه الأجهزة الأولى اسم “الملعقة التي تشير إلى الجنوب”.
ومع ذلك، وبعد أكثر من ألف عام، كان الإيطاليون هم الذين اكتشفوا الاستخدام النهائي لحجر المغناطيس وأطلقوا العنان لقوته الهائلة. ففي مدينة أمالفي الإيطالية، في وقت ما من القرن الثاني عشر الميلادي، وُلدت البوصلة، فتوجَّت الإيطاليين حكَّامًا جددًا للبحار، وبشَّرت ببداية العالم الحديث. ومن ثَمَّ، انتشرت في جميع أنحاء أوروبا، وأطلقت العنان لأسفار الأوروبيين واكتشافاتهم، لا سيَّما أن الملاحين الأوروبيين الأوائل كانوا قبل ذلك يعتمدون بشكل كبير على الأجرام السماوية، مثل الشمس والنجوم للتوجيه، وهو ما حدَّ من أسفارهم إلا في مواسم محددة. ولكن البوصلة سمحت بالإبحار بثقة أكبر عبر المياه المفتوحة، بغض النظر عن الظروف الجوية أو الطبيعية. وبعد ذلك، بحلول القرن الثالث عشر، تبنى العلماء المسلمون البوصلة لأغراض الملاحة والفلك، حتى إنهم طوروا نسخة تُعرف باسم “مؤشر القبلة”، التي ساعدت المسلمين في تحديد اتجاه القبلة في مكة المكرمة للصلاة.
وباستخدام البوصلة في عصر الاكتشافات، من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، وهي الفترة التي تميزت بالاستكشاف المكثف من قبل القوى الأوروبية، رسم مستكشفون من أمثال كريستوفر كولومبوس وفاسكو دا جاما، طرقًا جديدة عبر المحيطات، أدَّت إلى اكتشافات مهمة وفرص تجارية هائلة.
وبمرور الوقت، تطوَّرت البوصلة من جهاز مغناطيسي بسيط إلى بوصلة جيروسكوبية أكثر تطورًا تُستخدم في السفن والطائرات الحديثة، وتتأثر بشكل أقل بالشذوذ المغناطيسي. كما غيَّرت أنظمة الملاحة الرقمية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) طريقة تنقلنا، وأصبحنا نضع أنفسنا في مركز الخريطة كنقط زرقاء صغيرة تتحرك عبر تطبيقات جغرافية مكانية. ولكن، على الرغم من ذلك، فإن البوصلة التقليدية لا تزال تحظى بالتقدير لبساطتها وموثوقيتها، وتظل المبادئ الأساسية للاتجاه التي وضعتها حيوية لأغراض الملاحة.
وأخيرًا، يبقى القول إن البوصلة أصبحت رمزًا مجازيًا للتوجيه والإرشاد في حالات الضياع وعدم اليقين في الحياة؛ لمساعدة الأفراد في إيجاد الطريق الصحيح واتخاذ خيارات مستنيرة.
حضوره القوي في الوجدان الإنساني
تلامس المراكب البحرية الروح البشرية بطرق عميقة، وتستحضر مجموعة واسعة من الرموز ومشاعر الرهبة والخوف والحرية والمغامرة والتأمل والبدايات الجديدة. وتعمل المراكب بوصفها رموزًا قوية تعكس أعمق مشاعرنا بشأن رحلة الحياة، فهي تذكرنا بنقاط ضعفنا، بينما تحتفي بقدرتنا على التواصل والتحوُّل. وسواء أكانت مراكب تُبحر في بحار هادئة أم عاصفة، فإنها تجسِّد جوهر التجربة الإنسانية: رحلة مستمرة مليئة بالتحديات والاكتشافات والعواطف العميقة. كما أنها ترمز إلى وعد الأفق واحتضان المجهول، وتُحدِّد المسافة بين الفراق واللقاء، وهو ما يجعل الرحلات البحرية تجارب إنسانية غنية لقيت صداها بقوة في الموسيقى والفن ومختلف الأعمال السينمائية.

الخليج.. ونغمات البحر
يقال إن المراكب هي أقرب الأشياء إلى الأحلام التي صنعتها الأيدي البشرية. ففي خبايا هياكلها تكمن روح الألحان وكأنها عندما تواجه الأفق وتلامس مياه البحار بعواصفه العاتية وهدوئه الساحر وألوانه المتغيرة، تلهم النغمات وتثير المشاعر التي تتدفق أغنيات يطلقها البحَّارة للتعبير عن مجموعة واسعة من المشاعر؛ مشاعر الحرية والانطلاق والبدايات الجديدة والخوف والحزن والحنين والاحتفال بتجمعات البحارة المبهجة.
ففي مختلف أنحاء العالم، كانت هناك أغنيات اشتهر بها البحَّارة بشكل خاص، وربَّما كان أكثرها تميّزًا في منطقة الخليج العربي. فقد تميزت هذه المنطقة بنوع من الأغاني يُعرف بالغناء “البحري”، انتشر منذ سنين طويلة بين التجار عبر المحيط الهندي والصيادين والباحثين عن اللؤلؤ عندما كانت أصواتهم تصدح بأغانٍ جماعية يُطلقونها من على مراكبهم الشراعية، وهي تشق عباب البحر، فتعلو فوق صوت هدير المياه وهياجه. وكانت، بحسب الوصف الدقيق الذي قدَّمه المستكشف والأديب الأسترالي ألان فيليرز، كما كتب عام 1939م من على متن سفينة تجارية كويتية، “… تلك الضوضاء المتمادية للدمدمة التي تصدر فقط عن الحناجر الاستثنائية للبحَّارة الخليجيين، وهو أشبه بصوت مجموعة من الأسود الخاضعة والجائعة إلى تناول وجبة من الطعام، أو بزمجرة مجموعة من الدببة ثقيلة الوزن داخل حفرة طلبًا لعظمة تأكلها، أو بهدير بركان عميق يغلي”.
كان البحَّارة يغنون عندما يرفعون الأشرعة، ويغنون عندما يجدفون، ويغنون لبث روح العزيمة والاندفاع، ويغنون لكل شيء تقريبًا. وكان محور كل تلك الأغنيات مَن يُعرف باسم “النّهَّام” الذي كان حاضرًا على كل مركب وسفينة، ويُعدُّ العنصر المركزي في الغناء البحري. فكان يقود الأغاني ويعمل حلقةَ وصل بين البحارة، لا سيَّما أنه يتمتع بمهارات خاصة وقدرة على حفظ كثير من الأبيات الشعرية. فالأغاني الشعبية التي ينشدها كانت لها علاقة بكل عمل يُؤدَّى على ظهر السفينة تقريبًا؛ إذ إن له دورًا وظيفيًا مرتبطًا بدورة العمل. فهو يُوعز بكل حركة أو مجهود عضلي يتطلبه العمل من مجموعة البحَّارة، وذلك من خلال التنغيم والتلحين الموزون إيقاعيًا لنصوص باللهجة المحلية الدارجة، بمساعدة آلة الطبل والطوس التي تُسهم في الاندماج الذهني والعضلي لمجموعة البحَّارة، وتوجه طاقاتهم إلى العمل الجماعي الموحد.
وعلى الرغم من تراجع هذا النوع من الغناء مع تراجع تجارة المراكب الشراعية عبر المحيط الهندي في أوائل القرن العشرين، ومع توقف صيد اللؤلؤ بعد اختراع اليابان للؤلؤ المستزرع عام 1928م، فإن الغناء البحري بقي يُشكِّل الأساس الذي انطلق منه فن الغناء الخليجي، واستمر صداه يتردد ليُسهم في تشكيل الهوية الموسيقية للمنطقة، وما زال البحر والمراكب والإبحار من أبرز الرموز التي تتكرر في الموضوعات التي تتناولها الأغنية الخليجية الحديثة.
من الأغنيات البحرية، التي كانت تساعد البحَّارة على سهولة العمل والتخفيف من عنائه، وخاصة أثناء رفع الشراع الذي يتطلب مجهودًا شاقًا لكبر حجمه وثقله:
صلوا على النبي
ربي كريم ستار
تعلم بحالي والأسرار
سبحان ربي هدانا
اللي هدانا على الدين
احنا ضعاف مساكين
مولاي نظرتك في العين
توفي ديون علينه
توفي ديون الثقالي
الأولى والتوالي
يا موفي الدين يا الله
ومن أغاني الشيلة، التي عادةً ما تتألَّف من بيتين أو ثلاثة أبيات شعرية لها لازمة ثابتة تُغنَّى أثناء العمل، سواء عند نقل الأمتعة داخل السفينة أو تحريك السفينة عندما تغوص بالرمال والطين:
دمعي تحدر على وجناي
واستاهل يا قلبي العذاب
وإلى جانب ذلك، أسهم بعض تلك الأغاني في معرفتنا بخط سير المراكب والعلامات والجزر، فتحوَّلت إلى خريطة يستفيد منها كل من يركب البحر، فكان من بينها:
يا عبرتي مــن مكـلا
سنّـــد علــــى خورفكــان
اتجيك سبع الجزايـــر
وام الفيــاريـــن جـــــدام
إن جيت هنيـام ساعـــة
طـــاب المـــزر للرباعـــة
صبيان كـــود شراعــة
انـوا بنـــــو العزيمــــــة
يا نوخــذه دار كــوسان
قوموا اربطوا اليوش بالكـلب
غربي بــدوره شمـــال
دور العـماريــــن جــــدام
واستطاع بعض هذه الأغنيات أن يعرِّفنا بأماكن لم تكن معروفة مُسميَّاتها لدينا بعد أن طرأ عليها تغيير، سواء بعد انقضاء أهميتها المكانية، أو ضمها إلى دول غيَّرت من مُسميَّاتها، من بينها:
جينا الفحل تالــي الليـــل
واصبح جزيـــرة ســـوادي
يا سحـار ما فيــك بتـــور
كــود الوصــل والعتـــادي
أمَّا اليوم، فربَّما تكون الحناجر قد سكتت ولم يَعُد بحَّارة اليوم ينشدون أغاني البحر، ولكن صداها بقي ليجسِّد تاريخًا طويلًا من التجارب الإنسانية التي شكَّلت حياة المجتمعات الساحلية في الخليج العربي، واستمر في التأثير على الفنون والموسيقى الحديثة في المنطقة.




اترك تعليقاً