أكثر من ثمانية مليارات إنسان يعيشون على هذه الأرض. وأضعاف هذا الرقم هو عدد المرايا الرقمية التي باتت تحاصرنا بما يشبهنا من نسخ. لا غرابة إذًا أن يكون التفرُّد حلمًا بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى؛ التفرُّد بمعنى أن تكون نسخة واحدة لا يُشبهها شيء.
غير أن السعي نحو ذلك الحلم ضمير مشترك بيننا، يطفو على السطح تارة ويتوارى أخرى، دون أن يموت تمامًا. أحيانًا يُوقد جذوتَه التفاوت الذاتي بين الأفراد أو اختلاف الظروف، وحينًا تُخمده عجلة الحياة حين تسحقه كما تسحق صخرةٌ كفّ نملة! اذهب ببصرك وبصيرتك أينما تشاء، ستجد مظهرًا من مظاهر السعي نحو التفرُّد يتلبَّس بشريًّا ما إلى حد الجنون.
لعلَّ التفسير الذي ربَّما لا يتجاوز السطح كثيرًا، هو أن التفرُّد يساعدنا على “تحقيق الذات”، وهو الاحتياج البشري الأسمى وفقًا لهرم ماسلو في نظريته حول “الدافع البشري”. لكن المثير للدهشة حقًا هو أن يتحوَّل التفرُّد إلى غاية تبرِّر الوسيلة، بمعنى أن ينفصل السعي إليه عن هدف سامٍ يبرِّره، ليُصبح هو الهدف في حد ذاته. ومثال ذلك حين يُصبح في الهدف المقصود لَبسٌ من شر. كما في السعي نحو التفرد بوصفه وسيلةً إلى الشهرة؛ إذ نجد نماذجه تتكرر بكثرة بشكل يغني عن الإشارة إليه.
في المقابل، أليس الكائن البشري مجموعة أضداد تجعل من فهمنا لأنفسنا مهمة عسيرة؟! لماذا إذًا يُشعرنا التفرُّد أحيانًا بوحشة كئيبة تجعلنا نبحث عمّن يشبهنا بحثَ الظمآن المُصحِر عن قطرة ماء؟! هل يمكن أن يكون بحثنا عن حياة ذكية تفهمنا في هذا الكون توقًا إلى المتشابه والمشترك في أحد أبعاده؟
بالعودة إلى الواقع المضني، من الواضح أن جاذبية فكرة التفرُّد في صعود في كل بقعة بشرية. ويتبعها في ذلك تجليّات التمايز على مستوى الأفراد والجماعات، تتضمن في عمومها تركيزًا على المختلف دون المتشابه، وانحيازًا إلى الأنا في مقابل الآخر. مظاهر الكراهية والتمييز والإقصاء باتت زادًا يوميًا لوسائل التواصل، وصار التدافع نحو نبذ الآخر مبررًا بمنطلقات شتى، ربَّما ارتكز بعضها على فكرة تنطلق من دائرة البحث عما يُميز الـ “أنا” والـ “نحن الخاصة” عن الآخر.
لكيلا نشطَّ بعيدًا عن جوهرنا الإنساني، لا بُدَّ من كفة متوازنة، ولا بدَّ لنا إذًا من الالتفات بين حين وآخر إلى ذلك المشترك والمتشابه، الذي يجعلنا نتلمس في الآخر من حولنا ما يجعلنا نتعاطف معه بعيدًا عن أنانيتنا الموغلة في ذاتيّتها. ولا ينبغي أن يُفهم هذا دعوةً إلى إلغاء الـ “أنا” والـ “نحن الخاصة” وتهميشها، بل هي همسة لنحتفي بـ “المشترك” الذي يجعلنا مع الآخر جنسًا واحدًا، وبـ “العادي” الذي لا تحطّ “العادية” من شأنه ما دام مرتبطًا بمقصد طيب، وما دام يجعلنا نتحسّن بالقياس إلى ذواتنا الماضية، أو في أقل الأحوال يخفِّف عنا وطأة المنافسة الحميمة مع الآخر. ففي نهاية الأمر، كلّنا ذلك الإنسان الذي يعيش هموم هذه الحياة ويقاسي آلامها، ويفتّش في أنقاضها عن معنى لوجوده يستيقظ مطمئنًا إليه كل صباح.
الحديث عن المنافسة يأخذنا إلى موضوع متصل بها، وهو “السباق”، الذي يتناوله ملف هذا العدد. ونأمل أن يجد القارئ في مضمونه ما هو “مُختلف”، وما هو ملامس أيضًا للمشترك البشري. وفي سياق غير بعيد، يتطرق العدد إلى موضوع يرتبط بفهمنا لكرة القدم بوصفها ظاهرة اجتماعية متسعة الأبعاد، ولا سيَّما نحن نلمس أهميتها كلما عصف بنا صيف كروي صاخب، ليذكرنا أن تأطير فهمنا لهذه اللعبة بحدود الملعب لم يعد خيارًا مُتاحًا.
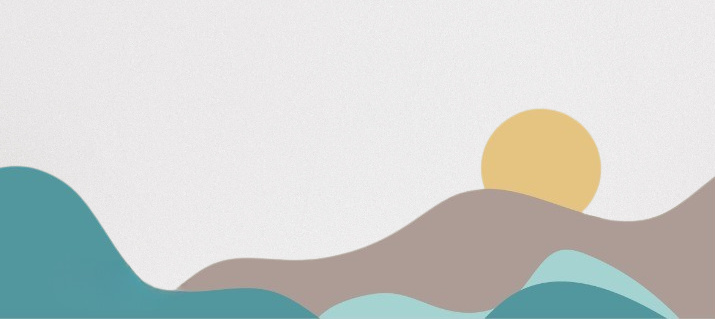



اترك تعليقاً