
من المدهش أن تكون إنجازات البشرية في استكشاف الفضاء من ثمار الجهود الحكومية وحدها. بمعنى أن تاريخ استكشاف الفضاء الذي نعرفه ارتبط دوماً بالإنفاق الحكومي لدول مثل الولايات المتحدة وروسيا، ونُفذ عبر مؤسسات حكومية أنشئت لهذا الغرض. فتلك الاكتشافات كانت غير مثمرة مادياً في البدايات. وكانت أقرب إلى مغامرات دافعها في أغلب الأحيان تحقيق التفوق السياسي، وانتهى كثير منها نهايات مأساوية خلفت وراءها ضحايا ومرارات لا تنسى. ولكن الأمور أخذت في السنوات القليلة الماضية تتغير شيئاً فشيئاً، وها هو القطاع الخاص يطل برأسه في مجال استكشاف الفضاء، مع ما يعنيه ذلك من منجزات جديدة.
ما يزال السفر عبر الفضاء الخارجي مغرياً لنا نحن البشـر لأكثر من اعتبــار. فهناك أولاً دافع الشغف الذي ما فتئ يحثنا على استكشاف المجهول. ثم هناك الأهمية الاستراتيجية للسبق في التحكم بالأجواء الفضائية لأسباب اقتصادية وعسكرية عدة.
هكذا ومنذ سبعة عقود، تتواصل محاولات إيجاد وسائل أجدى وأرخص للسفر إلى الفضاء الخارجي. وشهدنا خلال السنوات الماضية تطبيقات جريئة لأفكار بدت شاطحة لأول وهلة، في مشهد أقرب ما يكون إلى صندوق الرمل في ساحة ألعاب العلماء والمهندسين المنتمين في جلّهم لمراكز أبحاث حكومية وعسكرية.
فحتى وقت قريب، كانت الجهات الحكومية، أو تلك الممولة من الحكومات، هي الوحيدة المخوّلة للاستثمار في التجربة الفضائية وتحمّل تبعات الفشل أو النجاح. هكذا تم توظيف أجيال من العلماء والمصممين وسمح لهم بالمغامرة بالموارد والأموال لإنتاج مركبات (صواريخ أو مكوكات أو سواها) يسعها أن تفلت من جاذبية الأرض وتتجاوز غلافها الجوي محملة بالبشر والعتاد لتنفذ مهامها بسلام وبدون خسائر.
لكن مفردة “خسارة” أعلاه بحاجة إلى إعادة تعريف. فخلال 70 عاماً من عمليات اكتشاف الفضاء، فإن فلسفة “الصاروخ” كانت تعتمد إلى حد كبير على مركبة تقوم برحلة واحدة ذهاباً ثم تتحول إلى خردة. وحتى مع المركبات المأهولة بما فيها مشروع المكوك الأمريكي، فقد كان يتم “التخلص” حرفياً من أطنان من العتاد الزائد بدءاً من خزان الوقود الهائل وانتهاء بآلاف القطع والأجزاء الصغيرة، ناهيك عن مخلّفات الأقمار الصناعية وحطام عشرات العمليات الفاشلة والتي انتهت كلها إلى تكوين سحابة حقيقية من النفايات الفضائية؛ أطنان وأطنان من شظايا وبقايا أجهزة الكمبيوتر الغالية وقطع الغيار المدعمة بطبقات ثمينة من الذهب والبلاتين ومخازن الطاقة الشمسية عديمة الجدوى. كلها تدور حول كوكبنا بلا هدف مهددة عمليات الملاحة الفضائية اللاحقة في مثال شنيع لثقافة الهدر غير المحسوب في الموارد.
بالنهاية فإن مشروع إطلاق أية مركبة فضائية هو خاسر من ناحية الجدوى الاقتصادية. هكذا ومن منظور استثماري، بات القطاع الخاص، المتحمس لمنافسة الحكومة واقتحام قطاعات جديدة من سوق الترحال الفضائي، مهتماً في المقام الأول بتقليل الخسائر إلى أقصى حد.
المستثمرون يفكِّرون بشكل مختلف

تلك التركة من المشكلات التقنية، إضافة إلى الفرص المتاحة من حلها أو تجاوزها، لفتت أنظار الكثير من المستثمرين والمغامرين في الولايات المتحدة وأوروبا، وبالذات أولئك الذين يمتلكون خبرات نتيجة لخوضهم تجارب ريادية تقنية حلوا بها بعض المشاكل الأرضية. والذين، بعد أن نجحت مغامراتهم الأولى وبات لديهم من المال ما يكفي لتأمل النجوم. باتوا يرون المشكلات التي تواجهها المؤسسات الفضائية وبدأوا العمل على حلها بعقلية ريادية وتجارية.
أولى المشكلات التي تمَّت مواجهتها تعلقت بالتكلفة العالية وهدر الموارد المصاحبين لكل عملية انطلاق خارج الغلاف الجوي للأرض.
أدرك هؤلاءالرواد التقنيون أن عملهم لوحدهم قد لا يساعد على إيجاد حل فعال سريعاً. فاجتمعوا وأطلقوا مسابقات بجوائز مليونية لاستقطاب الموهوبين ذوي الحلول الثورية التي ينقصها التمويل.
 أشهر تلك المسابقات كانت إكس برايز “XPrize” التي وعدت في عام 1996 بعشرة ملايين دولار رصدتها “جمعية السياحة الفضائية” لأول جهة تنجح قبل عام 2005م في إطلاق المركبة الفضائية نفسها في رحلتين خلال أسبوعين تُقل كل منهما ثلاثة ركَّاب إلى ارتفاع لا يقل عن ثلاثمائة وثلاثين ألف قدم والعودة بهم سالمين إلى الأرض. فجّر ذلك الإعلان قنبلة من الحماس في أوساط المهتمين بتقنيات الطيران، وانبرى للمنافسة أكثر من عشرين فريقاً من أنحاء العالم. وفاز في النهاية المغامر والمهندس الأمريكي بورت روتان بمركبته سبايس شيب ون “SpaceShipOne”. وجاء هذا الشكل الجديد من الرحلات الفضائية بالمركبة نفسها ومن دون مخلفات ولا تضحيات في الأرواح والمعدات مختلفاً تماماً عن نمط الترحال بالمكوك الفضائي الذي يهدر ثلاثة أرباع مكوّناته عنوة بين رحلتي الانطلاق والعودة.
أشهر تلك المسابقات كانت إكس برايز “XPrize” التي وعدت في عام 1996 بعشرة ملايين دولار رصدتها “جمعية السياحة الفضائية” لأول جهة تنجح قبل عام 2005م في إطلاق المركبة الفضائية نفسها في رحلتين خلال أسبوعين تُقل كل منهما ثلاثة ركَّاب إلى ارتفاع لا يقل عن ثلاثمائة وثلاثين ألف قدم والعودة بهم سالمين إلى الأرض. فجّر ذلك الإعلان قنبلة من الحماس في أوساط المهتمين بتقنيات الطيران، وانبرى للمنافسة أكثر من عشرين فريقاً من أنحاء العالم. وفاز في النهاية المغامر والمهندس الأمريكي بورت روتان بمركبته سبايس شيب ون “SpaceShipOne”. وجاء هذا الشكل الجديد من الرحلات الفضائية بالمركبة نفسها ومن دون مخلفات ولا تضحيات في الأرواح والمعدات مختلفاً تماماً عن نمط الترحال بالمكوك الفضائي الذي يهدر ثلاثة أرباع مكوّناته عنوة بين رحلتي الانطلاق والعودة.
كما لو كانت سيارات أجرة
هنا استرجع المستثمرون زمام المبادرة، وبشّروا بعصر من السياحة الفضائية أو التنقل الفضائي على متن مركبات أشبه ما تكون بالتاكسي الفضائي. تطلبها فتأتيك حيثما تكون -في الفضاء الخارجي- وتعيدك إلى الأرض سالماً. أو توصل قمراً صناعياً إلى مداره وتعود سالمة لتستخدم لاحقاً كما يليق بأي شاحنة خدمة توصيل، فتوفّر بذلك ملايين الدولارات ومئات ساعات إعادة البناء والصيانة مثلما تحقق فعلاً مع الصواريخ التي أنتجتها شركة سبايس إكس “SpaceX” لصاحبها المستثمر ورائد الأعمال الشهير إيلُن مَسك الذي يعد أبرز المتقدمين في هذا الصدد. وعبر استثمار مبدئي بلغ 100 مليون دولار، نجح مَسك وفريقه في تحقيق نجاحات كان أبرزها إطلاق صاروخ محمّل بكبسولة (اسمها التنين) تم وصلها بمحطة الفضاء العالمية (ISS) بنجاح صيف 2012. وفي ربيع 2013 حقق صاروخهم الثاني الملقب بـ (الجندب – Grasshopper) إنجازاً بالانطلاق والتحليق 30 ثانية قبل العودة رجوعاً إلى نفس نقطة الإطلاق، مدشناً زمن الصواريخ متعدد الاستعمال!
 من الجميل أن هذه الصواريخ التي يبدو أحدها وكأنه لعبة تُقاد بعصا تحكم كالتي تستخدم في ألعاب الفيديو، ومع ذلك فهي ذات إمكانيات عالية ويمكنها إطلاق الأقمار الاصطناعية بنجاح تام. ويمكن أن جمع أكثر من صاروخ واحد لمهمة تحتاج إلى طاقة أكبر، بــدلاً من بناء صاروخ جديد لهذه المهمات الخاصة، ثم تعود كلها إلى الأرض كي تستمر في العمل.
من الجميل أن هذه الصواريخ التي يبدو أحدها وكأنه لعبة تُقاد بعصا تحكم كالتي تستخدم في ألعاب الفيديو، ومع ذلك فهي ذات إمكانيات عالية ويمكنها إطلاق الأقمار الاصطناعية بنجاح تام. ويمكن أن جمع أكثر من صاروخ واحد لمهمة تحتاج إلى طاقة أكبر، بــدلاً من بناء صاروخ جديد لهذه المهمات الخاصة، ثم تعود كلها إلى الأرض كي تستمر في العمل.
في سبتمبر 2016 أعلنت شركة سبايس إكس “SpaceX” نواياها للوصول إلى المريخ، وجعل السفر الفضائي سياحة متاحة للجميع. وقد بدأت بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن أسعار التذاكر كما ولو أن الرحلات ستبدأ غداً. ولكن إلى أي حد تُعد هذه التوقعات منطقية؟ وهل صواريخ-أجرة هذه الشركة تعمل وفق رؤية واقعية؟
التجارب السابقة لإطلاق وعودة الصواريخ لم تنجح جميعها. والصاروخ الوحيد الذي نجى من التجربة أعادوا إطلاقه مرة أخرى قبل أسابيع في 27 مارس 2017. وقد حمل معه قمراً فضائياً وضعه في المدار لحساب شركة ” SES ” التي كانت مهتمة جداً بأن تكون أول من يستخدم صاروخاً معاد الاستخدام ويطير من دون طيّار.
إن إعادة استخدام الصواريخ لمثل هذه المهام تحل أكبر مشكلة تواجه المستثمرين والعلماء في مجال أبحاث الفضاء، وهي التكلفة المادية العالية. فبدل أن تدفع عشرات الملايين على كل إطلاق صاروخي. فأنت تدفع بضعة ملايين. وفي هذا المجال من الأبحاث والاستثمارات، تُعد توفيراً عظيماً. خاصة أن بعض أجزاء الصاروخ يمكن إعادة استخدامها حتى 100 مرة. لكن إيلُن مَسك يؤكد أنهم لن يستخدموا أجزاء الصاروخ أكثر من 12 مرة في هذه المرحلة.
وعلى الرغم من سلسلة من التجارب الفاشلة بين عامي 2013 و2016، ونزاع قضائي مع الجيش الأمريكي وناسا انتهى بتحالف مثير للإعجاب، يبدو أن مَسك شديد التفاؤل بالمقبل، فهو يؤكد على عمل حسومات لمن يستخدم مركباته أكثر من مرة. ويؤكد أنه سوف يعيد إطلاق هذا الصاروخ الناجح في هذه المرحلـة أكثر من عشر مـرات. ولِم لا؟ فهو يَعُدُّ هذا النجاح مجرد خطوة أولى لاستعمار المريخ، والرحلات الفضائية السياحية.
 هذه الثقة العالية في القدرة على استشراف المستقبل لم تتأتَ من فراغ بل تمت تعبئتها بغرور الريادي الذي نجح في تحقيق فكرة بدت مجنونة. بل لأن هذه المرحلة التي نتكلم عنها الآن، تطلبت في الحقيقة 15 سنة على الأقل من العمل التحضيري للوصول إلى ما وصل إليه الرجل وفريقه. وبدأوا اليوم بالتخطيط النظري بناء على ما سبق، لإيصال مركبة فضائية إلى المريخ. هذه المركبة الفضائية تعتمد على الصواريخ معادة الاستعمال، لأنها ستحتاج حسب تقديراتهم تعبئة وقودها ثلاث مرات. وهذه المهمة سيقوم بها صاروخ يحمل الوقود إلى المركبة الفضائية بعد أن يساعد في إطلاقها أول مرة.
هذه الثقة العالية في القدرة على استشراف المستقبل لم تتأتَ من فراغ بل تمت تعبئتها بغرور الريادي الذي نجح في تحقيق فكرة بدت مجنونة. بل لأن هذه المرحلة التي نتكلم عنها الآن، تطلبت في الحقيقة 15 سنة على الأقل من العمل التحضيري للوصول إلى ما وصل إليه الرجل وفريقه. وبدأوا اليوم بالتخطيط النظري بناء على ما سبق، لإيصال مركبة فضائية إلى المريخ. هذه المركبة الفضائية تعتمد على الصواريخ معادة الاستعمال، لأنها ستحتاج حسب تقديراتهم تعبئة وقودها ثلاث مرات. وهذه المهمة سيقوم بها صاروخ يحمل الوقود إلى المركبة الفضائية بعد أن يساعد في إطلاقها أول مرة.
كما أن التقدم العلمي المنتظر لحل مشكلات فضائية نواجهها لا يمكن حلها برمي الفرضيات في الهواء. بل يتوجب العمل والتجربة وحتى تحمل تكلفة الخطأ. ودخول الاستثمار التجاري على هذا المجال وبطريقة عمل المستثمرين التجاريين والرياديين سيدفع بعجلة التقدم أكثر، ويدفع العلماء إلى التفكير بتقليل التكاليف المادية والبشرية مما ييسر عمل التجارب وجعل تكلفة الخطأ قابلة للاحتمال لمن استثمر في الأفكار الجديدة. والمزيد من التجارب يعني المزيد من الحلول والمزيد من الحلول يعني المزيد من الاستكشاف والمزيد من الاستكشاف يعني المزيد من المعرفة، وهلم جرا..
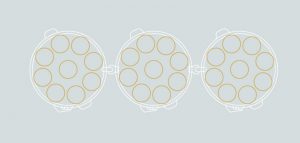 النتيجة الأخرى على هامش هذا التقدم العلمي هي إعادة تحفيز الشباب وصغار السن على دراسة هذا المجال والتعرف عليه أكثر. فمنذ أن خطا نيل أرمسترونغ على تراب القمر، لم تأتِ الأخبار بما يثير الشهية حقاً لمعرفة المزيد عن هذا المجال العلمي المدهش حتى صارت عبارة “علم الصواريخ” كناية عن الصعوبة البالغة في الفهم والتنفيذ، ويتم تصنيف المهتمين بمثل هذه العلوم بأنهم “مهووسين” و”غريبي الأطوار”، ويَعدون د د أن من يفكر بدراسة أو قراءة هذه المعلومات يعاني من مشكلة عقلية تبدأ بالعبقرية المجنونة وتنتهي بمتلازمة آسبرقر.
النتيجة الأخرى على هامش هذا التقدم العلمي هي إعادة تحفيز الشباب وصغار السن على دراسة هذا المجال والتعرف عليه أكثر. فمنذ أن خطا نيل أرمسترونغ على تراب القمر، لم تأتِ الأخبار بما يثير الشهية حقاً لمعرفة المزيد عن هذا المجال العلمي المدهش حتى صارت عبارة “علم الصواريخ” كناية عن الصعوبة البالغة في الفهم والتنفيذ، ويتم تصنيف المهتمين بمثل هذه العلوم بأنهم “مهووسين” و”غريبي الأطوار”، ويَعدون د د أن من يفكر بدراسة أو قراءة هذه المعلومات يعاني من مشكلة عقلية تبدأ بالعبقرية المجنونة وتنتهي بمتلازمة آسبرقر.
إن ريادة الفضاء الآن تدخل مرحلة مهمة تأخرت كثيراً، وهي كسر قيود الحصرية والتكاليف. وقد يكون جيل أبنائنا شاهداً على وطء قدم الإنســان الأول على المريخ. وقد يذهب أحـد أحفادنا للسياحـــة هناك، وهي كلها إرهاصات لمرحلـة التاكسي الفضــائي التي نشهدها نحن اليوم.